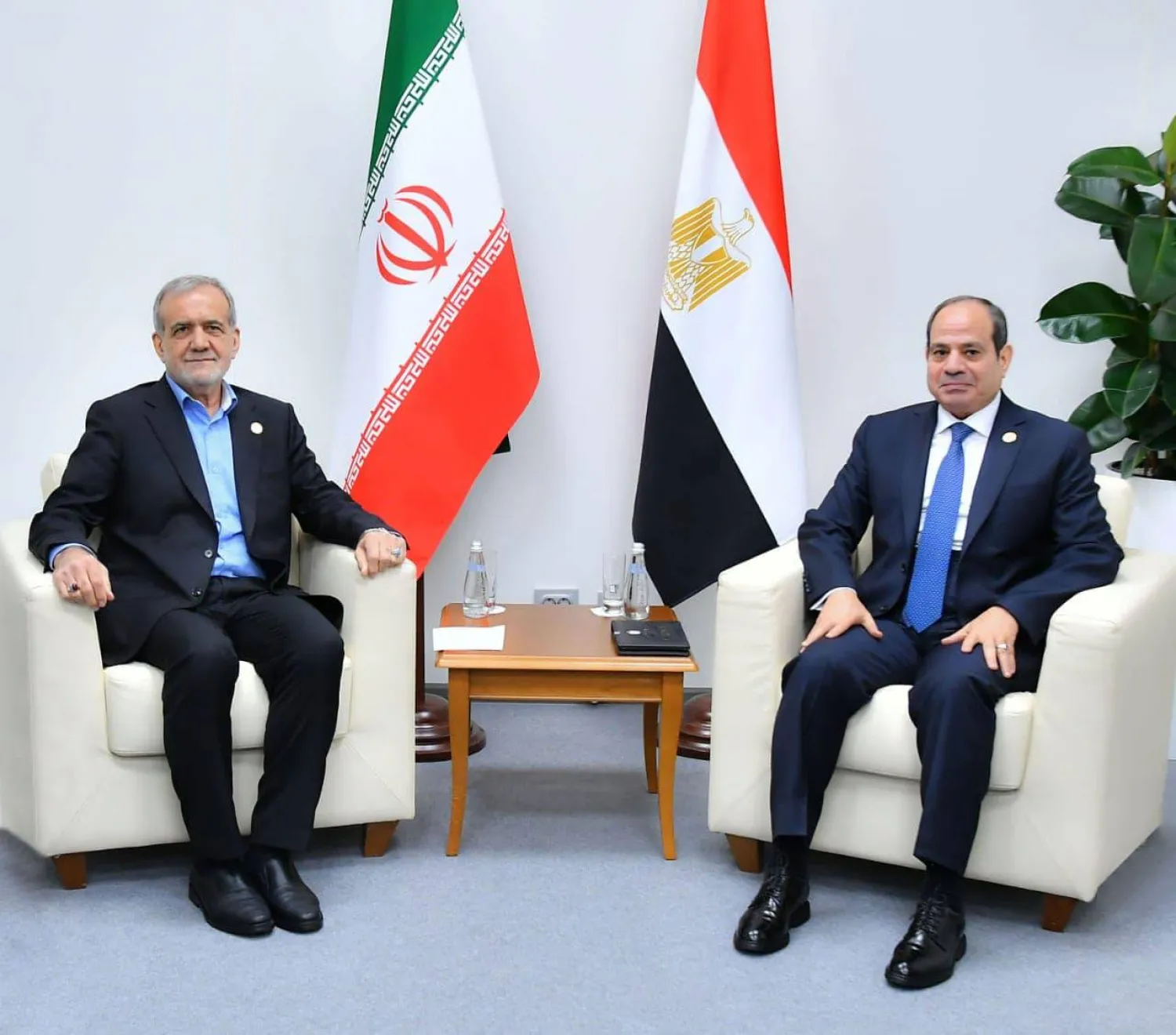بعزل الرئيس عمر حسن أحمد البشير، بثورة شعبية عارمة، مستمرة حتى الآن، طُويت صفحة نظام «الإنقاذ الوطني»، الذي جثم على صدور السودانيين لثلاثة عقود، ذاقوا خلالها الأمرين، من تقتيل ودمار للاقتصاد، وعزلة دولية وحروب لا تنتهي.
ولا يزال الثوار في الشارع، بعد عزلهم الرئيس البشير في 11 أبريل (نيسان) الحالي، يصارعون من أجل اجتثاث بقايا النظام، واقتلاع جذوره.
وبرحلة سريعة عبر سنوات نظام «الإنقاذ الوطني»، الذي جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكري، في 30 يونيو (حزيران) 1989. نجد أن العنوان الأبرز هو إقصاء الآخرين، وشن الحروب الداخلية، واتخاذ القرارات الخاطئة تجاه القضايا الدولية، ما أدخل السودان في عزلة دولية قاسية استمرت لسنوات. وأدرج السودان في قائمة الإرهاب، لاستضافته أسامة بن لادن، والإرهابي الدولي إلييتش راميريز سانشيز، المعروف باسم «كارلوس».
رأس النظام عمر البشير، هو أول رئيس على السلطة، تُوجه إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية، بسبب حرب دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف مواطن. وارتكب البشير «أم الكبائر»، حين أدت سياساته إلى فصل جنوب السودان، الغني بإنسانه وثرواته، واستقلاله بدولته، وفقد بسببه السودان ثلث سكانه، وثلث أراضيه، و85 في المائة من صادراته الخارجية، وعلى رأسها «البترول».
خطة الانقلاب
خطط الإسلاميون، للوصول إلى الحكم منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، عبر ما يسمى بمشروع «الحركة الإسلامية» لاستلام السلطة، ونجح عراب الحركة الإسلامية حسن عبد الله الترابي، منذ انشقاقه عن جماعة «الإخوان المسلمين» بداية السبعينات، في بناء تنظيم قوي، وفي خلق قاعدة جماهيرية وسط الطلاب والمهنيين؛ نافس بها فيما بعد تحت مسمى «الجبهة الإسلامية»، الأحزاب التقليدية، ومن بينها حزبا «الأمة» بقيادة الصادق المهدي، و«الاتحادي الديمقراطي» بقيادة محمد عثمان الميرغني.
في انتخابات 1986 حصلت «الجبهة الإسلامية» على 51 مقعداً في البرلمان عن دوائر الخريجين؛ إلا أنها سارعت إلى الانقلاب على الحكم الديمقراطي في نهاية عقد الثمانينات.
بدأت «ثورة الإنقاذ» متشددة آيديولوجيا؛ ومبرراتها آنذاك أنها استولت على السلطة بانقلاب عسكري، وتواجه مخاطر محلية ودولية كبيرة، ولم تعترف بالتداول السلمي للسلطة؛ واستمرت سيطرتها على السلطة بعسف القوة الأمنية.
عهد التمكين
قام نظام الإنقاذ بفصل الآلاف من الموظفين في كل القطاعات، وصاغ لذلك قانوناً أطلق عليه «قانون الصالح العام»، بموجبه أدخل عناصر «الجبهة الإسلامية» إلى كل المناطق الحساسة في الدولة، دون مراعاة للكفاءة أو المؤهلات، وفي ذات الوقت شرد مئات الآلاف من الخبراء والكفاءات، ما أفسد جهاز الدولة، بل أصبحت الدولة هي «الجبهة الإسلامية»، والجبهة هي الدولة، فضعفت الخدمة المدنية، وسهل الاعتداء على المال العام، الذي أصبح يوزع بين المحاسيب بـ«لا هدى ولا سلطان».
وفي هذا يقول القيادي الإسلامي المقرب من الترابي، المحبوب عبد السلام؛ إن قيادة الحركة الإسلامية مارست ما أسماه «التخطيط الاستراتيجي»؛ وفي الوقت نفسه حرصت على أن تكون لها رؤية وفكرة.
لكنها حين تسلمت السلطة، وجّهت مشكلة «إدارة الدولة والمجتمع»؛ وهنا جاء «مقتل الحركة الإسلامية»، فقد كانت تظن أنها مستعدة؛ لكن تحديات الدولة كانت ضخمة جداً. ويضيف عبد السلام، أن «الحركة الإسلامية» اعتمدت منهجاً أحادياً، ولم تعترف بالتنوع والتعدد في البلاد؛ واستولت على كل المسؤوليات وعزلت الآخرين؛ ما جعلها تواجه وحدها المشكلات المتراكمة، فانتقلت المشكلات من الدولة إلى داخلها، فانقسمت، وبذلك فقدت المرجعية الفكرية والتخطيط الاستراتيجي.
ومع استخراجها البترول، غرقت في الفساد، الذي قضى على آخر القيم الأخلاقية؛ لتعيش طويلاً كحكومة أمر واقع، بلا فكرة ولا تخطيط استراتيجي.
ويرى المحبوب أن أفراد النظام بحكم استمرارهم في الحكم لفترة طويلة، امتلكوا مقدرة كبيرة على المناورة والتكتيك والحصول على المكاسب؛ وظل موضوع الديمقراطية لديهم «مجرد تكتيك». ويقول: «انتهت (الإنقاذ) كما وصفها أحد كبار الإسلاميين، مثل غيرها من الأنظمة الديكتاتورية، بحكم طول المدة وثبات الوجوه والغرق في الفساد».
المفاصلة وعزل الترابي
بعد 10 سنوات من حكم «الإنقاذ»؛ انقلب البشير على شيخه الترابي؛ وأدت «مذكرة العشرة» الشهيرة إلى المفاصلة في العام 1999؛ التي انقسمت بموجبها الحركة الإسلامية إلى حزبين؛ وقف خلالها كثير من تلاميذ الترابي إلى جانب البشير؛ فذهب الترابي ومعه «القلة» ليؤسس حزب الضرار «المؤتمر الشعبي».
برّر البشير قراره بأن ازدواجية القرار (البشير – الترابي) داخل الدولة، هي التي دفعته للإطاحة بالترابي، بينما كان سعي التلاميذ الآبقين للمناصب الأعلى هو دافعهم الفعلي للتخلي عن «شيخهم» وعرّاب الحركة الإسلامية. بعد التخلص من الترابي؛ بدأت حقبة ثانية لحكم «الإنقاذ»، انفرد فيها البشير بالحكم المطلق؛ وساعده على ذلك «علي عثمان محمد طه» في الجهاز التنفيذي للدولة، و«نافع علي نافع» في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
الموقف من حرب الخليج الثانية
نشبت «حرب الخليج» الثانية، واحتل العراق دولة الكويت 1990. فاختار نظام البشير الموقف الخطأ من التاريخ؛ «مناصرة الجزار على الضحية». ووقتها كان كل العالم ضد «الغزو العراقي للكويت»، لكن نظام البشير اختار الوقوف إلى جانب «صدام حسين». بهزيمة صدام حسين، فقد السودان كل شيء، حلفاءه في الخليج وفي العالم، وحوّلت حكومة البشير بقراراتها الخاطئة، البلاد إلى دولة معزولة من كل العالم، ما اضطرها للارتماء في الحضن الإيراني السوري والجماعات الإرهابية المتطرفة جميعها، فأصبحت دولة «مجذومة» لا يقترب منها أحد، خوف العدوى والاتهام بالإرهاب.
استضافة بن لادن
كان نظام «الإنقاذ» على أيام عرّابه حسن الترابي، يملك أحلاماً وطموحات أكبر من حجم بلاده وقدراتها، كان الترابي يطمع في حكم «العالم الإسلامي»، أو على الأقل أن يكون مركز قراره، لذلك فتح البلاد للجماعات المغضوب عليها والمطاريد، وزعامات المنظمات الجهادية المتطرفة في السودان، وأتاح لها إمكانات البلاد.
استضافت حكومة الترابي - البشير، زعيم القاعدة «أسامة بن لادن»، خلال الفترة بين عامي 1990 - 1996. فحوّل الرجل بإمكاناته المالية الكبيرة السودان إلى ساحة لممارسة أنشطة منظمته الإرهابية، وفي ذات الوقت، وفّر دعماً مالياً مقدراً لحكومة الخرطوم.
استضافة بن لادن وغيره من الإرهابيين في السودان، كانت نتيجتها فرض عقوبات دولية وأميركية على السودان، بقيت حتى بعد أن أجبرت الخرطوم على الطلب من الرجل مغادرتها، بعد أن رفضت واشنطن مقايضته بصفقة لكسب ودّها، وترحيله إلى أميركا في 1996، على عهد إدارة الرئيس «بيل كلنتون».
وبسبب استضافة بن لادن، ما يزال السودان على رأس «قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب»، التي أدرج فيها عام 1993، وما زال يعاني من آثار وجوده ضمن تلك القائمة سيئة الصيت، اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً.
استضافة «كارلوس»
بلغت ذروة استهتار نظام البشير بالقيم العالمية، باستقدامه للإرهابي الدولي الشهير «كارلوس»، والسماح له بالإقامة في السودان، على أمل أن توظفه في حروبها العبثية حول العالم الإسلامي، قبل أن يضطر إلى تسليمه إلى المخابرات الفرنسية «مخدراً» في عام 1994؛ ليدون في سجله فضيحتين، إحداهما فضيحة بيع حليفه بن لادن والتخلي عنه، وفضيحة الخروج من لعبة الاستخبارات الدولية خاسراً.
محاولة اغتيال الرئيس مبارك
أتت الطامة الكبرى حين حاول متطرفون إسلاميون «اغتيال» الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، برعاية وتمويل وتدريب سوداني، حمّل عرّاب الإسلاميين الترابي وقتها المسؤولية عنه لنائبه «علي عثمان محمد طه».
جرت المحاولة الفاشلة، أثناء مشاركة مبارك في القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، لكنها فشلت، وتحملت الخرطوم المسؤولية الجنائية والأخلاقية والسياسية والدبلوماسية الناتجة عنها، واتُّهم بذلك مسؤولون سودانيون بارزون في حكمه بالضلوع في الجريمة غير المسبوقة.
وتعدّ محاولة الاغتيال واحدة من «الأخطاء الغبية» المسجلة في دفاتر نظام البشير، فلم يحدث في تاريخ العالم أن حاولت دولة اغتيال رئيس دولة أخرى في أراضي دولة ثالثة، وكان الثمن السياسي الذي دفعه السودان عليها كبيراً.
حرب دارفور
يواجه الرئيس المخلوع اتهامات من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، بسبب الحرب الأهلية التي أشعلها في الإقليم عام 1994، بسبب إصداره قراراً بتقسيم الإقليم إلى عدة ولايات. منذ تلك اللحظة، اندلع تمرد مسلح قامت به «حركة تحرير السودان»، قبل أن تنقسم إلى عدة حركات مسلحة، ووجد التمرد وقوده بسبب «عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع».
تصدّت حكومة البشير للاحتجاجات المسلحة، بعنف هائل، نتج عنه نحو 300 ألف قتيل، جُلّهم من المدنيين، ونزوح نحو 3 ملايين آخرين، وفق البيان الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 2008.
حكومة البشير رفضت التقرير، وقالت إن عدد القتلى لا يتعدى 10 آلاف شخص. وفي مارس (آذار) 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحقّ الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لتضاف في عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في مذكرة قبض ثانية، ليصبح البشير بذلك أول رئيس على السلطة يواجه أوامر قبض من محكمة لاهاي.
عهد النفط
استغل نظام «الإنقاذ» الإنتاج النفطي الذي بدأ من العام 1998، بـ«600» ألف برميل في اليوم، لدعم عملياته الحربية في دارفور والجنوب، وفي تمويل ميليشياته المنتشرة في أجزاء السودان، ومن أشهرها «الدبابين»، و«الدفاع الشعبي»، و«كتائب الظل»، و«الأمن الشعبي»، و«الأمن الطلابي» التابعة له ولحزبه (المؤتمر الوطني).
كما استخدم أموال النفط في إنشاء مؤسسات اقتصادية وصناعية لتمويل عملياته الحربية، وتكريس السلطة لديه. وأشهرها «مصنع جياد للأسلحة». ووزع ما تبقى من المال على من أطلق عليهم في آخر أيامه «القطط السمان» من قادته وعملائه.
فصل جنوب السودان
زادت «الإنقاذ» الحرب الأهلية في جنوب السودان وقوداً بتحويلها من حرب بين الحكومة المركزية وحركة تمرد إلى «حرب جهادية»، وصراع بين الإسلام والمسيحية والكفر، ما أدى إلى قتل أكثر من مليوني شخص، ونزوح أعداد مثيلة إلى داخل البلاد، ولجوء أعداد كبيرة إلى خارج البلاد.
وبسبب ضغوط دولية وتهديدات وإغراءات، وقّعت الخرطوم اتفاقية عرفت باتفاقية «السلام الشامل» مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، التي يقودها الراحل جون قرنق دمبيور في العام 2005. منحت تلك الاتفاقية حقّ تقرير المصير، بموجب استفتاء أجري في العام 2011. وصوّت بموجبه أكثر من 98 في المائة من سكان الجنوب لصالح الانفصال، وتكوين دولتهم المستقلة. وبانفصال جنوب السودان، فقد السودان ثلث مساحته، وثلث سكانه، وأكثر من 85 في المائة من عائدات النفط التي أصبحت من حصة الدولة الوليدة.
وبسبب انفصال جنوب السودان، واجه حكم البشير أزمة اقتصادية خانقة؛ لأنه فقد نحو 85 في المائة من الإيرادات التي كانت ترد إلى خزينة الدولة؛ ما أسهم بشكل كبير في تضعضع حكمه. ويعد فصل جنوب السودان، واحداً من أكبر كبائر النظام، وسيدون التاريخ في سيرة الإسلاميين والبشير، أنه الرئيس الذي «قسّم بلاده»، في ظاهرة مخجلة نادرة عالمياً في التاريخ. انفصل الجنوبيون، لأن البشير حوّل الحرب ضدهم من حرب على مطالب سياسية وتهميش اقتصادي، إلى حرب «جهادية» وإلى حرب «عرقية»، استمرت طويلاً.
انتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013
لم تتوقف الاحتجاجات الشعبية ضد نظام البشير، فمنذ أيامه الأولى واجه تمرداً في الجيش، ومحاولة انقلابية قمعها بقسوة شديدة، وأعدم من دون محاكمات أكثر من نحو 30 ضابطاً من خيرة ضباط الجيش السوداني. توالت الإعدامات والتصفيات والقتل غدراً للمعارضين، لتبلغ ذروتها في الاحتجاجات الشعبية التي شهدت البلاد في سبتمبر 2013، وكادت تطيح حكومته.
اضطر النظام إلى زيادة أسعار الخبز والسلع الرئيسية، فاندلعت مظاهرات هادرة شملت معظم المدن الرئيسية في البلاد، وتمركزت بشكل أساسي في العاصمة الخرطوم، فواجهها النظام بعنف مفرط، ما أدى إلى مقتل نحو 100 شهيد، ولم تقدم الجهات التي قتلت المتظاهرين لمحاكمات حتى قيام ثورة أبريل التي أسقطته، وينتظر أن تفتح ملفات هؤلاء القتلى، وتقديم الجناة للمحاكمات.
الحوار الوطني
استخدم البشير «الحوار» وسيلة لتمديد أمد حكمه، ولذلك قاد حوارات مطولة مع الحركات المتمردة بادئ الأمر، توصل خلالها لاتفاقيات كثيرة، لكنه كان يتنصل عنها، ولا يوفي بوعوده ومواثيقه، لكن مع ذلك جابت وفود التفاوض مع الحركات المسلحة مدناً وعواصم عالمية كثيرة؛ أبوجا، أديس أبابا، نيروبي، القاهرة، الدوحة، دون الوصول لسلام حقيقي. حين فشل البشير في خلق الاستقرار في البلاد، وضاق عليه الخناق، لجأ إلى حيلة مكرورة، أطلق عليها الحوار الوطني، استمر سنين مع أحزاب وحركات مسلحة صغيرة أو منشقة عنه. لكن المعارضة الرئيسية والحركات المسلحة الكبيرة، قاطعته ورأت فيه «حواراً داخلياً» بين النظام والموالين له، ومع هذا، فإن النظام لم يوفِ بما تم التوصل إليه في هذا الحوار، على الرغم من أن ضامنه الفعلي كان البشير شخصياً.
بقيت البلاد على حالها، إلى أن اضطر البشير لحل الحكومة التي تشكلت وفقاً للحوار الوطني وعرفت باسم حكومة «الوفاق الوطني» في 22 فبراير (شباط) 2019، وإلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد على إثر الاحتجاجات التي اندلعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، بروفسور حسن الساعوري؛ إن انقلاب «الإنقاذ» مرّ بأربعة تقلبات مهمة؛ حاول فيها الانتقال من حكم عسكري إلى ديمقراطي، بدأ ذلك باللجان الشعبية؛ والتوالي السياسي؛ ومن ثم اتفاقية «نيفاشا» للسلام، التي حدث فيها توافق بين القوى السياسية، حتى انتخابات 2010. ويضيف أن المرحلة الرابعة كانت الحوار الوطني؛ الذي قاطعته القوى السياسية المدنية والمسلحة؛ وهي التي رفضت من قبل مشروع التوالي السياسي، وواجهت محاولات «الإنقاذ» في التحول من نظام عسكري إلى حكم مدني؛ بسبب رفض الكيانات السياسية الرئيسية لها في البلاد.
ويشير الساعوري إلى أن الحركة الإسلامية كانت الحاكمة والموجهة للنظام والمسيطرة على القرار في الدولة حتى العام 1992؛ لينفرد بعدها الدكتور حسن الترابي بالحكم حتى العام 1999. حين حدث الفصال بين الحركة الإسلامية وتفرقت إلى حزبين؛ ولم تنجح محاولات إعادة الحركة الإسلامية في إعادة توجيه الأمور.
انتشار الفساد
سخّرت «الإنقاذ» إيرادات البلاد لمنسوبيها، واستخدمت المال العام أداة للبقاء في الحكم، ما أدى في النهاية إلى حالة «الإفلاس الشامل» التي تمثلت في عجز الحكومة وشللها الكامل، خاصة في السنين الأخيرة.
وتقدر إحصاءات غير رسمية إيرادات النفط وحدها بنحو 90 مليار دولار، الرقم الفعلي غير معروف بسبب تكتم النظام عليه، لكنها لم تستخدم في تنمية البلاد، بل ذهبت إلى تمويل الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام، وإلى جيوب ذوي الحظوة منه.
أثرى رموز النظام ثراء فاحشاً، وبنوا القصور الشامخات، وتزوجوا النساء ثلاث ورباع، وربما «خماس وسداس»، في الوقت الذي عاش غمار الناس في فقر مدقع. حتى المشروعات «الفاشلة» مثل مشروعات السدود والطرق والجسور التي يباهي بها النظام، لم تستثمر فيها أموال البترول، بل شيدت بـ«قروض مجحفة» تركها على عنق السودان، ما زاد ديون البلاد من 12 مليار دولار أميركي حين تسلم السلطة تقريباً، إلى أكثر من 50 ملياراً تقريباً.
ويتردد أن مليارات الدولارات وضعت في حسابات شخصية لرموز النظام، وعلى رأسهم المعزول عمر البشير، الذي كشفت «ويكيليكس» في واحدة من تحقيقاتها أن أرصدته في بريطانيا وحدها بلغت 9 مليارات دولار، فضلاً عن مليارات الدولارات التي يستثمرها أو أودعها رجال النظام في ماليزيا، لدرجة أن صحيفة محلية ماليزية نقلت أن «أموال السودانيين المودعة في بنوك ماليزيا»، تجعلها في المرتبة الثانية للأموال الأجنبية في البلاد.
حصاد الفساد الإنقاذي كانت نتيجته الفعلية سقوطه المدوي في 11 أبريل الحالي، في الثورة الشعبية التي استمرت 4 أشهر، وبدأت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قبل أن تتحول للمطالبة بتنحية البشير وحكومته. سقط نظام البشير وترك البلاد بلا سيولة، وعجزت البنوك والمصارف عن تلبية حاجة عملائها للنقد، فيما خلت خزائنها من النقد الأجنبي، وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني ليصل في عام واحد من 6.8 جنيه للدولار إلى نحو 80 جنيه للدولار الأميركي الواحد.
حكم الفرد
أما في المرحلة الأخيرة لحكم «الإنقاذ»؛ فقد انفرد البشير في الأشهر الستة الأخيرة بالحكم؛ وأصبح هو الناهي والآمر؛ ولم يعد هناك وجود لحزب المؤتمر الوطني؛ ما أدى إلى ارتباك النظام، فسقط منذ تلك الفترة؛ وليس في 11 أبريل الحالي، لحظة أن أجهزت عليه ثورة الأشهر الأربعة الأخيرة.
يقول المحبوب عبد السلام، إن الوجه الأخير لثورة «الإنقاذ الوطني» كان عنوانه «حكم الفرد»، وهو شيء شبيه بما حدث في الاتحاد السوفياتي؛ فقد بدأت «الإنقاذ» وهي ترفع شعار «حكم الشعب»، وانتقلت لحكم الحزب، لتنتهي بحكم الفرد؛ الذي لم يدمر الإسلاميين وحدهم، بل دمر السودان نفسه.