كان الكاتب والمفكر الفرنسي ألبير كامو، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1957، يقاسي من ندرة الأصدقاء، ويعاني من الخيبات المتتالية التي تسبب بها من كان يعدهم أصدقاءه، ويقول: «الصديق هو الذي يصل عندما يكون الجميع قد ذهبوا». ولأن كامو لم يكن إنساناً عادياً بأي معيار، كان من الصعب جداً أن يقيم صداقات تصمد في وجه الزمن الذي يعري الحقائق، وتنحل في مائه الأوهام.
لكن ثمّة صداقة في حياة صاحب «الغريب» و«الطاعون» شذّت عن هذه القاعدة، واستمرّت منذ نشأتها في عام 1946 حتى وفاته في حادث سيارة، عندما كان عائداً إلى باريس مطلع عام 1960؛ إنها الصداقة التي ربطته بالشاعر الكبير رينيه شار الذي يقال إنه نام ذات ليلة في خريف 1982 مع جائزة نوبل، ليستفيق في اليوم التالي وقد «اختطفها» منه غابرييل غارسيا ماركيز.
أربعة عشر عاماً من الصداقة الوطيدة التي كانت تترسّخ يوماً بعد يوم، كما تشهد المراسلات التي جمعتها دار «غاليمار» التي كان كامو يتولّى رئاسة تحريرها، عندما نشر أوّل ديوان وضعه شار خلال انخراطه في المقاومة المسلّحة ضد الاحتلال النازي. أكثر من مائتي رسالة تشهد على أن الأخوّة ممكنة بين المبدعين، وتنفي القول بأن الصداقة بين أهل الفكر لا يمكن أن توجَد خارج أعمالهم، وتدحض الاعتقاد السائد بأن قراءة مراسلات الكتّاب غالباً ما تؤدي إلى الخيبة.
يقول رينيه شار إن أوّل عهده بألبير كامو كان خلال وجوده مع المقاومة الفرنسية، عندما أهداه أحد الأصدقاء نسخة من «الغريب»، لكن الظروف يومذاك «حالت دون أن أخصّص ما يكفي من الحلم لقراءة تلك الرواية التي لم تترك عندي عميق الانطباع».
قبل اللقاء، كان شار وكامو ينسجان على المنوال السياسي نفسه في الجبهة المناهضة للفاشيّة والنازيّة والاستعمار الفرنسي في الجزائر، حيث كان يعيش كامو ويكتب في صحيفة «الجزائر الجمهورية»، قبل أن يضطر للمغادرة منفياً بسبب مواقفه وأفكاره. وفي الجزائر، انضمّ كامو إلى الحزب الشيوعي الفرنسي عام 1935، لكن ما لبث أن تركه عندما قرّرت قيادة الحزب أن النضال ضد الاستعمار لم يعد بين أولوياتها.
كان كامو وشار يجتمعان على استحالة الفصل بين الالتزام السياسي والاجتماعي من جهة، والإنتاج الفكري والفني من جهة أخرى. «ليس في الظلماء مكان للجمال؛ كل المكان هو للجمال»، كان يقول شار، ويردّ عليه كامو بقوله: «قبل النبع، ثمّة أرض يتبجّس منها النبع، وينثال فيها الماء».
الكتابة لم تكن ولادة طبيعية عند أي منهما، وكان لا بد لها، في عنف صيرورتها واجتثاثها من رحم المخاض، من مجاورة أولئك الذين ينطقون بلغة الشعر، والذين يسمّيهم شار «الشفّافين». كلاهما كان يعيش في وحدة ذاتية عميقة، تولّدت منها صداقة راحت تتكشّف عن مساحات مشتركة بين مفكّرَين عملاقين يختلفان كثيراً عن بعضهما، لكنهما يترافدان في ذلك «الجدول الذي يسري تحت الأرض»، فتتجاوز الصداقة الحدود الفردية، وتتسّع أمامها مساحات الإبداع. صداقة معجونة بماء الإعجاب والمعرفة، تحترم وحدة المبدع وتصونها، رغم أن «الرغبة في كتابة الشعر لا تتحقّق إلا بقدر ما يولد هذا الشعر من أفكار ومشاعر تتفتّح بجانب حفنة نادرة من الرفاق»، كما يقول شار في إحدى الرسائل.
تذكر كاترين، ابنة كامو التي حفظت الرسائل وساعدت على نشرها، كيف «كانت زيارات شار إلى منزلنا تحمل البهجة التي تطفح بها تلك الشخصيّة الودودة، وتملأ المكان بالمرح والحياة». في الظاهر، لم يكن ثمّة ما يجمع بين الاثنين سوى ذلك الانتماء العميق إلى المتوسط، إلى «الجنوب الذي تعتمل بين ضفافه كل الأحزان». كان شار شاعراً فذاً «في مصاف رامبو وآبّولينير»، كما كان يقول كامو، وصديقاً للسورياليين وهايديغير، ترك المدرسة باكراً، وانصرف إلى المغامرات والأعمال التي كان يديرها والده في أسرة معروفة ميسورة. أما كامو الذين كان مدمناً على القراءة والكتابة منذ صغره، وعبقرياً في كل ما أنتجه من روايات ومسرحيات ومقالات، فقد وُلد في عائلة فرنسية فقيرة في الجزائر التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي، وكان متفوقاً في كل مراحل دراسته، ولافتاً لأنظار أساتذته وغيرة رفاقه الذين كان يجد صعوبة في التعايش معهم.
المراسلات التي تبادلها كامو وشار طوال عقد ونصف تحمل صورة مجتزأة عن تلك الصداقة التي تجاوزت التواصل الكتابي، وكانت تدور في المقاهي واللقاءات الطويلة والنزهات الريفية والرحلات الكثيرة بين باريس ومسقط رأس شار، حيث اشترى كامو منزلاً له بعد فوزه بجائزة نوبل. لكنها أكثر من مجرد قطعة أثرية جميلة يتهافت عليها عشاق هذين المبدعَين، ويغوص في ثناياها الاختصاصيون، بل هي الرواية التي كان الاثنان يحلمان بكتابتها معاً، ومعاهدة في الصداقة قلّ نظيرها في الأدب العالمي.
ويتضّح من هذه المراسلات أن شار كان الطرف الرائد في تلك الصداقة، فهو كان أكبر سناً من كامو الذي كان يشعر تجاهه بمزيج من المودة والاحترام والإعجاب، كان يتحوّل إلى ما يشبه السلطة التي نادراً ما تنضح من الرسائل التي غالباً ما كانت توحي بالعكس، كتلك التي يكتب فيها شار: «ألبير، أنت من القلّة النادرة من الناس الذين أكِّن لهم المحبّة والإعجاب في آن معاً». وفي كلام ماري كلود، أرملة شار التي ساهمت هي أيضاً في نشر الرسائل، ما يؤكّد ذلك عندما تقول: «كانت صداقة شفّافة صادقة، كما لو أنها من زمان مضى. لا سخرية فيها ولا محاباة، ولا مشاعر مبتذلة، كلاهما كان يأخذ الحياة والفكر على محمل الجِدّ، لكن من غير ادّعاء أو تكبّر. كانت إخوة في الحياة والالتزامات بحثاً عن العدالة والحقيقة والجمال».
في عام 1950، كتب كامو إلى صديقه شار يقول: «كانت هذه سنة صعبة جداً بالنسبة لي، وكنت أنت بين قلّة نادرة من الذين ساعدوني على الحياة، بفضل صداقتك وهذا الشعور الغريب بالأمل الذي يأتيني من هذه الصداقة. كم أنا محظوظ بمعرفتك!»، ويجيبه شار: «كلما تقدّم بي العمر، أدركت أن الحياة ممكنة فقط بجانب الذين ننعم بدفء مودتهم، ونذوق معهم طعم الحرية».
لم يتخلَّ أي منهما عن الآخر أبداً. معاً سعيا إلى حشد المؤيدين لمانيفست ضد ستالين، أو لمساعدة بوريس باسترناك الذي كان ملاحقاً من النظام السوفياتي، وكلاهما وقف ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر بجرأة كلفت كامو المنفى وعذابات نفسية كثيرة. وعندما نشر كامو كتابه الشهير «الرجل المتمرد»، الذي ينتقد فيه التوتاليتارية اليسارية، وانتفض ضدّه صديقه السابق جان بول سارتر الذي أصدر بحقه فتوى فكرية ضربت حوله حصاراً من الكتاب والشعراء والفنانين، وحده شار وقف بجانب صديقه الذي كان قد بدأ يشعر باليأس، كما يستدلّ من إحدى الرسائل الأخيرة التي كتبها: «تعبت من باريس، ومن العصابات التي تسرح فيها وتمرح. عندي رغبة عميقة في العودة إلى الجزائر، بلد الرجال، البلد الحقيقي القاسي الذي لا أنساه».
ألبير كامو ورينيه شار... مساحات مشتركة بين عملاقين
دار «غاليمار» تجمع رسائلهما المتبادلة
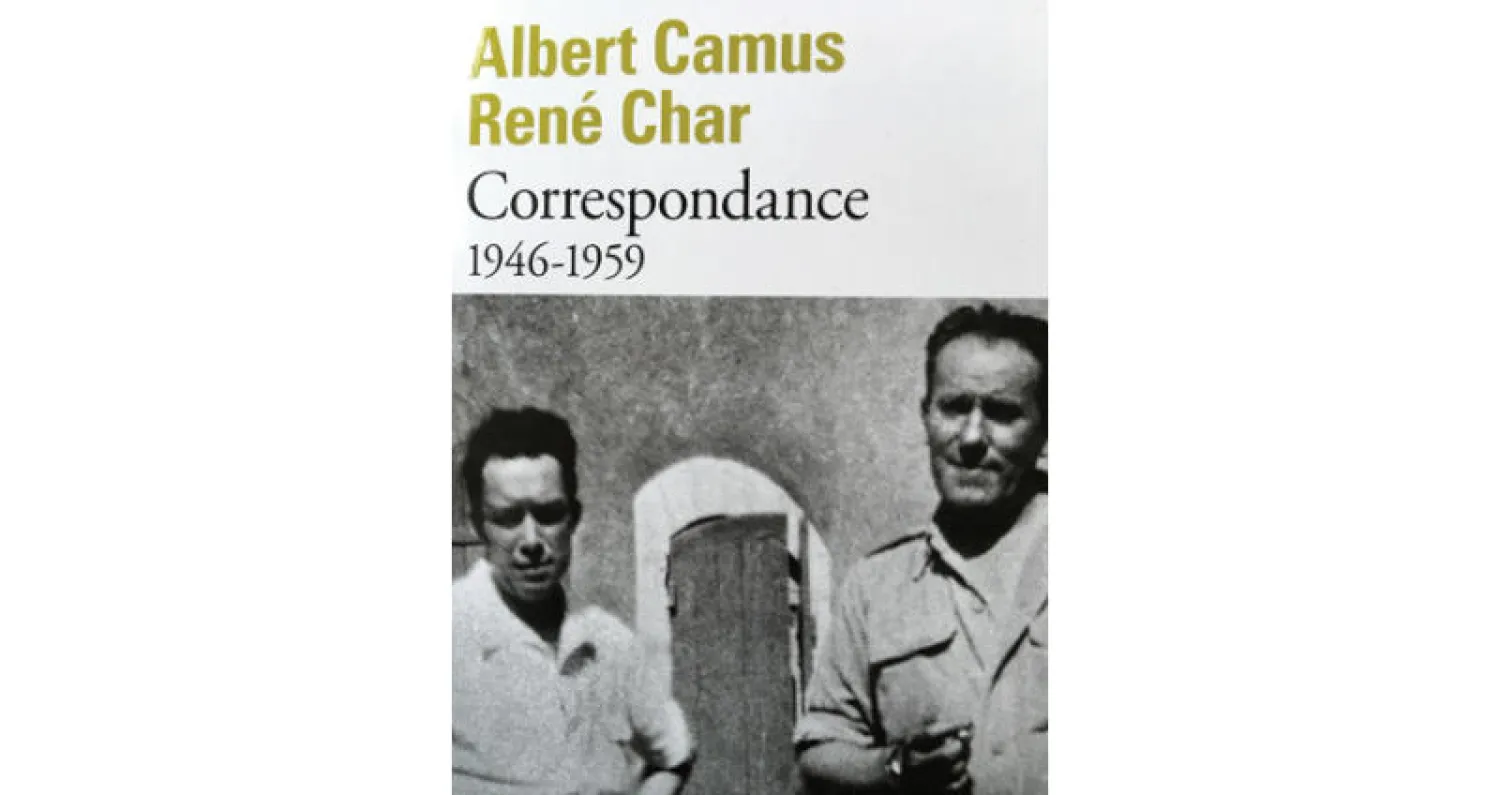

ألبير كامو ورينيه شار... مساحات مشتركة بين عملاقين
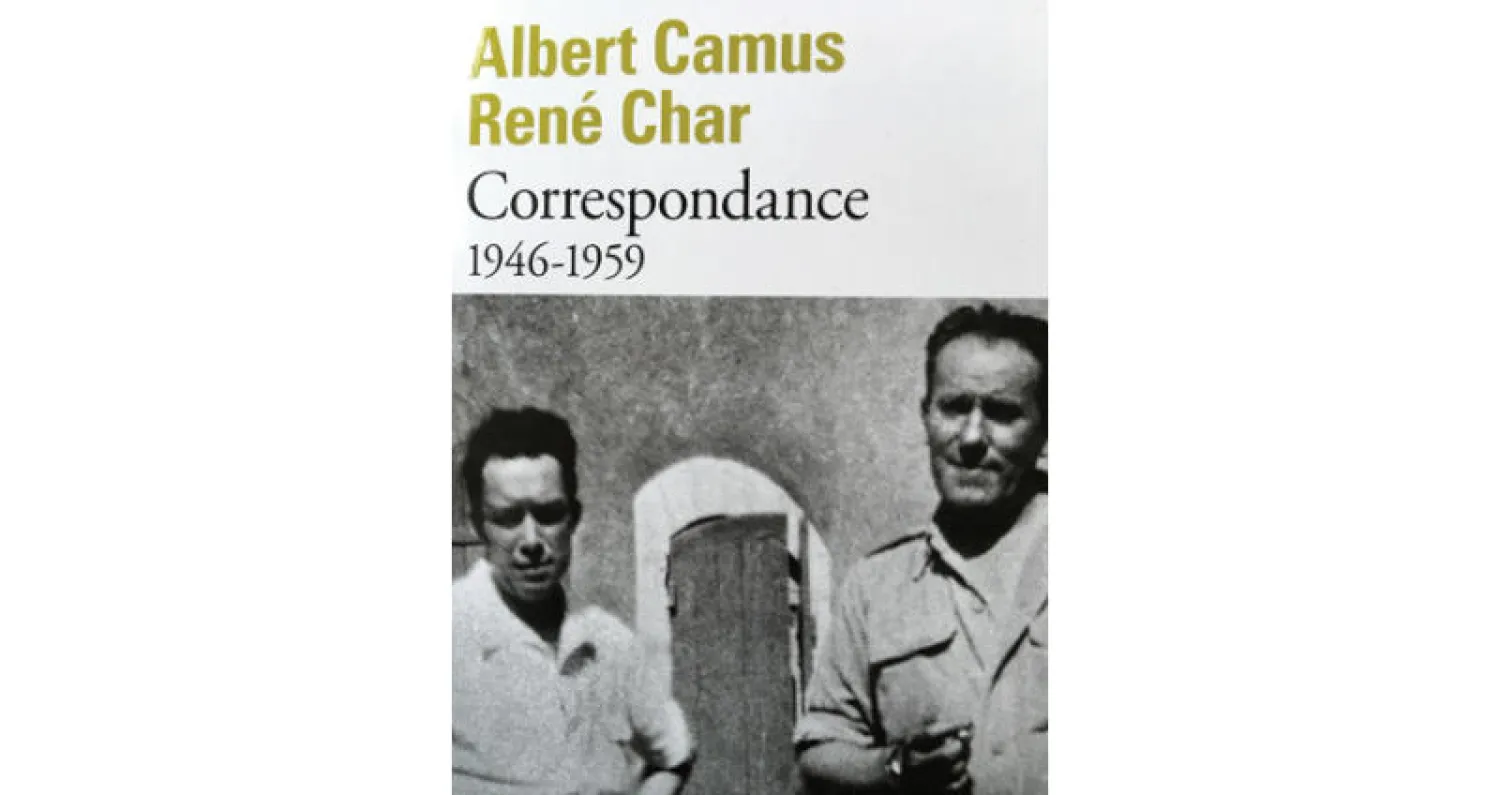
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة









