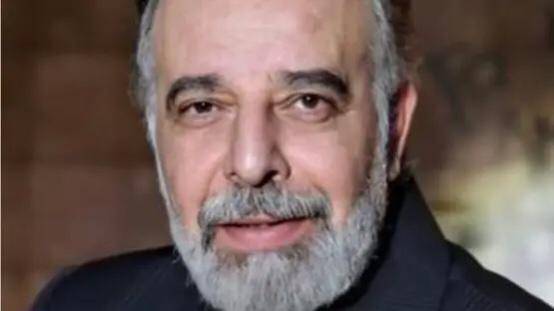من اللافت في جديد الحفريات الروائية العربية ما قدمت من تسريد للعبودية سواء في تاريخ قريب أم في تاريخ أبعد. ومن هذه الحفريات الروائية الحديثة ثلاث روايات سنتناولها هنا، وهي رواية «كتيبة سوداء» للمصري محمد المنسي قنديل، و«شوق الدراويش» للسوداني لحمّور زيادة (السودان): و«ثمن الملح» للبحريني خالد البسام.
تفتح «كتيبة سوداء» صفحة (السخرة) منذ عهد إبراهيم باشا. لكن الأهم هو ما تفتح من صفحة العبودية. فتاجر العبيد النوبي ود الزبير يبيع لرئيس القبيلة أربعين عبداً مقابل خمس بنادق، ويغريه بأن البنادق ستكون أداته في توطيد وتوسيع سلطانه. ويتحول العبيد إلى جنود في جيش الجهادية - جيش الخديوي. وسيكونون في عديد الأورطة السوداء الذي بلغ خمسمائة.
هكذا يترامى عالم الرواية من أعماق الغابات الأفريقية إلى المكسيك، ومن مصر إلى فرنسا وبلجيكا. ويصخب هذا العالم بالحروب وبالمؤامرات والأطماع والوحشية والصراعات في البلاطات وعلى الجبهات. وترمح بخاصة شخصية العبد الأسود الذي يفر من اصطياده فتوقعه رصاصة. وفي الكتيبة سيكون هذا الذي يُسمّي بالعاصي قائداً لمجموعة، وستختاره الإمبراطورة مرافقاً وحارساً ثم عاشقاً. وبينما يمضي الجنون بالإمبراطورة يصير العاصي واحداً من ثوار كومونة 1867. وفي دلالة مؤثرة، وفي وشفافية يختم الكاتب الرواية بطفلٍ ينجبه جوفان الذي يتعلق بمكسيكية، في إشارة أخرى وأخيرة إلى ما بين الذات والآخر.
- «شوق الدراويش» للسوداني زيادة
أما حمّور زيادة فيعود في روايته «شوق الدرويش» إلى القرن التاسع عشر، حيث يحفر فيما يمكن أن تدعى بسنوات الجمر في التاريخ السوداني. وتتمحور الرواية حول شخصية بخيت منديل الذي اختطفه تجار العبيد عندما هاجموا قريته، وباعوه في الخرطوم إلى سيد أوروبي سينتهك إنسانية العبد، ويغتصبه على امتداد أربع سنوات، حتى إذا فتحت المهدية الخرطوم وطردت منها الإنجليز والمصريين، اختفى السيد وتحرر العبد. ومن ممارسة بخيت لحريته كان تردده على الحانة ليشرب المريسة (الخمر)، حيث يقبض عليه، ويودع السجن عقاباً على جريمة الشرب. وينسى بخيت في سجن الساير سبع سنين حتى دخل الجيش المصري عقب سقوط الدولة المهدية، فتحرر بخيت، ومضى إلى مريسيلة حيث خطط للانتقام ممن تسببوا في مصرع محبوبته حواء - ثيودورا.
في الرواية نقرأ: «الوقائع أمواج تغطي ما سبقها بنشوة شريرة، فيعجز بخيت عن إدراك ما يحدث». ولعل هذا المقبوس على صغره أن يرسم اللعبة الفنية التي لعبتها الرواية وهي تحفر في التاريخ. وفي هذا الحفر تتلاطم مشهديات الجور التركي والعبودية والفقر والمجاعة والزحف المصري الإنجليزي إلى السودان، ومنه التنصير، وهنا تبرز شخصية ثيودورا الإسكندرانية المولد اليونانية الأبوين، والراهبة التي تحضر إلى السودان مبشّرة. وتلتقي ثيودورا ببخيت الذي يتعلق بها، بينما كانت في البداية تؤثره ولكن كعبد، كما كانت تنظر إلى السود عبيداً، وهي البيضاء المسيحية، وهم المسلمون الكفار. لكن ثيودورا ستخص ببخيت بدفترها التي تسجل عليه يومياتها، وهذه تعلّة روائية أخرى للحفرية التاريخية.
بسقوط أم درمان تقع ثيودورا في الأسر، ويقسرها سيدها على أن تسلم، ويسميها حواء ولأنها ترفضه يأمر بختنها، وينتهي الأمر بقتلها. وسوف يكتشف بخيت من أوقعوا بها، فيبدأ بالانتقام منهم بعد خروجه من السجن. وهكذا جاءت (شوق الدرويش) موّراة بالحب والوجد الصوفي، وصبوة الحرية ووحشية المستعبدين للعبيد.
- «ثمن الملح» للبحريني البسام
شكّل سؤال الأديب البحريني ناصر مبارك الخيري لجريدة المقتطف المصرية عام 1910. العتبة الأولى لرواية خالد البسام (ثمن الملح – 2016) كما يلي: «ما قولكم في بيع الرقيق: أفضيلة هو أم رذيلة، فإن كان الأول فلماذا يصادره الغربيون، وإن كان الثاني، فلماذا لا يقول بتحريمه رجال الدين في الشرق؟ ويقول الغربيون إن على هذا الداء الإسلام والمسلمين، فهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما سبب تأصله حتى صار يصعب قطع جرثومته من الشرق؟»
من هذه العتبة الوثائقية تمضي رواية (ثمن الملح) إلى وثيقة أخرى، فتنفتح بها على احتفال رأس السنة الأولى من القرن العشرين في مقر الحاكمية البريطانية في مدينة المنامة البحرينية. ثم تلي البرقية - الوثيقة التي تنقل تحرير البحرية البريطانية لثمانية عشر عبداً قرب مسقط على متن سفينة عمانية متجهة إلى دبي لبيعهم فيها. وقد فرّ العبيد، لكن أحد دلاّلي بيعهم عثر عليهم، ونقل إلى الكولونيل روبنستون أن من العبيد من يريد العودة إلى أسيادهم أو بيعهم مرة أخرى، فهم يرفضون الحرية. وستبين برقية - وثيقة أخرى أن معظم الرقيق المستوردين في مدينة صور العمانية، لهم رواج، وقد بيع الطفل منهم بمائة وعشرين دولاراً، وبيع العبد الذكر بمائة وخمسين، والفتاة بسعر يتراوح بين مائتين وثلاثمائة.
بعد هذه البرقيات تبدأ السردَ العبدة حنا من أسرة سيامي الحبشية، منذ بيع أبيها لها وهي ابنة الرابعة عشرة، وتروي حنّا من عبودية أبيها وخصاء الأمير له، وتعليق الخصيتين على باب المخصي بعد ولادة حنا التي تروي أيضاً من عبودية أمها الزنجية. وتأتي المشاهد المروعة من ميناء مصّوع العماني، حيث تحتشد السفن بالعبيد تحت حراسة مشددة من عبيد أشداء بانتظار الإبحار إلى جدة، ومنها إلى مكة والمدينة. ومن سوق العبيد تعصف مشاهد التجار والدلالين وشيوخ العشائر والجمهور، وخيام الكشف عن العبدات بعد بيعهن، وبيع العبد عارياً. والعبدة عارية.
كانت حنا من نصيب التاجر البحريني الفارسي الأصل محمد بن نصري الذي سمّاها (عبدة). وفي مقامها الجديد بين يدي عائشة زوجة التاجر، أحست عبدة أنها تولد من جديد وهي تحاول أن تتعلم اللغة والتقاليد العربية. وتظهر شخصيات العبدات الأخريات كالزنجبارية ميمونة والحبشية أم الخير. وتصف عبدة (حنا) المعاملة الوحشية العنصرية العبودية «لأننا ولدنا ببشرة سوداء (...) هذا هو ذنبنا وهذا هو عارنا».
تحدد الرواية هنا زمنها بسنة 1903. ويترهل السرد بالملخص الخاص بحياة التاجر محمد بن نصري. بيد أن السرد والشخصية المحورية سيتألقان كلما اتصل الأمر برقص عبدة وأول ذلك هو حفلة التاجر، حين شعرت كأن من حولهم هم العبيد لجسدها ورقصها وإثارتها، وليست هي العبدة.
تلك كانت «ليلة من الحرية» فرح بها العبيد والتجار والأمراء والإنجليز. وقد دفعت الليلة بعبدة إلى الجرأة فعوقبت بالسجن في القبو، حيث عالجت الوحشة والوحدة بالرقص في الظلام. ومن بعد، وفي التماعة كبرى أخرى في الرواية، تمضي عبدة إلى الكنيسة الأميركية في المنامة، وتشاهد الفرقة الموسيقية فينطلق السؤال: «لماذا هؤلاء العبيد سعداء بالمسيحية، ويعبرون عن تلك السعادة بالموسيقى؟ ولماذا نحن نشقى بعبوديتنا طوال الوقت؟». ويلوح السؤال: «هل الدين هو الذي يسعد أم لون البشر؟» وسيقول العبد العازف صموئيل لعبدة: «المسيحية الآن أعطتني الحرية ولا أريد أكثر من ذلك».
أخذ سؤال التخلص من العبودية يلهب عبدة: «أريد أن أصبح حرة». وفي سنة 1908 يساعدها بركات في تقديم طلب العتق إلى الحاكمية. وبعد حصولها على الورقة التي تمنحها العتق تلطمها موزة بما منح الرواية عنوانها: أنت يا ثمن الملح «هل تعرفين أنك لا تساوين حتى ذرة الملح؟ يا ثمن الملح الرخيص». ورغم أن عبدة التي ترفض تبديل اسمها، تحصل على حريتها، فإن العنصرية تلاحقها، فيتخلى بركات عنها لأن أهله يرفضون زواجه من سوداء: «يريدون من السود أن يكونوا خدماً لهم فقط وعبيداً تحت أقدامهم». وتختم عبدة الرواية بقولها: «لا زلت عبدة... لم تنفع الورقة ولا الحاكمية البريطانية في تغييري إلى حرة».
لا تخفي الوثائقية نفسها في هذه المدونة، لكنها تتفاوت في التسريد، كأن لا تخلو من الفجاجة في رواية «ثمن الملح» أو تبدع في التخفي كما في روايتي قنديل وزيادة. أما السؤال عن تركّز هذه الحفريات الروائية في العبودية - ومن ذلك أيضاً اشتباك العبودية بالعنصرية - فلعله في إقبال الرواية على العتمات التاريخية التي لم تكد تلتفت إليها بعد، ومنها تاريخ العبودية والعنصرية. وقد رأينا كيف كان القرن التاسع عشر. بخاصة موئل الروايات المعنية.