كأن كولن ويلسون الذي رحل في الخامس من هذا الشهر عن 82 عاما، ينتمي إلينا أكثر من انتمائه للثقافة الأنجلوساكسونية، بمعنى أنه احتل مكانا رفيعا في ثقافتنا، بينما عانى كثيرا من عدم الاعتراف به ككاتب، ناهيك بكونه مفكرا، في ثقافته الأصلية. فما إن ترجم كتابه «اللامنتمي»، الصادر عام 1956، حين كان ويلسون في الرابعة والعشرين من العمر، إلى العربية في منتصف ستينات القرن الماضي عن دار «العلم للملايين» حتى أحدث دويا هائلا. فنفدت الطبعة الأولى سريعا، وهو أمر نادر آنذاك، وتوالت الطبعات منه. وندر أن تجد مثقفا لم يقرأ الكتاب، وقلما خلت جلسة ثقافية من ذكر الرجل وكتابه. وهذا راجع في رأينا إلى طبيعة تلك الفترة المحتدمة، فكريا واجتماعيا، بعد الثورة الطلابية في فرنسا، والثورة الجنسية، وازدهار الأدب الوجودي، الذي انتقل إلينا مع الترجمات العزيزة التي أصدرتها دار الآداب البيروتية، وروجتها عربيا مجلتها «الآداب». لقد لبى «اللامنتمي» حاجة فينا في فترة التملل السياسي والاجتماعي والثقافي، وقدم لنا، دفعة واحدة، قراءات فريدة لكتاب قرأنا لهم أعمالهم، وأحببناهم، وكأنهم كائنات علوية لا تنتمي إلى عالمنا، نحن البشر.. لم نكن مطلعين على شخصياتهم الإنسانية، ودواخلهم، وتعقيداتهم النفسية والاجتماعية.. فجاء ويلسون ليقدمهم، ليس فقط كما هم، بل غار عميقا في دواخلهم، وأعاد قراءة أعمالهم، في ضوء ما سماه «ظاهرة الانتماء»، فبدوا لنا كشخصيات إنسانية شقية، بائسة، في صراعهم الفكري والنفسي مع ذواتهم ووجودهم، ومع الآخرين أيضا.
بتنا نرى نيتشه، وكامي، وباربوس، وتي إي لورنس، صاحب «أعمدة الحكمة السبعة»، وإتش جي ويلز، وفان كوخ، وإرنست همنغواي، وراقص الباليه الروسي الشهير فاسلاف نجنسكي في ضوء آخر تماما. فلورنس العرب، على سبيل المثال، ما عاد ذلك البطل الذي نسجت حوله أوهام كثيرة ارتبطت بدهائه ومقدراته السياسية والحربية، بل إنسان بائس لم يستطع إقامة حتى علاقة إنسانية بسيطة مثل الجنود الذين كانوا تحت إمرته، وظل طوال حياته يفتقد مثل هذه العلاقة. ولم نعد ننظر إلى فان كوخ على أنه إنسان فقد قواه العقلية، وإلى نجنسكي مجرد راقص باليه، اعتراه الجنون وهو على خشبة مسرح البولشوي احتجاجا على قسوة البشر، وغيرهم العشرات من كبار الفلاسفة والكتاب والفنانين الذين تناولهم ويلسون في كتابه. هؤلاء لا منتمون، بمعنى أنهم أكثر حساسية منا. إنهم يرون أكثر مما نرى، ويحسون بالغربة في واقع لا يتطابق مع رؤاهم، أو كما يريدون أن يكون، فينسحبون من هذا المجتمع إلى زواياهم الخاصة، تماما مثل شخصية بطل هنري بابوس في رواية «الجحيم» الذي يطل على العالم من خلال ثقب في جدار الغرفة. ولكنه يرى ما لم يره الآخرون. وهذه هي الفكرة الأساسية في كتاب «اللامنتمي».
ألبير كامي، صاحب نوبل، والشهير هنري باربوس، وإرنست همنغواي، مالئ الدنيا وشاغل الناس، وصاحب نوبل أيضا، الذي انتحر الرغم من كل مجده، جميعا كانوا يعانون من تراجيديا الانفصال بين المثال والواقع، ومن «مشكلة الهدف في الحياة»، حسب تعبير ويلسون نفسه. وحين يغيب هذا الهدف يتحول كل شيء إلى عبث وجودي لا معنى له. اللامنتمي يؤمن بأن لا شيء يستحق الفعل، وأنه لا يوجد طريق أفضل من الآخر. إنه فقط يراقب الحياة تمضي أمام عينيه. ومع الزمن، يتحول إلى مجرد رد فعل لفعل يقوم به الآخر. إنه، كما يقول بطل «الجحيم» لهنري باربوس، الذي لا اسم له، «أنا لا شيء، ولا أستحق شيئا». ولكن هذا لا يعني أن اللامنتمي، سواء أكان فنانا أم لا، إنسان عدمي. الأمر عكس ذلك تماما. إنه إنسان يبحث عن الحقيقة، ويرى أن كل ما في الوجود يصادر هذه الحقيقة، أو يطمرها تحت اعتبارات حياتية زائلة: المال، العائلة، النظام، المجتمع. من هنا، يرى ويلسون أن اللامنتمي هو صنيعة المجتمع البرجوازي، وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. فهذا المجتمع الذي بني على النظام والترتيب والحسابات المنطقية، عدو للأفراد الذين يتمردون على طبيعته السكونية، الباردة، الرياضية، التي تحسب كل شيء على حساب الانسجام والجمال، وتحقيق الذات. ونتيجة لذلك، يحصل الانفصام بين الفرد والمجتمع، وتحل الغربة حتى بين الفرد وذاته.
مثل هذه الأفكار وجدت صداها في المجتمعات الأخرى، ولكن ليس في بريطانيا. فالمؤسسة الثقافية في هذا البلد ظلت محصنة أمام التأثيرات التي يمكن أن تعكر «حياتها المنتظمة»، وتربك إيقاعها الموزون، وتفسد «ناسها المهذبين»، وتطرح أسئلة حول «طبيعة حياتها وعاداتها المحتشمة»، حسب تعبير الشاعر البريطاني الفاريس. لقد أحدثت الستينات خلخلة في المفاهيم الاجتماعية والأخلاقية إلى درجة القطيعة مع ما سبق، إلى هذه الدرجة أو تلك، وفي قسم كبير من البلدان المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، إلا في بريطانيا التي حافظت على انسيابها الطبيعي، ومن هنا لم يعرف الأدب البريطاني ظواهر مثل السوريالية - هذا إذا استثنيا ديفيد غاسكوين (1916 - 1999)، الذي عاش في فرنسا وتأثر بحركتها السوريالية - والوجودية، وأخيرا ظاهرة الانتماء. ولهذا السبب أيضا لا نجد دراسات نقدية تناولت هذه الظاهرة، كما في فرنسا. ولذلك ركز كتاب «اللامنتمي»، بشكل أساسي على الكتاب غير البريطانيين، ما عدا تي إي لورنس، صاحب «أعمدة الحكمة السبعة»، وكاتب الخيال العلمي إتش جي ويلز، لأنه لم يجد «كتابا لامنتمين» آخرين في الأدب البريطاني.
لم يستطع ويلسون، هذا الفتى المشرد، المفلس دائما، الذي كان يلتحف شوارع هامستيد في العاصمة البريطانية، والمنحدر من أب إسكافي، انتزاع اعتراف المؤسسة البريطانية به قط، على الرغم من أنه أصدر لاحقا نحو مائة كتاب، وظل هذا الأمر يعذبه طوال حياته. وكرد فعل على ذلك، تضخمت أناه إلى درجة مريعة. يقول في أحد اللقاءات معه: «لا بد أن يأتي ذلك اليوم الذي يعتبرونني فيه نبيا»، و« بعد خمسمائة سنة، سيقولون إن ويلسون كان عبقريا، لأنني نقطة فاصلة في التاريخ الفكري»!
وفي مقدمة طبعة لكتابه «اللامنتمي»، صدرت عام 2001، يردد ويلسون الشكوى ذاتها من تجاهل المؤسسة الثقافية له، مستشهدا بقول تي إس إليوت له بأن شهرته اتخذت الطريق الخاطئ، إذ من الأفضل أن تتحقق الشهرة شيئا فشيئا. ثم يذكر كيف أن المؤسسة لم تعد تعده «الطفل المعجزة» أو «المحتال»، بل تنظر إليه الآن بجدية بعد نشر كتاب له عن السحر والتنجيم، الذي نجح جماهيريا بالطبع. وكان ذلك وهما آخر من أوهام صاحب «اللامنتمي». فسرعان ما انتهى كل شيء. وانسحب الرجل إلى عزلته في مدينة كورنويل البريطانية، من دون أن يتوقف إنتاجه الغزير المتنوع إلى درجة غريبة: من علم النفس في «الإنسان وقواه الخفية»، و«أصول الدافع الجنسي»، و«الحاسة السادسة»، إلى الأبراج وحتى الفضاء «البرج.. عالم العناكب»، و«الدلتا عالم العناكب»، إلى «راسبوتين وسقوط القياصرة»، و« والجنس والشباب الذكي»، وعشرات غيرها، ترجم الكثير منها إلى اللغة العربية.
ماذا سيبقى من الرجل؟ نعتقد أن كتاب «اللامنتمي» سيبقى طويلا، فالمشكلات الوجودية والاجتماعية والثقافية، التي عالجها ويلسون مستعينا بعلم النفس والفلسفة وكم هائل من القراءات الروائية، والسير الذاتية، كالذات والآخر، والعزلة والانتماء، والقلق والوجود، وحرية الاختيار، والحب والجنس، وهي موضوعات كبرى شغلت الإنسانية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، لا تزال تشغلنا لحد الآن، وستظل تشغلنا طويلا.
ولا بد أن نذكر هنا، دور المترجم العراقي أنيس زكي حسن، الذي نقل كتاب «اللامنتمي» إلى العربية، واجتهاده في ترجمة العنوان الأصلي للكتاب «Outsider»، «إلى اللامنتمي»، معبرا بذلك عن الجوهر الأساسي للكتاب. والمفارقة، أن حسن، كان، بدوره، منتميا أيضا، وإن على طريقته. فبعد أن حقق هذه الترجمة الممتازة - من يقرأ النص الأصلي والترجمة العربية يتبين له صواب هذا الحكم-، وترجمات أخرى، منها لالبير كامي «أسطورة سيزيف»، و«السقطة»، و«الإنسان الصرصار» لدوستويفسكي، اختفى وكأنه شخصية من الشخصيات، التي تحدث عنها ويلسون في «اللامنتمي». ويذكر الكتاب علي حسين نقلا عن جبرا إبراهيم جبرا، أن حسن رفض عروضا من دار الآداب لترجمة أعمال أخرى لكولن ويلسون لقناعته أنها لا ترتقي إلى مستوى كتاب «اللامنتمي». إنه محق تماما. وهو رأي قسم كبير من النقاد البريطانيين، كما أشرنا، الذين يذهبون أبعد من ذلك، فيعدون أن كتاب «اللامنتمي» نفسه هو ليس أكثر من تجميع أفكار لكتاب آخرين، ويفتقر للعمق الفكري والنظري. لقد اشتهر الكتاب على المستوى الشعبي، وبيع بشكل واسع، ولكن لم يجر الاعتراف به على المستوى الأكاديمي والفكري قط، ما عدا كتابا قليلين جدا، كتبوا عنه مراجعات جيدة في الصحف البريطانية، وهذا كل شيء. لقد قتلوا الفتى حتى قبل أن ينضج، أو أنهم استكثروا عليه نضوجه المبكر جدا.
كولن ويلسون.. هل كان صاحب «اللامنتمي» عبقريا؟
رحل من دون أن ينال اعترافا به من المؤسسة البريطانية
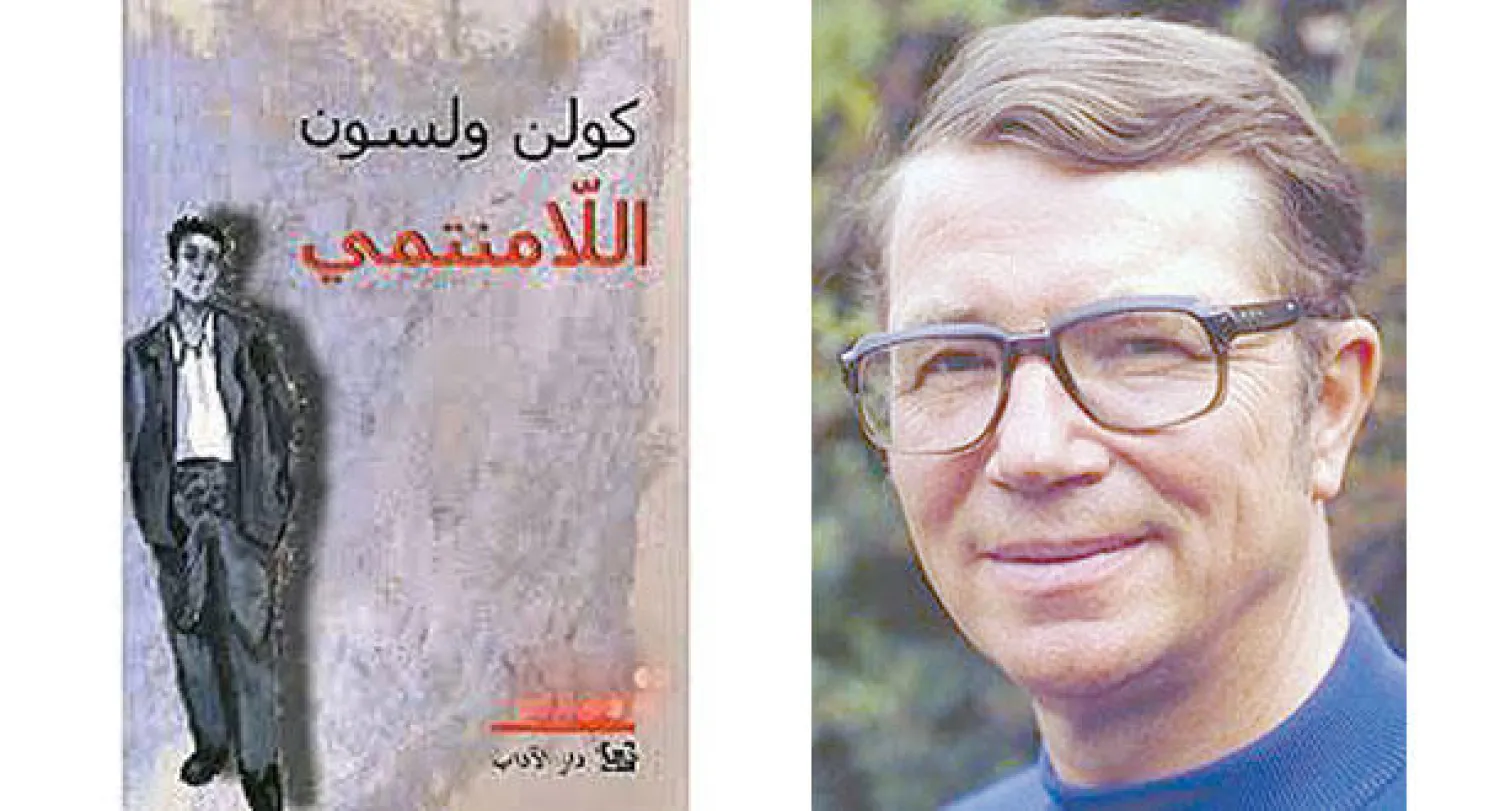
كولن ويلسون و صورة الغلاف

كولن ويلسون.. هل كان صاحب «اللامنتمي» عبقريا؟
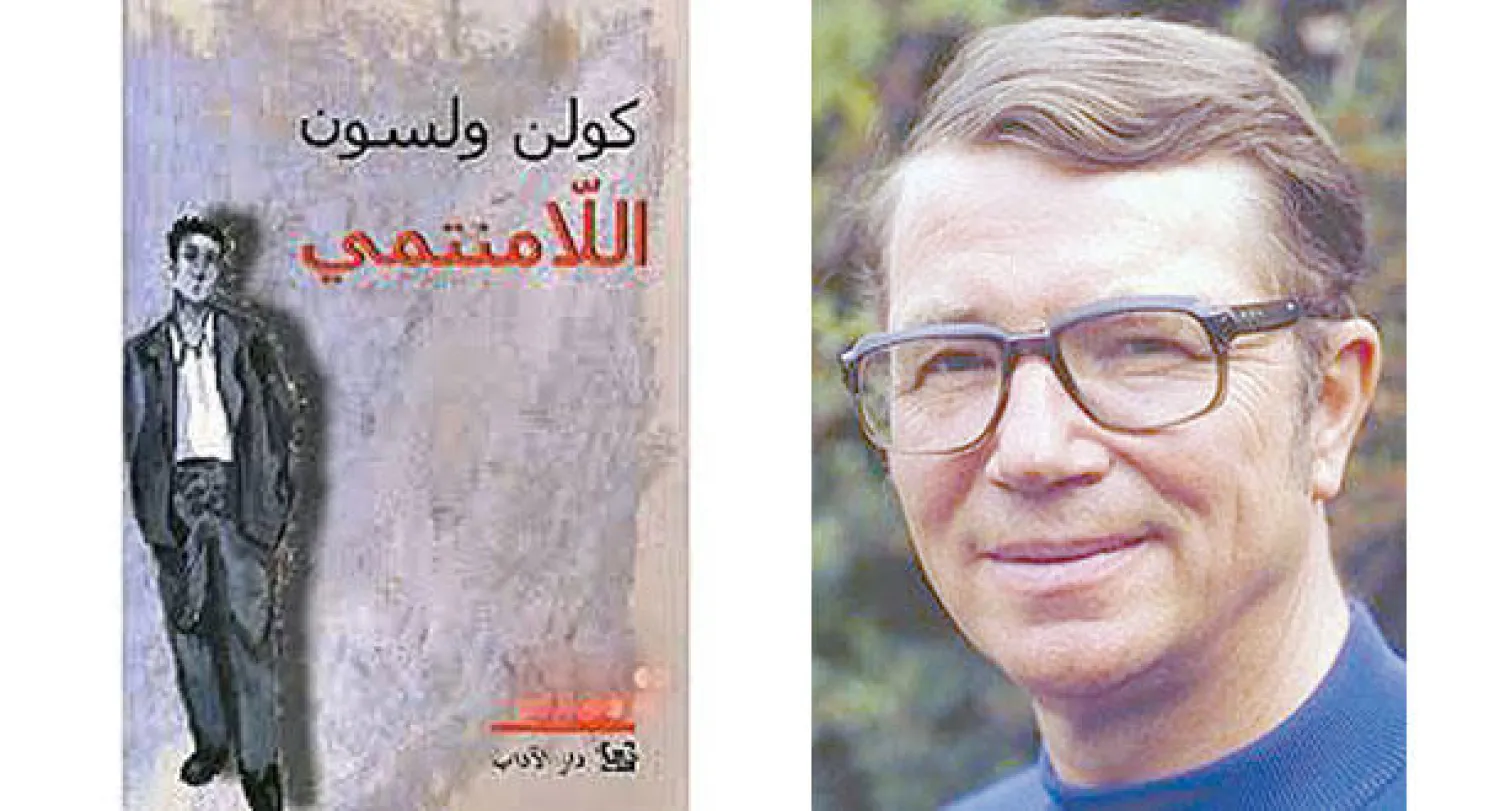
كولن ويلسون و صورة الغلاف
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة








