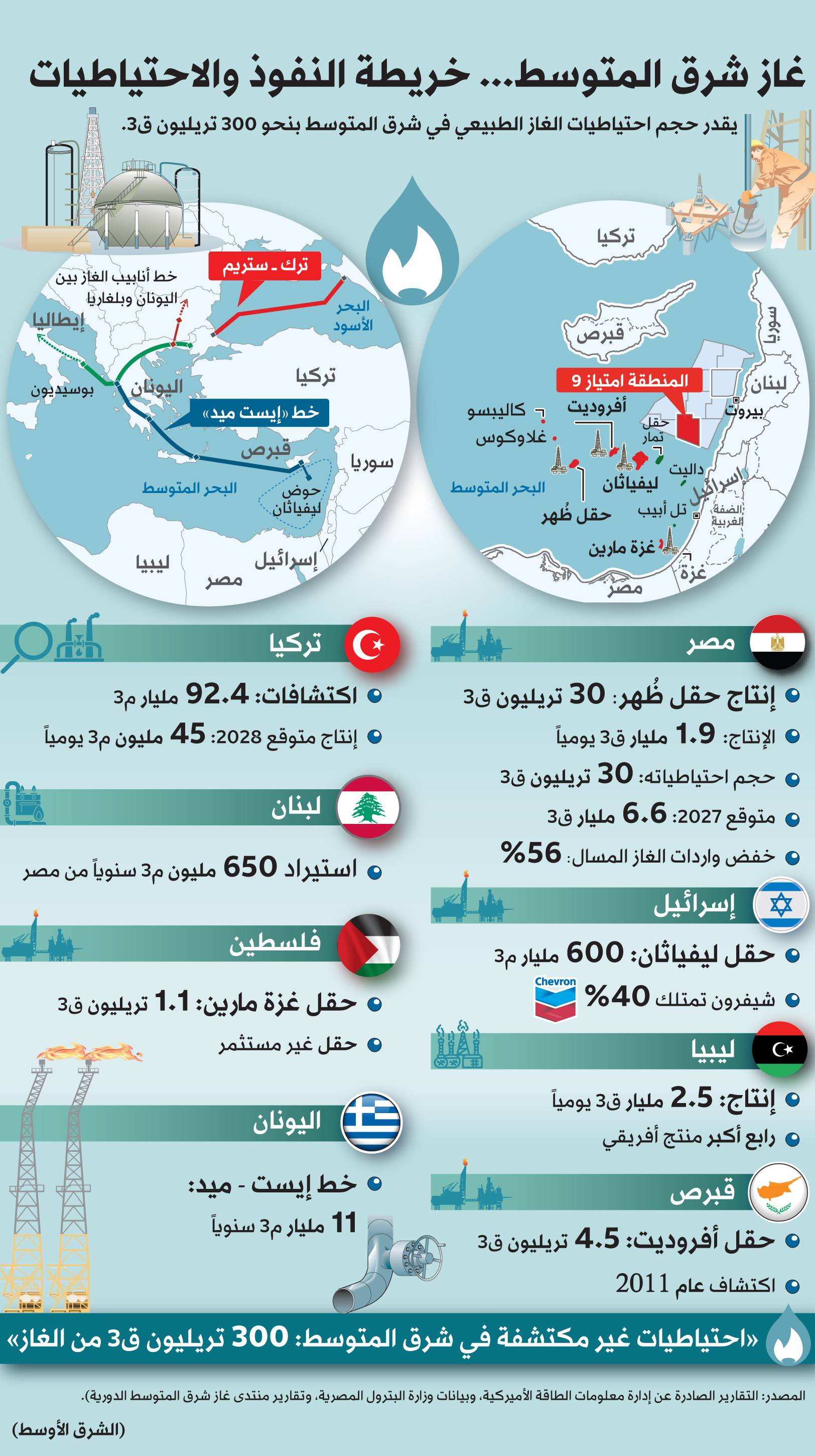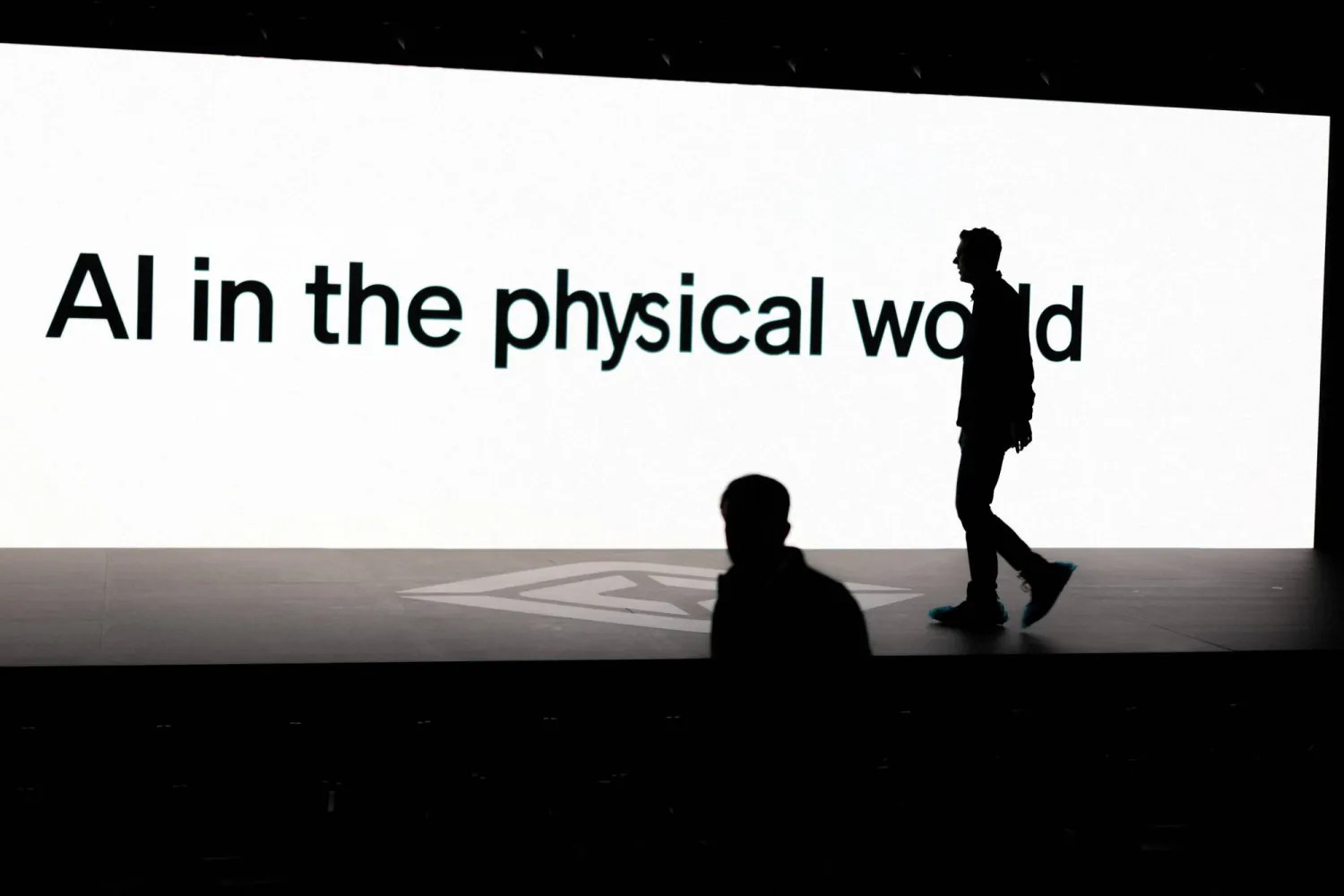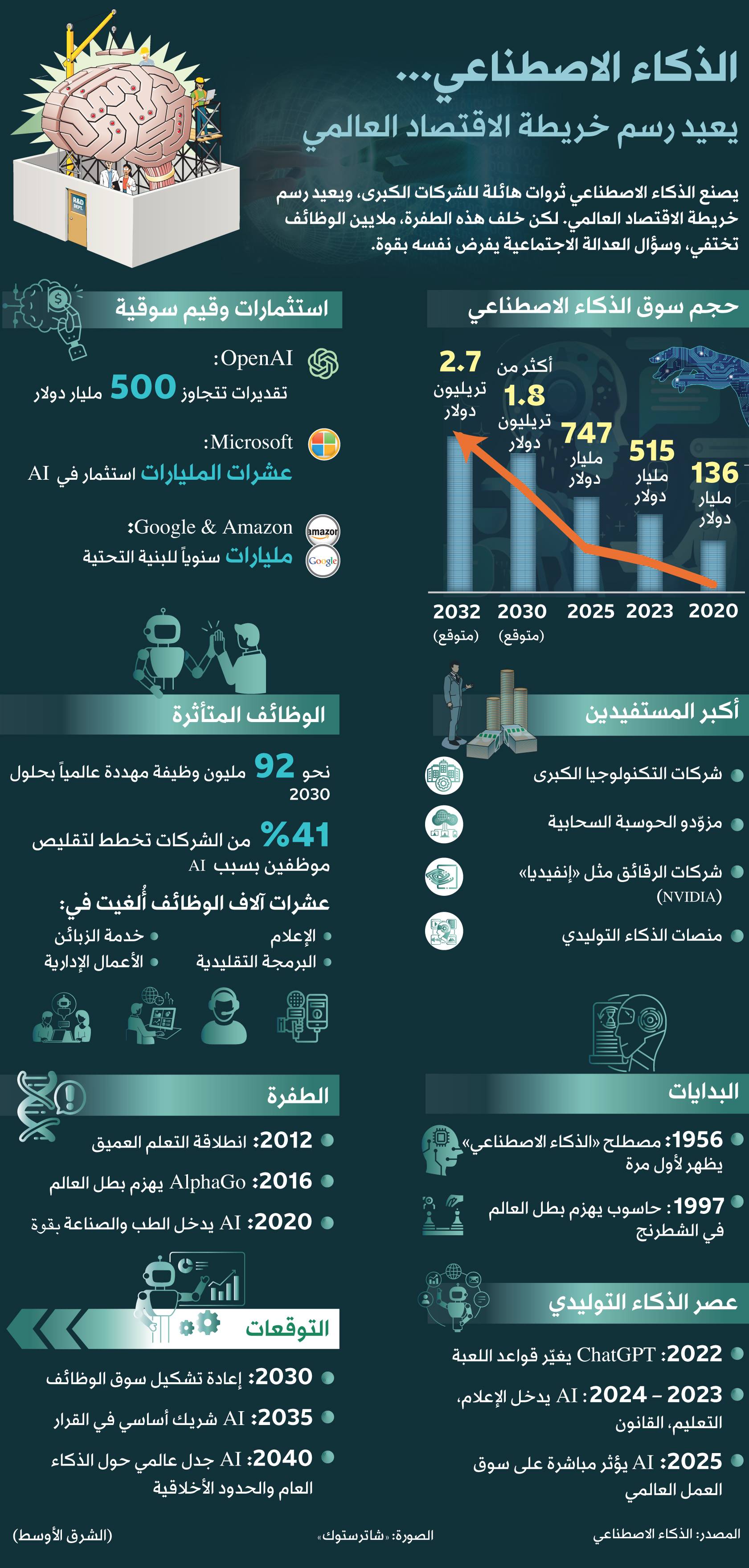ترتبط مسألة الغذاء ارتباطاً وثيقاً بكمية المياه المتوافرة، وتعتبر ذات أهمية حيوية. وعندما تخفت أصوات البنادق وطبول الحرب في المنطقة سيطغى الصراع على المياه في حوضي الفرات ودجلة، حيث سيكتسب النزاع السوري - التركي - العراقي حول مياه نهري دجلة والفرات بعداً دولياً، وقد تتحول المياه إلى سلاح رغم أن احتمال مواجهة عسكرية هي شبه معدومة، ويصبح خزان سد أتاتورك العظيم في تركيا سلاحاً بيد الحكومة للضغط على كل من سوريا والعراق.
ويتضمن تعبير «حرب المياه» في شرق البحر المتوسط استعمال المياه سلاحاً من أجل السيطرة على المنابع، أو تحويل المياه سلعةً تجاريةً تتحكم فيها دول المنبع القوية لأهداف سياسية.
أما في إيران، فإن المسألة لا تقل تعقيداً عن الدول المجاورة لها شرقاً. فمن جهة، فإن السدود التي أقامتها السلطات الإيرانية تعتبر ذراعاً رئيسية في البرنامج النووي. ومن جهة أخرى، فإن السلطات استخدمت السدود ومشروعات المياه وسيلةً لـ«الهندسة الاجتماعية»؛ إذ إنها نقلت المياه من مناطق الأقليات إلى «العصب الفارسي».
وإذا كان الجفاف ونقص المياه بين العوامل التي أدت إلى الحراك في سوريا وربما العراق، فإن احتجاجات مناطق الأحواز استندت إلى موضوع العطش ونقص المياه. كما أن مسؤولين إيرانيين باتوا يتحدثون بوضوح عن وجود «مافيا من المتنفذين» يهيمنون على ملف المياه، إضافة إلى أنهم يحذرون من «الإفلاس المائي» الذي يضاف إلى التحديات التي تواجهها طهران في الفترة الأخيرة.
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم ملفاً عن مشروعات المياه والتحديات المستقبلية في سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران:
عندما تخفت أصوات البنادق وطبول الحرب في سوريا والعراق، قد تظهر توترات جديدة بسبب المياه، خصوصاً في الصراع مع تركيا التي ينطلق منها نهرا الفرات ودجلة.
أدى القصف على الجماعات المسلحة في سوريا، والحرب في غرب العراق، إلى تدمير تجهيزات مصادر المياه من السدود والأقنية؛ ما أدى إلى نقص في المياه المتاحة ليس لأغراض للري وحسب، بل للشرب وتنشيط مناطق زلزاليّة؛ ما كان له تأثير على المياه الجوفيّة فيها في بلاد الرافدين، بل تعزى بداية الاحتجاجات في سوريا إلى القحط - الجفاف الذي لحق بمناطق الفرات ونزوح ما يقرب مليون مزارع إلى درعا لعبوا في الأزمة؛ الأمر الذي كان له أثر بالغ الضرر في المجالات الزراعية والبشرية وتربية الحيوان وإنتاج الطاقة.
ويتساءل كثيرون: هل هذه هي نقطة البداية، وهل ستعقبها أضرار كبيرة في المستقبل عند إتمام مشروع تطوير الأناضول جنوب شرقي تركيا (غاب)؟ إذ نتج من تدفق مياه نهر الفرات انخفاض في منسوب بحيرة الطبقة إلى درجة مخيفة، بحيث توقفت المولدات المائية، وانخفضت تغذية الكهرباء للمدن السورية، واضطر كثير من المزارعين السوريين على ضفاف النهر إلى بيع مواشيهم بأسعار متدنية لعجزهم عن توفير الأعلاف اللازمة لحياتها. كما نفقت الأسماك، كذلك فقد كثير من المزارعين محاصيلهم؛ لعدم توافر مياه الري، بل وانقطاعه تماماً في بعض الأحيان عن كثير من المجمعات السكنية.
لعبت العلاقات السياسية على مدى العقود الماضية دورا في النزاع على الحقوق المائية بين دول الرافدين، حيث كانت ضحية التقلبات السياسية بين تركيا وسوريا. ومن العبث التحدث عن الحقوق المائية للفرات ودجلة بمعزل عن النزاعات السياسية بين جناحي حزب «البعث» في سوريا والعراق خلال حكم صدام حسين.
كما يتساءل كثيرون عن أسباب تعثر المفاوضات السورية - التركية في العقود السابقة. لكن في الواقع يعود إلى عاملين سياسي - مائي. الخلافات السياسية بين تركيا وسوريا عميقة الجذور وتتمحور الخلافات على ثلاثة موضوعات، هي: المياه والأكراد ولواء الإسكندرون. بإقرار سوريا يتضمن تنازلها عن لواء إسكندرون، وبعقد اتفاقية شاملة للمياه وتعاون سوري - تركي لضرب العناصر الكردية ذات الأهداف القومية الكردية في التجمع الكردي في شرق تركيا، بل بالأحرى في مناطق ينابيع الفرات ودجلة، وهذا ما يفسر قلق تركيا من الأكراد الانفصاليين وخوفها على منشآت سد أتاتورك، حيث تقوم قوة تركية يربو عددها على خمسة آلاف جندي مسلحين ومزودين بالمروحيات، بحماية السد ومنشآته. واتهمت أنقرة سوريا بإيواء مجموعات «حزب العمال الكردستاني» وإذا كان لواء إسكندرون مصدر توتر سوري - تركي في العقود السابقة، فإن قضايا الخلاف حول المياه والأكراد أصبحت جدية، وقد تتحول المياه إلى سلاح سياسي بما يفوق دورها التنموي في الري والزراعة.
المفاوضات السورية - التركية
عندما طرحت تركيا وسوريا مشروعاتهما المائية لاستثمار حوض الفرات، عقد الجانبان اجتماعاً في أنقرة عام 1962 لبحث الآثار المترتبة عليها، حيث بحثا فيه استعمالات مياه الفرات عقب تنفيذ المشروعات، ووافقت تركيا على الاستمرار في التصريف الطبيعي للنهر، على أن يعدل هذا التصريف مع توسيع المشروعات التركية. وعرض الجانب السوري مشروعاته على نهر الفرات، واتفق الجانبان على ضرورة تنسيق جهودهما لتشغيل وتعبئة خزاني كيبان والطبقة، وتبع ذلك اجتماع تركي – سوري – عراقي، في بغداد عام 1965، حيث فشل المتفاوضون في التوصل إلى اتفاق حين رفض الجانب التركي التفاوض ما لم تتضمن المباحثات اقتسام مياه دجلة، بالإضافة للفرات باعتباره نهراً مشتركاً أيضاً بين الدول الثلاث لتغطية النقص المتوقع نتيجة مشروعات الري التركية المزمع تنفيذها.
بعدها، عقدت سلسلة من الاجتماعات لتعبئة خزانات سدود كيبان والأسد والحبانية بين تركيا والعراق وسوريا. كما جرى تبادل للمعلومات المائية في الاجتماعين الثالث والرابع في أنقرة عام 1972، وتم الاتفاق في الدورة الخامسة للمفوضات في عام 1983 باعتماد نتائج دراسة اللجنة الفنية الثلاثية من حيث القياسات المائية وتعبئة الخزانات. وبناءً على وساطة لجنة البنك الدولي ووفق اتفاق اللجان الفنية المشتركة في عام 1975، قسمت حاجات البلدان الثلاثة بنسبة الثلث لكل منها على متوسط الوارد السنوي، لكن بروتوكول عام 1987 المعقود بين سوريا وتركيا منحها 50 في المائة من واردات النهر الوسطية السنوية لتعبئة خزان سد أتاتورك لغاية نهاية عام 1993 حتى ملء سد أتاتورك، ثم تعود حصة تركيا إلى نسبة الثلث.
وعلى ما يبدو، فإن البرتوكول المؤقت أصبح حقيقة عندما وقّعت سوريا وتركيا في سبتمبر (أيلول) 1992 اتفاقاً للتعاون الأمني تمنع سوريا بمقتضاه أنشطة الانفصاليين من أكراد تركيا في سوريا ولبنان، وملاحقة القوات التركية حزب العمل الكردستاني داخل سوريا، وارتبط تنفيذ الفقرة المائية من البروتوكول بالتزام سوريا بالبرتوكول الأمني.
وفي ظل التحسن الملحوظ في العلاقات السورية - التركية بعد تسلم الرئيس السوري بشار الأسد مقاليد الحكم والفتور النسبي في العلاقات التركية - الإسرائيلية، اتفقت السلطات السورية والتركية بشكل مبدئي على بناء سد مشترك على نهر العاصي بين البلدين يقام في الأراضي السورية الدولية الأقرب للواء إسكندرون على نهر العاصي، في إشارة إلى مقاربة مختلفة إزاء الخلاف حول لواء إسكندرون.
ونتيجة مباشرة لزيارة الأسد إلى تركيا، تم اتفاق الطرفين على إيجاد مخرج استراتيجي للخلاف التاريخي حول إسكندرون (محافظة حيات) عبر التنمية، فعقدت اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير التعاون من خلال القيام باستثمارات مشتركة، لكن هذه الاتفاقيات توقفت بعد الأزمة السورية في 2011 وموقف انقره المعادي لدمشق.
المفاوضات السورية – العراقية
عقدت ثماني جولات من المفاوضات بين الجانبين العراقي والسوري لبحث تقاسم مياه والفرات على مدى ثلاثة عقود، باءت بالفشل إلى أن توصل الجانبان في الجولة التاسعة إلى اتفاق، حيث عقد الاجتماع الأول في دمشق عام 1962، حيث تبادل الجانبان المعلومات والإحصاءات المائية والمشروعات القائمة والمستقبلية في كلا البلدين.
وتبع ذلك اجتماع عام 1963، اقترح فيه الجانب العراقي تخصيص 18 مليار م3 من مياه الفرات، وبما يحفظ حقوقه المكتسبة، ويتضمن الحاجات المائية وفقاً لطرائق الري المستخدمة حالياً. وعقدت جولات في بغداد فشل فيها الجانبان بالتوصل إلى أي اتفاق، حيث أصر العراق على حقوقه المكتسبة. وفي الاجتماع الرابع في بغداد عام 1966 تم الاتفاق على جدول مشترك يضع الأسس والطرق الواجب اتباعها لتحديد الحاجات المائية للمشروعات القائمة حالياً مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة لسوريا والعراق وتأليف لجنة فنية مشتركة لتحديد حصة كل من البلدين من مياه الفرات.
وفي الجولة السادسة عام 1967، اقترح الوفد السوري أن يتسلم العراق 53 في المائة من إيرادات النهر على الحدود السورية – التركية، بينما طرح الوفد العراقي حساب الحاجات على النحو التالي: حساب حاجات المشروعات القائمة في البلد على أن يقسم فائض النهر مناصفة إذا زاد وارد نهر الفرات السنوي على مجموع حاجات المشروعات القائمة في البلدين.
وفي الجولة السابعة في دمشق عام 1971، طرحت سوريا إعطاء العراق 53 في المائة من موارد الفرات على الحدود السورية – التركية، بينما اقترح الوفد العراقي الحصول على 67 في المائة، ثم طالب الوفد العراقي بـ59 في المائة للعراق ولم يتوصل الطرفان إلى أي نتيجة. وفي الجولة التاسعة في دمشق عام 1971 طرح العراق 13 مليار متر مكعب حقاً مكتسباً له فألفت اللجنة العراقية – السورية التركية عام 1980 بهدف الوصول إلى قسمة مياه دجلة والفرات بين الدول الثلاث. ورأى الجانب العراقي أنه لم يكن طرفاً في بروتوكول عام 1987 بين سوريا وتركيا الذي حددت فيه كمية تدفق المياه عند الحدود السورية – التركية بـ500 متر مكعب، لم يوافق عليها، بحيث كان ينبغي أن يكون ذلك الاتفاق ثلاثياً وألا يقل الحد الأدنى للتصريف عن 700 م3 حتى لا يلحق ضرر بالعراق، لأن العراق يعاني قلة التصاريف المائية التي أدت إلى تردي نوعية المياه لزيادة ملوحتها قد حولت تلك المنطقة إلى أرض غير صالحة للزراعة نتيجة التبخر، وتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت عام 1990 ويقضي بمنح العراق 58 في المائة في المائة من المياه 42 في المائة لسوريا. وعلى الرغم من وجود الاتفاق؛ فهو يعد موقتاً ولا يتطرق لاقتسام مياه دجلة، وبخاصة بعد أن أصبح برتوكول عام1987 التركي - السوري نافذ المفعول، والذي أقر بتصريف 500 م3-ث عند الحدود السورية فقد أعطى سوريا حصة من مياه الفرات تبلغ 6.627 مليارم3، ووفق اتفاق اللجان الفنية المشتركة.
وفي عام1991 صدر بيان ختامي، أكد الجانبان السوري والعراقي تمسكهما ببروتوكول التعاون الاقتصادي والفني المشترك الموقع في دمشق في 17 يوليو (تموز) 1987 والبند المتعلق بالمياه الذي بمنح العراق 58 في المائة من مياه الفرات. وطرح الوفد السوري عام 1992 من خلال اتفاق نهائي بين الدول الثلاث أن يلغى العمل بالبرتوكول السوري – التركي لعام 1987 والاتفاقية السورية – العراقية لعام 1990. وأخيراً اتفق الجانبان السوري – العراقي في فبراير (شباط) من عام 1996 على وضع صيغة للتحرك المشترك تجاه المشروعات التركية، وطرح الجانب العراقي مناقشة خطة تشغيل سد أتاتورك وبهدف الوصول زيادة نصيبهما من المياه من 500 إلى 700 م3-ث.
مقاربة تركية
تطرح تركيا مبدأ استخدام المياه وفقاً لدراسات ميدانية لمشروعات الري في البلدان الثلاثة، وأن تعتمد هذه الدراسات على جدوى اقتصادية وفنية للمشروعات القائمة والمستقبلية، ووفقاً لمبدأ الاستعمال للاستخدام الأمثل للمياه. تركيا تعلن أن أراضيها خصبة وذات مردود اقتصادي أعلى كثيراً من مردود أراضي سوريا والعراق، وهذا يعني استثناء الأراضي السورية والعراقية من المشروعات الزراعية بحجة عدم خصوبة كثير منها والاعتماد على المشروعات الزراعية التركية، حيث تستطيع تركيا إنتاج محصولين أو ثلاثة سنوياً، لكن سوريا والعراق عارضتا الخطة التركية بدراسة جدوى اقتصادية لمشروعات قائمة وتدعو إلى تحديد الأراضي القابلة للري، وكيف يمكن الاستغناء عن مشروعات مائية بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وتعتمد السياسة التركية في حل مشكلاتها المائية مع جيرانها على مرتكزين، هما: فرض سياسة الأمر الواقع، وعامل الزمن؛ فتركيا ماضية في إكمال مشروعها.
اتبعت تركيا حتى بداية منذ السبعينات سياسة مائية غامضة لمشروعات ري عملاقة أخفتها عن جيرانها لعدم وجود استراتيجية زراعية سورية – عراقية، واقتناص الفرص، مستغلة الخلافات السياسية بين العراق – وسوريا للحصول على أكبر كمية من مياه الفرات. تارة تزعم أن السوريين يرفضون التباحث مع العراقيين، وتارة أخرى تدّعي أن سوريا ستحتفظ بالمياه الإضافية إذا خضعت تركيا لمطالب العراق وحصصه المائية، ذلك بفرض تركيا وإسرائيل استراتيجية مائية على المنطقة تحصل فيها الدولتان على أقصى ما يمكن من المياه.
لكن السياسة المائية التركية تحتوي على تناقضات جوهرية من حيث مضمونها بعدم وجود فائض مائي فحسب، بل هي تتعارض بوجود فائض مائي تركي. والتعاون الإسرائيلي – التركي سابقاً في مجال المياه ذو مضمون اقتصادي بعد أن طرح الأتراك فكرة الماء سلعةً اقتصاديةً قابلةً للبيع يمكن مقارنتها بالغاز السوري من خلال فكرة تعاون إقليمي، وذلك من خلال استثمار الدول العربية الغنية أموالها في إقامة منشآت ضخمة ومن خلال أنابيب السلام التي تمر عبر سوريا إلى إسرائيل وإلى دول أخرى، حيث اشترت إسرائيل كميات من المياه التركية تم نقلها بعبوات بلاستيكية تقطرها السفن.
وحاولت تركيا إثارة أحقيتها بالتصرف في مياه دجلة والفرات أسوة بالدول النفطية التي تملك حق التصرف بثرواتها النفطية؛ كون مياه هذين النهرين مصدراً طبيعياً خاصاً بتركيا عابرين للحدود الدولية وليسا نهرين دوليين، وأن حوضي دجلة والفرات حوض واحد، وإن لتركيا حق التصرف بمياه النهرين ضمن حدودها، وفي حفل تدشين سد أتاتورك قال رئيس الوزراء التركي سليمان ديميري، إن «ما يعود لتركيا من مجاري مياه الفرات ودجلة وروافدها هو تركي.... نحن لا نقول لسوريا والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطية... ولا يحق لهما القول إنهما يشاركاننا مواردنا المائية». ولا يخفي بعض الأتراك رأيهم بأن تركيا إذا استطاعت السيطرة على صنبور المياه فإنها تستطيع فرض سياسة شرق أوسطية.
توتر
وكان حدث توتر في العلاقات بين البلدين على توزيع المياه نتيجة انتشار وتعبئة خزاني بحيرة الطبقة والحبانية في سوريا والعراق.
وكان سكان مدينة حلب يشربون من نهر قويق الذي ينبع من تركيا في فترة الأربعينات. وقام الأتراك بقطع جريان النهر جراء إقامة مشروعات زراعية، كذلك قامت الحكومات السورية في ذلك الوقت بإقامة محطة ضخ من نهر الفرات لجر المياه إلى حلب. فإن ما حصل لنهر قويق ينبع في تركيا، قد تكون له دلالته المستقبلية على الفرات، حيث انقطعت مياه الشرب عن سكان مدينة حلب عندما حولت السلطات التركية مجراه في أوائل الخمسينات من هذا القرن؛ مما دفع السلطات السورية آنذاك لضخ مياه الفرات عبر أقنية لمدينة حلب.
ويصر السوريون على تطبيق المفهوم القانوني الدولي بأن الفرات نهر دولي وليس نهراً عابراً للحدود من حيث شروط التقاسم لنسب استغلال المياه، ويستندون إلى مبدأ السيادة عند بحث مسألة المياه العربية والسورية.
أما بالنسبة لنهر العاصي، فلا يخفى على الجميع أن مصبه في لواء إسكندرون، ولا تزال سوريا تتحفظ على ضمه لتركيا. بالتالي، فمشكلة مياه العاصي ذات صبغة سياسية أكثر منها مائية؛ إذ تهدف تركيا من وراء عقد هذه الاتفاقية المتضمنة توزيع مياه العاصي إلى اعتراف سوري رسمي بالسيادة التركية على منطقة إسكندرون.
وترتكز سوريا في شرعية مطالبتها باستعمال مياه الفرات على تقدير حاجة المنشآت المائية القادمة أو التي قيد التنفيذ، أو المخطط لتنفيذها في البلدان الثلاثة بوساطة لجان فنية مشتركة تتعاون فيما بينها، وأن يشارك الجميع في الأعباء إذا حدث شح في المياه بحيث يتحمل كل من الدول الثلاث نصيبه. ولا تعترض سوريا بصورة مبدئية على حق تركيا في إقامة المنشآت المائية على الفرات واستغلال نصيبها منه شرط ألا يؤدي ذلك إلى إيذاء الغير بشكل كبير بحسب القانون الدولي وما يفرضه البنك الدولي من شرط لتمويل مشروعات المياه.
وبما أن مياه الفرات ليست كافية لجميع المشروعات المائية للبلدان الثلاثة، فإن لكل بلد الحق في وضع الأولويات المناسبة لمشروعاته المائية على أن يلتزم بحصته المائية؛ فسوريا تعتبرها حقوق ارتفاق على نهر الفرات، ويجب أن تتفق تركيا مع الدول الأخرى المتشاطئة.
الأنهار
تشترك تركيا بأنهار الفرات، ودجلة، والعاصي، وجغجغ، وساجور، وقويق، وعفرين، والأسود، والخابور مع سوريا، وأهم ثلاثة أنهر هي:
> نهر الفرات: ينبع نهر الفرات ومعظم روافده من أعالي هضبة أرمينيا شرق الأناضول في الأراضي التركية.
يتكون نهر الفرات من مجموعة روافد تزيد على السبعة، حيث يكوّن نهر الفرات وطوله 400 كلم، ومراد صو، وطوله 600 كم، نهر الفرات عندما يلتقيان في ملاطية الذي تنحدر المياه إليه عند ذوبان الثلوج. يبلغ طول الفرات 2330 كم منها 442 كم في تركيا، و675 كم في سوريا و1213 كم في العراق. وتبلغ مساحة حول الفرات 440 كم2 منها 72 ألف كم2 في سوريا، ويتأثر معدل جريان الفرات بروافده، وكمية الأمطار والثلوج ويقدر الوارد المائي في تركيا 19 مليار م3 وعلى الحدود السورية – التركية بـ25 مليار م3 سنوياً، وعلى الحدود السورية - العراقية بـ2.7 مليار م3 سنوياً.
ويختلف الوارد السنوي من سنة إلى أخرى، ويبلغ متوسطه بـ28 مليار م3 سنوياً، وللفرات خاصية حيث تتدفق الأنهار بعنف في البداية وتتلاشى تدريجياً مياهه من خلال التبخر والاستعمالات الإنسانية، وتختلف كمية مياه الفرات بين الفصول بثمانٍ وعشرين مرة، بينما يصل الفرق بين أعلى كمية للمياه وأدناها لدجلة ثمانين مرة.
> نهر العاصي: تشترك سوريا مع لبنان بنهر العاصي، وهو ثاني أنهار سوريا من حيث الأهمية، ويخرج من نبعين عظيمين، هما نبع اللبوة وعين الرقاد في البقاع اللبناني، وتجري مياهه بانتظام طوال العام. ويبلغ طوله 571 كلم منها، 325 كلم في سوريا، ويبلغ إيراده السنوي 400 مليون م3 عند الحدود السورية – اللبنانية. وقد أقيم عليه سدان مهمان في سوريا، هما قطينة والرستن لأغراض متعددة، وهو يتابع سيره مسافة 79 كلم إلى أن يصب في هاتاي (لواء إسكندرون) خليج السويدية.
> نهر دجلة: ينبع نهر دجلة جنوب شرقي الأناضول في تركيا، ويبلغ طوله 1718 كلم2، ويمر في سوريا ستة كيلومترات وتقدر موارده المائية 47 مليارم3، ومعظم جريانه في الأراضي العراقية ويرفده أنهار الخابور في سوريا، والزاب الكبير والزاب الصغير وديالي والعظيم في العراق التي تشكل ثلث مياهه ليلتقي مع الفرات ليشكلا شط العرب.

الموارد المائية لدول حوض الفرات
- يتبلغ متوسط الموارد المائية المتجددة في سوريا بـ19 مليار م3 سنوياً
- يتبلغ متوسط الموارد المائية التركية المتجددة 200 مليار م3 سنوياً
- يتبلغ متوسط الموارد المائية العراقية المتجددة بـ145 مليار م3 سنوياً
توزيع المياه حسب المساحة الإجمالية لمجرى النهر
- في تركيا 125 ألف كم2.
- في سوريا 176 ألف كم2.
- في العراق 243 ألف كم2.
حاجات المياه
- تركيا 12 مليار م3
- سوريا 11.5 مليار م3
- العراق 13 مليار م3
* خبير سوري في المياه الدولية