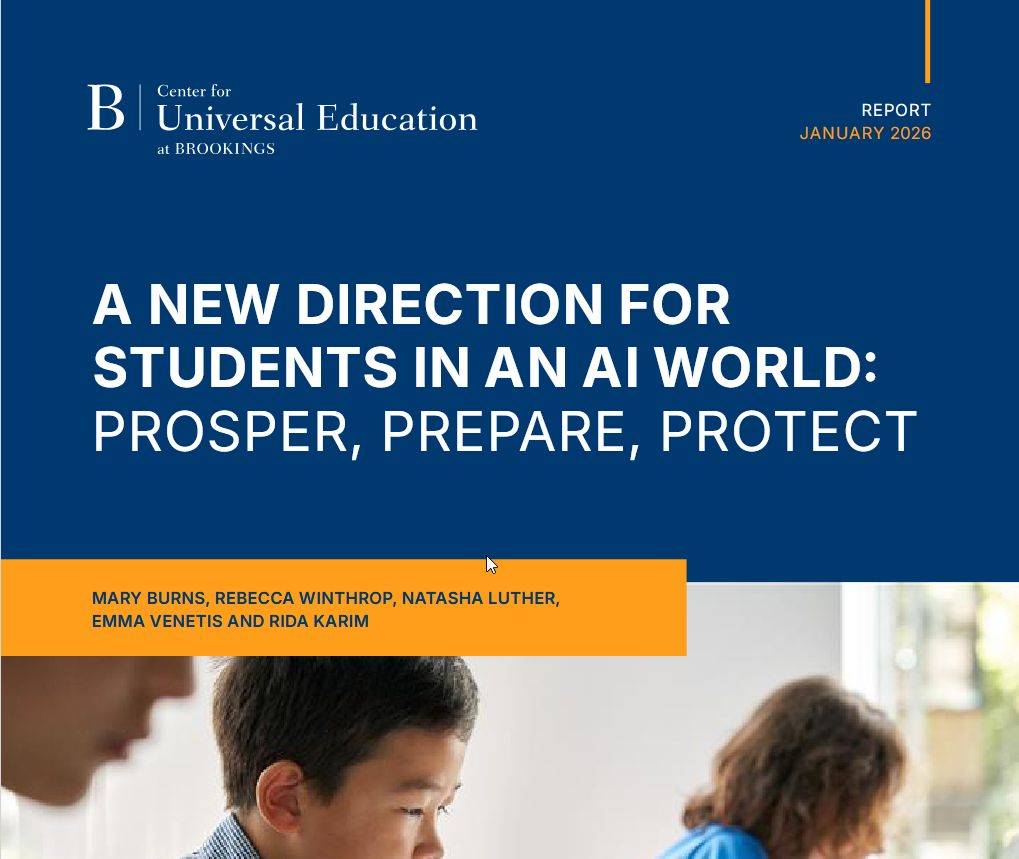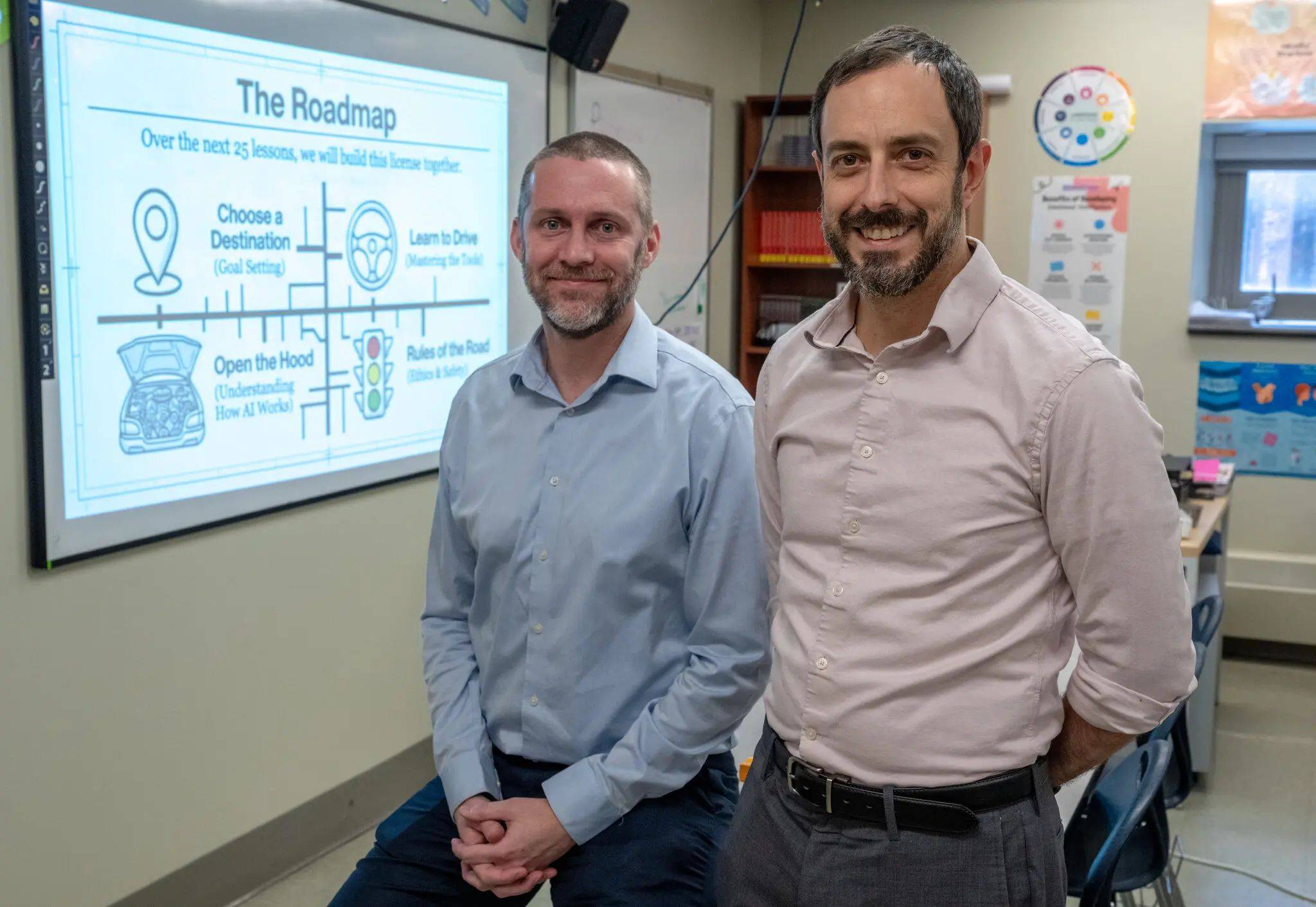وفّرت بصمات الأصابع أدلة أساسية ودامغة في قضايا جنائية كبيرة لا تعدّ ولا تحصى. ولكن لا تزال هناك بعض الأوضاع التي يصعب أو حتى يستحيل فيها رفع البصمات من مواضعها، الأمر الذي يسبب الأرق للمحققين الجنائيين. وفي إطار البحث عن حلّ لهذه المشكلة، أدرك بعض الباحثين، أنّه يمكن الاستفادة من بصمة الإصبع في أمور أبعد من مجرّد تقفي الأثر.
بصمة نادرة
تتشكّل البصمة حين يحتكّ الإصبع مع سطح ما. ويترك الإصبع في هذه الحالة خلفه آثارا من العرق وغيره من المواد الموجودة عليه والتي يكون المشتبه به قد لمسها. ويأخذ شكل هذه المواد شكل ومواصفات الخطوط الرفيعة المقوّسة الموجودة في طرف الإصبع. وتكون غالبية البصمات غير مرئية للعين المجرّدة ولا يمكن رؤيتها إلا عن طريق عملية معالجة كيميائية.
وتقدّم العمليات الحديثة لرفع البصمات اليوم، معلومات أكثر عن صاحب البصمة، كنوعية المادّة التي لمسها، وما تناوله من طعام، وحتى نوع الدواء الذي تناوله ربما.
لا تحمل بصمة الإصبع المتروكة في ساحة جريمة معينة (في عالم التحليل الجنائي تعرف بـ«علامة الإصبع») عرقاً من المشتبه به فحسب، بل أيضاً آثاراً من المواد التي قد يكون احتكّ بها. وتعتبر هذه الآثار أدلة مفيدة جداً في حال كانت البصمة تحمل آثاراً من دماء الضحية أو من مكونات متفجرة، لأنها تثبت علاقة المشتبه به بشكل فوري باستخدامه لهذه المواد. ولكنّ حتى حينها، لا تساهم البصمة في أي إنجاز استقصائي ما لم يكن المشتبه به مدرجا على قاعدة البيانات الخاصة لبصمات الأصابع.
هنا، قد تظهر وسائل جديدة لتحليل البصمات. فقد أظهر الباحثون في دراسة نشرت علام 2016 قادتها الباحثة الأميركية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أمينة بوسليماني، أن المواد التي قد تغطي هاتفاً نقالاً قد تختلف حسب الشخص الذي يملك الجهاز، والسبب يعود لتنوع واختلاف الأطعمة والمواد التجميلية والأدوية وغيرها من الملوثات البيئية التي قد يتعرّض لها الشخص. ووفقاً للمنطق نفسه، تختلف المواد الموجودة في بصمة الأصبع بشكل مماثل، وتمّت محاولة إثبات هذه النظرية في بعض المحاولات البحثية القديمة.
في حال تمّ إثبات هذه النظرية، هذا يعني أن بصمة الإصبع تستطيع ربّما أن تقدّم توقيعاً جزيئياً يكشف أنماط أسلوب حياة والبيئة التي يعيشها الفرد، كوظيفته، وعاداته الغذائية أو مشكلاته الصحية. هذا الأمر من شأنه أن يساعد الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الشخص صاحب البصمة.
اختبارات الأدوية
قد نكون ما زلنا بعيدين عن تطوير طريقة بسيطة لدراسة بصمات الأصابع بهذا الشكل الذي يفيد أجهزة الشرطة، إلا أن بعض التقدّم في هذا المجال قد تحقّق بالفعل. فقد أثبت الباحثون مثلاً أن الاحتكاك بالمخدرات أو المتفجرات يمكن رصده في بصمة الإصبع ممّا قد يساعد في حصر عدد المشتبه بهم.
وفي حال فكّرنا أبعد من العمل الجنائي، يمكن لبصمات الأصابع أن تقدّم بعض الاحتمالات المثيرة للاهتمام في الاختبارات الطبية المستقبلية. فقد تكون بصمة الإصبع مثلاً طريقة مناسبة جداً لإعطاء عينة في فحوصات المخدرات مثلاً، لأنها أسرع وأسهل بكثير من إعطاء عينة دم أو بول، فضلاً عن استحالة تزويرها لأنها تعتمد على رسمة الإصبع الفريدة التي تحدّد هوية الشخص.
إلى جانب المواد التي يحتك بها الفرد، تتضمّن بصحة الإصبع مواد تفرزها الغدد العرقية الموجودة في الإصبع. ولأن العرق يحتوي على آثار من المواد التي يهضمها الإنسان، هذا يعني أن بصمات الإصبع قد تتضمن بدورها آثاراً من الأدوية التي استهلكها. في ورقة بحثية جديدة نشرتها دورية «كلينيكال كيميستري»، أثبتّ العلماء أنّه يمكن رصد آثار مواد الكوكايين والهيروين والمورفين في بصمة واحدة.
تشيع هذه المواد بشكل كبير مفاجئ في بصمات الأصابع عامة بين الناس. فقد بيّن مثلاً أن 13 في المائة من الأشخاص الذين أخضعتهم الدراسة للاختبار وتبيّن أنّهم لا يتعاطون المخدرات، يحملون أثاراً للكوكايين في بصماتهم، التقطوها ربّما من الأوراق النقدية أو أي أسطح أخرى تحملها. أمّا الشخص الذي يعاقر االمخدّرات فعلاً، فسيحمل أثاراً تفوق ما يحمله هؤلاء بـ100 مرّة في بصمته. والأهمّ، هو أنّ آثار المخدّرات يمكن ضبطها حتى بعض أن غسل الفرد ليديه، لأن إفراز هذه المواد يستمرّ حتى بعد استخدامها. هذا يعني أن البصمة يمكن أن تثبت من الناس يتعاطى المخدّرات، ومن لا يتعاطاها.
قد تكون فكرة حمل آثار المواد المخدّرة رغم عدم تعاطيها مقلقة بعض الشيء، ولكنّ يجب أن نلفت الانتباه إلى أن الكمية التي ترصدها الفحوصات من هذه المخدرات لا تتعدّى عشرات البيكوغرامات (البيكو واحد من المليون مليون) من المخدّر، أي بمعنى آخر، فهذا الأمر لا يعني أننا نواجه حدثاً طبياً طارئاً. ومع تطوّر التقنيات العلمية لتصبح أكثر حساسية تجاه الآثار الصغيرة، بات أسهل علينا اليوم أن نرصد الأشياء التي كانت تفوتنا سابقاً.
ووجد الفريق أن الوصفات الدوائية يمكن رصدها أيضاً بواسطة بصمة الإصبع، وأن هذه الآثار تختفي مع توقف الفرد عن تناول أدويته. هذا يعني أننا سنتمكّن يوماً ما ربّما من اعتبار البصمة طريقة سهلة أخرى تساعد المرضى على التأكد من أن جسدهم يمتص الأدوية بالشكل الصحيح. يتمتّع هذا الأمر بأهمية كبيرة وتحديداً لدى الأشخاص الذين يخضعون لعلاجات الصرع، والسكري، والحالات القلبية أو الذهان، الذين قد يواجهون صعوبات في امتصاص الأدوية أو ينسون ما إذا كانوا قد تناولوا أدويتهم أم لا.
وإن كان علم البصمة قد تقدم بشكل كبير منذ أن اكتشف الباحثون للمرّة الأولى أن بصمة الإصبع هي الطريقة الوحيدة التي تتيح تمييز إنسان عن آخر، فإنه وفي المقابل، لا تزال هناك الكثير من الفرص التي يجب اكتشافها في المستقبل.