يرصد الروائي محمود سعيد سيرة تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر، التي قطعها بطله «سامر» ومن معه، هرباً من جبهات الحرب العراقية - الإيرانية، أواسط ثمانينات القرن المنصرم.
يدير سعيد مخلوقاته الروائية بمهارة، يتجلى هذا سواء عند رصد حركة الشخصية الرئيسيّة (سامر) وشخصيات أخرى فاعلة في السرد الطويل نسبياً (511 صفحة من القطع الكبير) أو عندما يدير مجموعات من الشخصيات، كأنْ يرصد سجن النساء أو «بيت الأصدقاء»، مثلاً.
يقرر «سامر» الجندي العراقي، من أهل الموصل، الهرب من وحدته العسكرية، على خطوط القتال مع إيران، صحبة «ياسين» كاتب الفرقة العسكرية، لتنشأ بينهما علاقة صداقة حميمة، تنمو عبر مراحل رحلة العذاب بحثاً عن بلد أوروبي للجوء.
مثلما سيغتني السرد بدخول عشرات الشخصيات، الثانوية لكن الفاعلة، على الخط الروائي الأساس، فهو ينمو عبر المكان، أيضاً، إذ كل رحلة تقتضي مدناً وشخصيات، وفِي الرواية تبدأ الرحلة من كردستان، شمال العراق، حتى بانكوك-تايلاند، مروراً بإيران وباكستان والهند.
ليس الجنود، كلهم، يَرَوْن الحرب وجهاً لوجه. الجنود الذين في جبهات القتال، وحدهم، من يرونها ويعرفونها، لأنهم من أقام فيها أو جرح، أو مات، ومنهم، أيضاً، من رفضها وكره مشعليها فهرب منها كي لا يقتل جندياً لا يعرفه في الخندق المقابل، ولكي لا يذهب هو ضحية مجانية في حرب لا يد له فيها ولا قلب ولا مصلحة.
«سامر» يحمل وثيقتين شخصيتين، يونانية وإيرانية، ويتعلم تزوير الوثائق وجوازات السفر، ليساعد كل من يطلب منه المساعدة.
كل الذين التقوا «سامر»، أو التقاهم، أحبوه وفتحوا له بيوتهم وقلوبهم، فصار واحداً منهم. يقيم معهم أو يزورهم، بل يسافر إلى حيث يقيمون في بلدان ومدن بعيدة.
المصادفات أحد الحلول الروائية التي يلجأ إليها الروائي في حالات عدة، بل إن المصادفات أحد أشكال الفانتازيا الأكثر حضوراً في فضاء السرد.
المصادفات، تلك، أنقذته من الموت الوشيك، على الحدود أو داخل أكثر من بلد، وهذا يحدث للشخصيات الأخرى أيضاً. والمصادفات هي التي قادته أيضاً إلى أكثر تجارب الحب دفئاً، بما فيها تلك التي انتهت بخيبة أمل مريرة. تحديداً شخصية «سانتا» البريطانية التي تعرّف عليها في «سفينة الحب» لزيارة مدينة اسمها «كوا». تبادر تلك البريطانية إلى التعرف على «سامر» الذي سرعان ما يقع قتيل هواها العاصف، أو كمينها الخطير، عندما تخبره بأنها أحبته لمقتضيات العمل (البزنس)، وهو باختصار: العمل معها كشريك في تهريب المخدرات، الأمر الذي لا يقبله حتى لو قتل مشاعره الغرامية الملتهبة.
لم يكن «سامر» من حملة العقائد السياسية المتداولة، فالموقف من الحرب المجانية، وحده، هو ما دفعه، في البداية، إلى رفضها والوقوف ضدها، إثر ما تعرض له الجنديان الصغيران اللذان رافقاه في اليوم الأول للالتحاق بوحدتهم (الوحدة 241) عندما قُتلا بقنبلة من الجانب الإيراني، وهو مشهد لن ينساه «سامر» لسنوات عدة لاحقة. لم يكن يحمل (سامر) أي آيديولوجيا عدا آيديولوجيا ضميره الشخصي.
لكن، وبدافع من ذلك الضمير يتحول (سامر) من جندي هارب من الحرب إلى ناشط إنساني يعمل مع بقية أصدقائه على التعريف بسجناء وسجينات لا يعرف عنهم ذووهم شيئاً، عبر نشر أسمائهم وأماكن اعتقالهم في وسائل الإعلام الدولية المتنوعة، بمساعدة أصدقائه وبجهودهم الفردية لا غير.
عدا تفاصيل ما تعرض له هذا (السامر) من مخاطر حقيقية هددت حياته –نجا من الموت سبع مرات– إلا أن المنعطف شبه الحاسم الذي نقل حياته إلى مستوى درامي مختلف هو تعرفه على سجن النساء في بانكوك.
هُن متهمات بتهم مختلفة أو محكومات لمدد طويلة. وفقاً للقانون يحق لكل منهن إجازة خارج السجن ولكن بشرط الكفيل الضامن. هناك يبدأ «سامر» نشاطه بشكل مختلف هذه المرة: البحث عن كفيل ضامن يتيح لإحداهن (هيلين) التمتع بتلك الإجازة وهي الفتاة التي أحبها «سامر» حباً جارفاً. «هيلين» متورطة في قضية مخدرات، ملتبسة، بعد أن تخلى عنها خليلها، الذي يتعاون مع الشرطة، لينجو من التهمة بنفسه بينما وقعت هي في قبضتهم. وإذ تستحوذ «هيلين» على «سامر» لتصبح أجمل امرأة في الوجود تعرف عليها في حياته، سيبذل كل ما في وسعه من أجل إخراجها من السجن حتى لو في إجازة مؤقتة.
في واحدة من فانتازيات الرواية، وعن طريق المصادفة أيضاً، يتعرف «سامر» على شخصيات نافذة في بانكوك، هم أصدقاء الملك التايلاندي المقربون، منهم كون تان جيسداواتاتشيان، الذين أكرموا وفادته، كما يقال، وساعدوه في مهمته مع السجينات، وخصوصاً «هيلين».
يولي صاحب «زنقة بن بركة» عنايته للمهمشين، ضحايا الحرب والعنف واللجوء، وبسطاء الناس، وينقلهم من الغياب القسري إلى الواجهة، ويغذّيهم بالإصرار على الحياة والأمل والكفاح من أجل مواصلة الشروع بالحياة وبهجة الوجود.
ملاحظة أخيرة: منح سعيد مناظر الطبيعة الخلابة في شرق آسيا وجنوبها الكثير من الوصف وتوقف طويلاً عند مشاهد الترفيه والسهر وريادة المراقص والمطاعم، في تلك الأصقاع، مما أثقل سرده بشيء من السياحة، وهذا قلل من طاقة الدراما والتوتر في متن الرواية وجسمها الأساس، ولا أعتقد أن اختصار هذا سيؤثر على البعد الدرامي والتشويقي في هذا العمل الروائي المتميز.
9:11 دقيقه
سيرة الألم العراقي
https://aawsat.com/home/article/1252906/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
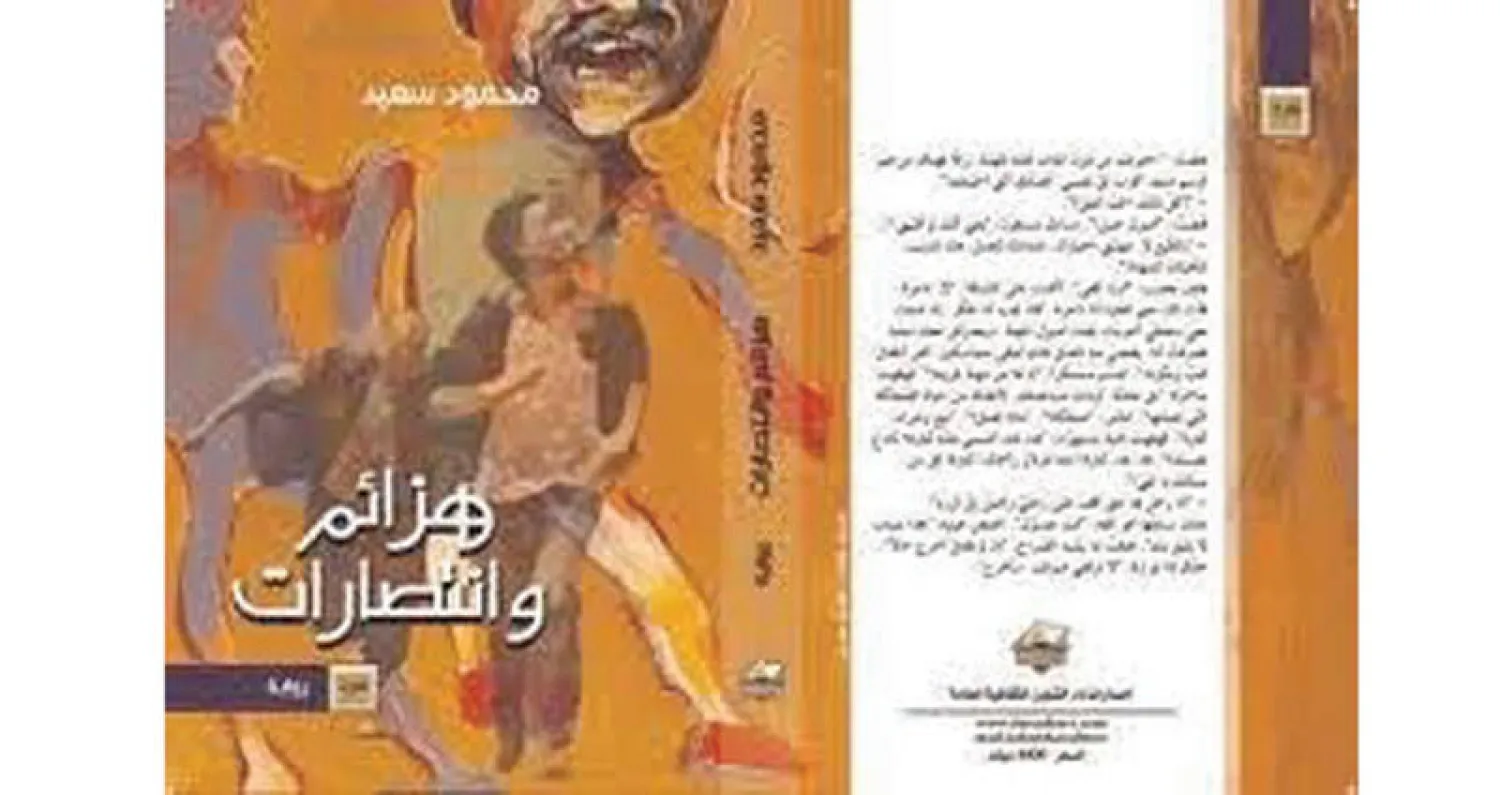

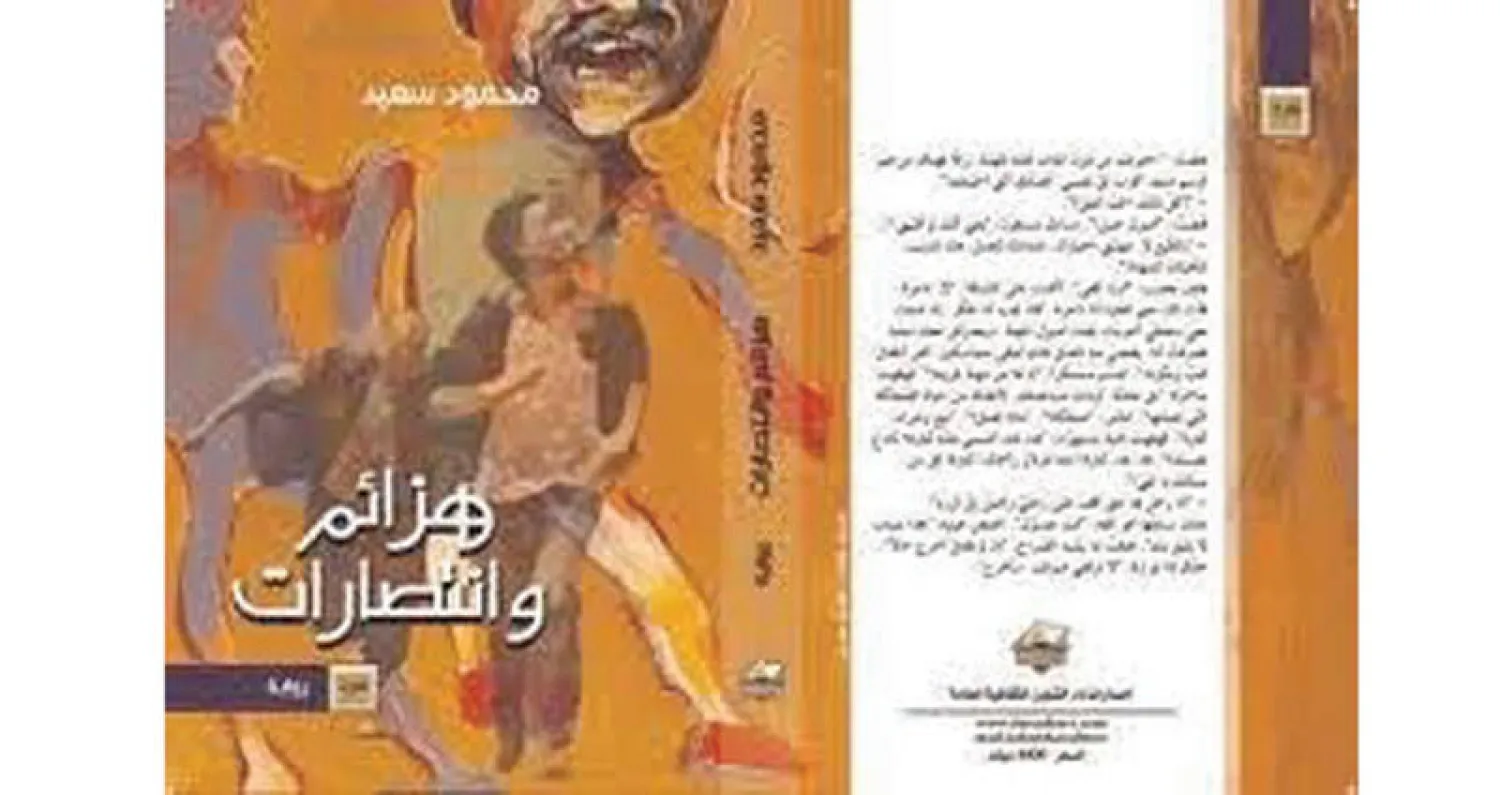
سيرة الألم العراقي
رواية «هزائم وانتصارات» لمحمود سعيد
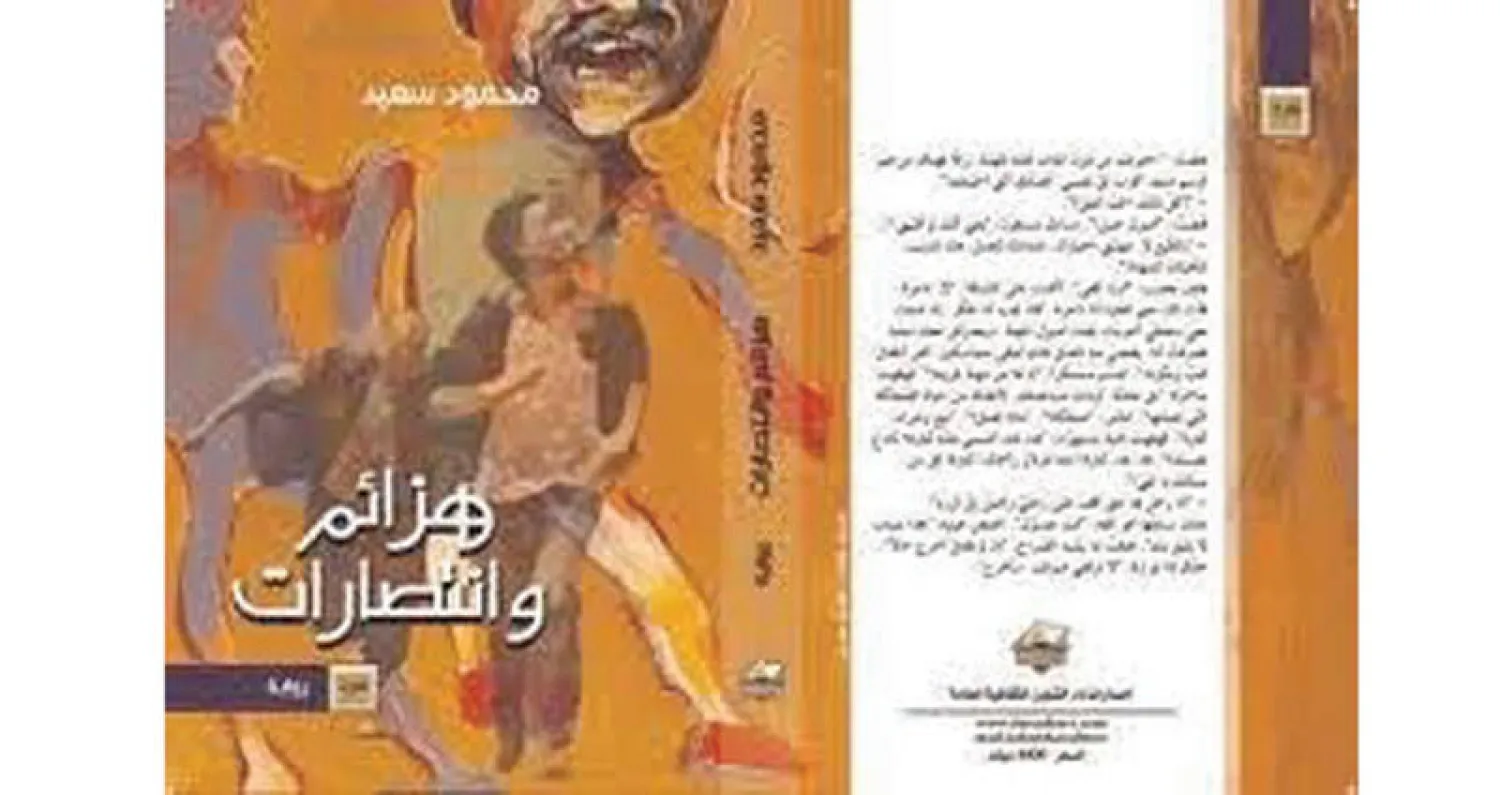
- لندن: عواد ناصر
- لندن: عواد ناصر

سيرة الألم العراقي
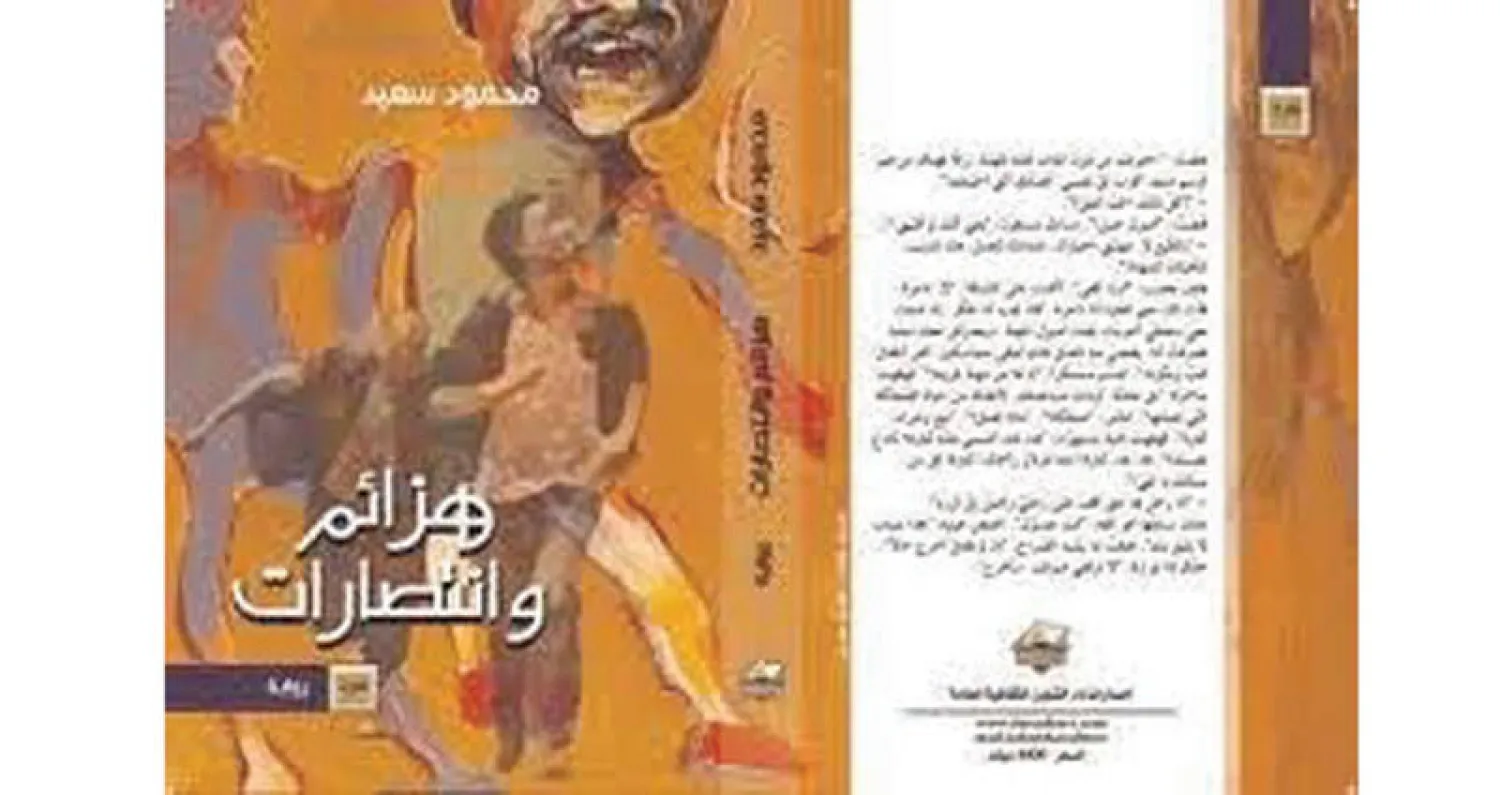
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة










