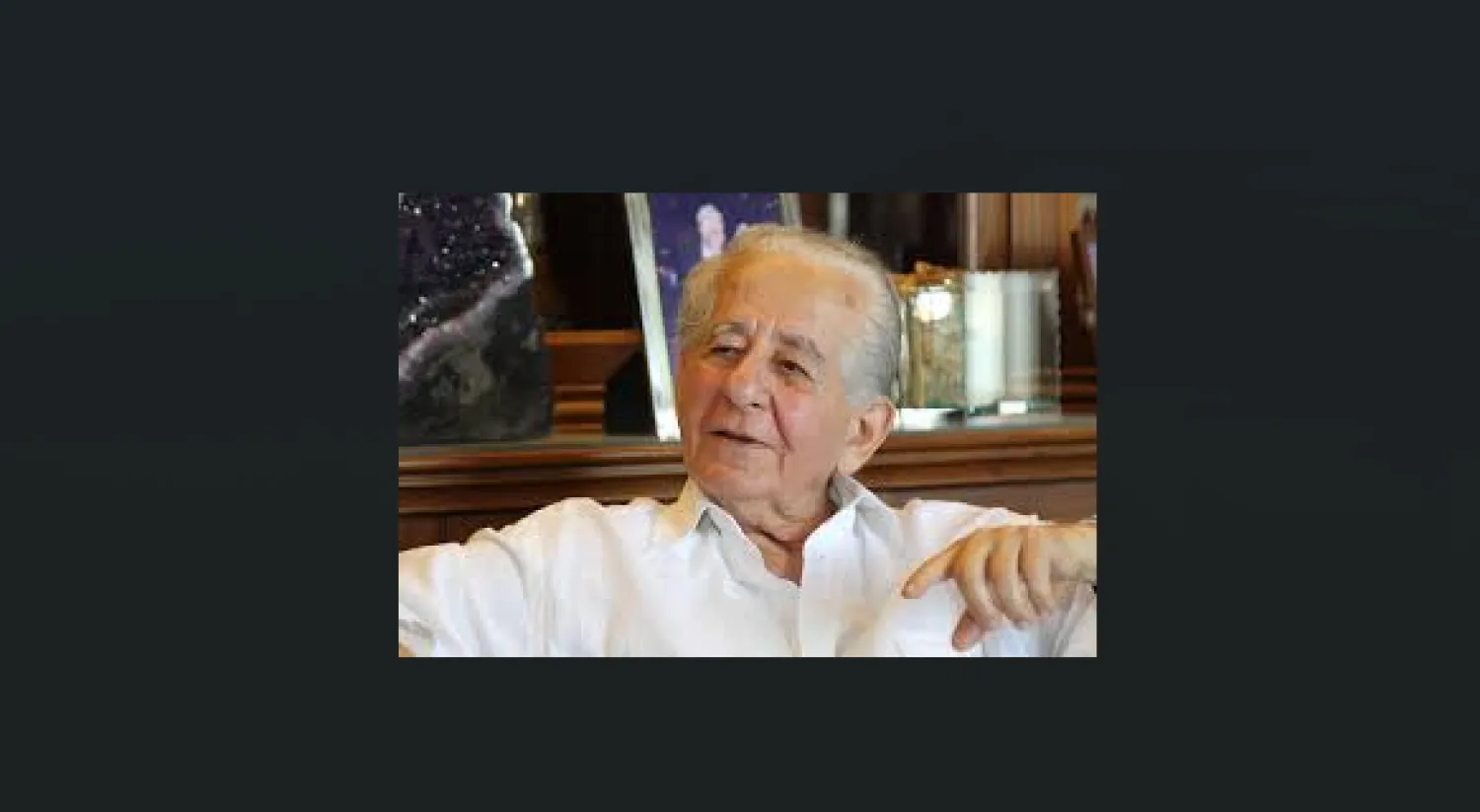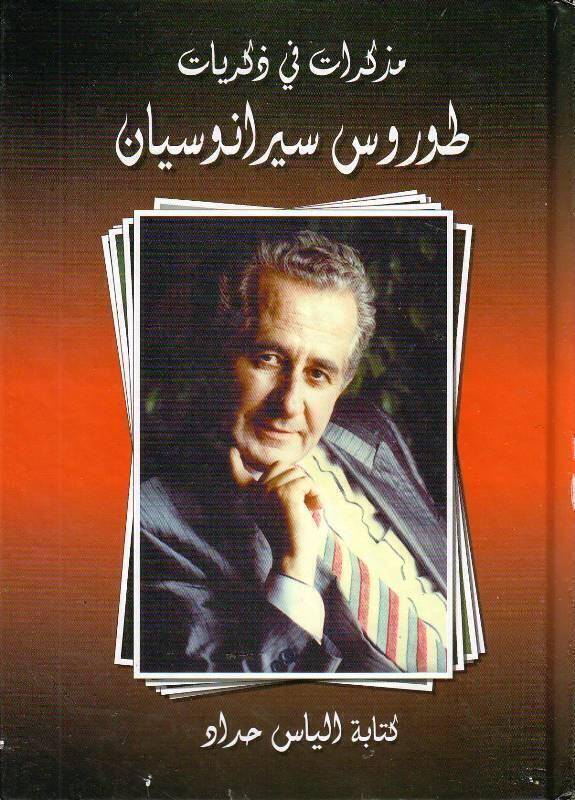ما زلتُ أتذكر لحظة قراءتي لقصيدة الجواهري الكبير «إيهٍ عميد الدار» قبل أكثر من 30 عاما، وقد كانت مهداة للدكتور هاشم الوتري، الذي كان يسمى «أبو الأطباء» في العراق، قرأتُها واستعدتُها مراراً، ولكني لا أعرف من الوتري؟ ولماذا استحق قصيدة من الجواهري؟ وهو عميد كلية فقط، حتى تبينت لي الخطوط فيما بعد، وتبين أن هاشم الوتري هو مؤسس كلية الطب في العراق، وعميد الكلية الطبية الملكية فيها، ومؤلف كتاب «تاريخ الطب في العراق» وأن تاريخه وتاريخ الأكاديميين معه مرتبطٌ بولادة الدولة الحديثة ونشأتها، لهذا كتب فيه الجواهري قصيدته الشهيرة في إحدى المناسبات التكريمية لهذا العميد، عميد الدار:
مجَدتُ فيك مشاعراً ومواهباً
وقضيتُ فرضاً للنوابغ واجبا
بالمبدعين الخالقين تنوَرت
شتَى عوالم كن قبلُ خرائبا
شرفاً عميد الدار عُليا رتبةٍ
بُوئتَها في الخالدين مراتبا
ثم يستمر الجواهري بهجاء الواقع السياسي، وكان ذلك عام 1949، ويهجو الجميع، حكوماتٍ ومتواطئين، حسب رأيه، متخذا من الوتري حائطاً يستند عليه، ومنارةً يبثُها شكواه، بعد ذلك عرفتُ أن هذا الصرح الذي يُسمَى «الأكاديمية» هو الرحم الذي ينتج الطاقات، والبوصلة التي توجه الدولة، وترسم ملامحها وفلسفتها، وكلَما كانت هذه البوصلة مخلصة وحقيقية، كانت الدولة أكثر اتزاناً، وأوفر حظَاً في البناء والتطور.
بعد «هاشم الوتري» يظهر لنا اسم مهم في المعرفة والإدارة وهو الدكتور «عبد الجبار عبد الله» ثاني رئيس لجامعة بغداد، وأحد تلاميذ «أينشتاين» والذي استقال من رئاسة الجامعة لأن شرطياً دخلها بسلاحه، ولذلك فالجامعات تُسمى «حرماً» فاستقال، ومن ثم سجنه البعثيون حتى غادر البلاد بداية السبعينات.
الأكاديمية العراقية تنضح أسماء علمية مهمة، أسهمت بصناعة هذا الصرح وتطويره، وخشعت في محراب المعرفة، والأسماء التي سأورد بعضها قد تكون عينةً صالحة للزهو والبكاء في الوقت نفسه «علي الوردي، وطه باقر، ومهدي المخزومي، وعلي جواد الطاهر، وعناد غزوان، وجلال الخياط، وعلي المياح، وخديجة الحديثي وآخرون»، حتى أمسك الجيل الثاني بعد جيل الريادة الأكاديمي أمثال «طارق الجنابي، وصاحب أبو جناح، وعلي عباس علوان، ومحسن إطيمش، وخالد علي مصطفى، وشجاع مسلم العاني، ومحمد حسين الأعرجي، وناصر حلاوي، وحسام الدين الألوسي، ومدني صالح وآخرون أيضا»، وهنا أذكر هذه الأسماء وهي في الأعم من أساتذة اللغة العربية والفلسفة وعلم الاجتماع والآثار الذين يتحركون في ذاكرة أساتذتنا، ومن ثمَ عشعشوا في ذاكرتنا، فالجيل الأول هو جيل التأسيس، الذي تعلَم معظمه في أوروبا وأميركا، وتتلمذوا على أيادي كبار المستشرقين، وتعلموا معنى أنْ تكون أستاذاً جامعياً ملتفاً بالمدينة ومهموماً بها، فهؤلاء الأساتذة الأوائل والتابعون لهم كانوا مصدر تنوير للمدن التي يخدمون بها، والجامعة إنْ لم تكن مصدر إشعاعٍ وتنويرٍ وبث لروح التجدد، فإنها ستعطل جناحاً مهمَاً من أجنحة طيرانها، وتتحول إلى دائرة حكومية كأي بلديةٍ أو مديرية للزراعة.
أسهم ذلك الجيل في ترسيخ قيم المدنية، وفي النأي بالجامعات من صراع السياسة وحبائلها، لأن السياسيين دائما يسيل لعابهم على اثنين (الجامعات والعسكر)، فإنْ سيطر عليهما ستكون الدولة بكاملها منقادةً لأي سلطة من السلطات، استطاعت الجامعة أنْ تحصِنَ نفسها بلقاحات المعرفة، والشخصية المعنوية الكبيرة، من كوليرا السياسة، على عكس العسكر العراقي الذي سال لعابه على القصور الرئاسية، فأدمن لعبة الانقلابات، وتحوَل الكثير من قادته إلى متحزبين، وجنود في رقعة شطرنج الزعماء.
لكن ما يؤسف له أن الجامعات لم تستطع الصمود طويلاً أمام الوباء الذي تبثه السياسة، وأظن إنَ أول الوباءات كان في أواسط السبعينات، حين أحالت الحكومة العراقية عدداً كبيراً من الأساتذة الكبار إلى التقاعد، وطردتهم خارج أسوار الجامعة، وذلك لدخول «حزب البعث» إلى كل مفاصل الحياة العراقية، وأولها الجامعات، التي ظن الحاكمون أنَها ستكون بوَابتهم لصناعة قادةٍ جددٍ من خلالها.
يُروى لنا أن الحكومة أحالت العلَامة اللغوي الكبير «مهدي المخزومي» إلى التقاعد، وهو في قمة العطاء فتقبَل الأمر، وذهب إلى «المملكة العربية السعودية» يدرِس في إحدى جامعاتها، وقد وجد من الحفاوة والتكريم ما لم يجده في بلده، فبعث بعض كتَاب التقارير إلى السعودية وإلى رئيس تلك الجامعة التي يعمل فيها «المخزومي» يحذرهم ويخبرهم بأن «المخزومي» «رجل شيعي وشيوعي» في الوقت نفسه، فأجابه رئيس الجامعة السعودية: إنْ كان لديكم شيعة وشيوعيون مثل «المخزومي» ولستم بحاجة لهم فابعثوهم إلينا.
بعد تلك الحادثة استطاعت السلطة أنْ تروِض الجامعات، وأنْ تضع قيادات موالية للسلطة على هرم كل جامعة، وبدأت حملات «التبعيث» حيث أُجبر معظم الأساتذة والطلاب في أنْ يكونوا بعثيين مجبرين - معظمهم طبعا - وخصوصا في الكليات الإنسانية التي تخرِج معلمين ومدرسين حيث يعدَونها مفقساً لتخريج الأساتذة الذين يجب أنْ يكونوا مؤمنين بفلسفة الدولة الجديدة، وثورتها، وحزبها الأوحد.
بعد ذلك دخلت العسكرة إلى الجامعات بشكل فاقع فترى بعض القيادات ترتدي الملابس العسكرية، أو ما يُسمَى بـ«الزيتوني» ومن ثم أُجبر الأساتذة أنْ يذهبوا أشهر العطلة إلى ساحات القتال أيام الحرب العراقية الإيرانية، وأنْ يذهب طلبة الجامعات إلى المعسكرات طيلة أشهر العطلة، ومنْ لم يذهب سيُرقَنُ قيدُه ويُساقُ إلى جبهات القتال، بعد ذلك فرَختْ المعسكرات بيوضها داخل الحرم الجامعي، فبدأنا نرى أساتذة كراماً يقفون في طوابير طويلة داخل ملعب الجامعة، يعلمهم عريفٌ لا يقرأ ولا يكتب الرمي والهرولة، وذلك استعداداً لما يُسمَى بـ«جيش القدس» في أواسط التسعينات، ومن لم يذهب ستذهب به تقارير الوشاة المتبرعين، فضلاً عن سنوات الحصار المريرة التي أنهكت الجانب الاقتصادي للأستاذ الجامعي وللطالب.
بدأت الهجرة الثانية لأساتذة الجامعات من بداية التسعينات حتى ما قبل 2003 بقليل، وهي هجرة اقتصادية بعكس الهجرة الأولى في بداية السبعينات وحتى نهايتها حيث كانت هجرة سياسية، لهذا انتشرت الكفاءات العراقية في اليمن وليبيا والأردن، وهنا أتذكر مقطعا من الشعر الشعبي للشاعر العراقي «موفق محمد» وقد طعَم نصه الفصيح به، حيث أهداه لصديقه حسن الذي يبحث عن عملٍ في اليمن فقال له: ((ما صارت ولا جرتْ / يا ريت عيني عمتْ / ما أنصفتْ من صفتْ / أيدِور خبز باليمن / لا تيأسنْ يا حسنْ)) ومحظوظ من كان عقده في إحدى جامعات الخليج، وقد سمحت الدولة حينها بذهابهم، وهي غاضة الطرف عنهم نتيجة للضغط الكبير الذي مورس على هذه الشريحة التي سُلبت كلَ شيء.
بعد عام 2003 اختلف ميزان القوى في البلد كما هو معروف، ولكن الأكاديمية العراقية للأسف لم تستطع أنْ تنأى بنفسها عن الصراع الذي أشعلته الأحزاب، والطوائف، والقوميات، فبدأت الجامعات تتدفَى على تلك النار، بل أسهمت بمد صغار الحطب لها، وفي بعض المرَات أصبحت هي النار نفسها، فبدل أنْ تكون حلَاً لمشكلات البلد، أضحت في بعض الأحيان هي المشكلة نفسها، إذ انساقت تلك الشخصية المعنوية المهمة التي يأوي إليها العراقيون جميعا بكل اختلافاتهم إلى صراع الديكة، وأضحت جامعات مغلقة لفئة محددة، أو طائفة محددة، وأضحى طلاب المحافظات على سبيل المثال يخشون الذهاب للدراسة في جامعات محافظات أخرى كانوا يحلمون في الدراسة فيها، والتخرج فيها، بسبب تلك النزاعات.
وسنتوقف بتفاصيل أكثر في حلقة ثانية عن الجامعات العراقية بعد 2003.
الأكاديمية العراقية بين التنوير والتحجير
لم تستطع الصمود طويلاً أمام الوباء الذي تبثه السياسة

مبنى جامعة بغداد

الأكاديمية العراقية بين التنوير والتحجير

مبنى جامعة بغداد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة