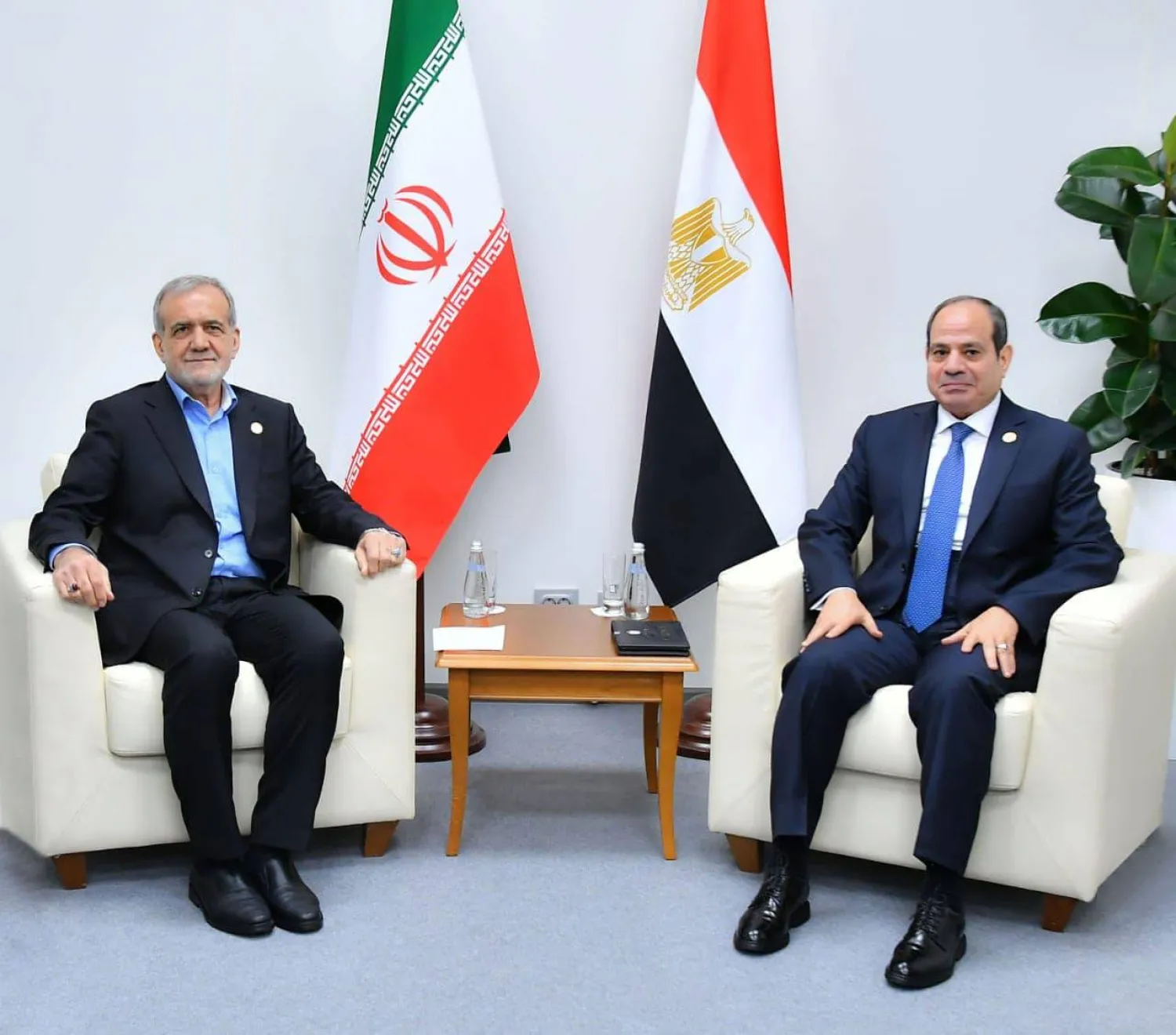قبل نحو شهرين من بدء إجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، يبدو المشهد مختلط الحسابات بين ثلاثة تطورات: التطور الأول هو «إعلان نوايا» من قبل مرشحين محتملين للرئاسة أمامهما عوائق. والثاني هو أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي لم يؤكد صراحة حتى هذه اللحظة خوضه المنافسة رغم أنها مسألة محسومة بدرجة كبيرة. والثالث هو أنه بين «إعلان النوايا» والتراجع عنها والعوائق المصاحبة، تلوح في أفق المشهد السياسي المصري مخاوف من الفراغ الذي يمكن أن يكون سمة المواجهة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري ينص على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
في يونيو (حزيران) 2014، تسلَّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهام منصبه رسمياً، الأمر الذي يعني - وفق الدستور - بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجري الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه.
وخلال فترة شهر تقريباً، تحرك المسار الانتخابي الرئاسي بشكل محدود، ولكن لافت، إذ بينما كان المحامي الحقوقي خالد علي أول من أعلن نيته خوض الانتخابات في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برزت أخيراً خطوات أحمد شفيق (منافس الرئاسة السابق في عام 2012) التي بدأها من دولة الإمارات بإعلان حاسم للغاية عن دخوله المضمار وبدء جولات مع أبناء الجالية المصرية في دول أوروبية، ثم تغيّرت الوتيرة هبوطاً بحديث مغاير بعد العودة إلى مصر عن رغبة في «التدقيق والفحص».
وإذا كانت الرغبة في التروي والتريث - بحسب ما أعلن شفيق نفسه - هي الحائل دون إقدامه على تجديد حسمه لخوض الانتخابات الرئاسية، فإن حقائق الحسابات السياسية تشير، بلا شك، إلى تأثر سلبي نال جانباً من شعبية الرجل الذي كان على مرمى حجر من رئاسة مصر في عام 2012.
أما المرشح الآخر، أي المحامي خالد علي، أول من مبادر بإعلان الترشح، فسيمثل في يناير (كانون الثاني) المقبل أمام القضاء الذي ينظر حكماً بالاستئناف على حكم سابق ضده بالحبس 3 أشهر في قضية من شأنها، إذا أدين فيها نهائياً، منعه من خوض الانتخابات.
في هذه الأثناء، كما سبق، لم يصدر بشكل رسمي عن الرئيس السيسي أي تعليق يشير إلى نيته خوض انتخابات الرئاسة لفترة جديدة. وهو يكتفي بالقول إنه «أمر سابق لأوانه»، مكرّراً أنه سيعلن ذلك عقب تقديم «كشف حساب» في غضون الشهر الحالي أو المقبل بشأن ما حققه خلال 4 سنوات تمثل فترة ولايته الأولى.
لكن، على مستوى آخر، تنشط حملة يقودها نواب برلمانيون وتدعو إلى ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، في جمع توقيعات من المواطنين. ولقد أعلنت مصادر الحملة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها «جمعت ما يزيد على 3 ملايين استمارة موقعة من مواطنين في محافظات مختلفة».
القانون... وآلية المنافسة
كيف ينظم القانون آلية المنافسة على مقعد الرئاسة؟
تحدد المادة 142 من الدستور آلية التقدم للانتخابات الرئاسية على النحو التالي: «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
ووفق توزّع الكتل البرلمانية للأحزاب في داخل مجلس النواب، فإن 3 أحزاب فقط هي حزب المصريين الأحرار، وحزب الوفد، وحزب مستقبل وطن، يمثل كل منها أكثر من 20 نائباً في المجلس. وبالتالي، يمكنها إذا ما قررت خوض الانتخابات، أن تحقق الشرط اللازم لذلك. غير أن حزب المصريين الأحرار أعلن تأييده ترشيح الرئيس الحالي لفترة رئاسية ثانية، بحسب تصريحات رئيسه عصام خليل، في حين أكد السيد البدوي رئيس «الوفد» أن حزبه لن يُقدم مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب دعمه للسيسي، والموقف نفسه أبداه رئيس حزب «مستقبل وطن» أشرف رشاد.
وعليه، إذا كانت هذه الأحزاب التي تمتلك بطاقة مرور سهل للسباق الرئاسي لن تُقدم (كما يبدو) على تلك الخطوة، فهل يقرر بعضها أن يبني تحالفاً أو تكتلاً في المسار ذاته؟
«الشرق الأوسط» طرحت السؤال على بهاء محمود، الباحث المتخصص في الشأن البرلماني بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الذي قال إن «نظرة أقرب على سلوك القوى والأحزاب السياسية الرئيسية في مجلس النواب، تشير إلى صعوبة توافقها في معركة مثل انتخابات الرئاسة، خصوصاً، إذا ما تعلق الأمر بمساندة وتدعيم مرشح في مواجهة الرئيس الحالي».
وأردف محمود: «هناك مجموعة تعبر عن تيار الإسلام السياسي لا تتخطى 13 نائباً من حزب النور، وهؤلاء سيطرت قضايا الأقباط والمرأة والشؤون الدينية، على خطابهم طوال دوري الانعقاد الماضيين... وهم لا يقدّمون أنفسهم بأي حال كرقم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن الصعب انخراطهم مع تحالف آخر حتى وإن لم يكن برلمانياً في الشأن ذاته».
وفي ما يتعلق ب«كتلة 25 / 30» النيابية المعارضة، يشرح محمود أنها «تمثّل تجمعاً معارضاً داخل «النواب» لكن لا يمكن اعتبارها تمثيلاً لاتجاه فكري واحد أو حتى سياسي يمكنه الخروج بموقف موحد مع أو ضد مرشح رئاسي بعينه». ويضيف أنه حتى هذه الكتلة التي تجمع يساريين وناصريين وليبراليين، ويوجد بينها مَن يؤيد تقدّم المرشح المحتمل خالد علي، غير أنه من المستبعد أن يكون ذلك موقفهم الجماعي، مستدركاً: «يمكن بدرجة أو أخرى إذا قرّر شفيق خوض المعركة مستقلاً أن يجمع التوقيعات من المواطنين، لا سيما أن مسألة شعبيته قد اختُبِرت من قبل في انتخابات عام 2012. وأياً كان مدى تأثّره فإنه لن يكون مستحيلاً أن يجمع المنافس السابق للرئاسة 25 ألف توكيل فقط، خصوصاً أن الحزب الذي أسّسه وهو «الحركة الوطنية المصرية» يعاني من الانقسام بشأن رئيسه، إضافة إلى أنه لا يتمثّل سوى بـ4 نواب فقط، وبالتالي، فهو طريق غير مناسب لشفيق لكي يمر منه إلى الانتخابات الرئاسية.
ولا يستبعد الباحث السياسي بمركز الأهرام، أن يكون «الفراغ» أحد سمات الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يشير إلى «معوقات ترشح شفيق، المتمثلة في بلاغات قُدّمت ضده فضلاً عن إعلانه بنفسه حاجته لإعادة التفكير في المسألة، في حين يواجه خالد علي عقبتين أساسيتين: أولاهما القضية التي لم تُحسَم بعد وتهدد موقفه القانوني من الترشح، والثانية اشتراطه 6 ضمانات حددها في خطاب إعلان النيات تتعلق بالإشراف على الانتخابات، وهذه مسألة نسبية وجدلية بين السلطة ومعارضيها، وقد تكون سبباً في انسحاب علي».
وبشكل عام، يعرب بهاء محمود، عن اعتقاده بأنه «من الأفضل أن يسعى النظام السياسي القائم مبكراً إلى تحفيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للحفاظ أولاً على سمعتها ونزاهتها كإطار ديمقراطي تلتزم به مصر أمام العالم، فضلاً عن تجنب الوصول إلى مرحلة الاستفتاء على شخص الرئيس مرة أخرى بين خياري الموافقة والرفض... وبالتالي، ستفقد سلطة السيسي التي تضمن في كل الأحوال نجاحاً شبه مؤكد في الانتخابات المقبلة، جزءاً من السمعة الدولية الإيجابية».
المفاجآت مستبعدة
على صعيد آخر، على الرغم من صعوبة حدوث مفاجآت في ضوء المعطيات الحالية للمشهد الانتخابي الرئاسي في مصر، يصعب استبعاد حدوث تغيرات في صورة المنافسة. ولعل ما يلفت في هذا الشأن تصريحات أفاد بها المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، خلال حوار تلفزيوني مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (الـBBC) في أبريل (نيسان) الماضي، وفيه لم يعترض أبو الفتوح على مبدأ الترشح، إلا أنه اشترط أن «تكون الانتخابات حقیقیة وتحت مظلة المعاییر الديمقراطية»، وأضاف خلال الحوار أن «الانتخابات لیست مجرد أصوات في الصندوق، بل لها مقدمات ومعاییر حتى نقول إن هناك تنافساً حقیقياً».
وإضافة إلى المؤشر السابق، نجد الدعوات التي ظهرت على الفضاء الإلكتروني وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي طرحت اسم الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، كمرشح محتمل. ومع أنه لم يعلن نيته في هذا الشأن صراحة، قبولاً أو رفضاً، انتشرت على صفحات مختلفة صور لملصقات دعائية تحمل صورته. وبالإضافة إلى حجازي أو أبو الفتوح، هناك عصام حجي، المستشار العلمي سابقاً للرئاسة المصرية. وكان حجي هو الذي تقدّم قبل سنة تقريباً، بمبادرة «الفريق الرئاسي»... لكنه تراجع بسبب ما اعتبره «أجواء لا تسمح بالدفع بمرشح».
الطريق إلى 2018
- خلال الفترة الممتدة على مدار 4 سنوات، لا يمكن على وجه الدقة معرفة مدى تأثر شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي صعوداً أو هبوطاً، إلا أن الحقيقة الثابتة تشير إلى أن الرئيس الحالي وصل إلى منصبه في انتخابات خاضها مرشحان، هو أحدهما. أما الثاني فهو القيادي السياسي الناصري حمدين صباحي.
وكما هو معروف أسفرت نتائج الانتخابات التي أُجرِيَت عام 2014، عن فوز السيسي لحصوله على 23.7 مليون صوت (96.9 في المائة من الأصوات الصحيحة)، في حين نال منافسه 750 ألف صوت (3.1 في المائة من الناخبين). وقبيل إجراء تلك الانتخابات، أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى عزوفه عن الترشح للانتخابات الرئاسية. كذلك أحجم سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة، وأيضاً رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق عن دخول المنافسة.
ويومذاك تطابقت المبررات التي أوردها الثلاثة تقريباً في ذلك الحين، وعلى رأسها أن السيسي (القائد السابق للقوات المسلحة) يستحق دعمهم لدوره في «ثورة 30 يونيو» التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقرار الجيش بعزله عقب مظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.
ومن أبين أهم ملامح تلك الانتخابات، التي يضعها المراقبون في الحساب اليوم، أن نسبة الإقبال في حينه بدت متراجعة للغاية، إذ بلغت 47.45 في المائة بواقع 25.5 مليون ناخب من إجمالي أكثر من 53 مليون ناخب يحق لهم التصويت، وهذا على الرغم من قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات حينها بمد فترة التصويت ليوم إضافي ليكون 3 أيام بدلاً من يومين.
من جهة ثانية، ظهر اتجاه تصويتي آخر، أسفر عن إبطال أكثر من مليون صوت انتخابي، وهذه نسبة أكبر من إجمالي الأصوات التي نالها المرشح حمدين صباحي صاحب المركز الثاني في تلك الانتخابات.
65 سنة... من الاستفتاء إلى الانتخاب
- منذ تحولت مصر من الملكية إلى الجمهورية في أعقاب ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 تبدلت طرق انتخاب المنصب الأكبر في البلاد. وخلال 65 سنة اختير الرئيس في غالبيته المرات بالاستفتاء المباشر من دون منافسة تعدّدية. ومن ثم، عرف المصريون للمرة الأولى الانتخابات التعدّدية في عام 2005 على الرغم من الانتقادات التي وُجّهت إليها بأنها كانت صورية.
أجرى الاستفتاء للمرة الأولى على منصب الرئيس في عام 1956، واختار المصوّتون حينها التصويت بالموافقة على تولّي الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بنسبة 99.9 في المائة. وبعد نحو عامين طرحت رئاسة عبد الناصر لاستفتاء جديد، ولكن هذه المرة كرئيس للجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا)، وذلك عام 1958، وجاءت النتيجة كذلك بشبه إجماع.
وكان الاستفتاء الثالث أيضاً على رئاسة عبد الناصر، وأجري عام 1965، ولم تختلف نسبته عن الـ99.9 في المائة.
في أواخر سبتمبر (أيلول) عام 1970 رحل الرئيس جمال عبد الناصر، ودخل نائبه أنور السادات استفتاء على خلافته، وجاءت نتيجته بالموافقة بنسبة 90.04 في المائة. ثم أعيد الاستفتاء على رئاسة السادات عام 1976، وهذه المرة ارتفعت نسبة الموافقة بالمقارنة مع ما سبقها إذ كانت 99.9 في المائة.
للعلم، كان النص في دستور عام 1971 يشير إلى عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين، غير أن نواباً في البرلمان تقدموا في نهاية عهد السادات بتعديل دستوري يلغي ذلك القيد. وبالفعل طرح الرئيس السادات في مايو 1980 على المواطنين الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي كان يفترض أن يسمح له بفترة ثالثة، وحظي التعديل بموافقة بلغت 98 في المائة، غير أن واقعة اغتياله في أكتوبر 1981 حالت دون خوضه استفتاءً آخر. وفي أعقاب ذلك أجرى استفتاء على تولي نائبه الرئيس حسني مبارك السلطة، وجاءت نتيجته 98.4 في المائة. وتكرر الأمر عام 1986 بنتيجة 96 في المائة، واستمر ذلك في استفتاءي 1993 و1999.
تغير شكل انتخاب الرئيس، بدرجة أو أخرى، بإجراء تعديل دستوري يسمح بإجراء انتخابات تعددية تنافسية بين أكثر من مرشح وذلك في عام 2005. ويومذاك فاز بتلك الانتخابات التعددية الرئيس مبارك بنسبة 88 في المائة حائزاً على أصوات 6 ملايين ناخب، وجاء في المركز الثاني رئيس «حزب الغد» أيمن نور لحصوله على نحو نصف مليون صوت، وكان يتنافس في تلك الانتخابات 8 مرشحين.
في أعقاب «ثورة 25 يناير» 2011، أُجرِيَت تعديلات دستورية وقانونية، وظلت رئاسة الدولة تحت حكم انتقالي تولاه حينها وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي بحكم منصبه.
ثم أُجِريت الانتخابات الرئاسية عام 2012، وكانت هذه الانتخابات الأكثر تنافسية بسبب تقارب نتائج المرشحين وتنوّعهم بدرجة كبرى، إذ أسفرت في جولتها الأولى عن فوز مرشح حزب جماعة «الإخوان» محمد مرسي، والمرشح المستقل أحمد شفيق (خاضاً جولة الإعادة) وفي المركز الثالث جاء حمدين صباحي، ثم السياسي المحسوب على تيار الإسلام السياسي عبد المنعم أبو الفتوح، وحل رابعاً الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى.