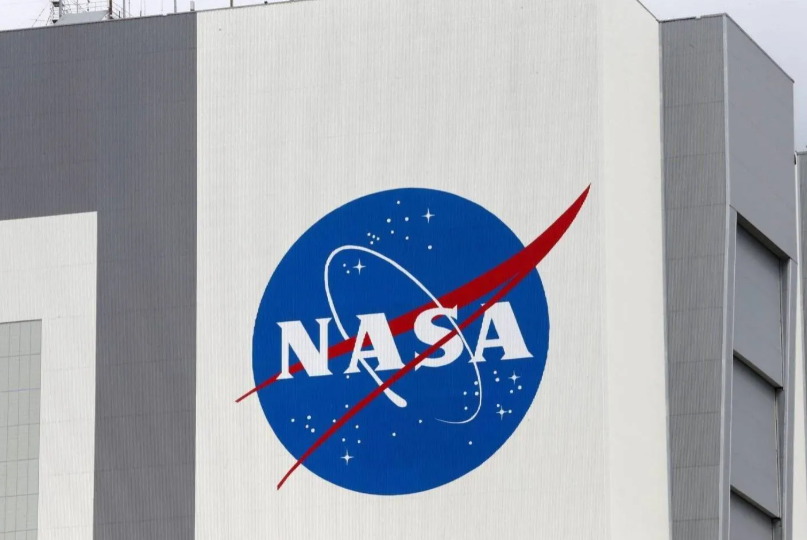ما بين الولع بالموسيقى وشعرية الفكرة، تدير الشاعرة ديمة محمود مناوراتها الشعرية في ديوانها «أشاكس الأفق بكمنجة» الصادر حديثاً عن دار العين بالقاهرة. فالفكرة تصل إلى غايتها ومعناها بطاقة التجريد، وحين تتشرب بروح الشعر، تتخلص من إطارها الذهني، لتكتسب فاعلية الموسيقى والدراما. حينئذ تشع انعطافات مغوية للعب شعرياً مع الذات والزمن والواقع والوجود، لا استثناء في هذه اللعب، الكل يتبادل الأدوار والأقنعة تحت فضاء النص، حيث لا قائد سوى الشعر، بل إن الفكرة نفسها تصبح قادرة على الامتداد والتواصل في جسد الزمان والمكان، تتفجر من شظايا صرخة، من رفة عين، من قطعة سكر، من تراتيل البحر، من لفحة وردة تحبو في شرنقة الموسيقى... فلا غرو إذن أن تستهل الشاعرة ديوانها بقصيدة تسميها «وردة»، تقول فيها:
«لا تعاني الوردة من عقدة أوديب
وتقف على البعد ذاته من الجميع
وليس لديها سبق إصرار وترصد للقتل ولا لسواه
وتحتفظ دوما باتزان يضمن فعاليتها واكتمال ماهيتها
......
الوردة لا تخضع للتمييز العنصري
ولا تكيل بمكيالين
الرائحة واللون في الوردة يصلان في نفس اللحظة
بكمال وتساوٍ
للبيض والسود وللمسالمين والعنيفين
رغم ارتفاع وتيرة الزحام».
في هذا النص تجترح الوردة رمزيتها ومحمولاتها التراثية المعتادة، متحولة إلى فكرة، في «عقدة أوديب»، وإلى معنى للمساواة بين البشر، بعيداً عن الأعراق والجنس واللون والطباع، كما أنها ليست حبيسة في حوض أو إناء، إنما حرة بروح الشعر والفكرة معاً. يعزز ذلك أن الفكرة مسكونة دائماً بالسؤال، بل إن شعريتها تتفتق منه معرفياً وجمالياً، ما يشي بطموح أبعد للنص، وكأنه سفر إلى الوجه الهارب، فيما وراء الفكرة والموسيقى، ما وراء الشعر واللغة والكلام.
يطالعنا ذلك على نحو لافت في نص بعنوان «مرثية لتذكرة الفقد والاغتيال» وهو مهدى إلى روح الصحافي السوري ناجي الجرف وكل المغدورين. وقد اغتيل الجرف بكاتم صوت في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2015... يشتبك النص مع مشهد الاغتيال المروع، ويستدعيه بقوة السؤال وآليته، فيبدو كأنه طاقة تحرير، للفكرة ذاتها من ظلالها المضطربة وتشابكاتها الشائكة الكامنة وراء السؤال نفسه... تقول الشاعرة في هذا النص:
«هل كان من حق الصيف أن يطيل الغياب
ويتركنا لجحيم الصقيع
أم أن الرّحى التي انشغلت بدك الجثث
أصرت أن تنظف حجارتها بسحق ما تبقى من عظامنا
.......
هل كان على العين أن تقاوم المخرز
أم أن ثوب العرس الأبيض كان باهظ التكلفة
وكان الكفن أقرب منه.
......
هل كان من حق الصيف أن يماطل في مشيته
أم أن قدر الفلاحات أن يتعلقن بأستار الحاصدة
وتتلقى حجورهن كل هذه الجماجم وبقايا الأظفار»
يغلف السؤال النص، وينفتح بإيقاعاته المتنوعة النازفة على قوسي البداية والنهاية، مشدوداً إلى ما هو أبعد، فلم تعد الفكرة وشعريتها قرينة حرية العقل أو الجسد أو الموسيقى، وسط عالم أصبح مصبوغاً بمشهد الدم والقتل حتى في الأفكار نفسها. إزاء كل هذا، لا سبيل أمام الشعر سوى أن يتحول إلى طاقة حية لاستعادة الحياة وتخليصها من براثن الوحشية والدمار في الخارج. لذلك لا تقتصر بنية السؤال في الديوان على طرح الفكرة، إنما تسائلها، تقلَّب ماضيها وحاضرها وغدها، تاركة الإجابة مفتوحة على شتى الاحتمالات، ما يجعل اللغة قلقة ومتوترة، تنطوي على مزاج حاد أحياناً؛ تترقب السؤال وكأنه منصة لوظائف وغايات متعددة، فهو يواجه الفكرة بالحلم، والحلم بالفكرة، يواجه العالم بذاكرة الذات والواقع والأشياء، إنه نقطة التشهي المتجددة، غير القابلة للزوال، في جسد الشعر والفكرة معاً... وكما تقول الشاعرة في نص بعنوان «خذلان»:
«تتثاءب قناديل البحر بعد ليلة مكدّسة بالحب والأسرّة
تستفيق حينما يقذفها موج أتخمه الشرابُ والسمك
ينزّ السؤالُ من مجساتها
هل لفوارغ الرصاص أن تكون أقلاماً لأمر الشفاه
هل لأفواه البنادق أن تصبح أعمدة إنارة
هل لتروس المدرعات أن تصبح حلقات للرقص
هل للقنابل أن تغدو زجاجات حليب».
تضع الشاعرة الفكرة على رأس النص متجسدة في علاقة الحب بالبحر، ثم تتناثر حولها الأسئلة لاهثة وحيرى، وكأنها نقطة اختبار تنز من مجساتها، كما يشي النص، كما أنها لا تحفل بعلامات الاستفهام كأداة لغوية، بل تترك أسئلتها منداحة، تضرب هنا وهناك، لتعيد اختبار الفكرة بروح الشعر في فضاء حر، فتلجأ أحياناً إلى اختزال الفكرة، في كلمة أو رمز، أو معنى ما لشيء محدد مادياً، وبآلية السؤال، تحاول الكشف في هذه العناصر عن صوتها الداخلي، وعلائقها السرية المستترة في حنايا الروح والجسد والعناصر والأشياء. يبرز ذلك على نحو لافت في عدد من نصوص الديوان، من أبرزها نص بعنوان «إصبع واحدة تكفي»، حيث نجد محاورة شعرية شيقة لمفردة «السقف»، وهي مفردة مغوية كمقوم أساسي من مقومات الوجود، تضمر الكثير من الإحالات الرمزية على عوالم متنوعة وشجية، لعل أبرزها فكرة البيت، الغطاء، الحاجز، الاحتواء، كما أن رفع السقف، كثيراً ما يصبح مرادفاً للحرية والتحليق.
يستهل النص بالسخرية من فكرة السقف وحيواته الطبيعية محاولاً اكتشافه في عباءة الضد، وعلاقة النور بالعتمة، وأثرها على كتلة المشاعر والعواطف والانفعالات. فالسقف ليس مجرد إطار أو برواز، يمكن أن تحاصرك منه صورة أفلاطون أو نابليون، إنه كذبة غبية، إنه باختصار في داخلك، في مخك، كما يمكن أن تراه أكثر حنواً في تشابك إصبعين في كف محب، مثلما تقول في هذا النص:
«أنت تقرر أن تصنع السقف أو تستعيره أو تعبره
لا يمكن لأفلاطون أو نابليون حتى،
أن يحاصراك في البرواز
وفي اللحظة الدسمة
عندما تستوي السنبلة وتتأهب أظافرك
ستهوي بسقطة واحدة كل الأسلاك
حتى التي دخلت فيها بمفردك».
لكن الشعر أوسع من الفكرة، ومن السقف، ولا يمكن أن يتحدد بمكان ما، كما أنه من دون إشراق العقل الكامن في امتزاج الحسي الأرضي بالأعلى المجرد فيما يشبه الخميرة المقدسة، تظل شعرية الفكرة مجرد مفتاح يوصل فقط إلى الباب، إلى نقطة محددة تشد الخيال دوماً إلى منطق الاستعارة الذهنية، ما يحد من تخوم المغامرة مع اللغة، حيت تبدو مجرد تصور لفكرة، أو تعبيراً عنها.
تعي الذات الشاعرة ذلك، فتموّه الفكرة وتشوشر عليها في الكثير من نصوص الديوان، مستندة على الذات وشطحها، فتحولها إلى شرك مغوٍ لاصطياد لذة النص والحياة، فنجد في الكثير من هذه النصوص ومنها: «ديسمبر ونصف مظلة - في عين اللؤلوة - في عيد ميلادك الخمسين - في مواجه المذبح - قطعة سكر - فراشة - البالون - مواربة - حبائل قمح» شكلاً من أشكال التواشج الحميم بين الضرورة الطبيعية لحركة الكون والعناصر والأشياء في الخارج، والضرورة الشعرية الذاتية في الداخل، فالذات ليست مشغولة بالتعبير عن شيء ما، إنما مسكونة بالحرية، تتكاثر وتتوالد في رحمها الأرحب والأعمق، ككتاب مفتوح بحيوية على العناصر والأشياء، بينما الشعر يقود ويلوّن ماضيها وحاضرها ونظرتها للقادم، يغمرها بمحبته الكفؤة الخالصة، وينتشلها من قمع الواقع. إنه لحظة انكشاف استثنائية مشاكسة، تتخطى الجغرافيا والتاريخ، تتصل وتنفصل، تبني مغامرتها على جوعها وعطشها وحلمها المفرد، حتى وهو يشتبك مع الكل والمجموع... تقول الشاعرة في نص بعنوان «شرنقة»:
«كفراشة نيئة أحلّق في بيتي
وقتي الذي أقضيه في المطبخ
أقطع بالسكين جزءاً منه للشعر وراء الستار
لا يعلم أحد أن ثمة قصيدة انسكبت مني وأنا أغسل الأطباق
وأن إعصاراً من الكلمات اجتاحني وأنا أطهو البامية
أحياناً لا أجد تفسيراً لهذا الزخم الذي يعتريني وأنا أشوي السمك
كالبندول تتردد المقاطع في رأسي».
فهكذا، في هذه المشهدية المقطوعة من نسيج الواقع اليومي، وفي براح قصيدة النثر، يتدفق الشعر في تراسلات حسية ولغوية خاطفة، مخلفاً ذبذبة بصرية، تخطف العين إلى المعنى الأبعد وراء ضربات الفرشاة العفوية المرتجلة في اللوحة، تماماً مثلما يحدث في القصيدة. إنها اللحظة الذي يشف فيها هذا الديوان الشيق عن نفسه ويلوذ بها، حافراً كينونته الخاصة.
اصطياد الوجه الهارب... شعرياً
ديمة محمود في ديوانها «أشاكس الأفق بكمنجة»


اصطياد الوجه الهارب... شعرياً

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة