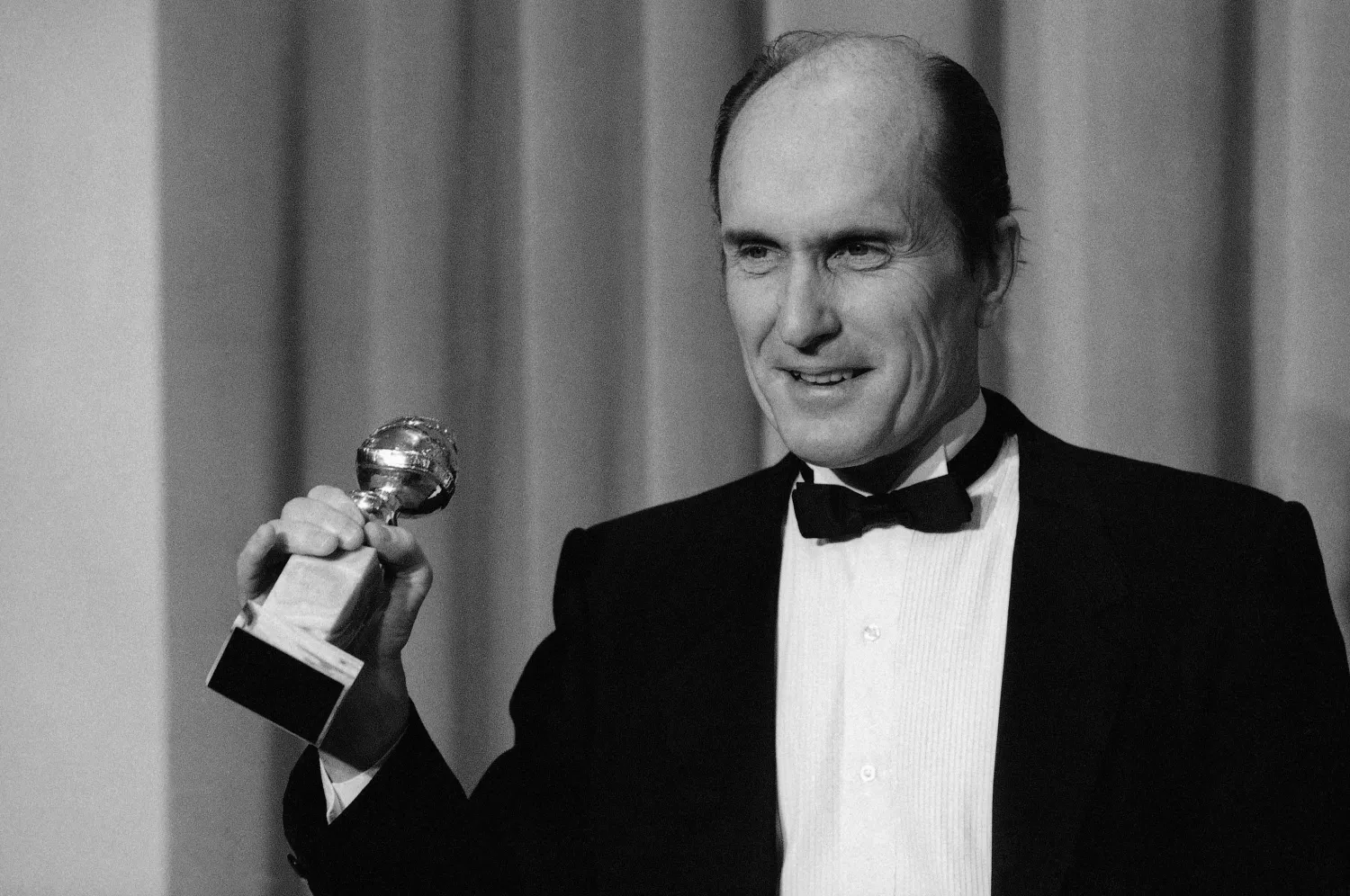كسل
• هذه الأيام تتزايد، عربياً، الأفلام التسجيلية التي تدور حول الأقارب. يختار المخرج شخصية معينة من أهله. قد يكون والده أو والدته أو جدته. أو قد يكون عمّـه أو ابن خالته. يلتقي به. يتفق وإياه على تحقيق فيلم تسجيلي حوله يتناول ذكرياته الخاصة.
• من خمسة أعوام وإلى اليوم، صارت لدينا مجموعة لا بأس بها من الأفلام. كان من بين أول هذه الأفلام فيلم سوري أجلس فيه المخرج والدته أمامه وأخذ يطرح عليها الأسئلة. ثم ترك الكاميرا مفتوحة موهماً إياها بأنه يحضر للتصوير وتركها تجلس طويلاً حتى استنجدت به أن يتركها تذهب في حالها («والله تعبت»، قالت له). لم أفهم الغاية من هذا الفعل القاسي.
• في فيلم لبناني من الصنف ذاته. الرجل وقف وراء الكاميرا يطرح أسئلة الماضي على جدته التي فقدت السمع وبعض الذاكرة. وفي البداية يسألها «أنا (فلان) تذكرتيني؟، فترد عليه «مني سامعة» فيكرر طرح السؤال بصوت أعلى مرة ومرتين وثلاثا وفي كل مرّة بصوت أعلى إلى أن سمعت وبطريقة ما قبلت أنه من العائلة.
• إلى ذلك، هناك حقيقة الفارق بين فيلم يعتمد على المقابلات وفيلم يعتمد - فقط - على المقابلات. الأول يملأ المساحات بجهد مواز للبحث في الموضوع والإتيان بشواهد ونبش في الوقائع والثاني يكتفي بأن يسأل ويصور الجواب.
• هذا الوضع الثاني هو كسل فاضح إن لم يكن أيضاً خلو موهبة. ويا لها من بداية فقيرة الخيال ومفتقرة إلى الإبداع. أكاد أتخيل حال المخرج وهو يبحث عن موضوع ولا يجده فيقرر كبديل التوجه إلى أحد المعمّـرين من أسرته وسؤاله.
• أحد الأفلام الأخيرة مقابلات مع سجينات ليس بينهن من هي قريبة للمخرج. هذا هو كل الفيلم بينما في فيلم سابق قابل سجينات، قامت المخرجة باختيار موضوع مصاحب تملأ به المساحة الفارغة بين المقابلة والأخرى، إذ طلبت منهن القيام بتمثيل مسرحي داخل السجن. بذلك أخرجت الموهبة الدفينة ومنحتهن تحقيق ذواتهن ومنحت الفيلم ومشاهديه عملاً لا يُنـسى.
• الكسل الذي هو عصارة مثل التجارب المذكورة أعلاه يخفق في الإشارة إلى أنّ هناك موهبة ما تستحق أن تحقق فيلماً ناهيك عن الاستمرار في صنع الأفلام. أول ما يكتفي المخرج بالبسيط من التحدي وشكله، يكون وضع كلمة النهاية قبل العنوان. وفي الوقت الذي تتكاثر الأفلام، وكلها باتت غير تجارية وهذا ليس دليل صحة، فإنّ المطلوب هو الجهد الحاسم للتميز والعمل بمقتضى ما هو مطلوب فنياً لإنجاز الفيلم، عوض المطلوب كنص أو كموضوع.
م. ر
10:34 دقيقه
المشهد
https://aawsat.com/home/article/1078891/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF



المشهد


المشهد

مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة