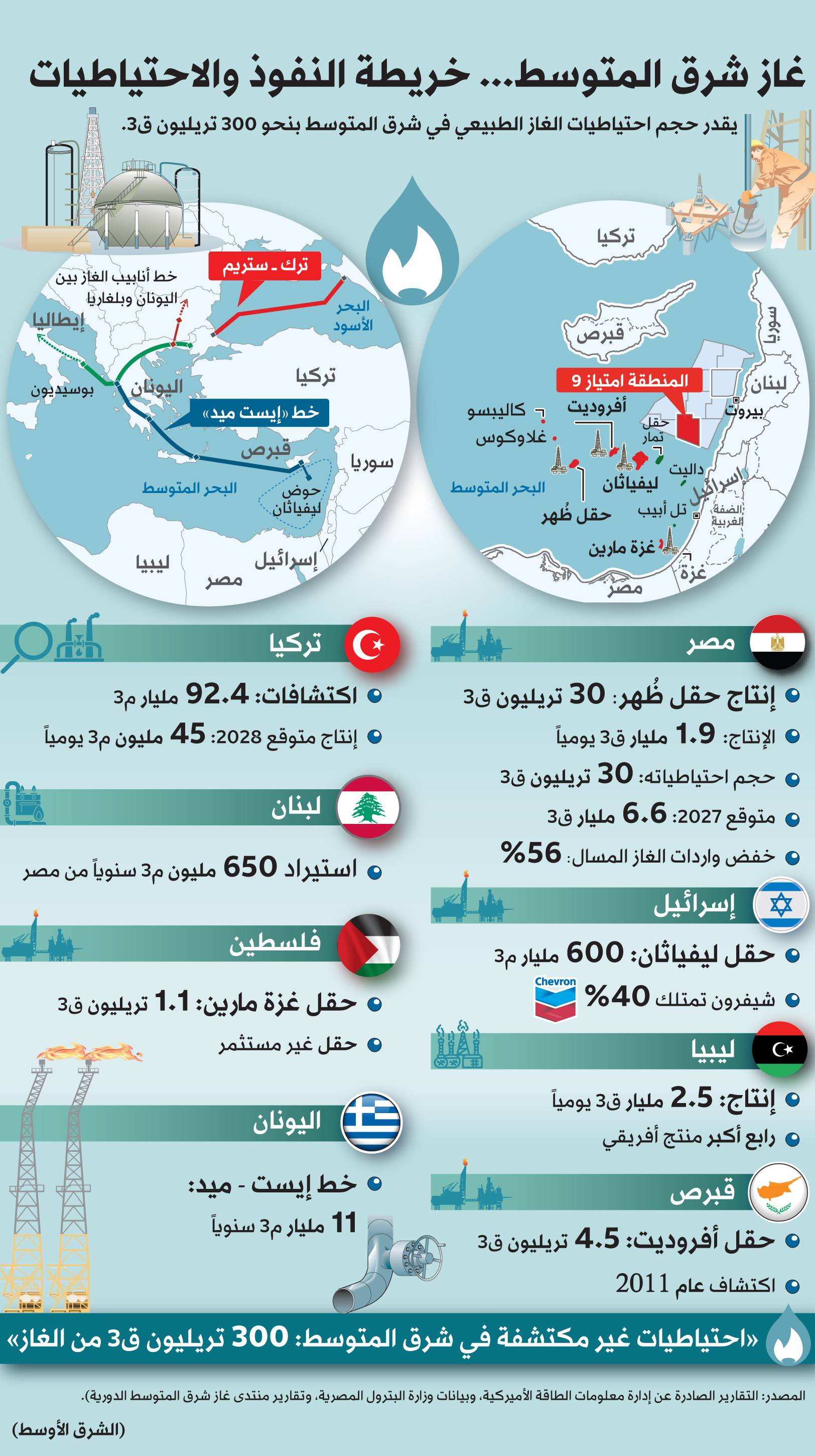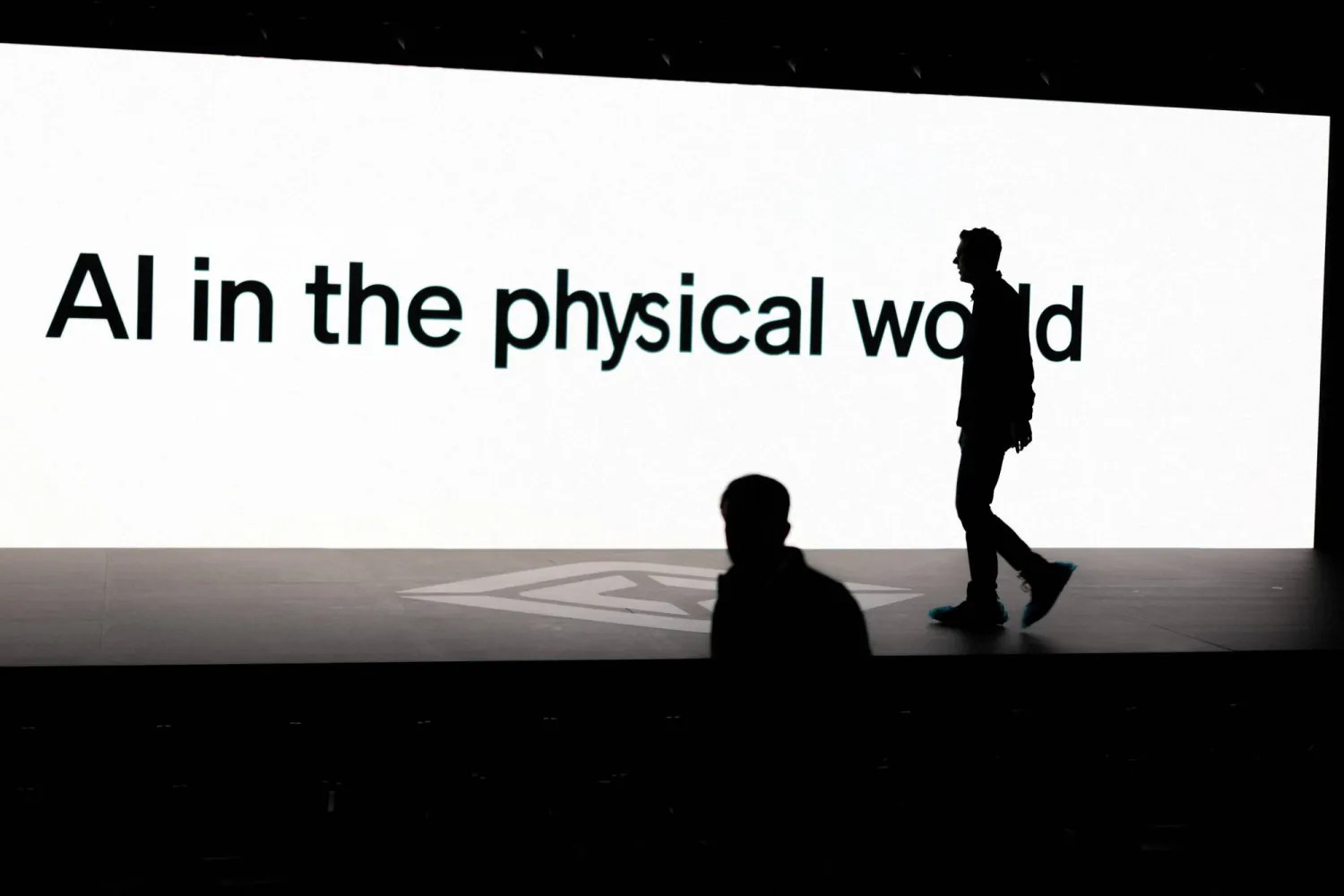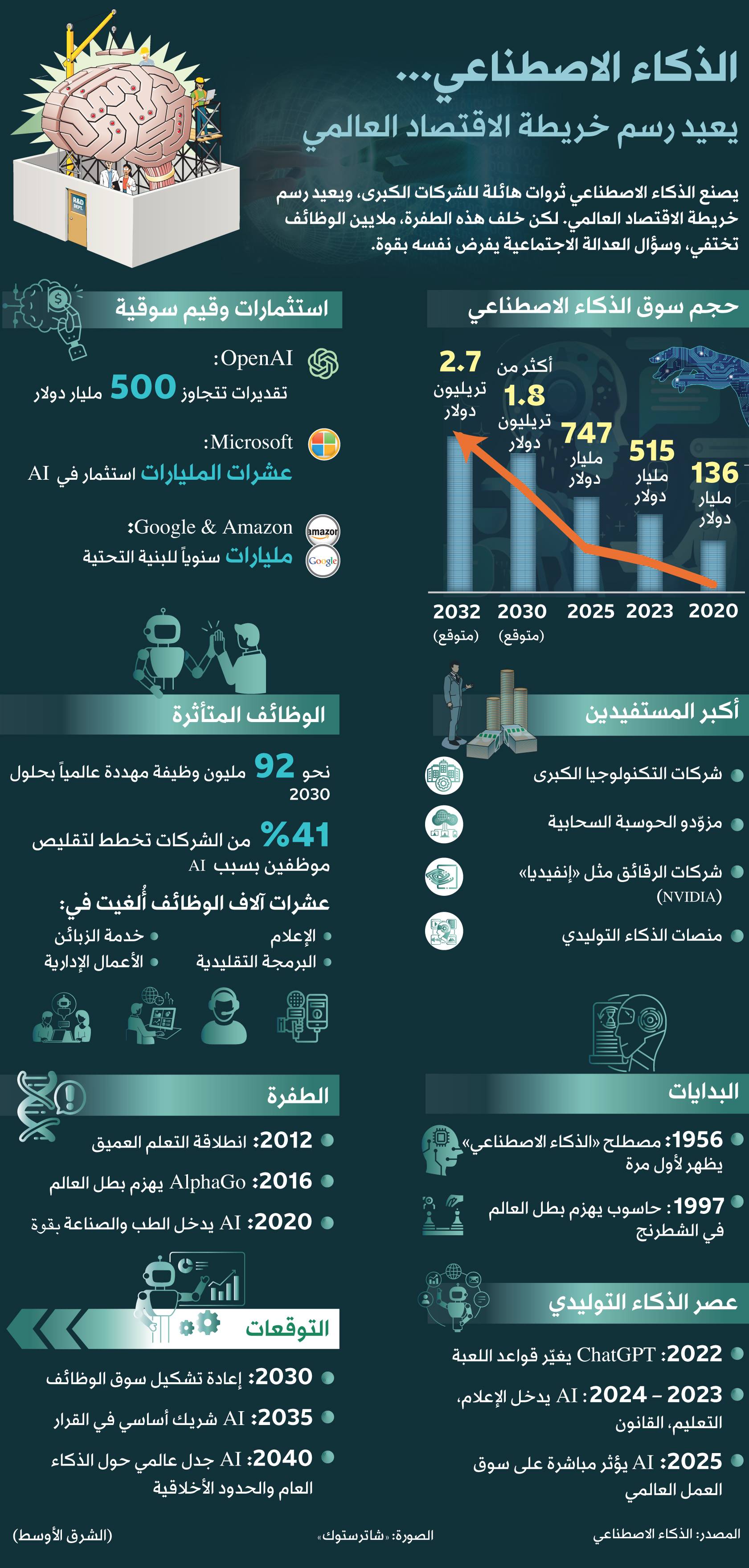في عام 2011. أخلت السفارات الأجنبية مسؤوليتها عن إدارة المدارس الأجنبية التابعة لها وأوكلت المهمة لجهات سورية أهلية استثمرت تلك المدارس، كالمدرسة الأميركية والمدرسة الفرنسية في دمشق. وكانت المدرسة تستوعب أكثر من 900 تلميذ تقلصوا خلال فترة الحرب إلى 220 تلميذاً.
لكن إدارة المدرسة نحت باتجاه تعزيز وجودها الثقافي من خلال مكتبة للمهتمين. وواصلت المدرسة الباكستانية التي واصلت عملها من دون تغيير رغم تراجع عدد طلابها جراء الحرب، وارتفاع أقساطها إلى ما يتجاوز المليون ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 500 ليرة) ما يجعلها حكرا على أبناء طبقة الميسورين.
في المقابل وسعت المدرسة الباكستانية الدولية نشاطها الاجتماعي الخيري كتقديم مساعدات لذوي الحاجات الخاصة وغيرها من أنشطة تؤكد حضورها على الساحة السورية، ولو بمستوى لا يعكس طموحها كباقي المدارس الأجنبية التي تنتظر جلاء حالة الحرب.
لكن ذلك لا ينطبق على نشاط المراكز الثقافية الإيرانية التي بدأت بالانتشار في سوريا منذ عام 2006 بهدف الترويج للغة والثقافة الفارسية. ومع بدء الصراع المسلح والوجود الإيراني العسكري تنامى الاهتمام الإيراني بنشر اللغة الفارسية بالتوازي مع نشر المذهب الشيعي الجعفري، عبر مدارس ثانوية شرعية انتشرت في قرى الساحل السوري منذ عام 2008 وريفي إدلب وحلب، المناطق التي تتطلع إيران لبسط نفوذها العسكري والاجتماعي والثقافي مستغلة حالة التهميش والفقر التي تعيشها تلك الأرياف، ومستفيدة من تقارب مذاهب العلويين (الذين يتركزون في قرى الساحل) مع مذاهب الشيعة، وتواجد عدد من القرى الشيعية في ريف إدلب وحلب.
لكن النجاح الذي حققته إيران في التغلغل في تلك المناطق إضافة إلى بعض أحياء دمشق في السنوات التي سبقت اندلاع الثورة ضد النظام، تأثر سلبا بالتدخل العسكري الإيراني إلى جانب النظام، على الضد مما أرادته إيران فتواجدها لم يلق العداء من المعارضة وحسب بل إن المجتمع الموالي للنظام تقبله على مضض، كالدواء المرّ.
حيث ساهمت المدارس الشرعية الإيرانية بانتشار طقوس ومظاهر دينية غريبة عن طبيعة تلك المناطق. ويقول علي. م موجه تربوي ريف اللاذقية: «بعد افتتاح الثانويات الشرعية الإيرانية لاحظنا أن بناتنا توجهن لارتداء الحجاب وبعض الشباب بدأوا يستنكرون عاداتنا المنفتحة في الساحل باعتبارها كفرا وبعدا عن الدين، وراحت مفاهيم وعادات متزمتة تنتشر في مناطقنا». ندى.ح تقول: إنها لم تعارض رغبة ابنتها بتعلم الفارسية والتردد على المركز الثقافي الإيراني، والمشاركة في نشاطات مجمع الرسول الأعظم، لكنها رفضت رفضا قاطعا التحاقها بالثانوية الشرعية، ما أدى إلى تفجر أزمة عائلية كبيرة. «لم أتقبل تدينها وتحولها إلى فتاة متزمتة معقدة ترفض مصافحة الرجال وتفرض علينا الحجاب».
وشهدت المدارس الإيرانية إقبالا متزايدا في القرى الفقيرة كون تلك المدارس تمنح رواتب شهرية للطلاب، كما تقدم لهم كافة التسهيلات لمتابعة الدراسة بإيران وإيجاد فرص عمل، في مساعٍ لتأسيس حاضنة شعبية مشبعة بالثقافة الإيرانية من خلال مؤسسات تغطي كافة المناطق السورية المستهدفة مثل «مجمع الرسول الأعظم» الذي افتتح في اللاذقية عام 2014 وتولى مهمة الترويج والدعاية للثقافة الفارسية كما أشرف على المدارس والمعاهد الخاصة لتعليم اللغة وأقسام اللغة الفارسية في الجامعات الحكومية دمشق وحلب وتشرين في اللاذقية والبعث في حمص.
وأسهم المجمع الذي يديره الشيخ أيمن زيتون خريج قم والمتحدر من بلدة الفوعة الشيعية في ريف إدلب، في تزايد الإقبال على تعلم الفارسية في ريف اللاذقية مقارنة بالمحافظات الأخرى حمص وحلب ودمشق. وظهرت برامج الدورات التي يجريها المجمع تناميا في برامجها، لا سيما بعد التدخل الروسي العسكري في سوريا، الذي لاقى قبولا في المجتمع الساحلي. وقال الموجه التربوي «علي.م» إن التدخل الروسي جاء «رحمة» لإنقاذ أهالي الساحل من المد الإيراني. وأضاف: «لا نكره إيران بل نحبها لكننا لا نحب مساعيها لتحويلنا إلى المذهب الشيعي والتزمت الديني، نحن لنا هويتنا ومعتقداتنا الخاصة بنا، وإذا أظهرنا ميلا لروسيا فليس حبا بها بل لأنهم يجلبون معهم قيما منفتحة متحضرة ولا يفرضون علينا معتقداتهم الدينية».
ربما حالة الرفض التي عبر عنها الموجه التربوي شكلت دافعا لحكومة النظام كي تأمر بإغلاق المدارس الشرعية الإيرانية في قرى الساحل مع بداية العام الدراسي الجاري، كمدرسة عين شقاق، ومدرسة رأس العين، ومدرسة القرداحة، ومدرسة كرسانا، ومدرسة سطامو، والثانوية المركزية ومدرسة البهلولية.... وغيرها، بزعم أنها لا تلتزم بتدريس المناهج المعتمدة من وزارتي الأوقاف والتربية التابعتين للنظام.
إغلاق تلك المدارس لم يلق الاحتجاج المتوقع سوى من بعض أهالي الطلبة الذين تساءلوا عن مصير دراسة أبنائهم، أما الجانب الإيراني المهموم بالسيطرة على أرياف حلب والساحل فاتجه نحو زيادة نشاطه في دعم تعليم اللغة في الملحقية الثقافية التابعة للسفارة الإيرانية بدورات على أربع مراحل و8 مستويات، في مراكز تعليم الفارسية في اللاذقية، ومركز تعليم اللغات الأجنبية التابع لجامعة دمشق، ومركز جامعة المصطفى لتعليم اللغة الفارسية، وحوزة الإمام الخميني والمدرسة المحسنية في دمشق، وحسينية الإمام المهدي في منطقة زين العابدين في دمشق، والكلية العسكرية السورية، وجامعة السيدة رقية ومركز الحجة في محافظة طرطوس والعديد من المراكز الأخرى. إضافة إلى توقيع اتفاقيات تتضمن منحاً دراسية متبادلة للمراحل الجامعية. والدراسات العليا، وكذلك مراحل الدكتوراه والماجستير. حيث تقدم إيران 200 منحة دراسية سنوياً للطلاب السوريين، مقابل 60 منحة يقدمها الجانب السوري للطلاب الإيرانيين!.
بالتوازي مع ذلك، نشطت «هيئة إعادة الإعمار الإيرانية» في حلب بإعادة تأهيل نحو خمسين مدرسة، منها 35 مدرسة في ريف حلب، أعيد تشغيل عشرين مدرسة ويجري العمل على المدارس الثلاثين الباقية. ووجدت إيران نفسها في تنافس محموم مع روسيا التي تمكنت فور دخولها سوريا من فرض تعليم لغتها بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم الأساسي إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية حيث تتولى وزارة الدفاع الروسية مهمة الإشراف على تدريس اللغة الروسية عبر كادر روسي خاص بوزارة التربية التابعة لحكومة النظام.
كما تعمل على تقديم منح لدراسة الأدب الروسي في موسكو ضمن خطط تأهيل كوادر سورية لتدريسه. وبعد أربع سنوات من إدخال اللغة الروسية على المناهج السورية، ما تزال مشكلة نقص الكوادر التدريسية العقبة الأهم في وجه نجاح هذه التجربة، إذ يتم الاعتماد على نساء روسيات متزوجات من سوريين، وكانت وزارة التعليم العالي التابعة للنظام قد أعلنت مؤخرا عن 18 بعثة علمية في روسيا للحصول على درجة الإجازة في اللغة الروسية وآدابها لصالح وزارة التربية.
وقال مدير تربية حلب إبراهيم ماسو: «عدد المدارس التي تدرس الروسية في حلب حالياً هي أربع مدارس، ويوجد توجه لتوسع نشر المادة في عدة مدارس أخرى بحلب، لكن ذلك يحتاج إلى كادر تدريسي» يجري العمل بالتعاون مع روسيا على تأمينه، كونها تطمح إلى تمكين تواجها في سوريا لا سيما في منطقة الساحل حيث تتواجد قواعدها العسكرية، وإذا كانت إيران تتغلغل في الريف كمجتمعات بسيطة أكثر قابلية للتجاوب مع دعايتها التبشيرية الدينية، لتكون قاعدة لسيطرتها على سوريا من خلال مؤسسات وهيئات إيرانية تنشئها داخل الجسم السوري، ولا تلقى القبول الكافي، فإن روسيا تسلك الخط الأسرع والأقوى والأكثر فعالية نحو المجتمع السوري عبر مؤسسات النظام التعليمية والثقافية القائمة، لتمارس وصايتها من الداخل حيث تجد في المجتمعات المدنية في مناطق النظام، تقبلا يضعها في موقع الراعي «المتفهم».
الفارسية تتغلغل بين الفقراء في مناطق النظام... والروسية في المدارس الرسمية
https://aawsat.com/home/article/1037076/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9

الفارسية تتغلغل بين الفقراء في مناطق النظام... والروسية في المدارس الرسمية
تقليص الاهتمام بالمدرستين الأميركية والفرنسية

الفارسية تتغلغل بين الفقراء في مناطق النظام... والروسية في المدارس الرسمية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة