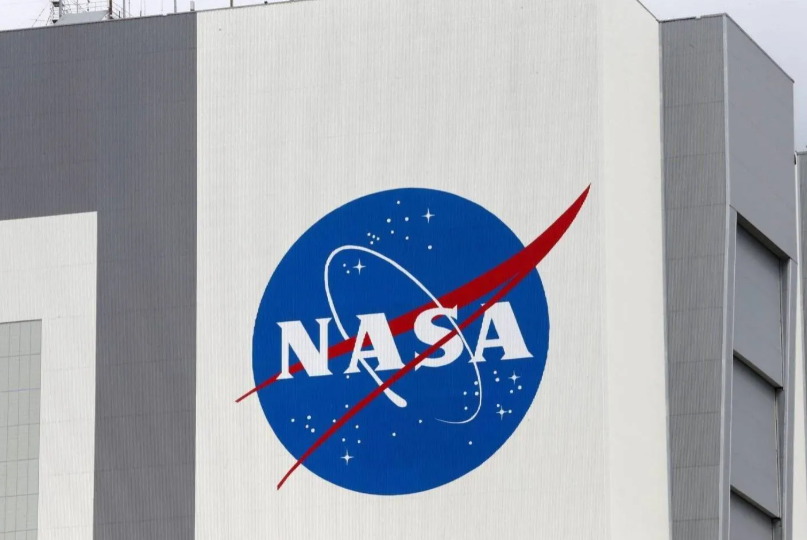في فلورنسا، أو فيرينزي كما يسميها الإيطاليون، تشعر بجلال الفن ومهانته في الوقت نفسه، عظمة التاريخ وتحوله إلى بضاعة معلبة، عمق الثقافة وتدجينها تحت أقدام السياحة المنمطة. عاصمة عصر النهضة، حيث دانتي ومايكل أنجيلو ودافنشي وميكيافيلي و... و...، تتحول إلى سوق للسياحة العالمية التي تدعم الاقتصاد المحلي والإيطالي، لكن على حساب الجمال والتفرد والعمق الذي يصعب التقاطه في زحمة الطوابير أمام المتاحف، وظلال الجوالات المتزاحمة لتصوير التحف ومناظر الغروب وانسياب نهر أرنو وسط المدينة العتيقة التي شهدت إحدى أهم ولادات الحضارة الإنسانية.
أمام المدن، يجد المرء نفسه أمام نصوص هائلة. يقول الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا إنه لا شيء خارج النص، والصدق - وإن كان نسبياً في هذه المقولة - هو ما يحسه المشاهد أمام ذلك الحشد من الإنجازات الفنية والمعمارية في الشوارع المؤدية إلى تاريخ ملتف عامر بالأسماء والأعمال والأحداث. المدينة تدعوك لقراءتها كنص، لكن أي نص هو؟ وأي أدوات ستوظف؟ أي منهج ستسلك للوصول إلى حقيقة النص وأنت أمام ركام القراءات السابقة والمقترحة التي تطالبك أو تدعوك إلى الانسجام مع مضامينها؟ ومع التسليم بأهمية تلك القراءات، بما هي مؤسسة على معرفة مباشرة ومعلومات مؤكدة حول تاريخ المدينة، أو منجزات أهلها ومبدعيها، فإن تلك الأهمية كثيراً ما تحول دون الخروج بما هو مختلف جديد، قادر بالتالي على الإضافة. تجد نفسك مسوقاً إلى الطوابير لترى ما يراه الآخرون، وتسمع ما يسمعونه، ويُلفَت انتباهك إلى ما يُلفَت إليه انتباههم؛ التفاصيل هي هي، حتى النهر يكاد جريانه يتعثر بتاريخ آل مديتشي الذين حكموا المدينة قروناً، وكانوا وراء عصر النهضة بأكمله: النهر والأسرة الحاكمة أسرى معلومات تتكرر، معرفة معلبة تسوق للسائحين، ابتداء من غرف الفنادق والمطارات ومحطات القطار حتى الوقوف أمام تمثال ديفيد أو قباب الكاتدرائيات.
ليست فلورنسا هي المدينة الوحيدة التي تئن تحت وطأة الركام المعلوماتي، والطرائق المتبعة في قراءتها، لكن الزائر إلى مدينة مثلها سيواجه مهمة بالغة الصعوبة، ربما فاقت ما سيواجهه في مدن أخرى أوروبية وغير أوروبية، صعوبة تتمثل في رؤية مدينة يكاد تاريخها يحجب واقعها، تكاد قداستها الفنية تحول دون رؤية فنونها، الفنون التي يقدسها البعض من بعيد، ويرى البعض الآخر مشاهدتها لازمة أو فرضاً لا بد من أدائه لكي تكتمل فيه معاني السياحة أو الزيارة الحقة.
عند متحفي أوفيزي وبالازو، بيتي الشهيرين، سيعرف الزائر أن عليه في معظم المواسم أن ينتظم في طابور مدته ساعتان ونصف الساعة إلى 3 ساعات لمشاهدة الأعمال الفنية بالداخل، أو أن يعمل حجزاً مسبقاً بموعد فينتظم في طابور أسرع. وحين يدخل، سيجد أنه يمارس طقساً تكرر آلاف المرات، بتلاوة المرشد كلاماً ردده آلاف المرات أيضاً، لكن الثقافة المعلمنة التي حولت الفنون، لا سيما الآتية من الماضي، إلى أيقونات ومجسمات ورموز، قامت أيضاً بتجريد تلك الأيقونات والمجسمات والرموز حتى من بقايا روحانيتها، وذلك بتعليبها تجارياً في المحال التجارية التي تتيح للزائر شرائها بأسعار معقولة، واصطحابها معه إلى بلاده أو منزله.
لوحات دافنشي وتماثيل أنجيلو وغيرها تتحول إلى سلع يشعر الإنسان بالسعادة حين يمتلكها، وإن لم يدرك قيمتها الجمالية أو دلالاتها الثقافية وسياقاتها التاريخية؛ لقد تجردت الأعمال من كل ذلك، وصارت تحفاً تقف على الفترينات، وتنتقل منها إلى صالات الجلوس أو الغرف في جميع أنحاء العالم. ومما يزيد من عبء عملية التسليع تلك عملية الاستنساخ. تقف تحت تمثال هائل، أو عند لوحة مدهشة، فتعرف أنها ليست الأصول، وإنما نسخ للأصل. عندئذٍ، قد تتذكر الألماني فالتر بنيامين، وحديثه عن تأثير الاستنساخ على الفنون، ثم تكتشف أن الاستنساخ قديم قدم الفن نفسه، وأن النسخ لا يعني تكرار الأصل فحسب وإنما قد يعني محوه أيضاً.
إحدى الطرق لكسر طوقي الاستنساخ والنمطية، سواء في فلورنسا أو غيرها، هي أن تزورها لكن دون أن تكون «سائحاً»، أن تشب عن الأطواق، لا سيما طوق الأدلة السياحيين و«القروبات» وكتيبات الشركات والباصات وطوابيرهم، أن تذهب بناء على معلومات تجتهد في لملمتها، وشوارع قد تضل أثناء السير فيها، فهي وإن اعتورها النقص وتخللها الخطأ ستقودك إلى تجربتك الخاصة في المشاهدة والتعرف. لكن كم هم الذين لديهم الاستعداد لتجربة صعبة كتلك؟! حاولت ذلك شخصياً ولم أحقق النجاح المطلوب، لكني على يقين أن الطريق الآخر، الطريق التقليدي السهل، لن يقود إلى المدينة الحقيقية بتاريخها ومنجزاتها. وليس هذا محصوراً في فلورنسا، وإنما هو منسحب على غيرها. لقد قيل إن الطريق الصحيح للتعرف على مدينة جديدة هو أن تضل في شوارعها (وأظن أن الاحتياط الوحيد هنا هو ألا تكون الشوارع خطرة).
من المعلومات المهمة والطريفة حول فلورنسا، التي ليس من المحتمل أن يبحث عنها السياح، أو يذكرها أدلتهم، أن اللغة الإيطالية ولدت من لهجة تلك المدينة العتيقة. في الربع الأول من القرن الرابع عشر، أتم دانتي رائعته الشهيرة «الكوميديا الإلهية»، تحفة الأدب الإيطالي والعالمي، وذلك باللهجة المحلية، مخالفاً عرف الكتابة باللاتينية السائد في أوروبا آنذاك، الأمر الذي أدى إلى تكريس تلك اللهجة، لتصبح مع الأيام، وبإضافات أدبية وفكرية أخرى، لغة إيطاليا «الفصحى».
الآخرون الذين أضافوا كان من بينهم بوكاتشيو الذي ألف حكايات «الديكاميرون»، في القرن الرابع عشر، معتمداً على قصص شائعة وضعها على لسان أشخاص تجمعوا في مكان معزول هرباً من مرض الطاعون الذي انتشر في ذلك الجزء من أوروبا، وحصد أرواحاً كثيرة. الطريف أنه على الرغم من أجواء الرعب المحيطة، جاءت الحكايات، أو بعضها، مثقلاً بالرغائب الحسية (الإيروتيكية)، وكأن بوكاتشيو على ما يبدو يساير انفتاح الفنون وتوجهها، وما تمخض عن ذلك من التماثيل العارية التي استعاد فنانو إيطاليا الكبار من خلالها الأساطير الدينية المسيحية والوثنية الإغريقية والرومانية، فتحقق معنى عصر النهضة، أو النهوض مرة أخرى (رينيسانس أو الولادة من جديد).
العمل الفلورنسي الآخر، الذي كرس الإيطالية المحلية، كان كتاب «الأمير» لمكيافيلي. فعلى الرغم من العنوان اللاتيني، فإن الكتاب ألف بالعامية، أو الإيطالية المحلية، الأمر الذي كرس تلك اللغة ومكانة فلورنسا الثقافية، ليس في إيطاليا وحدها وإنما في أوروبا ككل، لشهرة الكتاب، وتحول المؤلف إلى أب لعلم السياسة الحديث. هذا الكتاب، وغيره من روائع فلورنسا، ليس مما تكرسه السياحة النمطية بحصاراتها المألوفة، وطوابيرها الطويلة. إنها الثقافة التي يصعب «تسييحها» أو تعليبها لتناسب عصر السرعة.
فلورنسا... حين تدعوك المدن لقراءتها كنص
السائح {محاصر} في عاصمة النهضة

لوحة «عيد البشارة» لليوناردو دافنشي

فلورنسا... حين تدعوك المدن لقراءتها كنص

لوحة «عيد البشارة» لليوناردو دافنشي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة