على الرغم من انغماس الفنان سعد علي بمشروعيه الفنيين «صندوق الدنيا» و«أبواب الفرج والمحبة» فإن متابعته للمشهد التشكيلي الإسباني القديم والحديث قد فتحت له آفاقاً جديدة لم نعهدها في نتاجاته الفنية السابقة التي أنجزها على مدى أربعة عقود وهو يتنقل بين أربعة بلدان أوروبية عريقة، فقد درس في أكاديمية الفنون الجميلة في مدينتي فلورنسا وبيروجا الإيطاليتين وأقام فيهما منذ عام 1977 حتى عام 1984، ثم انتقل إلى هولندا وعاش في مدينتي أمستردام وأوتريخت حتى عام 1995 ليرتحل بعدها إلى بورغوندي في فرنسا ويقيم فيها حتى عام 2004 ثم يسافر إلى إسبانيا ويقرر الإقامة فيها بشكل نهائي مع زوجته النحّاتة الهولندية مونيك باستيانس. وبغية التعرف على أعماله الفنية التي أنجزها مؤخراً قررت زيارته بمرسمه الكائن في بلدة «شيفا» التابعة لمدينة فالنسيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
هنا حوار معه:
- خلال السنوات الخمس الأخيرة بدأتَ تتمرد على مشروعَيكَ الرئيسيين «صندوق الدُنيا» و«أبواب الفرج والمحبة» ما سرّ هذا التحوّل على صعيدي الثيمة والتقنيات؟
- ما أزال وفياً ومُتشبثاً بالمشروعَين الرئيسيين ولكنني بلغت مرحلة النضج، وصار لِزاماً علي أن أجرّب في الثيمة والأسلوب. ورحلتي الفنية لا تختلف كثيراً عن رحلات أجدادي السندباديين الذين ركبوا البحار مُغامرين بحيواتهم من أجل المعرفة، وحُب الاكتشاف، واختراق المجهول. لا تنس أنني قادم من بلاد ما بين النهرين، هذه البقعة الجغرافية المعروفة بمناخها المتطرف، وبيئاتها المتنوعة، وجنون نهريها في أوقات الفيضانات. وقد تعلّمت من عنفوان دجلة والفرات اللذين يغزوان البحر في كل عام ويحفران في الأرض عميقاً أن أقوم برحلتي الخاصة مهما كان مركبي الخاص صغيراً لأكتشف بنفسي القارة الأوروبية التي عشت في بلدانها أكثر من أربعة عقود متنقلاً بين إيطاليا وهولندا وفرنسا وإسبانيا. وفيما يتعلق بالجانب الرومانسي فقط ظهر عندي في مرحلة النضج التام واكتمال المدارك حيث رسمت عشرات اللوحات المفرطة في رومانسيتها مثل لوحات «حُبّي» و«البحث» و«مِلْكيتي» والقسم الأكبر من لوحات معرضي الأخير الذي سميتهُ بـ«الروح الحلوة». لقد أخذتُ الجانب الإيجابي من الحُب الذي يعشق فيه الإنسان ويكرّس حياته من أجل تكوين عائلة سعيدة شرط ألاّ يتخلى عن روح المغامرة، وارتياد الآفاق، والاستمتاع بحلّ ألغاز الحياة، وفكّ أسرارها، وهذا ما يفعله الأديب والفنان أو المنغمس في أي حقل إبداعي. الموضوعات سهلة وكثيرة، فهي تأتي عن طريق المُشاهدة العابرة أو المُراقبة الدقيقة التي تحتفظ بها ذاكرتي البصرية، وهي ذاكرة فنان، تختلف بالتأكيد عن ذاكرة الناس العاديين الذين لم يتخصصوا في الفن التشكيلي. أما التقنيات فهي تتطور عندي دون أن أشعر بذلك لكنني أكتشف الفرق حينما أشاهد مصادفة أعمالي القديمة التي مرّ عليها بضع سنوات وأقارنها بالأعمال الأخيرة التي تكشف حجم التطور في أساليبي الفنية التي تطوّع الموضوعات التي أشتغل عليها.
- التصوير الذهني
- لديك الكثير من الظِباء والغزلان والحيوانات الآخر التي تبدو وكأنها مُخترَعة ترسمها من مخيلتك الفنية التي تلتقط سرّ التفاصيل بشيء من الغموض المُحبب الذي يغلّف العمل بهالة فنية تدعو، في الأقل، إلى المفاجأة والدهشة والحبور. كيف يشحن الفنان سعد علي مخيلته في اللحظة الإبداعية؟
- يُعيدني هذا السؤال إلى الفترة الإيطالية في أواخر السبعينات من القرن الماضي في مدينتي فلورنسا وبيروجا الإيطاليتين، حيث اعتدت أن أسمع البروفسور أنيغوني وهو يقول بأن «التصوير جيد وله تأثيره في المستقبل» لكنه لم يكن يتوقع الثورة الإلكترونية، ومع ذلك فقد كان يؤمن «بالتصوير الذهني» الذي يُراعي التكوين، ويعطي كل لقطة حقها، فحينما تُمسك يدكَ بالتفاحة ينبغي للمشاهد أن يرى ثقل التفاحة على أوردة اليدّ دون أن تُصوَّر بطريقة عشوائية. البعض من الفنانين العراقيين، يراهنون، مع الأسف، على قابليتهم في تقليد الفن الأوروبي لكن هذه المراهنة خاسرة سلفاً، لأنها لم تضع في الحسبان التدرّج الفني الذي مرّت عليه سنوات، وعقود، وقرون طويلة من المتابعة، والدرس، والتقييم. أنا أراجع نفسي كثيراً، فحينما أُشاهد عملاً للفنان الإيطالي ساندرو بوتشيلي (1445 - 1510) مثل لوحة «الربيع» أقف مدهوشاً ثم أعود راكضاً إلى البيت وكأنني لم أفعل شيئا طوال عمري الذي تجاوزت فيه العقد السادس ببضع سنوات، وهذا الأمر يضعني أمام المسار الطويل الذي أنفقته في تجربتي الفنية. فمثلما تريدون كتابة الشيء الجديد وغير المكتوب سابقاً نحن الفنانين نريد تجسيد الصورة المستحيلة الموجودة في زاوية ما من هذا العالم بعد حكّ وتقشير غلافها الخارجي، وأعني بهذه العملية امتلاك الفنان عُدّته التقنية التي تساعده في إنجاز اللوحة بمدة زمنية معقولة، ولهذا تراني أحتج على بعض الفنانين الذين ينجزون لوحة واحدة خلال سنة أو سنتين وربما أكثر من ذلك. ولكي أكون صريحاً معك أنا أنجز لوحات كثيرة تكفي لإقامة معرضين أو ثلاثة معارض في السنة الواحدة. وكما رأيت فإن مرسمي في بلدة Chiva مليء بالأعمال الفنية المُنجزة التي تنتظر أعين المُشاهدين.
- جماليات التشكيل
- عشتَ في عدة دول أوروبية وتأثرت بفنونها التشكيلية. ما حجم تأثرك بالفن الإسباني القديم والحديث، وهل أفدتَ من ثيماته وتقنياته معاً؟
- المشهد التشكيلي في إسبانيا واسع ويضم عدداً كبيراً من الفنانين التشكيليين الذين يصعب حصرهم في هذا المجال الضيق المتاح لنا، ولكنني أستطيع القول بثقة كبيرة بأن الحركة التشكيلية الإسبانية متطرفة في الإبداع والحداثة لأنهم يجمعون بين الجذور العربية والأوروبية. وقد خلق هذا التزاوج بين الحضارتين العربية والإسبانية نوعاً ثالثاً مُهجناً يحمل العناصر الأولية لكلتا الثقافتين. ومن بين الأسماء الإبداعية البارزة في الفن التشكيلي الإسباني دييغو فيلاسكيز (1599 - 1660) الذي أثّر على أجيال فنية لاحقة حتى أن الفنان الفرنسي إدوار مانيه قد وصفه «برسّام الرسامين»، ونظراً لحرفيته العالية فقد عُيّن فيلاسكيز رسّاماً للملك فيليب الرابع وهو في سنّ الرابعة والعشرين حيث رسم الكثير من البورتريهات للملك ولأسرته، كما أنجز الكثير من اللوحات الفنية للقصور الملكية. لا يقلّ فرانسيسكو غويا (1746 - 1828) عن سلفه فيلاسكيز في التأثير وقد أنجز أعمالاً فنية خالدة مثل «الإعدام رمياً بالرصاص»، «هجوم المماليك»، «عائلة كارلوس الرابع»، «دوقة ألبا»، «العاصفة الثلجية»، «عازف الغيتار الأعمى»، وغيرها من اللوحات الفنية المستقرة في ذاكرة المتلقين. إن مشاهداتي المتواصلة لأعمال الفنانين الإسبانيين الكبار قد أفادتني كثيراً، ولعل لوحاتي الكبيرة التي أنتجتها مؤخراً ناجمة عن هذا التأثر المدروس، وربما هي التي أخرجتني قليلاً من مشروعي القديمين حتى أنني بتُّ أشعر وكأني أطير وأحلّق بجناح ثالث. رحلة التأثر الإيجابي طويلة وربما تمتد من روفائيل وكرافاجو إلى رمبرانت وفيرمير وكوخ ولا تنتهي بفيلاسكيز وبيكاسو وعشرات الفنانين المحدثين الذين أشاهد أعمالهم وأتأملها بعينٍ تشكيلية قادرة على الفرز والتقييم والنقد المُحايد الذي ينتصر لجماليات الفن التشكيلي.
- بصمة لونيّة
- لا تخلو لوحاتك من حس تراجيدي مثل لوحة «مِلكيتي»، فمع أنها تتمحور على الحُب إلاّ أنها مليئة بالمعاناة
- لكي يكون المُشاهد على دراية بما نتحدث عنه لا بد لنا أن نصوّر طبيعة العمل، فهو عبارة عن امرأة اصطحبت معها تمثال حبيبها وأخذت تتنقل به في كل منطقة تحلّ بها، فهو كنزها الوحيد، ومِلكيتها الخاصة بها تحمله معها أينما حلّت وارتحلت. ما يميّز هذه اللوحة هو لون (الفيكَرين)، فلون الرجل غامق وأكثر دُكنة منها، ورغم أنّ هذا اللون بارد لكنه محروق، وهذه بصمة لونية أتميّز بها عن بقية الفنانين العرب خاصة، والأجانب بشكل عام.
- إيهام المتلقي
- بعد سنّ الستين لم تعد تهتم بالمظاهر الخارجية للمرأة المعشوقة فهي بلا شعر مثلاً بينما كانت في السابق مكتملة لا يعوزها شيء. كيف تفسّر لنا هذه الرؤية الجديدة للمرأة المحبوبة؟
- الحُب، بالنسبة لي في هذا العمر، أعمق من الشكل الخارجي الذي يراه عامة الناس، فلا حاجة إلى الغُرّة ولا إلى شعر الرأس كله لأنني أركِّز على ملامح المرأة ولعلك تجد في سلسلة لوحات «البحث» نساء بلا شعور لأنني أريد أن ألفت انتباه المتلقي إلى العينين مثلاً أو الأصابع الطويلة الليّنة أو إلى بقية أعضاء الجسم البشري الذي لم يألفه المُشاهد من قبل. لقد سعيت في السنوات الأخيرة إلى خلق اللوحة السريالية أو إيهام المتلقي بأن الكائن البشري يمكن أن يمتلك ثلاث أيدي لكسر آلية التلقي المعهودة. وقد توصلت إلى جماليات الروح وحلاوتها، وهذا الفهم هو الذي دفعني لأن أسمّي معرض الأخير المُقام حالياً في مدينة ركينا الإسبانية بـ«الروح الحلوة»، وهي تسمية خاصة بي لأنني اجترحتها خلال أسابيع العمل وما أزال تائهاً بين ثناياها.
سعد علي: ما أزال تائهاً بين ثنايا الروح الحلوة
الجانب الرومانسي برز في لوحاته في مرحلة النضج
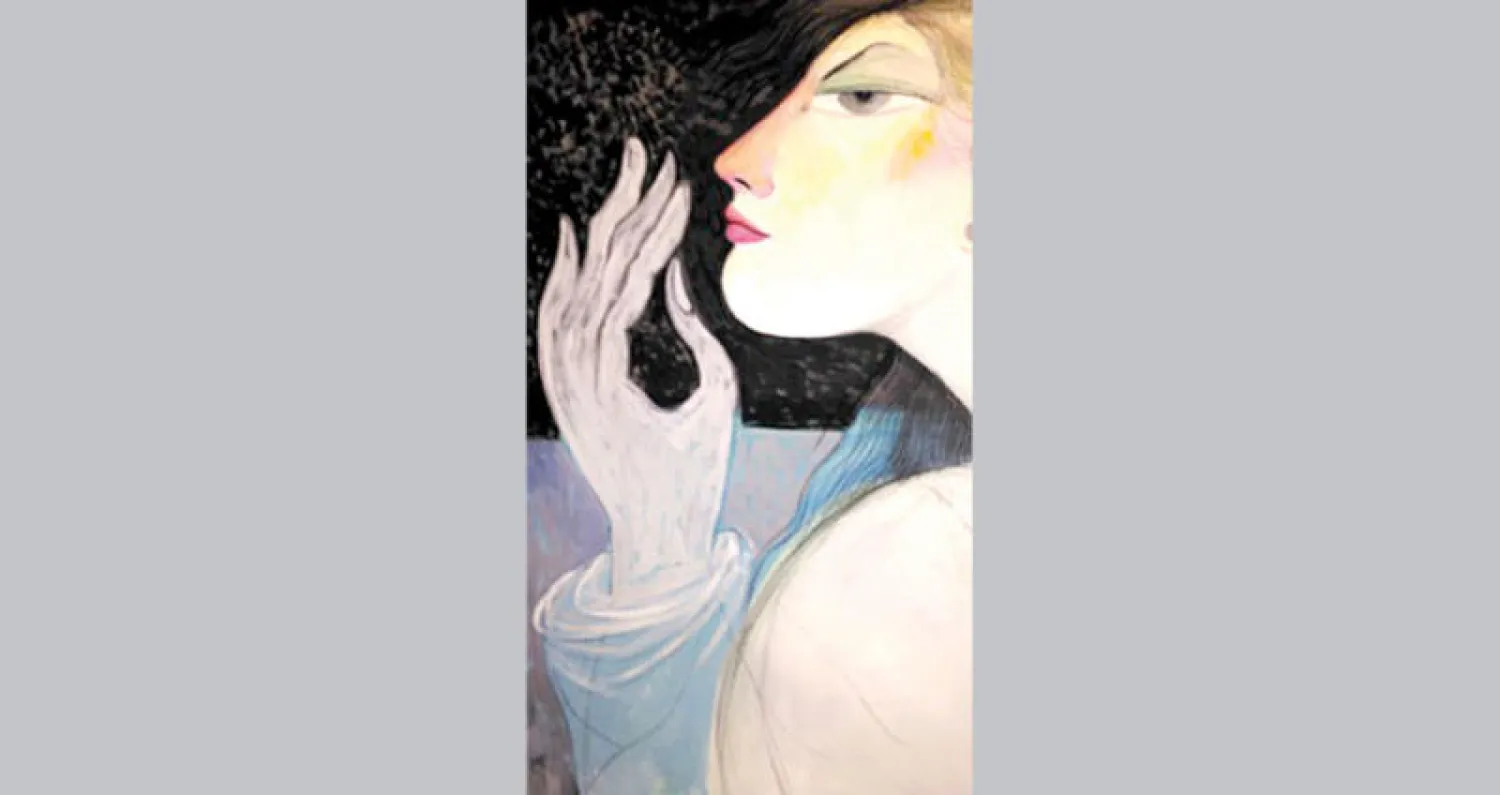
لوحة «اللقاء الأزلي»

سعد علي: ما أزال تائهاً بين ثنايا الروح الحلوة
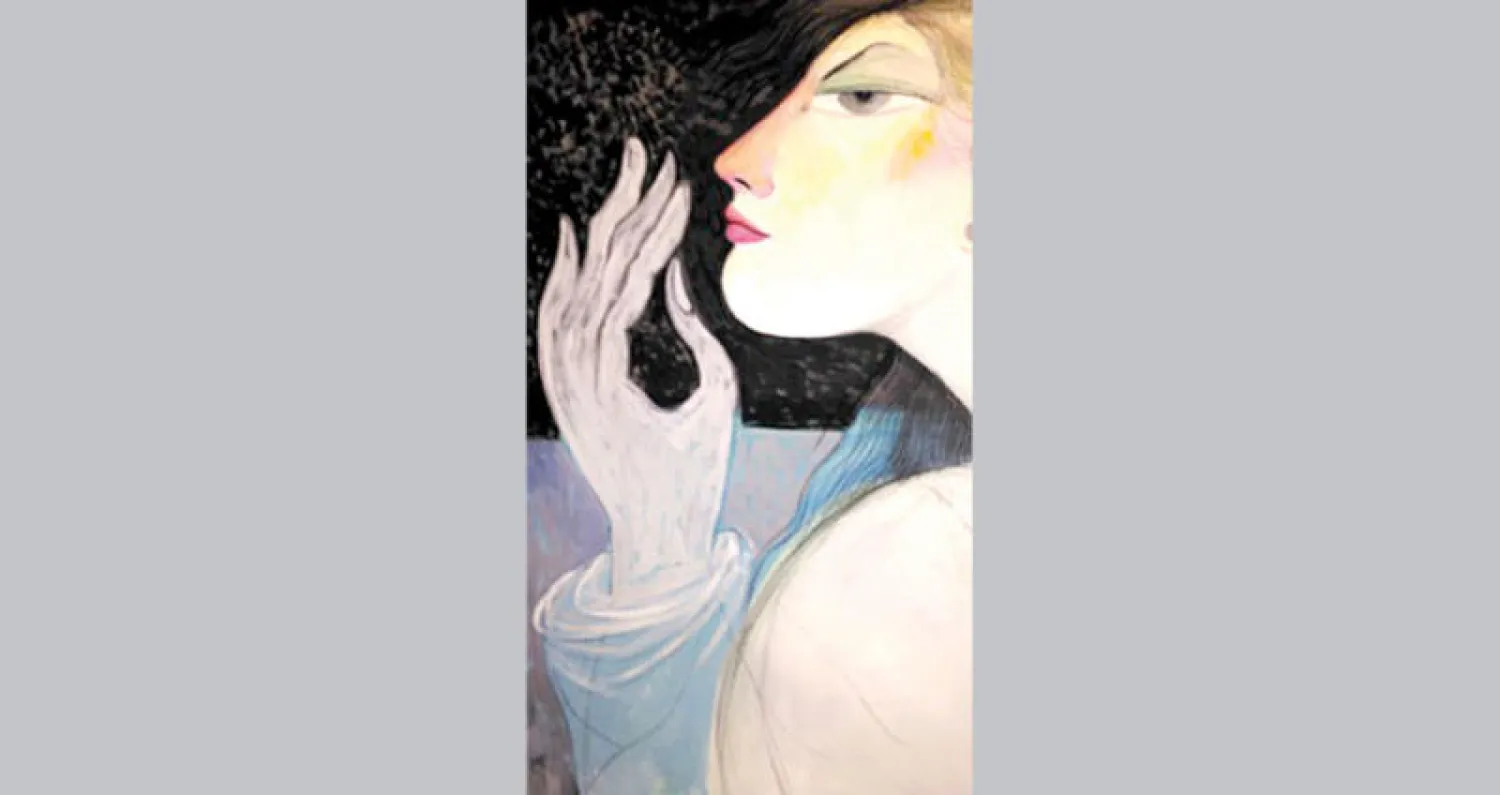
لوحة «اللقاء الأزلي»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة











