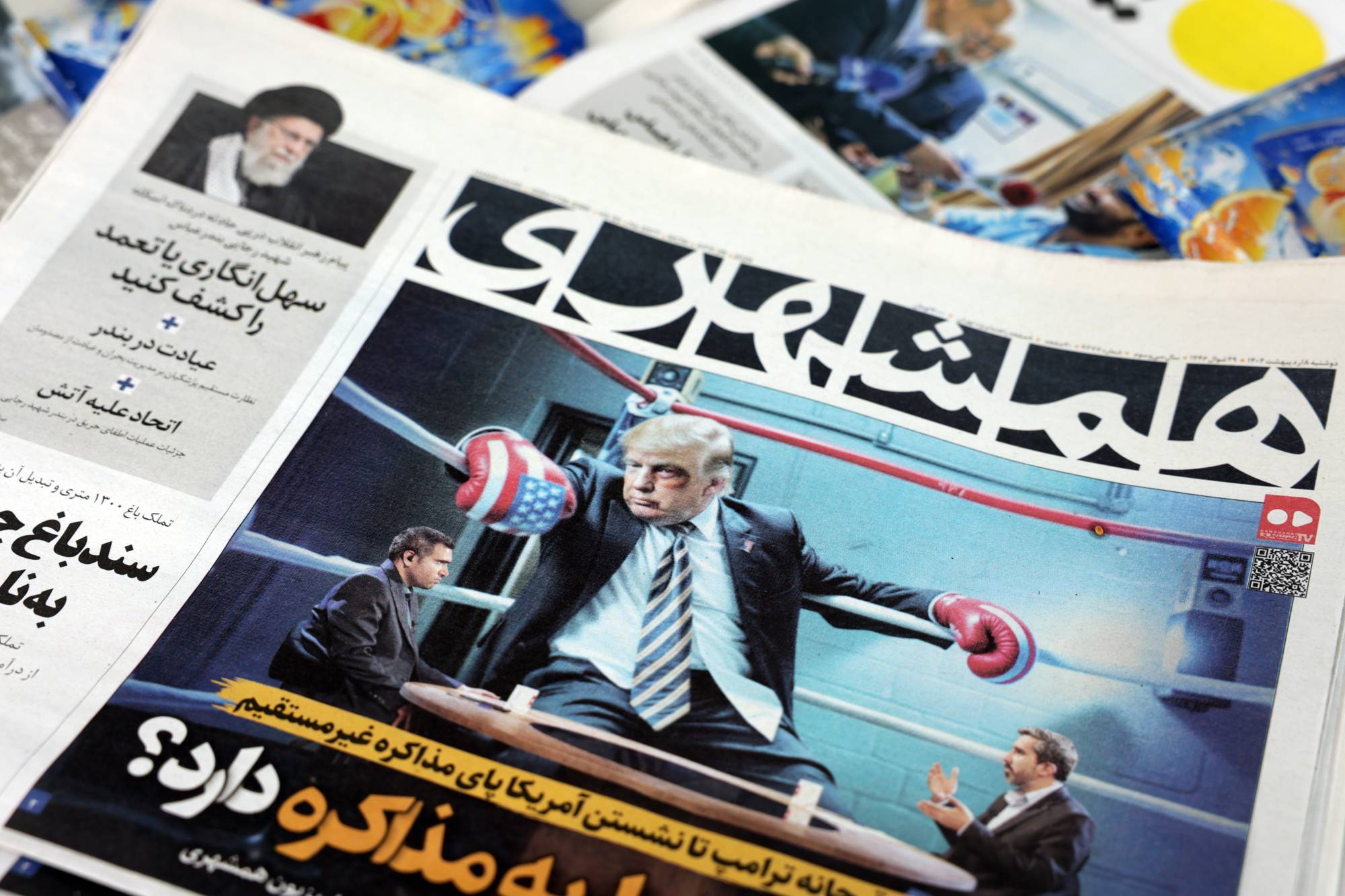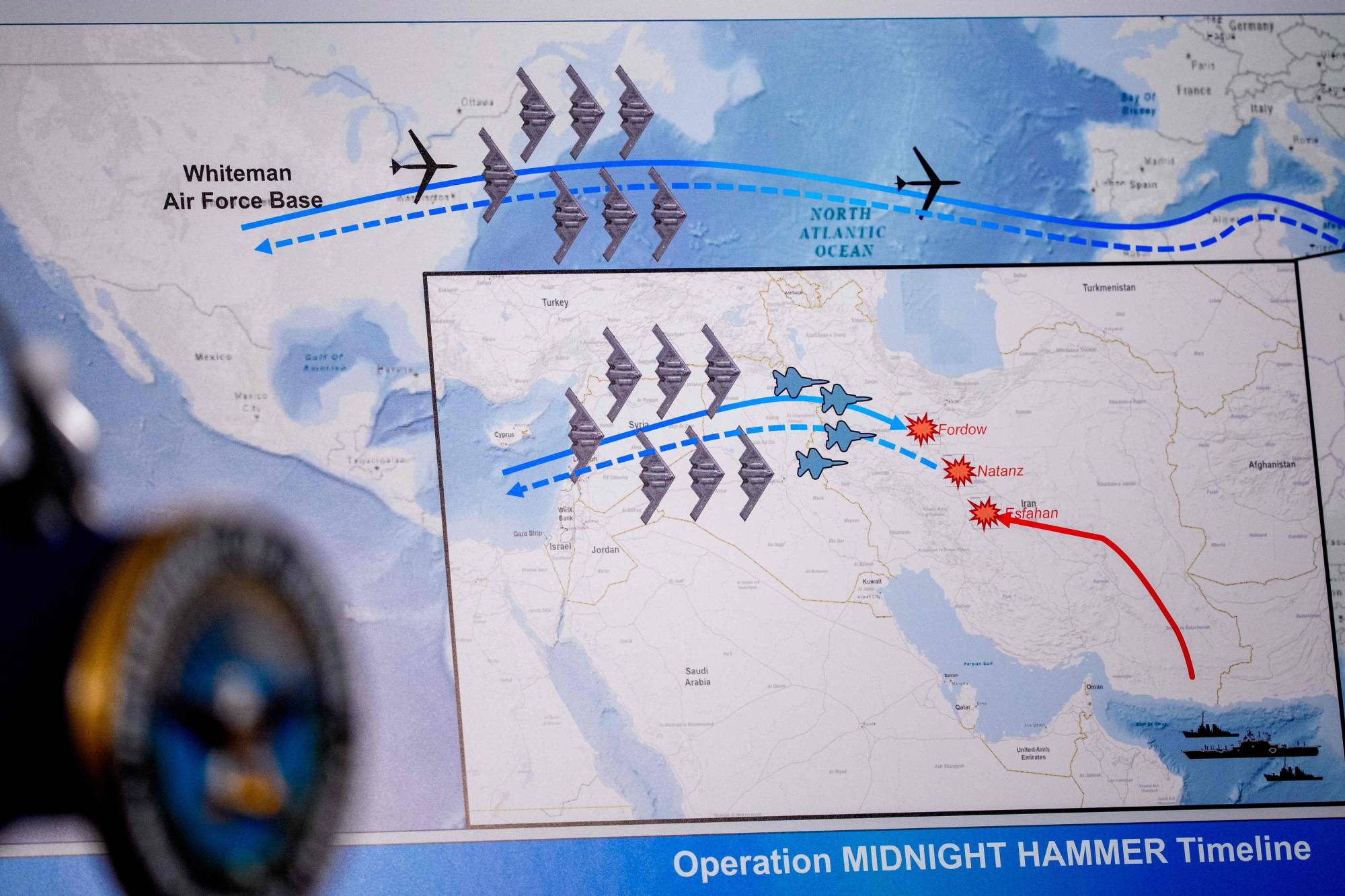بعد تكريمه في سادس أيام «مهرجان مراكش»، اعترافاً بموهبته وتأكيداً لقيمته الفنية داخل المشهد السينمائي المغربي، حلّ المخرج وكاتب السيناريو والممثل فوزي بنسعيدي، أول من أمس الجمعة، ضيفاً على فقرة «حوار مع ...»، ضمن فعاليات اليوم الثامن من هذه التظاهرة الفنية التي تواصلت على مدى 9 أيام. كما كان الموعد، في فقرة حوارية ثانية، مع المخرج وكاتب السيناريو الفرنسي برتران بونيلو، الذي تحدث عن بداياته واختياراته الفنية وقناعاته، وكيف صار مخرجاً سينمائياً.
وعلى مستوى العروض السينمائية، تميزت فعاليات هذا اليوم بدخول فيلمين جديدين سباق الفوز بجوائز المهرجان هما «الهدير الصامت» (2023) للأسكوتلندي جوني بارينكتون، و«عالمنا» (2023) للكوسوفية لوانا باجرامي؛ فيما عُرض «مايكينغ أوف» (2023) للفرنسي سيدريك كان، في فقرة «العروض الاحتفالية». و«مروكية حارة» (2023) للمغربي هشام العسري، في فقرة «بانوراما السينما المغربية»، و«غير المرغوب فيهم» (2023) للفرنسي لادج لي، في فقرة «العروض الخاصة». وفي «القارة الحادية عشرة»، كان الموعد مع «فتاة صغيرة زرقاء» (2023) للفرنسية منى عشاش، و«العروس» (2023) للرواندية ميريام بيرارا، و«بين الثورات» (2023) للروماني فلاد بيتري، و«جبل رأس جوز الهند» (2023) للكونغولي آلان كاساندا.

حواران مع بنسعيدي وبونيلو
شكل اللقاء الحواري مع بنسعيدي فرصة للوقف على قناعاته واختياراته، والاقتراب أكثر من طريقة تدبيره لتجربته السينمائية، وتأكيداً للمضمون الذي تتحرك من خلاله أعماله، قال بنسعيدي إن بإمكان الأعمال السينمائية تمرير رسائل قادرة على «قلب المعايير وتغيير العالم».
وجاء ربط المخرج المغربي بين السينما وأوضاع العالم، في سياق تفاعله مع مشهد من «يا له من عالم رائع»، ظهرت فيه بطلة الفيلم، في دور شرطية مرور، وهي تؤدي مهمتها في ضبط حركة المرور على مستوى إحدى المدارات الطرقية، قبل أن تتقاطع نظراتها مع شاب، فيتبادلان الإعجاب، قبل أن ينتقل إلى «مشهد راقص» لحافلات وسيارات ودراجات نارية، حول المدارة الطرقية، فيما يشبه سمفونية تضبط الشرطية إيقاعها بدقة عجيبة.
وتطرّق بنسعيدي، في معرض مروره الحواري، إلى الكيفية التي يختار بها الفضاءات التي يصور فيها أعماله، مشيرا إلى أنه يتعامل معها كتعامله مع عملية «الكاستينغ» التي تتم على مستوى اختيار الممثلين. وأضاف أنه يزور تلك الفضاءات بمفرده، قبل بدء التصوير، وخلال أوقات متفرقة من اليوم، لأجل تحديد الوقت الملائم للتصوير. كما تحدث عن التطور والتجديد الحاصلين على مستوى أعماله، وشدّد على أن المهم بالنسبة إليه يبقى الوفاء لشغف شخصي بالسينما.
وعن أعماله، ومدى إمكانية مفاضلته بينها، قال إنه لا يميز بين عمل وآخر، مشدداً على أنه صنع كل فيلم من أفلامه بالحب والشغف والصدق نفسه. كما تحدث عن علاقة المسرح بالسينما، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة استفادت كثيراً من الممثلين القادمين من المسرح، لكنه رأى أن السينما تبقى أقرب إلى الموسيقى والهندسة المعمارية منها إلى المسرح.

من جهته، تحدث بونيلو، في فقرته الحوارية، عن انتقاله من الموسيقى إلى السينما، وهو الذي بدأ رحلته الفنية منشغلاً بالموسيقى الكلاسيكية، وكان يحلم في مرحلة المراهقة بأن يصبح قائد فرقة موسيقية، قبل أن يتحول إلى موسيقى الروك والبوب. وفي منتصف العشرينات من عمره، بدأ يهتم بالسينما، من خلال مشاهدة الأفلام، وأخذ فكرة عن أفكار وقناعات المتخصصين بها من خلال قراءة حواراتهم، ليبدأ، شيئاً فشيئاً، في اكتساب صرامة فنية، مكنته من سرد القصة وكتابة الفيلم بطريقة خاصة ومميزة.
ولتوضيح أفكاره أكثر، استعرض بونيلو أمام الحضور مقتطفات من عدد من أفلامه، كما تحدث عن عناصر تكوين المشروع السينمائي، متوقفاً عند تجربته في فيلم «سان لوان»، الذي يتناول السيرة الذاتية للمصمم الفرنسي الشهير إيف سان لوران. كما تحدث عن تفاصيل التصوير ورؤيته للعملية الإبداعية.
وعُرض لبونيليو أول فيلم طويل، «شيء عضوي» (1998)، في قسم البانوراما بمهرجان «برلين»، وشارك فيلمه «المصور الإباحي» (2001) في قسم أسبوع النقاد بمهرجان «كان»، حيث فاز بجائزة الاتحاد الدّولي للنقاد السينمائيين. كما اختيرت أفلامه المتوالية في مهرجان «كان»: «تيريزيا» (2003)، و«في الحرب» (2008)، و«التسامح: ذكريات من منزل الدعارة» (2011)، و«سان لوران» (2014). وبعد ذلك، أخرج «نوكتوراما» (2016)، واختير «طفلة زومبي» في قسم «أسبوعي المخرجين» (2019)، و«الغيبوبة» (2022) في المسابقة الرسمية لمهرجان «برلين»، حيث نال جائزة الاتحاد الدّولي للنقاد السينمائيين. فيما عُرض فيلمه الأخير «الوحش» (2023)، في مسابقة «مهرجان البندقية السينمائي الدّولي».
هدير صامت وثورات
جاءت أفلام اليوم الثامن في المهرجان متنوعة، في توجهاتها الفنية والمضامين التي تلامسها، تتراوح في ذلك بين رصد هشاشة الواقع اليومي وانكسارات الأفراد في مختلف تجلياتها ومستوياتها، علاوة على استحضار مظاهر البؤس والتوتر والألم التي تعاني منها شعوب وجماعات في عدد من مناطق العالم، وتوْقها إلى مستقبل أفضل.
وتدور أحداث «الهدير الصامت» في جزيرة لويس في أسكوتلندا، من خلال شخصية دوندو، راكب الأمواج الشاب، الذي لم يتقبل واقعة رحيل والده الصياد بعد فقدانه في البحر منذ ما يزيد على السنة. بطبعه الهادئ والحالم، بدأ يقترب من ساس، زميلته في الدراسة، وهي فتاة مفعمة بالذكاء لا تتردد في استفزاز الآخرين. ستنمو بين الشابين صداقة غير متوقعة ستساعدهما في شق طريقهما في مجتمع ريفي، بين الأمواج العاتية والمعتقدات ونيران الجحيم.
أما «عالمنا»، فتدور أحداثه في كوسوفو في 2007، حين تغادر كل من زوي وفولتا قريتهما النائية من أجل الالتحاق بجامعة بريشتينا. وعشية الاستقلال، ومع تصاعد حدة التوتر السياسي والاجتماعي، تواجه الشابتان صخب بلد في بحث عن هويته، بلد ترك شبابه كل شيء خلفه.

فيما تتمحور أحداث «مايكينغ أوف» حول سيمون، وهو مخرج فرنسي شهير، بدأ تصوير فيلم جديد عن العمال الذين يناضلون لمنع نقل مصنعهم. لا شيء يسير كما هو مخطط له. فمنتجته فيفيان ترغب في إعادة كتابة نهاية الفيلم وتهدد بخفض الميزانية، وفريقه مضرب عن العمل، وحياته الشخصية في حالة من الفوضى، ومما يزيد الطين بلّة أن الممثل الرئيسي آلان شخص غبي وأناني. يوافق جوزيف، الممثل الثانوي في الفيلم الذي يريد ولوج عالم السينما، على تصوير مرحلة تصنيع الفيلم. يأخذ جوزيف دوره الجديد على محمل الجد ويبدأ في متابعة طاقم التصوير والتقاط كل صور هذه الفوضى. ما يلي من أحداث يدل على أن «المايكينغ أوف» قد يكون في بعض الأحيان أفضل بكثير من الفيلم نفسه.
أما «مروكية حارة» (مغربية حارة) فيقدم تشخيصاً مصوراً للمجتمع من خلال امرأة مغربية ترفض الخضوع. وتدور أحداث الفيلم في مدينة الدار البيضاء المتوهجة، حيث تبدأ خديجة، الملقبة كاتي، يومها بمزاج سيئ. وفي لحظة من العزلة والصراحة، تكتشف أن الحياة لم تكن سهلة بالنسبة لها، لتدرك، عشية عيد ميلادها الثلاثين، أن عائلتها تستغلها، وخطيبها أيضاً.
في «غير المرغوب فيهم»، يتعلق الأمر بقصة هابي التي تولي اهتماماً بالغاً لكل ما يهم أمور بلديتها، فتكتشف التصميم الجديد لإعادة تهيئة الحي الذي تقطن فيه. بإيعاز من بيير فورجيس، طبيب الأطفال الشاب الذي أصبح عمدة للمدينة، يضع التصميم من بين مخططاته هدم المبنى الذي نشأت فيه هابي، فتخوض مع أقاربها نضالاً قوياً في مواجهة البلدية وطموحاتها الكبيرة لمنع هدم العمارة رقم 5.

أما «فتاة صغيرة زرقاء» فيحكي قصة منى عشاش، التي اكتشفت بعد وفاة والدتها، آلاف الصور والرسائل والتسجيلات، لكن هذه الأسرار الدفينة قاومت لغز اختفائها. وبقوة السينما وبفضل إمكانية التجسيد، تقرّر بعثها من جديد لتعيد إحياءها ولتستطيع فهمها.
ويعرض «العروس» قصة إيفا، وهي امرأة شابة تطمح في أن تصبح طبيبة. ستُختطف هذه الشابة، بعد مرور ثلاث سنوات على الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا. ووفقاً لتقاليد كوتيرورا، ينوي مختطفها الزواج بها رغماً عنها. وبعد شعورها بأن عائلتها تخلّت، ودفعت بها للخضوع والقبول بالأمر الواقع، تتقرب الشابة من ابنة عم خاطفها، لكنها، عندما تكتشف الماضي المأساوي لعائلتها الجديدة، ستصبح في حيرة من أمرها، بحيث لم تعد تعرف هل عليها الفرار أو البقاء.
وتدور أحداث «جبل رأس جوز الهند» في نيجيريا، حيث تنظم مجموعة من طلبة جامعة إيبادان، وهي أقدم جامعة في نيجيريا، كل خميس، نادياً سينمائياً يحوّل مدرجاً صغيراً إلى فضاء سياسي تُطوّر فيه وجهات النظر وتُصقل الكلمة النقدية. والفيلم هو تعبير ازدرائي يرمز للشباب السطحي الذي يفتقد القدرة على التفكير، وقد مُنح معنى جديدا بعدما تخلّص الطلبة من وصمة العار هذه التي أُلصقت بهم، ليطالبوا بحقهم في حرية الفكر.
أما «بين الثورات»، الذي أنجز بصور أرشيفية مقترنة بشريط صوتي مفعم بالألوان، فيستحضر بشكل حميمي، تتخلله لحظات حزن وفرح، نضالات الشعوب من أجل مستقبل أفضل، من خلال الصداقة المتينة التي تجمع بين امرأتين. وتدور أحداثه في رومانيا نهاية سبعينات القرن الماضي، حيث تربط بين زهرة وماريا علاقة صداقة قوية منذ فترة دراستهما في كلية الطب ببوخارست. لكن، ما إن شعرت زهرة بأن رياح التجديد بدأت تهب على بلدها إيران، حتى تركت الجامعة وعادت مسرعة إلى طهران مفعمة بتطلعات ثورية، في فترة تميزت بانعدام الاستقرار الذي يعرفه نظامان سياسيان على وشك الانهيار. لكن علاقتهما استمرت بتبادل رسائل تصفان فيها حياتهما اليومية.