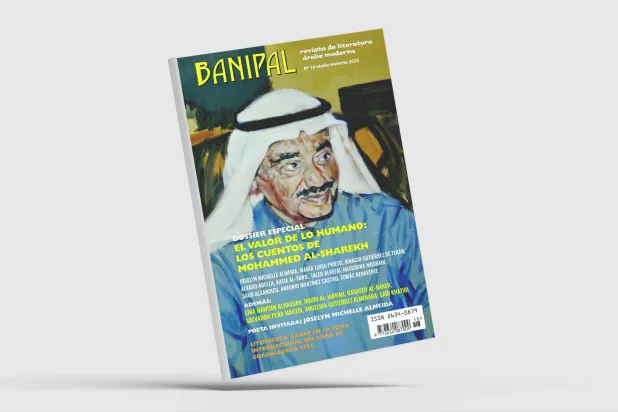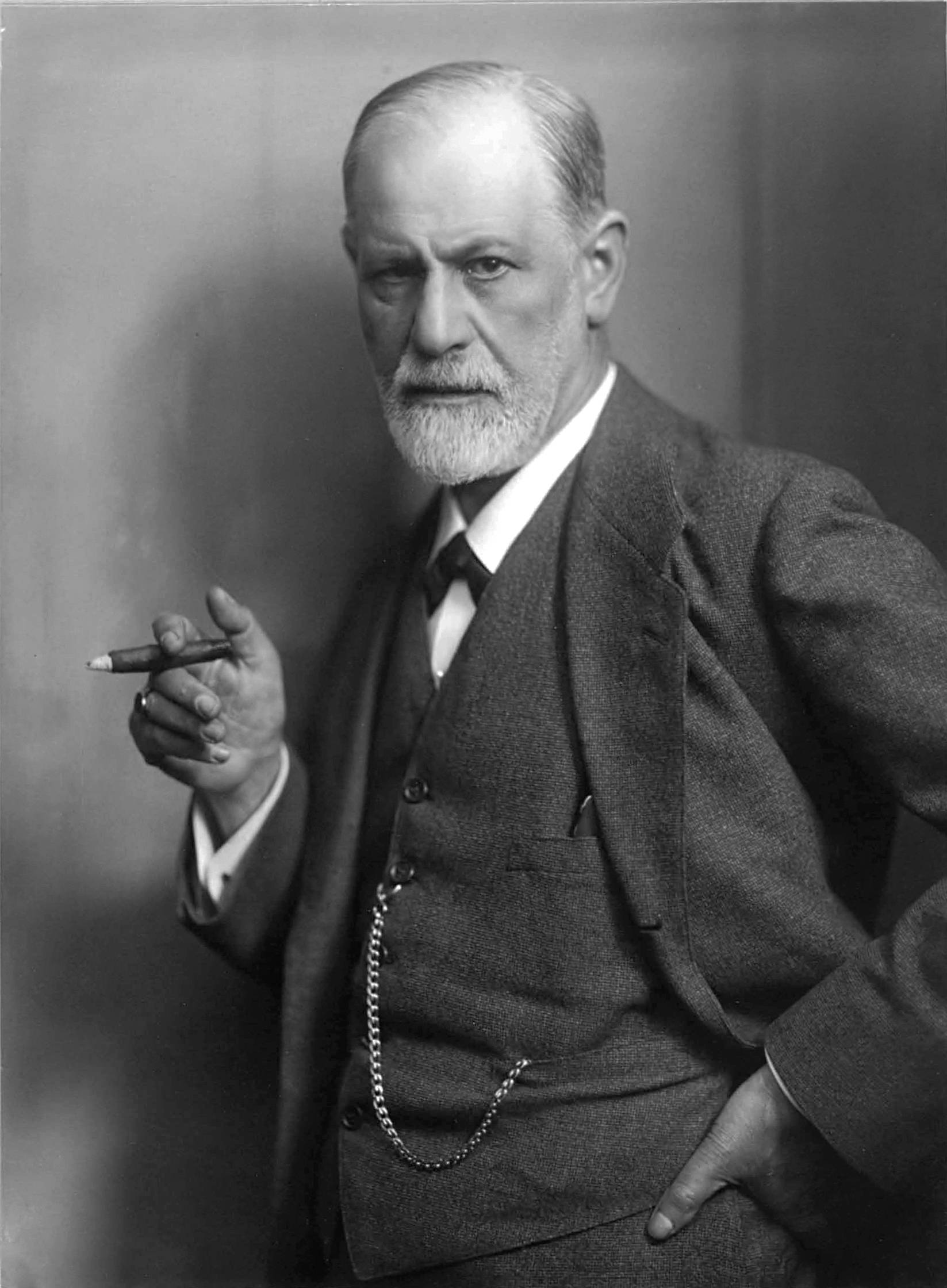بقدر ما يحاول الكاتب حسّان الزين أن يقنعك بأنك تقرأ رواية، وهو يبعث الحياة عفيّة في شخصية طانيوس شاهين، الثائر اللبناني الذي حمل لواء تحرير الفلاحين من ظلم الإقطاع وجور الحُكّام في القرن التاسع عشر، يصرّ على ان يبقيك متيقظاً؛ لأن ما تقرأه هو صفحات من التاريخ، سواء من خلال المقدمة التي كتبها خالد زيادة، أو توثيق بعض الأحداث، وتوضيح الوقائع والمسارات في نهاية الكتاب.
لعبة فنية متقنة، تجعل كتاب «طانيوس شاهين... ماذا فعلت لأستحق هذا؟» الصادر عن دار «رياض الريس» في بيروت، رواية تاريخية بحقٍّ تحترم الجانب التوثيقي، والخط الزمني للأحداث، لكن كاتبها يمنح نفسه حرية التخييل ورسم التفاصيل إلى أقصاها، مستفيداً من المراجع والرسائل التي عكست روح طانيوس شاهين، والملامح العامة لشخصيته الغضوب التوَّاقة إلى التحرر والتمرد. بالتالي فالكتاب يقدّم أكثر من مجرد تغليف أدبي للتاريخ، فهو يذهب إلى استبطان شخصية طانيوس، ومحاولة إعادة تركيب بنيته النفسية، ودوافعه الاجتماعية، ومكامنه المخبوءة، وتلك هي المهمة الصعبة.
من العدالة إلى الطائفية
تمكَّن الكاتب من تقمص شخصية إشكالية، لها رمزية كبرى في التاريخ اللبناني، ثمة من يمجدها، ومن يبقيها في حدود ضيقة، وهناك من يرى فيها عنفاً واستبداداً. لكن أهمية طانيوس أنه يختزل سيكولوجيا الشخصية اللبنانية، إن صح القول. كما أن الظروف التي واجهها والتي عاشها جبل لبنان في تلك الفترة، فيها ما يشبه إلى حدٍّ كبير الواقع الحالي، بأزماته وتعقيداته، وصعوبة فك خيوطه المتشابكة، وارتهان الطوائف كلٍّ لجهة دولية تؤمِّن لها الإحساس بالحماية والاستقواء.
طانيوس شاهين، ماروني من جبل لبنان، وتحديداً كسروان، عمل مكارياً، وبائعاً متنقلاً، وحدّاداً. قاد «ثورة الفلاحين» بين عامي 1859 و1861 غاضباً على الإقطاع والظلم. بدأت حركته اجتماعية خالصة من أجل العدالة والحرية، لكنها وبسبب التدخلات الخارجية والعصبيات المحلية، سرعان ما انقلبت طائفيةً صرفةً. استطاع أن يقيم كياناً سياسياً، وهزم جزءاً من الإقطاع، لكنه، وكما يقول في نهاية الرواية، «ما ترك لنفسه صاحباً»، وتخلى عنه الجميع باستثناء رجاله الذين أحبوه ولم يتمكنوا من نصرته.
اعترافات طانيوس
اختار الكاتب أن يُنهي مؤلفه بنصٍّ معبِّر أشبه باعتراف يناجي فيه طانيوس نفسه، متأملاً في سبب هزيمته النكراء بعد فوز ملأ قلبه بالرضا والغرور. يقول: «رغم أنني لا أشك في أن رفضي للظلم وحميّتي تجاه الأهالي المنداقين المعتّرين، هما ما دفعاني إلى العصيان والتيسنة، فإنه لا يمكنني أن أنكر أن في الأمر طمعاً شخصياً». هذا إضافةً إلى غواية السلطة وصعوبة التخلي عنها؛ «لقد عزّ عليّ أن أصير ضعيفاً، ما بيطلع بإيدي شي، بعدما تمشيخت وكنت أضرب بسيفي وآمر. قلقت على المكانة التي حققتها، وتمسكت بها بأسناني وأظافري».
واحدة من غوايات الرواية هي لغتها، التي اختار حسّان الزين أن يُطعِّمها بسخاء بعامية منطقة كسروان، في محاولةٍ لجعل الكلام أقرب ما يكون إلى ما تحدَّث به طانيوس في زمانه، مع شروحات في الهوامش لغير اللبنانيين الذين يصعب عليهم فهم عامية مُغرقة في محلِّيتها. وجاءت الأمثال الشعبية التي تدور على ألسن الشخصيات، لتُشعرنا بحيوية الحوارات وواقعيتها. وما يمنح الكتاب نبضه هو حرص المؤلّف على تصوير المشاهد كأنه يُعدّ لفيلم سينمائي، حتى يمكنك القول إن الكتاب جاهز ليصبح مصوَّراً. وقد يكون هذا مما دخل في حسابات الكاتب، وهو مُحقٌّ فيما رمى إليه، إذ إن طانيوس بما له من مكانة في السرديات اللبنانية، وما تحمله سيرته من شَبهٍ مع الحاضر، تكاد تتحول إلى مرآة يمكن فيها للمواطن أن يرى صورته ومجتمعه، وعلاقته مع السلطات والزعامات الطائفية، كما الخلافات السياسية الممتزجة بالحقن الطائفي المستمر. شخصية درامية توفرت لها كل الأبعاد اللازمة لتمثل التناقضات في أبرز تجلياتها. طفولة منكوبة بموت الأب قتلاً على يد أحد إقطاعيي المنطقة آنذاك من شيوخ آل الخازن، الذي لم يحتمل أن يلقي عليه فلاح بسيط التحية فاستحقَّ أن يشرب قهوة مسمومة تودي به. مات الأب وبقي طانيوس وإخوته؛ خمسة صبيان وبنت وأمه، يذوقون مرارة اليتم والترمّل.
الحقد محرك الثورة
ستبقى هذه الحادثة محركاً في حياة طانيوس: «لم أكن ناقصاً هذا الحقد. الحقد كان يملأني ونما معي. سكن بدني ولبسته. كان أنا وكنت هو. كان يشتعل في عيني ويوقد غضبي، ينبض في صدري وعروقي وزندي وقبضتي، غيَّرني وكبّرني سنين. ولأعوام طويلة اعتقدت أنه هو ما كبّر بدني وجعلني عتراً (قوياً)».
تريده أمه متعلماً لأنه «أذكى أبناء الضيعة» غير أنه منشغل ومبتهج بتزعّم رفاقه. إذ كيف للفلاحين أن يتجاوزوا طبقتهم دون تعليم، لكنه لا يريد. عمل كوالده مكارياً، وقرر أن يصبح رجلاً، وهكذا كان، لا بل أصبح بطلاً وزعيماً. أحبه الأهالي بقدر ما أبغضه الآخرون الذين أراد أن يكون ندّاً لهم. قرر أن يستغني عن الجميع، لكنه في النهاية انتظر نجدة فرنسا «مين إلنا غير فرنسا؟ مين بقى لنا غيرها؟». لكنها لم تأتِ، مع أن المتداول حينها «أن الملك الفرنساوي سيرسل عماير لنقلنا إلى بلاد بعيدة هي الجزائر». عاش بلا أب، ولم يتمكن من أن ينجب ولداً. بقدر ما نراه قاسياً صنديداً عنيداً، نشعر بعاطفته الفياضة في لحظات الضعف والسكينة. أرادها حركة لتحرير الفقراء من جور الإقطاع، وانتهى حبيس طائفته، مارونياً يلجأ إلى الكنيسة فلا تغيثه، وتصبح ثورته من أسباب اندلاع أسوأ وأشرس حرب طائفية بين الموارنة والدروز شهدها جبل لبنان وامتدت نيرانها إلى سوريا، بل ربما إنها أسَّست لطائفية لا تزال تلتهم أبناءها إلى اليوم.
ما أشبه اليوم بالبارحة
يريد الكاتب أن يُرينا كم يشبه اليوم البارحة رغم مرور 170 سنة. إذ بمقدور كل مواطن لبناني أن يسأل نفسه، كما طانيوس: ماذا فعلت لأستحقَّ هذا؟ فمن استبداد أصحاب النفوذ بمن هم دونهم، إلى النزاعات الطائفية المرتبطة بسلطوية طاغية، وتبدل التحالفات بلمح البصر وتقلّب المصالح وانعكاساتها التي يدفع ثمنها البسطاء، حين يحاولون تغيير قواعد اللعبة... لا تزال المأساة نفسها قائمة. والأهم حضور النفوذ الأجنبي، حيث نرى القوى الكبرى تحرك بأصابعها الأحداث وتُشعل الفتن من فرنسا وبريطانيا إلى روسيا والنمسا، وبالطبع الدولة العثمانية التي بدأت تشيخ وتتسلل الدول الأجنبية بكل قواها؛ خصوصاً حين يُفسح لها المجال.
الحرية وثمنها الباهظ
كتاب يُقرأ بمتعة رغم أن موضوعه مركَّب، ويتحدث عن مرحلة غاية في التعقيد، وتفاصيله الكثيرة تحتاج إلى تركيز. الإحساس بالثقل يتلاشى وأنت تتحسس كم أن طانيوس مهمٌّ استرجاعه كشخصية حرَّكت المياه الراكدة، وَسَعَتْ إلى التغيير، بكل أخطائه وانفعالاته واندفاعاته. تراه يحتجّ على الاستخفاف به وبما يستطيع إنجازه في لحظة خطر يمكنه فيها أن يكون منقذاً ويتزعم جيشاً يوحِّد الموارنة المنقسمين. يقول للبطريرك: «شقفة مأمور بكسروان ما خليتوني أعمل، بدّكن تقبلوا أتزعم جيش الموارنة؟ وليش؟ كرمال ما يزعل الأُمرا والمشايخ والبكوات والأعيان والتجار والسماسرة والمطارين الموارنة. وهودي شو فارقة معن؟ نُصُّن أصحاب الأُمرا والمشايخ الدروز وبيمسحوا جوخ للباشا (العثماني)». أكثر من ذلك، هؤلاء «لا بيقاتلوا ولا بيلموا حجار» وعلى أهبة الاستعداد للهرب بثرواتهم والاختباء، حيث تتسع لهم أماكن كثيرة. وبينما تسيل الدماء ويُذبح الفقراء، ينتظرون المراكب الفرنسية أو العثمانية التي تحملهم حيث يريدون.
قد تكون الحرية هي الفكرة الأكثر إلحاحاً في الكتاب، يسعى إليها طانيوس بكل ما أوتي من عزيمة: «أباهي بأني حرّ، أنفّذ ما في رأسي، وسأبقى حراً حتى آخر يوم في حياتي، وأدفع الآن ثمن ذلك».