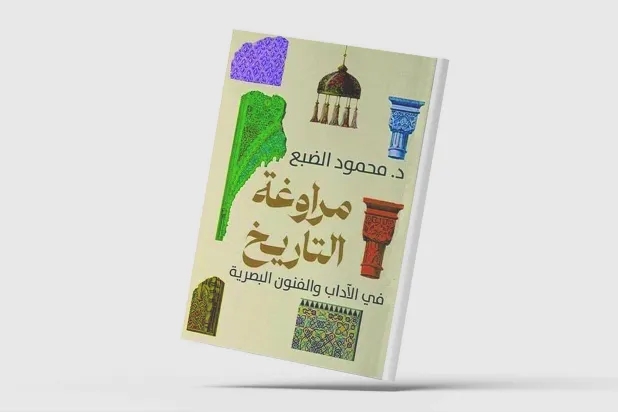شكلت دار «شرقيات» للنشر والتوزيع حالة خاصة واستثنائية في ذاكرة الثقافة المصرية، خاصة في حقبة التسعينات، فقد كانت فضاء حراً للإبداع ومنبراً اعتلاه كثيرون صدرت أعمالهم عنها في الرواية والقصة القصيرة والشعر لتكون بمثابة ميلاد لجيل جديد من الكتاب، فضلاً عن أناقة مطبوعاتها وتميز أغلفتها عبر هوية بصرية جديدة أسهم في تجسيدها الفنان التشكيلي الراحل محيي الدين اللباد.
أسس الدار حسني سليمان بعد عودته من الإقامة الطويلة في استوكهولم، وتحول مقرها بشارع «محمد صدقي» بوسط القاهرة إلى ملاذ آمن لأفكار متمردة وأحلام صاخبة وجدل لا ينتهي حول علاقة الإبداع بالواقع، وبرؤية ثقافية مغايرة لسليمان وإيمانه بأن النشر وسيلة لتعميق الوعي الثقافي لدى القارئ، قدمت الدار العديد من الأصوات الجديدة من شتي أطياف الإبداع في الثمانيات والتسعينات منهم: مي التلمساني، مصطفى زكري، ميرال الطحاوي، منتصر القفاش وعلاء خالد، كما احتفت بإبداعات رموز من الأجيال السابقة: إدوار الخراط، خيري شلبي، محمد عفيفي مطر، محمد البساطي، وجمال الغيطاني.
وقدمت الدار العديد من روائع الأدب العالمي في طبعات جديدة أنيقة عبر ترجمات مختلفة بثت فيها روحاً جديدة مثل «البحث عن الزمن المفقود» لمارسيل بروست، و«الأحمر والأسود» لستاندال، و«مدام بوفاري» لفلوبير، و«صورة شخصية في السبعين» لسارتر، فضلاً عن بعض أعمال بورخيس ووليم بليك وآني إرنو وكونديرا وكافكا وإيتالو كالفينو وسودرجران.
من هنا، كانت موجة الحزن العنيفة التي سادت الوسط الثقافي مؤخراً حين ذاع خبر رحيل مؤسس الدار حسني سليمان بعد 6 أشهر من وفاته دون أن يودعه الأدباء بما يليق بدوره المستنير الرائد. وزاد من مشاعر الحزن والصدمة، تبين أن كنوز الدار من المؤلفات العربية والعالمية بعد إغلاقها عام 2017 قد بيعت إلى تجار الورق والكتب القديمة في نهاية مؤسفة لم يكن يتوقعها أحد، ما أسهم في تكريس حالة العزلة والاكتئاب التي عاشها سليمان في سنواته الأخيرة بقريته بعيداً عن القاهرة.
يقول الكاتب منتصر القفاش أنه منذ الإصدارات الأولى لدار «شرقيات» عام 1991، اتضح أن صاحبها حسني سليمان ينظر إلى عملية نشر الكتب نظرة مختلفة عن المعتاد والسائد وقتها سواء من ناحية اختيار الأعمال التي ينشرها أو من ناحية الغلاف الذي كان يبدعه الفنان محيي الدين اللباد، حتى صارت في فترة قصيرة علامة على الكتاب المعتنى بكل تفاصيله، والذي يتميز من أول وهلة عن بقية الكتب على أرفف مكتبات القاهرة، كما صارت وجهة من يريد التعرف على الكتابة الجديدة في مصر.
ويشير القفاش إلى أنه على مدار صداقته لحسني سليمان تكرر مشهد لقائه بأصدقاء مصريين يعيشون في السويد ويزورون القاهرة لفترة قصيرة، ولا يكفون عن إبداء دهشتهم من قرار حسني بالعودة إلى مصر بعد أكثر من عشرين عاماً عاشها في السويد، ولا يستوعبون قدرته على العودة والتخلي عن كل ما حققه هناك، وخوض مغامرة جديدة غير مأمونة العواقب، ويلمحون إلى أن دار «شرقيات» ستفشل.
ولم يكن حسني يحاول أن يفلسف قراره ولا يخوض في الأسباب، ويكتفي مبتسماً بردود مقتضبة، ويسارع بتغيير الموضوع ليتحدث عن الكتب الجديدة التي نشرها، ويختار لهم عدداً منها ويشجعهم على قراءتها.
يضيف القفاش: «كان حسني سليمان يبدأ عمله في السابعة صباحاً، ويغلق المكان في الثالثة ظهراً ليعود إلى منزله في مدينة بنها التي رفض أن يغادرها ويقيم ولو مؤقتاً في القاهرة. تحولت جلساتنا الصباحية، نحن الأدباء الذين صدرت لهم أعمال عن الدار، إلى ورشة أدبية دون قصد ولا برنامج معد سلفاً، نتبادل فيها الآراء حول الكتابة والكتب التي قرأناها، وأحياناً نناقش أعمالاً قُدمت لـ(شرقيات) لنشرها، وخلال كل ذلك لا تشعر بأن حسني يتبوأ مقعد الناشر خلف مكتبه الذي لم يتغير موضعه أبداً، بل تراه كأنه واحد من هؤلاء الكتاب دون أن يكتب حرفاً، ولا تحس بأنه أكبر منهم سناً».
وتشير الروائية مي التلمساني إلى أنه عندما اعتزل حسني سليمان الوسط الثقافي بشكل فجائي وأغلق باب «شرقيات» دون رجعة عام 2017، كان المقربون منه يدركون أنه لا يتراجع عن قرار اتخذه، ولا يقبل أنصاف الحلول، لذا فقد احترمت مي رغبته في الانسحاب التام، وإن كانت تتساءل مع الآخرين ماذا لو أنهم استطاعوا خرق هذه العزلة والبحث عنه فمن أين يبدأون؟ كانوا يسمعون من آن لآخر أخباراً غير مؤكدة عن احتمال عودته للإقامة بالقاهرة بعد أن غادرها وفضّل عليها بيته الريفي في مدينة بنها، كما سمعوا أيضاً أن كتبه تفرقت بين المكتبات وفي أسواق الكتب القديمة، ولكن المؤكد أن أرقام هواتفه تغيرت وأصبح العثور عليه صعباً للغاية، حتى فُجع الجميع بخبر وفاته.
تقول التلمساني: «كان حسني سليمان أميناً على الكتاب، فهو الناشر الوحيد الذي يقرأ أعمال كُتابه ويناقشهم فيها بوصفه محباً ومتذوقاً للأدب، يجاهد كي لا يقع فريسة لضغوط السوق وحسابات الربح، ناشر من مصر مر بتجربة هجرة عريضة إلى السويد دفعته للعودة والمغامرة، وجعلت لحلمه مذاقاً خاصاً. التقيته في بدايات التجربة، وكانت (شرقيات) الدار الأشهر في قائمة الدور الخاصة المحدودة جداً والتي اهتمت بتكوين ذائقة أدبية ودعم الكتابات الجديدة».
وتضيف: «نعم، كان حسني سليمان حالماً، وكانت الدار استثناءً. أفاق حسني من حلمه على حقائق التوزيع المرعبة، ولطالما تمت سرقته، ولطالما أغرقته الحسابات في بحر من اليأس ثم عاد ليرفع رأسه خارج الماء، يتنفس هواءً جديداً مع كل اكتشاف مثير، يبحث في كوم القش عن العملة الثمينة، يبحث بتفان حقيقي فيما يمر العشرات ببابه ويتمنون الوصول. يدفعه الحماس للمجازفة أحياناً، ويعرب للأصدقاء عن مخاوف الفشل كاشفاً لنا عن جانب لا يستهان به من تحديات السوق».
ومن جانبه، يقول الناشر شريف بكر، مدير «دار العربي»، إن دار «شرقيات» كان لها السبق والريادة من حيث الذهاب إلى مناطق لم يجرؤ عليها الناشرون قبلها، مثل الانفتاح على تجارب الجيل الجديد وتبني الموهوبين من بين أصواته المختلفة والتعامل معهم بجدية واحترافية غير معهودة، فضلاً عن الحماس لطباعة ترجمات تبدو للآخرين مغامرة غير مأمونة العواقب مثل إصدار الترجمات الكاملة لرواية «البحث عن الزمن المفقود» لمارسيل بروست.
ويرى بكر أن جوانب التسويق والتوزيع كانت بمثابة نقطة الضعف في منظومة حسني سليمان، حيث لم ينجح في تغطية النفقات الباهظة التي تحاصر دور النشر عادة، وتتطلب وجود موارد من خلال الدعاية والتوزيع والإيرادات، لكن تظل تجربة «شرقيات» في النهاية مثالاً ملهماً للقدرة على السير عكس التيار، والتسلح برؤية ورسالة في مجال حساس ومتقلب مثل صناعة الكتاب.
ويشير الشاعر علاء خالد إلى أن غالبية الكتَّاب الذين ظهروا في التسعينات كانوا يرفضون الاقتراب من مؤسسات الدولة أو أي مكان له طابع مؤسسي سلطوي مثل دور النشر الخاصة والمكرسة حينئذ، فقد كانت سوق النشر مفككة، وبسبب هذا ظهرت مساحات عشوائية لأنواع مختلفة من النشر المجاني، سواء كان فردياً، أو من خلال مجموعات، ولكنها جميعها كانت بعيدة عن حس السوق الجديد الآخذ في التبلور والتطور، تقنياً، بشروطه وذائقته في تلك المرحلة.
ويضيف: «كان النشر الخاص قبل دار (شرقيات) يقوم على فكرة فردية، على شخص متحمس يقوم مقام دار، ولكن مع تلك الدار الوليدة، ورغم أنها تقوم أيضاً على فرد، فإنها صنعت بالمجموعة التي تحوط مؤسسها من الأدباء والجيل الجديد، والمكان الذي اختاره في إحدى عمارات وسط البلد؛ فكرة مؤسسية بالمعنى الإيجابي. كونت (شرقيات) دون أن تدري جماعة أدبية ولكن بمفهوم متسع، نظراً لهذا التداخل المستمر بين الأشخاص والنصوص والأفكار المتداولة، والمزاجية الأدبية غير المسيسة لكتابها وأيضاً لصاحبها».