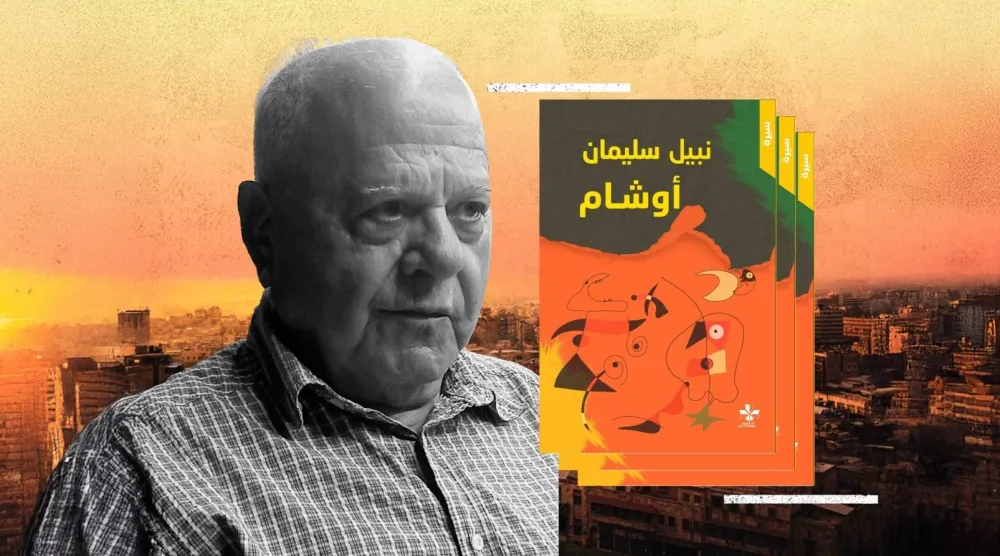لا تبرح الرواية الأحدث للكاتب التونسي محمد عيسى المؤدب «الجندي المجهول» ولعه بالغوص في مناطق مجهولة من التاريخ بحثاً عن معان تتعلق الوطن والتسامح الإنساني.
وعبر رواياته الخمس السابقة «في المعتقل»، «جهاد ناعم»، «حمّام الذهب»، «حذاء إسباني»، «بلاص دِيسكا»، ينشغل المؤدب بقضية الهوية بعدّها مسألة وجودية تخص حاضر ومستقبل الأوطان، و«ليست ترفاً آيديولوجيا يمارسه بعض المثقفين في أوقات فراغهم؟
هنا حوار معه:
> رغم تنوّع حكايات الشخصيات في روايتك الأخيرة «الجندي المجهول» لكنها تلتقي في سمة واحدة عنوانها العريض الألم والفقد والوحدة في مواجهة مناخات قاسية إنسانيّاً... ألم تتخوّف من زيادة جرعة الحسّ المأساوي في النص؟
- في الحقيقة أتجنّب في رواياتي ما أعدّه «نكداً»، واستدعائي ذوات مُختلفة أو مُتنوّعة نفسياً وثقافيّاً يندرجُ في إطار تنوّع طرق مقاومة الألم بأشكاله المُختلفة. وما تُعالجه الرّواية هو التّناسق أو ما اُسمّيه التّعايش بين مقاومة ذوات شعبيّة مهمّشة ومقاومة بلد، هو تونس. هذا البلد ظلّ يتصدّى للحركات الاستعماريّة منذ القرن السّادس عشر ميلاديّاً: الإسبان، العثمانيّين، الفرنسيّين، والمتطرّفين، فكيف لا تنتصرُ هذه الذّوات في نهاية الأمر؟
من سيقرأ الرّواية فسيعرفُ أنّ حضور الحسّ المأساوي موظّف في سياق البناء العام، أو ما تتطلّبه الحبكة الفنيّة، فالحريّة ليست معطى جاهزاً، وإنّما هي تُفتكّ من فم العبوديّة، وكذلك السّعادة، لا يُمكن أن نتلذّذ بالسّعادة إلّا بعد رحلة مُقاومة للألم.
> تحوّل قبر الجندي المجهول في العمل إلى بطل يُطلّ من شرفة التّاريخ عبر تجارب وأجيال ومشاعر... ما المعنى الذي أردت توصيله من خلال ذلك القبر الذي حار البعض في تأويل رمزيته؟
- تطرحُ الرّواية سؤالاً مركزيّاً: من الجنديّ المجهول الذي تتحدّث عنه الرّواية، الذي يقبعُ قبره في قلب أحد أنهج المدينة العتيقة، ويتبارك به التجّار والسكّان، كما رفضوا إزالته رغم جهلهم بمن يكون؟ شخصيّاً حيّرني هذا القبر عندما كنتُ أمرُّ بسوق «السكّاجين» بتونس العاصمة، لم أعثر على مُدوّنة تاريخيّة تُعرّف به، وتُزيل الغموض حوله. كلّ ما صادفني مجرّد حكايات شفويّة مُتنوّعة لا تُقدّم معلومة أو شخصاً محدّداً، هي أقرب للخرافة وللأسطورة، وفي الرّواية تحوّل إلى بطلٍ فعلاً يُحرّك الأحداث عبر تجارب أجيال على امتداد مئات السّنين.
شخصيّاً أعجبني ما قاله الإعلامي والرّوائي التونسي ماهر عبد الرّحمن عن الجندي المجهول بعد أن قرأ الرّواية: «إنّه الجنديّ الرّمز رغم اختلاف الرّوايات حوله. فمع مسارد السّرد، نكتشف كلّ مرّة شخصيّة جديدة. وفي الأخير، نفهم أنّ ذاك الجندي المجهول، وبغضّ النّظر عمّن يكون حقيقة، ليس سوى ذاك المواطن التّونسيّ الذي يظلّ مجهولاً، لكنّه هو الذي كان ينتقم دائماً للشّرف التّونسي، والتّراب التّونسي من المستعمرين».

> تتّخذ بعض الشخصيّات من الحكي والتّدوين وسيلة لمواجهة الحزن... إلى أي حدّ ترى في الأمر استراتيجيّة ناجعة، وهل تفعل الأمر نفسه في حياتك مؤلّفاً؟
- في ذاكرتي صورة أمّي رحمها الله تُدير الرّحى التّقليديّة لطحن الحبوب وهي تُردّدُ بعض المواويل والأهازيج الشّعبيّة، كنتُ أُتابعها بشغفٍ وأحفظ الكثير ممّا كانت تُردّده، ثمّ عرفتُ أنّها كانت تتخفّفُ من تعبها وأحزانها بذاك الغناء الشّعبي الذي وظّفتُه في العديد من قصصي القصيرة. أنا نفسي وجدتُ مع الكتب، ثمّ مع الكتابة شرفةً، أو شرفاتٍ، لمواجهة الأحزان وتعكّرات الحياة.
لا أدري ماذا كنت سأفعل خارج عالم الكتب، أو خارج عوالم الخيال، أو الحيوات البديلة التي تُسعفنا بالكثير من الحلول. تُقدّم لنا الكثير من الشّخصيّات أيضاً جرعات سعادة حقيقيّة، وفعلاً أعيش هذا مع شخصيّاتٍ من داخل رواياتي، مع نساء، أو مع أبطال خاضوا تجارب ومغامرات، مثل شخصيّة الضّابط الإسباني مانويل قريقوري في روايتي «حذاء إسباني»، فقد هرب من ديكتاتوريّة فرانكو ومن أهوال الحرب الأهليّة الإسبانيّة عام 1939، واستطاع هذا البحّار أن ينتصر على الخوف والموت بالفنّ والكتب وقصائد غارسيا لوركا وكذلك بالحبّ.
> يبدو التاريخ التونسي حاضراً بقوّة في أعمالك ويلقي بظلاله، بشكلٍ أو بآخر، على الحاضر...
- فى رواياتي الستّ اشتغلتُ على مواضيع شائكة وخطيرة، تاريخيّاً وجغرافيّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً. كتبتُ عن آفات عميقة مُتغوّلة تمزّق نسيج الهويّة التونسيّة لتُكرّس الجهل والتخلّف والعنف والكراهية. هناك كراهية غريبة لمفاهيم الدّولة والمواطنة والحريّة والمرأة وجنوح إلى تعميم التطرّف والعنف. نحن أمام خطر حقيقي، خطر تدمير الهُويّة والمصير، لذلك فإنّ التاريخ حاضر بقوة في أعمالي.
> إلى أيّ حدّ تأثّرت أدبيّاً بنشأتك في بلدة «صاحب الجبل» القريبة من «الهوارية» التي حظيت بأهميّة لافتة في عهد الإمبراطوريّة الرومانيّة، كما أنّها لا تبعد كثيراً عن جزيرة صقليّة الإيطاليّة وتتمتّع بخصوصيّة نادرة من حيث الطبيعة؟
- بالفعل تتمتع المنطقة بخصوصيّة نادرة، فبالإضافة إلى المغاور البونيقيّة وصخورها التي نُقلت عبر البحر لتشييد مدينة قرطاج، هناك البحر والجبل والغابة، هذا الثّلاثي يشكّل ملحمة طبيعيّة نادرة في شمال الوطن القبلي التّونسي. وكنت قد وثّقت الكثير من مواطن السّحر والجمال والأسرار تلك في روايتي «جهاد ناعم» التي صدرت عام 2017... والواقع أنّني تأثّرتُ أدبيّاً أكثر بمدينة «قليبية» القريبة من الهوارية، فهي مدينة ساحرة وعظيمة بتاريخها وثقافتها وطيبة أهلها المتنوّعين، ولعلّي خلّدتُ كلّ ذلك في رواية «حذاء إسباني» التي صدرت عام 2021.
> جاءت بدايتك الواعدة في التّسعينات عبر مجموعتين قصصيّتين هما «عرس النّار» و«أية امرأة أكون؟»، لكنّك توقّفت فجأة عن النّشر لمدة 14سنة... ما السبب؟
- أنا مدين للرّوسيّيْن مكسيم غوركي وأنطوان تشيخوف، فقد قادتني الصّدفة إلى أعمالهما العظيمة بمكتبة كتب قديمة بـ«نهج زرقون» بتونس العاصمة، وانطلاقاً من ذلك شغفتُ بالقصّة القصيرة، وزاد هذا الشّغف أيّام دراستي عند أستاذي الجليل توفيق بكّار بكليّة الآداب، فقد كان يدرّسنا قصص علي الدّوعاجي الذي أعدّه أبا القصّة القصيرة في تونس. وبالفعلِ نشرتُ مجموعتين قصصيّتين، وكانت رغبتي في أن أُواصل الكتابة في هذا الفنّ، لكنّ مُحاولة «تدجين» مجموعتي القصصيّة الثّالثة وعنوانها «هِيلينا» نفّرني من الكتابة والنّشر، وكان من المفروض أن تُنشر عام 2000، لكنّها لم تُنشر. فكيف أكتبُ وأنشرُ في ظروف نفسيّة وسياسيّة خانقة؟
> هل دفعك كل هذا إلى اللّجوء للرّواية فيما بعد؟
- في الواقع لم تكن القصّة القصيرة في تجربتي مجرّد محطّة عبور، الأمر مُرتبطٌ أساساً بتغيّر القناعاتِ وتطوّرها في ظلّ مُتغيّرات العالم، ومُرتبطٌ بمشروع الكتابةِ أيضاً، أعتقدُ أنّ القضايا المُتفجّرة بعد ثورة 14 يناير(كانون الثاني) 2011 في تونس، وبعد ذلك في الكثير من البلدان العربيّة، لا يُمكن أن تستوعبها القصّة القصيرة، لذلك كانت الرّواية ملاذي.
> بعد توالي أعمالك الروائيّة تباعاً وسط احتفاء نقديّ وإعلاميّ... برأيك، ما الهاجس الذي كان المحرّك الأوّل لديك في إنتاج كلّ تلك الأعمال؟
- لعلّ الهاجس الأكبر هو المشروع في حدّ ذاته، وأعني مشروع الكتابة الرّوائيّة الذي طرحتُ من خلاله سؤال الهوية التّالي: من أنا ومن نحن بعد الثّورات العربيّة؟ لقد سعى «المشروع الإخواني» في تونس ومصر وغيرهما من البلدان العربيّة إلى طمس معالم الهويّة وتكريس ثقافة بديلة تقوم على العنف والتطرّف ومحو الشّخصيّة. صدمني الواقع التّونسي والعربي بعد تلك الثّورات وكان لا بدّ من تفجير الأسئلة الحارقة في الكتابة الرّوائيّة.

> تمارس أيضاً النّقد الأدبي إلى جوار الكتابة الرّوائية... ألا تخشى من أن تؤثّر تلك الممارسة سلباً على إبداعك الأدبي؟
- انشغلتُ بالنّقد الأدبي طوال سنوات، وكانت قناعتي ألّا أُطيل في تعايشي معه، لذلك اكتفيتُ بإصدار كتابٍ واحدٍ عنوانه «نصوص منسيّة في الأدب التّونسي الحديث». وبالفعل، علينا أن نختار، بين مُطاردة تطوّر الأطروحات النّقديّة، والكتابة الرّوائيّة، واخترتُ الكتابة بتعميق أسئلتها داخل مشروع روائي يقوم أساساً على فكرة الهوية.
> كيف ترى تجلّيات فن الرّواية على السّاحة التّونسية حاليّاً، بما له وما عليه، وهل نال برأيك الأدب التّونسي المعاصر ما يستحقّه من تقدير واحتفاء... أو أنّه «ضحيّة» ابتعاده الجغرافي عمّا يُسمّى «مراكز الثّقافة المشرقيّة التّقليدية» مثل القاهرة وبيروت؟
- الرّواية التّونسيّة شهدتْ انفجاراً كبيراً بعد ثورة 14 يناير 2011، لم تُسقط الثّورة نظاماً سياسيّاً فقط وإنّما أسقطتْ كذلك «تابوهات» كثيرة ظلّت جدراناً سميكة أمّام الإبداع والفنّ بشكل عام. في الحقيقة، لا أُومن بمفهومِ «الضحيّة» في الأدب، الأدب الجيّد والمُكتمل والرّاقي يصل إلى الجميع. طُرحتْ هذه المسألة في القديم، مع بداية القرن العشرين، لكنّنا اليوم إزاء ثورة اتصالات تُلغي كلّ الحدود والمسافات، والرّواية التّونسيّة خرجت من ضيقها، وصارت تُنشر بدور نشر معروفة، بالقاهرة وبيروت.