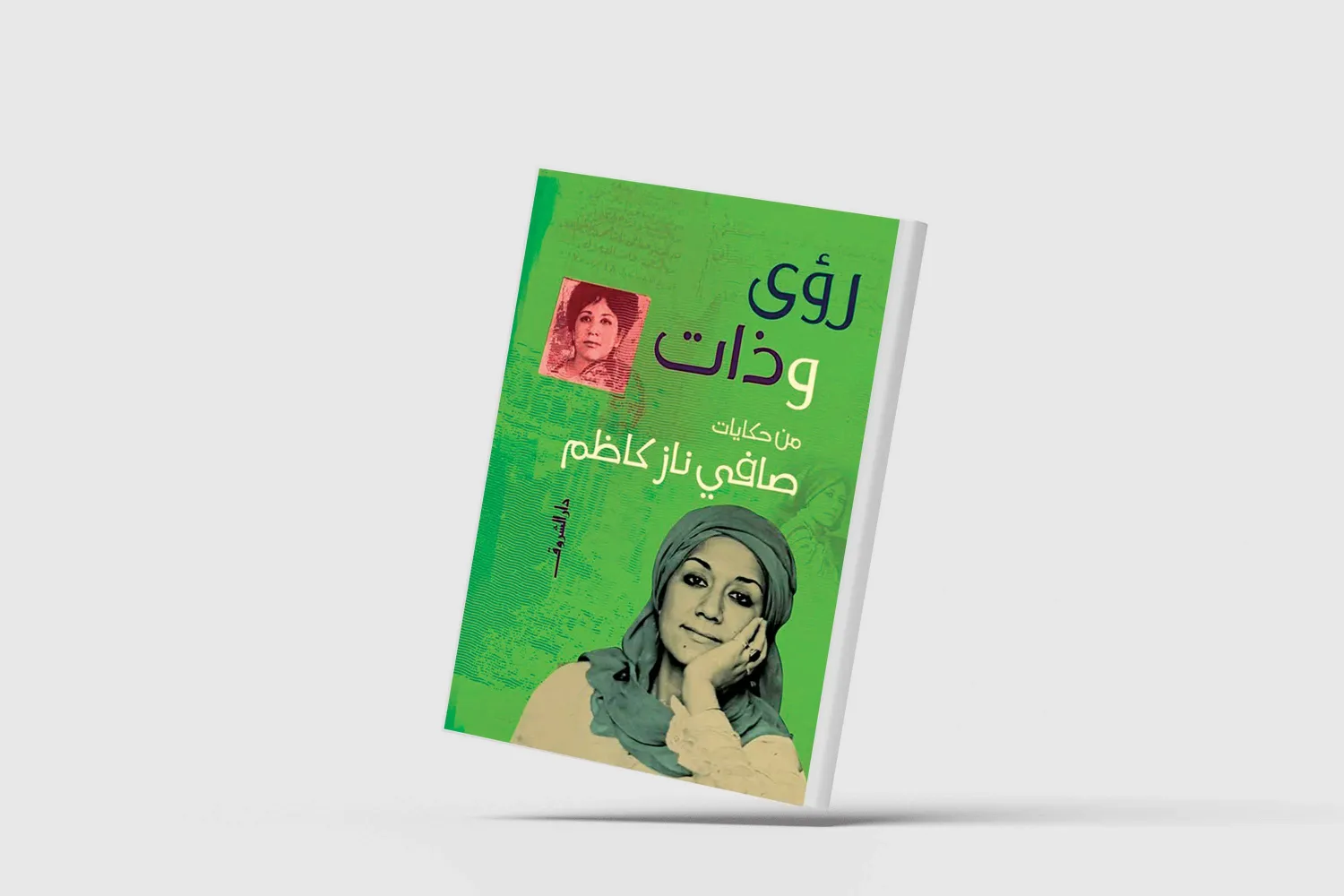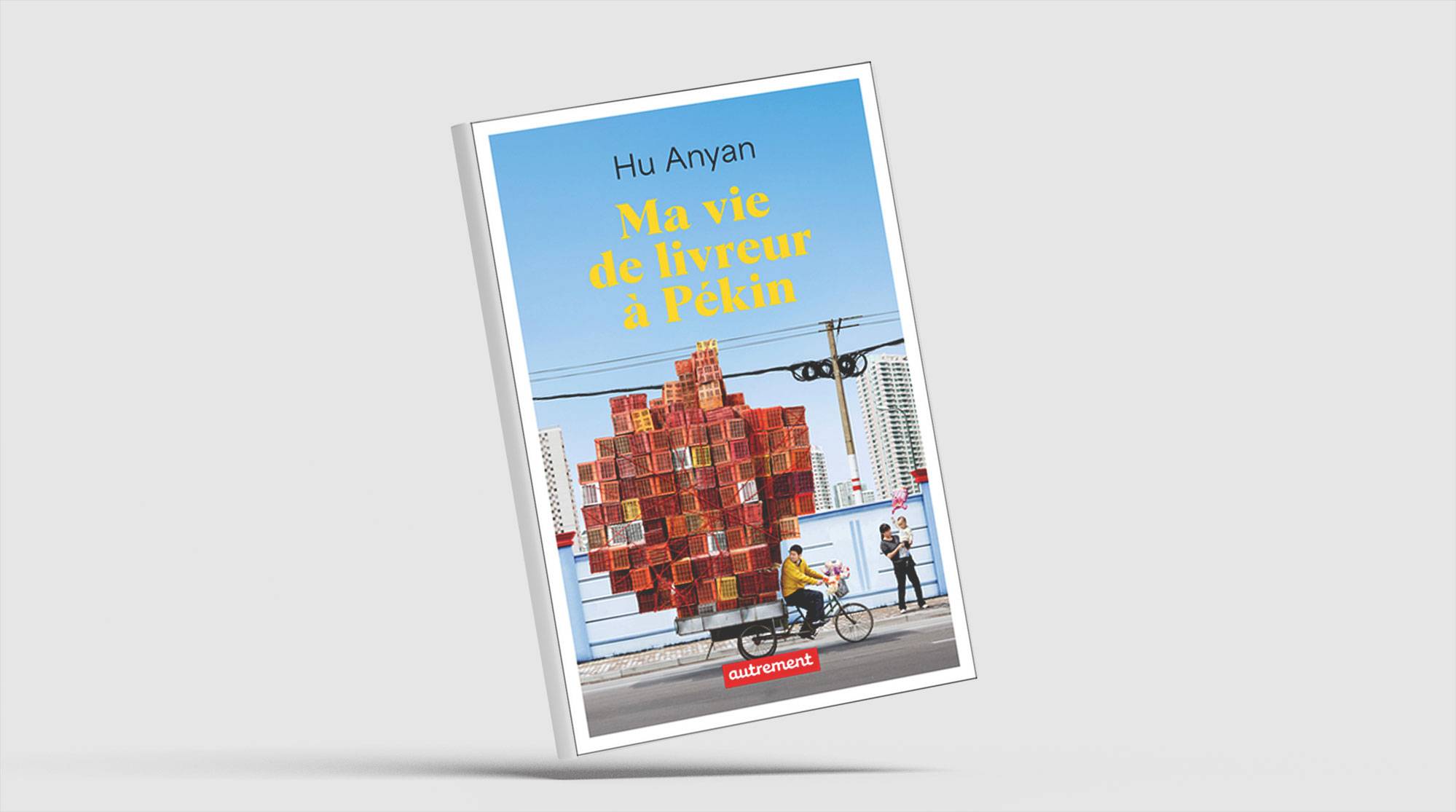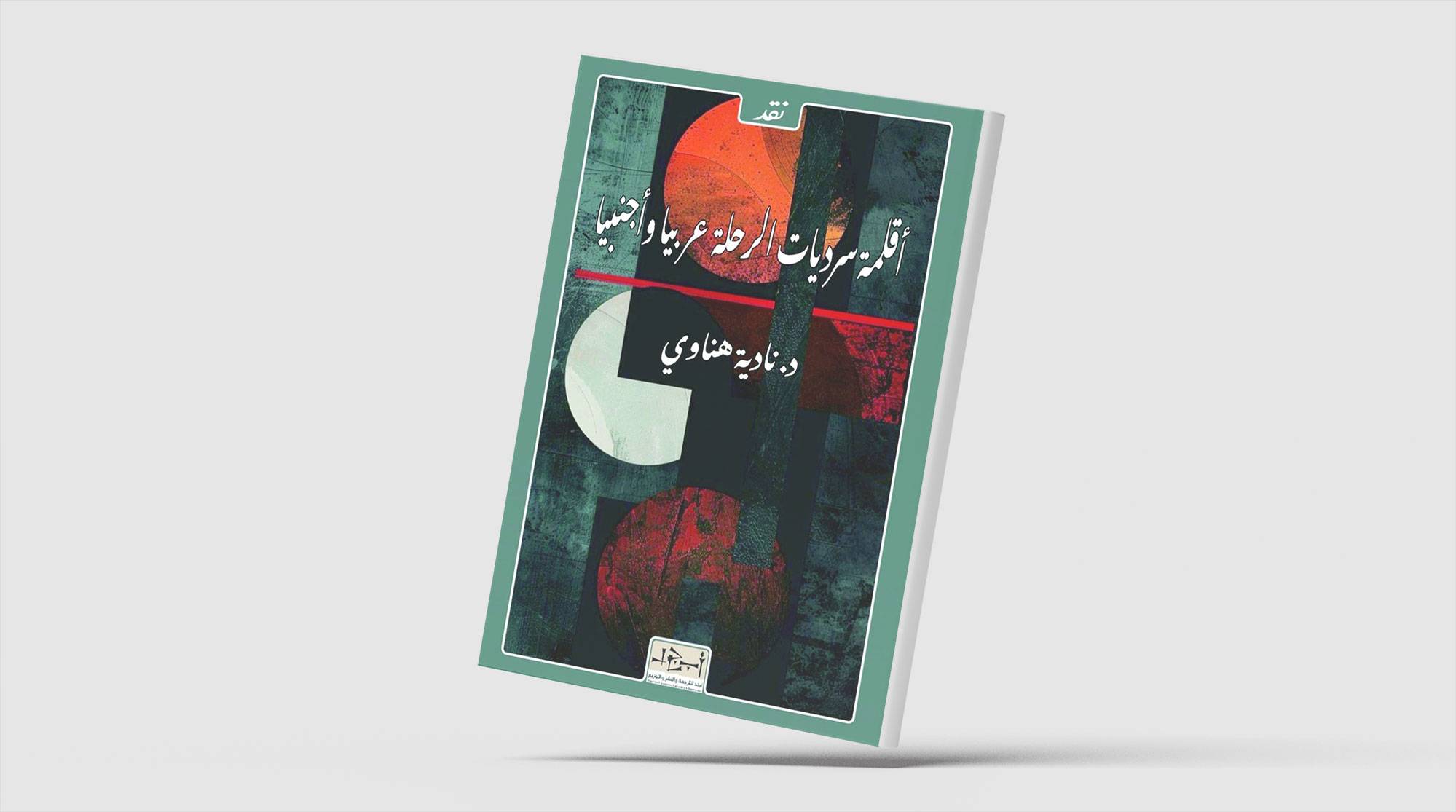تتميز نصوص الكاتبة المصرية صافي ناز كاظم بمذاق خاص من الحيوية والصدق والحرارة ينبع من مزجها الدائم بين السيرة الذاتية والرؤى النقدية في سبيكة واحدة قادرة على وضع مؤلفاتها في مساحة خاصة.
وتعد الطبعة الجديدة من كتابها «رؤى وذات» الصادر عن «دار الشروق» بالقاهرة تجسيداً لهذه الفكرة، إذ يحتوى على 40 فصلاً تقدم خلاصة رؤاها في الصحافة والفن والكتابة والنقد والثقافة عبر نصف قرن، مع حكايات من تجاربها على المستوى الإنساني كصحفية وناقدة وكاتبة.
تتعدد وجوه صافي ناز في الكتاب، فهي تارةً محرِّرة صحفية معروفة بمقالاتها المشاغبة التي تأخذ القارئ في جولة داخل أروقة ومكاتب المؤسسات الصحفية والقائمين عليها، بما لهم وما عليهم، راويةً تجاربها الكاشفة مع الرؤساء والزملاء. وتارةً أخرى هي ناقدة أدبية تُبحر في عالم كبار الأدباء والكتاب والمفكرين والفنانين ممن شكَّلوا الثقافة المصرية والعربية المعاصرة. وتارةً ثالثة هي الكاتبة المصرية الصاخبة، خفيفة الظل، التي تصطحب قارئها في جولة عبر أحياء مدينة القاهرة الحية.
تروى كاظم طرفاً من علاقتها بنظيرتها الكاتبة لطيفة الزيات، صاحبة الروايات الرائدة في تاريخ الأدب المصري، مشيرةً إلى أنها التقتها في قسم الصحافة بكلية آداب القاهرة، حيث كانت الأخيرة قد حصلت على درجة الدكتوراه في الترجمة وتزوجت من الناقد والأكاديمي الدكتور رشاد رشدي، وكانت تسكن بالقرب من الجامعة أمام حديقة الحيوان بالجيزة. وتشير إلى أنها كانت كلما رأتها تسير في شارع الجامعة متوجهةً إلى بيتها تركض لتلحق بها حيث كان يجمعهما نفس طريق العودة إلى المنزل، لكنها كانت مع لطفها متحفظة حريصة على مسافة بينهما لا تُغري «صافي» بصداقة.
كانت رواية الزيات الشهيرة «الباب المفتوح» قد صدرت عام تخرج صافي 1959 فقرأتها وكانت قد ترسخت في عملها بدار «أخبار اليوم» بمجلة «الجيل». أعجبتها الرواية فاتصلت بصاحبتها هاتفياً وقالت لها: «أريد أن أرسل لكِ باقة ورد»، وذهبت لإجراء مقابلة معها.
وتتذكر من هذه المقابلة تهليل وسعادة الدكتور رشدي لنجاح زوجته، حيث بدا يومها فخوراً بها جداً وكانت شقتهما ساطعة النور، مرتَّبة ترتيباً ملائماً لزوجين مثقفين كاتبين تسود بينهما روح النِّدِّية الواضحة التي ترى الاتفاق والاختلاف حقاً مكفولاً للطرفين. كانت ترتسم على وجه لطيفة الزيات، كما تذكر الكاتبة، ثقة المتأكد من مكانته العزيزة لدى الآخر، مكانة عزيزة على المستوى العاطفي والإنساني والعقلي، لذلك دُهشت صافي عندما أخبرها الناقد د. عبد العزيز حمودة وهو يزورها في شقتها بنيويورك عام 1965 بوقوع الطلاق بين الثنائي المثقف السعيد.
كان حمودة لا يزال يُعدّ الدكتوراه في جامعة قريبة، ويأتي إلى مدينة نيويورك زائراً ليتابع العروض المسرحية من حين لآخر، ونقل خبر الطلاق كأنه صاعقة ألمَّت بأستاذه قائلاً لصافي: «خطاب د. رشدي الذي أرسله إليَّ يقطر ألماً وهو يقول: تصوَّر لطيفة تركتني!».
عندما عادت صافي من أمريكا عام 1966 كان معها جزء من رواية تكتبها عنوانها «طريق إلى منزلي» وطلبت من د. لطيفة أن تُبدي رأيها فيما كتبته. قابلتها في مقهى «الشرفة العلوية» بفندق «النيل» بجاردن سيتي وكانت تجلس مع شقيقتها وزوج شقيقتها وأطفالهما منى وعلي. كان صباحاً شتوياً ليوم جمعة وكان وجهها مشرقاً متمتعاً بالشمس ومزاجها رائقاً ودوداً. رحَّبت بصافي ترحيباً مخالفاً لتحفظها السابق معها وقالت: «تبقي مجرمة لو لم تكملي هذا العمل النابض الجميل»، ولكنها لم تكمل الرواية أبداً، وما زالت تحتفظ بها، وكلما راجعتها تَثقُل على صدرها فتطويها وتعيدها إلى الرف.
وتروي صافى ناز كاظم كيف تعرضت في مطلع يناير (كانون الثاني) 1967 لتجربة زواج تبطنت وتلفعت بـ«خديعة» تصل إلى مرتبة «الجريمة المدبرة»، ولم تكن وهي في خضمِّها مدركةً حقيقتها التي رأتها بعد ذلك بوضوح. كانت في البداية حريصة على سرِّية المشكلة، ولكنها أرادت مشاركةً أمينةً لمشكلتها، فلم تجد أمامها سوى الاتصال لتحديد موعد مع د. لطيفة الزيات، وذهبت إليها في مسكنها الذي اتخذته بين أشقائها ووالدتها في حي «المهندسين».
كان الوقت مساءً والطريق جديداً وغامضاً في تلك الناحية. صعدت إليها في غرفة استقبال خارجية وقالت لها: «أنا مثلك برج أسد وستفهمين أن صراحتنا وصدقنا هما السبب في سهولة خداعنا، إذ نتصور أن كل ما نسمعه هو كذلك صراحة وصدق، وأزمتي الآن هي...».
حكت لها كل شيء، فلم تندهش الزيات، وإن تعاطفت وقالت ما معناه باختصار إن الطلاق قد يكون من الأشياء المُرَّة والمؤلمة ولكنه في أحيان كثيرة يكون «الخلاص من الدمار الأكثر خطورة من المرارة والألم». قالت لها: «هل تعرفين يا دكتورة أن عبد العزيز حمودة قال في أمريكا كذا وكذا. ابتسمت في تهكم وأشاحت بيدها ثم قالت: ولو أن أزمتي كانت نقيض أزمتك!».
وتتذكر المؤلفة بدايات ثورة 1952، مشيرةً إلى أنها كانت هي وجيلها على مشارف الخامسة عشرة من أعمارهم، صبايا وصبياناً غذَّتهم الدراسة الوطنية في المدارس العربية المرعيّة جيداً بوزارة المعارف العمومية على «الجلاء بالدماء» و«فلسطين لبِّيك نحن الفدا» ومحفوظات خطب مصطفى كامل وسعد زغلول وتضحيات الزعيم محمد فريد... ينظرون غير آسفين إلى رحيل «ملك فاسد»، حسبما قيل، لم يتجاوز الثانية والثلاثين من عمره، وفرحين بظهور «فتية آمنوا بربهم» أكبرهم في الرابعة والثلاثين أمسكوا بزمام البلد.
وتذكر أن طه حسين والعقاد وأبو حديد كانت أعمارهم آنذاك تناهز الستين أو أكبر قليلاَ، باستثناء أحمد لطفي السيد الذي كان قد بلغ الثمانين وأعطوه لقب «أستاذ الجيل». وهناك أيضاً فتحي رضوان وأحمد حسين ونجيب محفوظ الذين كانوا في الحادية والأربعين، وعلي ومصطفى أمين في الثامنة والثلاثين، ومحمد حسنين هيكل ومحمد عودة قد بلغا الثلاثين، ومعهما حشد من الشباب في العشرينات، ومنهم أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وفتحي غانم ولطفي الخولي وصلاح جاهين وصلاح عبد الصبور ووديع فلسطين.
تروي صافي ناز أنه في تلك الفترة كان فتحي غانم يرأس الصفحة الأدبية بمجلة «آخر ساعة» تحت عنوان «أدب وقلة أدب» وكانت ثمة مناوشات بينه وبين د. رشاد رشدي لا تستوعبها، لكنها اهتمت بقراءة ما كان يكتبه غانم، وبدا في بعض حلقاته كأنه في «مناجاة فكرية» يتبادل آراء في الأدب مع سيدة تسكن بعيداً على أنها شخصية حقيقية لم يُفصح عن اسمها ليلفَّها بالغموض. تقول له ويقول لها. كانت السيدة في تلك المحاورات ناقدة عتيدة شديدة البأس، لا تكفُّ عن الاستهزاء والتوبيخ، وبدا فتحي غانم أمامها كأنه مغتبط بالتعنيف، مستكين للتوجيهات، ينظر إليها مبتهلاً أن تُرشده سبيل الصواب. ولم يكن هذا ينسجم مع «الاستعلاء» الذي كان يُبديه في ممرات ومكاتب مجلة «آخر ساعة».
صافي ناز كاظم من مواليد الإسكندرية في 17 أغسطس (آب) 1927، حصلت على ليسانس الآداب، قسم الصحافة، من جامعة القاهرة 1959، وعلى ماجستير في النقد المسرحي من جامعة نيويورك 1966. اشتهرت في بداية حياتها العملية بأنها أجرأ مَن قامت بمغامرات صحفية خلال مسيرتها الزاخرة الممتدة لأكثر من خمسة عقود. عملت في كبرى الصحف والمؤسسات الصحفية مثل «أخبار اليوم» و«دار الهلال» وغيرهما. وحالياً تمارس الكتابة الحرة. لها كثير من المؤلفات في الأدب والنقد المسرحي مثل «من ملف مسرح الستينيات» و«تلابيب الكتابة» و«صنعة لطافة» و«تاكسي الكلام».