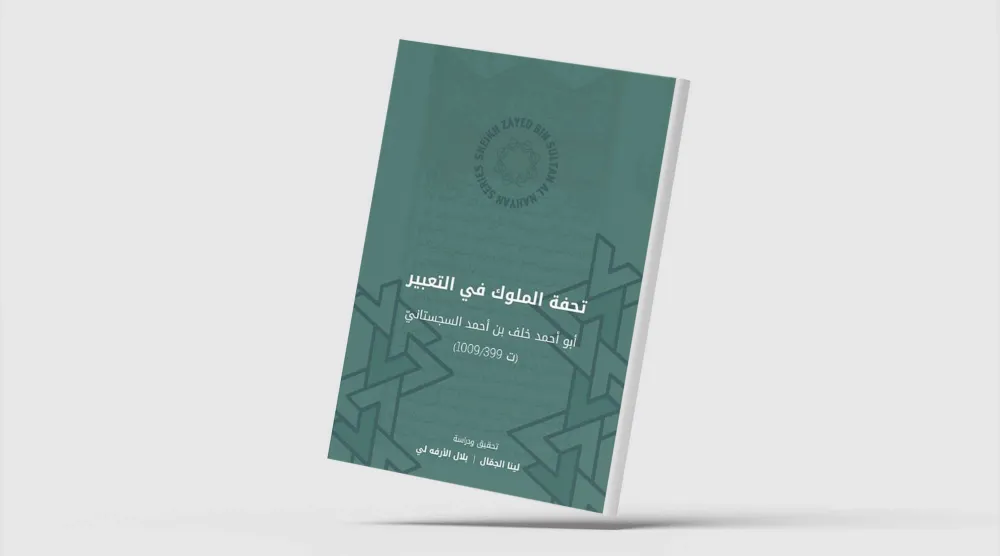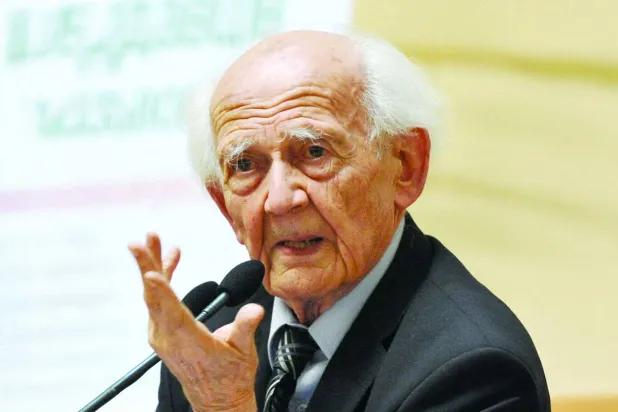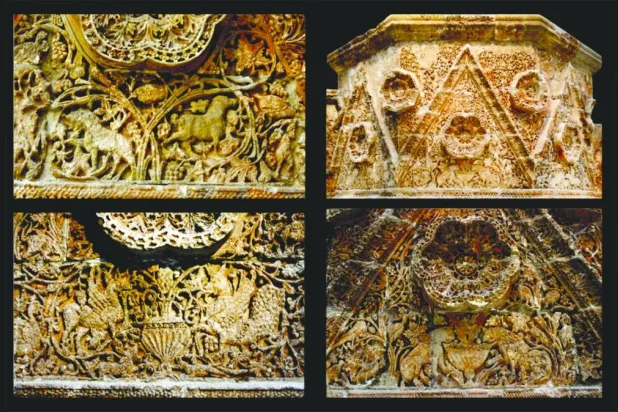ثمة انتظام حكائي سردي موضوعاتي تحرص رواية «وادي الفراشات» لأزهر جرجيس («مسكيلياني» - تونس/ «الرافدين» - بغداد 2024) على اقتفاء آثاره شبه الثابتة في روايتين سابقتين لأزهر جرجيس: «النوم في حقل الكرز» 2019، ثم «حجر السعادة» 2022. وقد شكَّلتا مدونة سردية ذات عوالم حكائية وموضوعاتية شبه مكررة. وقد نقول إن التكرار هو سمة تقوم عليها أغلب المدونات، بل إنه من غير الممكن وصف منظومة سردية بالمدونة من دون سمة التكرار. فلا ضير مما هو أساسي. إنما تتخذ النصوص المختلفة اتجاهاتٍ وموضوعاتٍ ضمن الإطار العام للمدونة، سوى أن التكرار يولِّد ضغطاً يُنتج، غالباً، تحوَّلاً أو اختلالاً في العالم السردي. في الروايتين السابقتين، كان لدينا موضوعان كبيران. فقد انشغلت «النوم في حقل الكرز» بسردية أساسية هي «العودة» المتخيلة للبلاد بعد منفى طويل. وكانت سردية الاحتجاج المنفتحة على عوالم السرد التشردي هي الموضوع الأساسي في «حجر السعادة». فهل ثمة موضوع جديد تنهض به رواية «وادي الفراشات»؟
دفتر الأرواح
أسهل طريقة لكتابة رواية ناجحة هي أن تعتمد نظام المخطوطة. نلمس حدود هذه القناعة بأكثر من سبيل في «وادي الفراشات». لنتذكر أنها الطريقة ذاتها التي اعتمدت في إنجاز الروايتين السابقتين، وقد حققتا نجاحاً ملحوظاً «سواء لناحية الانتشار والمقروئية، أو الوصول إلى مرتبة متقدِّمة في جوائز الرواية العربية. فهل هذا تسويغ كافٍ لتكرار المحاولة للمرة الثالثة؟ الحجة المقنعة تفترض أن نظام المخطوطة قد وفَّر الانتظام السردي المطلوب للروايتين. ثمة، إذاً، راوٍ يخبرنا، ابتداءً، أن خاتمة مسبقة تُصاغ أمامنا في مطلع الرواية. فهل الاستشعار أو الإخبار المسبق بالخاتمة هو أمر ذو وظيفة بنائية أساسية في الرواية؟ أغلب الظن أن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بإشكالية أساسية تتصل بنظام المخطوطة ذاته. لنختصر الإجابة ونسأل: لماذا يبدو نظام المخطوطة فاعلاً في كتابة رواية ناجحة؟ أفكر أن المخطوطة تمكِّن الرواية من أمور كثيرة أهمها، ربما، إمكانية إعادة كتابة الحكاية ذاتها بمنطق آخر. وهذه الإمكانية هي الطريق الأجدى لاقتراح تاريخ جديد، يختلف، أو يتعارض، جذرياً مع التاريخ السردي المعتمد. فأي تاريخ تقترحه «وادي الفراشات»؟
تاريخ «الأرواح»، أو تاريخ «الموتى»، هي المهمة الجليلة التي يتركها «الموتى» للأحياء؛ إذ إن كتابة تاريخ خاص للموت هو شأن الأحياء، إنما «الموتى» فعلوا ما بوسعهم وماتوا تاركين للأحياء مهمة كتابة تاريخهم من بعدهم. لكن أي «أرواح» يريد «عزيز جواد»، بطل الحكاية وراويها، أن يكتبها؟ تقترح الرواية لنفسها نوعاً جديداً من الأرواح، وهي أرواح «الفراشات» غير المسماة، أو ممن لم يُمنحوا حتى فرصة أن تكون لديهم أسماء بعينها. فيكون بعض مهمة المؤرخ أن يسمي الأجساد اللقيطة الملقاة على الأرصفة أو في حاويات القمامة، قبل أن يدفنهم في منخفض، أو سفح التل، خارج العاصمة، وسيسمي المقبرة المقترحة «وادي الفراشات». والمفروض، أو مثلما تقترح الرواية ذاتها، ابتداءً، من عنوانها، أن جمع الفراشات الميتة من الشوارع هو الموضوع البديل عن الموضوعات الكبيرة شأن سردية الحياة في بلاد الديكتاتور، أو أن تتعلَّق الرواية بموضوعة الاحتجاج. فهل تريد «وادي الفراشات» أن تعيد السرد إلى إيقاعه الهادئ العبيد، إلى حد ما، عن صخب السرديات الكبيرة؟
جمهورية الخوف
الصدفة العمياء، ربما، تقود «عزيز جواد» لاكتشاف سردية «وادي الفراشات»؛ عندما يوصل بسيارة التاكسي العجوز المتبرع بالتقاط الأجساد اللينة ويتولى دفنها في الوادي المنخفض قرب مدينة «ديالى». هذه الصدفة تشبه إلى حد بعيد صدفة دخول البوليس لمكتبة الخال «جبران» وعثورهم على كتاب «جمهورية الخوف» فيجري سجنه بتهمة الكتاب الممنوع المعارض لسردية الديكتاتور. لكن الكتاب يصل إلى «جواد» عن طريق صديق الأمس، الـ«متدين»، حالياً، المنقلب على تاريخ تشرده وضياعه؛ فكيف لمنقلب أن يعتمد السرديات الليبرالية المعارضة؛ وهو الأقرب لسردياته الدينية ذات الأصل المعروف «فلسفتنا مثلاً»؟ لكن الانتظام المفترض في «وادي الفراشات» يعيد تفسير فقدان المسوغات الكافية لسردية الصدفة ذاتها؛ فحياة «جواد» هي سلسلة مصادفات؛ مصادفة الحياة جوار أب فاقد لمقدرة الكلام والتعبير عن الذات وتحول هذه المصادفة، من ثمَّ، لقدر لا سبيل للخلاص منه بمواصلة حياة ناقصة تحت سلطة الأخ الكبير. فهل انتهت المصادفات؟ حياة «عزيز جواد» سلسلة مصادفة آخرها تعثره، بالصدفة، على سردية «وادي الفراشات»؛ فالمصادفة هي المسوّغ، يا للمفارقة، للحب الجامع بينه و«تمارا»، الشابة المنحدرة من عائلة غنية، ثم الزواج منها. وهي المفسِّرة لفصله من عمله الوظيفي الحكومي. لا قصة متماسكة سوى المصادفة ذاتها. حتى اللحظة المؤدية إلى القصة الرئيسة، قصة الفراشات، وهي خطف «سامر» من مجهولين من باب منزلهم لا تفسير متماسك لها سوى أنها تمهِّد لقصة الفراشات وواديها. كأن الرواية تقول لنا ضمناً إن الحياة في بلاد الديكتاتور، ثم في حياة ضحاياه، تفتقر إلى جدارة التسويغ. ولا بأس، فهذا ذاته هو شأن سرد ما بعد الحداثة؛ فهو سرد بلا مسوغات وتفسيرات أساسية، سرد مخطوطة تتولى الرواية الجديدة إعادة كتابتها بمنظور ومنطق مختلف.
وادي الفراشات... الجدل الخفيّ
لِنَعُدْ إلى أصل القصة، بالضبط إلى السؤال الرئيس: ما موضوع الرواية؛ بل ما موضوع المخطوطة المقترحة؟ ثمة مساران مختلفان، ظاهرياً، وهما المتحكمان في عالم رواية «وادي الفراشات». المسار الأول تمثِّله قصة «عزيز جواد»، وقد وجدنا أنها حياة مؤجلة تغذِّيها صدف مختلفة. هذا المسار يشغل المساحة الكتابية الكبرى من حجم النص؛ إذ يؤلف ثلاثة فصول من خمسة فصول هي الحجم الكتابي الكلي لنص الرواية. وبلغة الأرقام فإن قصة عزيز جواد تشغل مائة وواحداً وخمسين صفحة، فضلاً عمَّا تشغله في الفصلين المتبقيين. وتشغل مخطوطة «دفتر الأرواح»، وهي الأصل في المخطوطة غير المنتهية أو المكتملة، شأن مدونة الليالي الشهيرة؛ فهي ألف ليلة وليلة، ومخطوطة الأرواح لا تنتهي، ويتولى «آخرون» كتابتها، أو إضافة الفصول إليها. ولا نترك هذه الموضوعة من دون حفر إضافي يعطي المخطوطة أهمية مضافة؛ فالعجوز يترك المخطوطة خلفه في سيارة «جواد» ويذهب لحاله، بعد أن دفن فراشة جديدة هناك في «وادي الفراشات»، ويجري إيهامنا بأن العجوز قد ترك «المصحف»، ونكتشف مع «جواد» أن المصحف ليس سوى نسخة العجوز من «دفتر الأرواح». هذا الإيهام ذو وظيفة مفيدة تعطي قيمة جديدة للمخطوطة؛ فالتسوية الأولية، غير المقصودة حتماً بين «المصحف»، وهو هنا كتاب «القرآن»، ودفتر الأرواح لا يلبث أن يكشف عن معنى ودلالة غير معلنة لتوصيف «المصحف»؛ فالأصل اللغوي للمصحف كما يقول ابن منظور هو أن المصحف: «وإنَّما سُمِّي المصحفُ مصحفاً؛ لأنه أُصْحِفَ، أي جُعل جامعاً للصُّحُفِ المكتوبة بين الدَّفتَّين». وهو معنى يتجاوز الدلالة الاصطلاحية للكتاب، ويظل فاعلاً عند معنى الصحف المجموعة بين دفتي كتاب، وهو المقصود هنا بصيغة الكتاب غير النهائي أو غير المكتمل مما ينسجم مع دلالة «المخطوطة» غير المكتملة. لكنَّ هذه الصلات الحقيقية أو المتوهَّمة لا تلغي المفارقة الأساسية مما لا تخفيه الرواية؛ فالقصة الأساسية هي قصة «عزيز جواد» وليست حكاية أو مخطوطة «دفتر الأرواح». هذا ما تدَّعيه الأرقام ويعززه الحجم الكتابي الفعلي للمسارين في الرواية. فهل تؤيد الدلالات الأولى لعنوان الرواية «وادي الفراشات» الافتراض المتقدِّم؟
تفتتح الرواية عالمها بزيارة أخيرة من الخال «جبران» لابن أخته «عزيز جواد» في محبسه. وفي الزيارة تَرِد الإشارة الأولى لحكاية «دفتر الأرواح»؛ إذ يسلِّم الخال «المخطوطة» ويذهب إلى قبره المنتظر. ثم يجري تغييب المخطوطة وأثرها حتى يتعثر «عزيز جواد» بالشيخ العجوز، دافن جثث الأطفال في وادي الفراشات. فهل يُفيد هذا الأمر أن السرد يأخذ بالتصدع جراء تنازع موضوعين أو قصتين لا تصل إحداهما بالأخرى على عالم الرواية؟ هل نذهب، نحن القراء، مع ظاهر النص بحجومه وانحيازاته أم نفترض أن وادي الفراشات هو الدلالة الكلية للقصص كلها؟ فهو، بهذا التوجيه، أقرب ما يكون إلى الدلالة الكلية لما يُصطلح عليه بجامع النص؟ ربما؛ فالتصدع وتنازع القصص والموضوعات، هما شأن قصص ما بعد حطام الديكتاتوريات، وهما مآل المخطوطات غير المكتملة أيضاً. وأياً ما كان تأويل التنازع المفترَض في «وادي الفراشات» فإن الرواية تكافح لأن تنجو بجلدها بألا تنحاز إلى أيٍّ من المصادفات الصانعة لعالمها. وتحاول، بقدر ما تستطيع، ألا تتورط بأي تأويل ذي انحياز معلن، ولكن هيهات؛ فهي «وداي الفراشات»، وهي قصة «عزيز جواد»، وهي كذلك «دفتر الأرواح»!
* ناقد عراقي