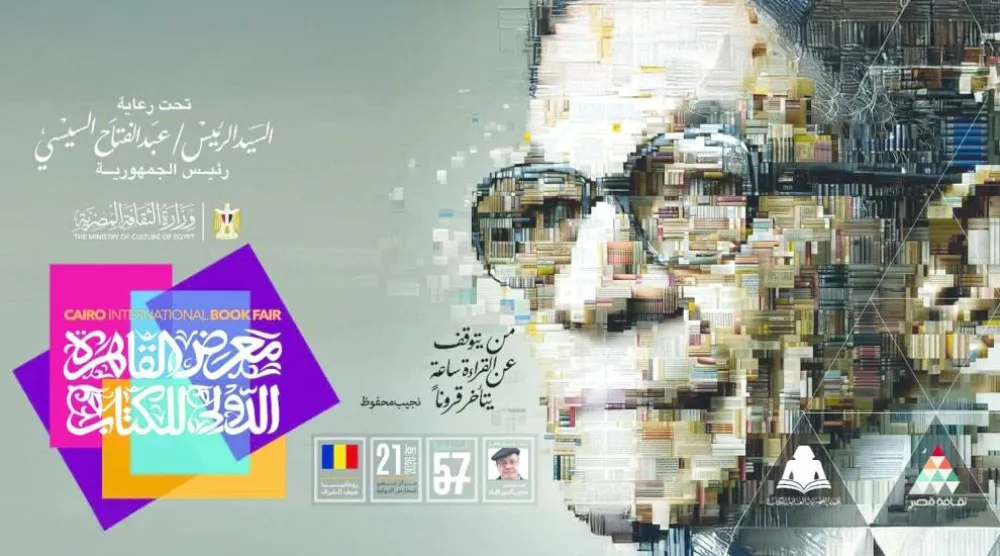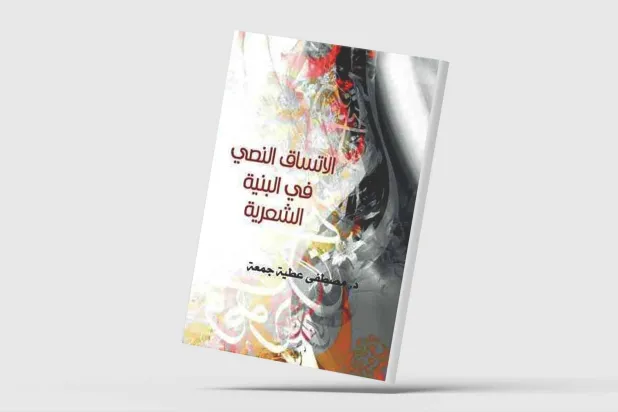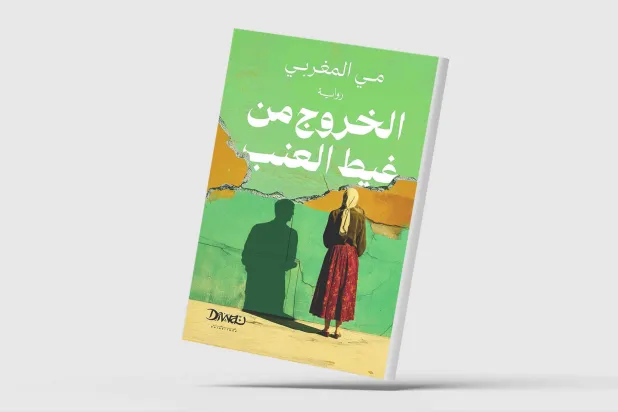عن دار «الوفاء لدنيا الطباعة» بمدينة الإسكندرية صدر كتاب «الأدب العرفاني - في الشعر والقصة والرواية»، للناقد والكاتب أحمد فضول شبلول الذي يرصد فيه ظاهرة الحس الروحاني والمسحة الصوفية في عدد من الأعمال الأدبية قديماً وحديثاً، ضمن منهج نقدي يمزج النظرية بالتطبيق. وتتنوع موضوعات الكتاب بين بعض النصوص التراثية مثل ديوان «ترجمان الأشواق» لمحيي الدين بن عربي، وما يعود إلى العصر الحديث عبر نماذج عالمية كما في حالتَي الكاتب الأميركي إرنست همنغواي، والكاتبة التركية إليف شافاق، فضلاً عن نماذج لمبدعين مصريين معاصرين.
ويعرّف المؤلف مصطلح «الأدب العرفاني» بأنه ذلك اللون من الإبداع الذي يتضمن حالة مرهفة من المعرفة الباطنية ذات الطابع الصوفي التي تذهب بالنفس الإنسانية إلى آفاق رحبة من الزهد وعدم الانشغال بالماديات، والبعد عن الملذَّات الجسدية. ويشتغل النص العرفاني، بشكل أو بآخر، على الجانب الروحاني في التراث الحضاري عموماً، ليحرره من النظرة الأحادية، ويجعله منفتحاً على تراث التأويل والأفكار التي تسمو بالفرد من عالم الملذات الضيق إلى عالم التأمل الفسيح في الكون.
وفيما يتعلق بديوان «ترجمان الأشواق»، فقد كتبه محيي الدين بن عربي قبل أكثر من ألف عام في ابنة الشيخ زاهر بن رستم بن أبي الرجا الأصفهاني، وكان اسمها «نظام»، وكانت شاعرة وأديبة فصيحة، «أخلاقها كأنها روضة من رياض الجنة، فضلاً عن جمالها، فهي هيفاء»، تلقب بـ«عين الشمس والبَها». قال عنها ابن عربي إنها «من العابدات العالمات السائحات الزاهدات، ساحرة الطرف، عراقية الظرف، إن أسهبت أتعبت، وإن أوجزت أعجزت، وإن أفصحت أوضحت، يتيمة دهرها، كريمة عصرها، سابغة الكرم، عالية الهمم، سيدة والديها، شريفة ناديها، مسكنها جياد، وبيتها من العين السواد، ومن الصدر الفؤاد».
وهكذا، نشعر أن هذا الوصف ليس وصف أنثى بشرية، وإنما وصف حالة من الحالات الصوفية.
وفي رواية «العجوز والبحر» لإرنست همنغواي، نجد أنفسنا إزاء «لحظة عرفانية نادرة»، تقوم على ما الذي يشعر به المرء لحظة أن يكون وحده وسط المحيط، فوقه السماء وحوله الماء من كل مكان، ولا شيء غير الزرقة، والقارب وبعض الأسماك، وصمت الكون. يعلو الإحساس في مثل هذه اللحظات بالخالق الأعظم، فتكون المناجاة أصدق ما تكون، ويكون «القرب والرجاء والدعاء والابتهال، والمونولوج الداخلي، هو الخيط الرفيع بين العبد وربه، أنت مع الله والماء والقدَر والرياح والشمس والظلام، وعدة أسماك تظهر من وقت لآخر، وطيور بحرية وأعشاب ودلافين».
وفي رواية «قواعد العشق الأربعون» للكاتبة التركية إليف شافاق، تتنوع الأصوات والأماكن والأزمنة، مثلما تنوعت الديانات، داخل الرواية، وانقسم التأويل ما بين الباطني والظاهري لينتصر الظاهري شكلياً، بمقتل شمس التبريزي، ولكن تعيش أفكاره ويتحول تلميذه جلال الدين الرومي إلى أحد رموز التصوف والعرفانية على مدار التاريخ.
وترصد رواية «عرش على الماء» للروائي المصري محمد بركة، سيرة «مشهور محسن الوحش»، منذ أن كان طفلاً في قريته «رملة العربان» بمدينة طنطا على عهد الملك فؤاد؛ أي قبل عام 1936، وحتى لحظة وجوده الأخير في لندن بعد ذلك بعقود عديدة. وما بين اللحظتين أو الزمنين حياة حافلة بالهدوء والصخب، بالعرفانية والشهوانية؛ إذ الشهوانية تعني عدم السيطرة على الشهوات الحسية. تراوح شخصية «الوحش» هنا بين المتناقضات، فنراه حيناً «ميت القلب حي الشهوة»، وحيناً آخر «حي القلب ميت الشهوة».
ويتخذ المؤلف من المجموعتين القصصيتين «دمى حزينة» و«المعاطف الرمادية» للكاتب سمير الفيل، نموذجاً للأدب العرفاني في القصة القصيرة؛ إذ يورد تلك العبارة من قصة «تلك الحواجز» التي تقول فيها إحدى الشخصيات: «لو وصلتَ سالماً فسوف يُسمح لك بالعيش في واحة خضراء مع تسع من الحور العين». وفي قصة «رائحة العطر» يظهر رمز الغزالة على لسان شخصية أخرى تقول: «في نصف ثانية نطَّت غزالة برية، ومرقت من الستارة الملونة، جرت ناحية غرفة النوم». وللغزالة رصيد كبير في عالم المتصوفة، بخاصة غزالة السهروردي رمز الروح الملائكية الشفيفة.