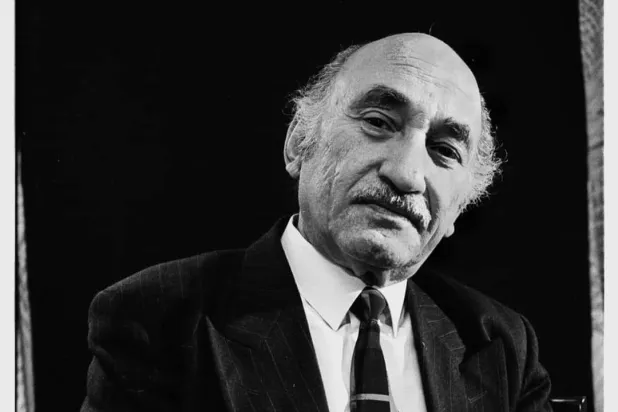لطالما كانت البيوت، بأشكالها وأنماطها كافة، ظهير حيواتنا الأوفى، والسجل الرمزي الذي يؤرّخ لحظة بلحظة، لتحولات أعمارنا منذ صرخة الولادة وحتى ذبول الأنفاس. وسواء اتخذت البيوت شكل الكهوف والمغاور زمن الأسلاف البدائيين، أو شكل المنازل المتواضعة والبيوت الطينية البسيطة في الريف الوادع، أو ارتفعت قصوراً باذخة وأبنية شاهقة في المدن المعولمة، فهي تظل بالنسبة لقاطنيها، الحاضنة والكنف وفسحة الطمأنينة والملاذ الآمن.
وقد يكون الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار، أحد أكثر الفلاسفة المعاصرين احتفاءً بالبيوت، وتغنياً بما تمثله من وداعة العيش ودفء الوجود الأصلي. وهو ما يبدو على نحو جلي، في كتابه الفريد «جماليات المكان»، حيث يؤالف على طريقته بين الفلسفة والشعر، وبين الحواس والحدوس، راسماً للبيوت صورتها المحمولة على أجنحة التأويل، ومتحدثاً عن دلالات المداخل وغرف الاستقبال والطعام والنوم، ومتنقلاً بين أحشاء الأقبية وفضاء الشرفات. والبيوت عند باشلار ليست الأماكن التي تحتوي على الزمن مكثفاً فحسب، بل هي الدروع الصلبة التي تعصم الإنسان من التفتت، و«تحميه من أهوال الأرض وعواصف السماء». والبشر الأوائل الذين كانوا يكبرون في أماكن مبهمة ومجهولة الأسماء، بدأوا بعد مكابدات طويلة وشاقة «يتعرفون إلى المكان ويستدعونه بحب ويسمونه بيتاً. كما أخذوا يلقون فيه جذورهم ويتوجهون نحوه بالحب، وحين يبتعدون عنه يُفضون بحنينهم إليه، ويكتبون عنه أشعار الشوق وكأنهم عشاق».
وإذا كان الشعراء والكتاب والفنانون قد أولوا البيوت الكثير من الاهتمام، وأفردوا لها عبر العصور الكثير من القصائد واللوحات والأغاني، فليس غريباً أن يتوقف الشعراء العرب ملياً عند ما وفَّرته البيوت لهم من مشاعر السكينة والأمان، وسط الخلاء الصحراوي المفتوح على المجهول، والمثخن بالوحشة والخوف والاقتتال الدائم. وسواء كانت طينية أم حجرية، خياماً أم مضارب، فقد سمى العرب البيوت منازل؛ لأنهم يدركون في قرارتهم أنهم سكانها المؤقتون الذين ينزلون في ضيافتها، ويحطون بين ظهرانيها رحالهم، ويودعونها أجسادهم الآيلة إلى موت محقق. والأرجح أن اتسام تلك الأماكن بالهشاشة، وافتقارها إلى الصلابة والثبات، هو الذي دفع العرب الأقدمين إلى أن يطلقوا اسم البيت، على السطر الشعري المؤلف من شطرين متناظرين، والذي يتكرر بالطريقة نفسها على امتداد القصيدة، كما لو أنهم رأوا في الشعر، الظهير الرمزي الذي يعصمهم من الزوال، ويوفر لهم سبل الالتئام وأسباب الخلود.
ومع أن امرأ القيس قد أعطى الأولوية للحبيب على المنزل، وهو يصعد سلم البكاء الطللي، فإن ذلك لا يقلل أبداً من قيمة المنازل، بقدر ما يؤكد على اعتبارها امتداداً لأجساد ساكنيها ووعاءً لأرواحهم، وخزاناً لذكرياتهم وحنينهم العصي على النفاد. ولهذا السبب حذا الشعراء اللاحقون حذو سابقيهم، فاحتفى أبو تمام بالبيوت التي سكنها بصورة متتابعة، جاعلاً الحنين إلى المنزل الأول، صورة من صور الحنين إلى الحبيب الأول الأول. وهو ما عبر عنه في بيتيه الشهيرين:
نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى
ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى
وحنينه أبداً لأول منزلِ
ومثلما فعل أبو تمام، هتف المتنبي بحرقة مماثلة:
لك يا منازل في القلوب منازلُ
أقفرتِ أنتِ وهنّ منكِ أواهلُ
ولعلنا في ضوء هذه التوطئة نستطيع أن ندرك السبب الذي يدفع الغزاة والمحتلين، منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا، إلى جعل البيوت جزءاً لا يتجزأ من غنائم الحرب، حتى إذا تعذر القبض عليها بصورتها السليمة، تم إحراقها وتحويلها رماداً، أو تدميرها وتسويتها بالأرض. ولعل ما فعلته قوى الاحتلال الإسرائيلي ببيوت غزة والضفة ولبنان، هو الشاهد الأبلغ على ما تقَدم. فما الذي يعنيه دكّ البيوت والمباني والأبراج على رؤوس ساكنيها، بلا إنذار مسبق، أو بإنذار لئيم دون فاصل زمني؟ وما الذي يعنيه انقضاض الطائرات المحملة بالقذائف الفتاكة على البشر الآمنين لتسوية أحياء كاملة بالأرض، ودون تمييز بين المقاتلين والبشر العزّل؟ ألا تعبّر النشوة الغامرة التي يعيشها الطيارون المطلون من شاهق على المدن والقرى المكلفين تدميرها، عن نزوع سادي، مماثل تماماً لذلك الذي انتاب نيرون، وهو يحوّل روما التي أحرقها لوحة بصرية ممتعة، أو لذلك الذي حمل في أحشاء طائرته قنبلة هيروشيما، منتشياً بمشهد المدينة التي تحولت خلال لحظات قليلة ركاماً؟ والمؤلم ألا يكون هذا النزوع مقتصراً على أفراد بعينهم، بل تتسع دائرته لتشمل الجماعة الإثنية أو السياسية التي يمثلونها، والتي لا ترضى بأقل من إبادة الآخر ومحوه من الوجود، بذرائع أسطورية ولاهوتية تم اختلاقها لمثل هذه الأهداف؟
إن أكثر ما يُشعر المرء بالصدمة في هذه المحرقة التي تسمى حرباً، أن ذلك الذي أطلق بالأطنان صواريخه وقنابله المتفجرة فوق غزة أو بيروت، متسبباً بانكماش المباني على نفسها كالصفيح، لم يقْدم على ذلك بتأثير نوبة غضب أو خروج عصبي عن السيطرة، بل فعل ذلك عامداً ومدفوعاً بدم الآيديولوجيا البارد، وبحقه المزعوم في إبادة المئات من «الأغيار» حتى لو كان الهدف متعلقاً بواحد أو أكثر من أعدائه المقاتلين، أو مقتصراً في أغلب الحالات على الشبهة المجردة. وللمرء أن يتساءل كيف لذلك الشخص الذي ينتمي إلى أسرة يعيش في كنفها، أو بيت يأنس إلى هدوئه الوادع، أن يعود إلى بيته، أو يعانق بعد ارتكاب مجزرته الدامية، زوجته وأطفاله المتلهفين إلى عودته، دون أن تخزه لسعة الندم، أو يفكر قليلاً بزوجات مماثلات وأطفال مماثلين، كانت لهم هناءات عيش مماثلة، قبل أن ينقلهم بلحظة واحدة إلى خانة العدم.
ولو كان البيت الذي يتهدم، مؤلفاً من حجارته وإسمنته وسقوفه وأراضينه الصغيرة لهان الأمر. لكنه يضم بين جنباته، الحيوات التي كانت تضرب مع المستقبل مواعيد من أحلام خالصة ورجاء متجدد. وهذه البيوت التي لم يعد لها أثر، هي سجل سكانها الحافل بالمشقات والمسرات والأنفاس والدموع ورعشات اللذة أو الخوف، وغيرها من التفاصيل والذكريات التي لا تنضب.
ولعلني لا أجد ما أختتم هذه المقالة أفضل من استعادة قصيدة «البيوت»، التي كنت قد كتبتها في حرب مشابهة.
ما الذي يعنيه دكّ البيوت والمباني والأبراج على رؤوس ساكنيها بلا إنذار مسبق أو بإنذار لئيم دون فاصل زمني؟
البيوت طيورٌ تزقِّمُ أفراخها لوعةً
كلما ابتعدوا عن حديد شبابيكها المائله
والبيوت جسور الحنين التي تصل المهدَ باللحد،
ريشُ المغامرة الأمّ،
طين التكاثرِ،
سرُّ التماثل بين الطبيعة والطبع،
بين الجنازة والقابله
والبيوت سطورٌ
يؤلّفنا بحرها كالقصيدة بيتاً بيتا
لكي نزِن الذكريات بميزانها
كلما انكسر اللحنُ أو تاهت البوصله
والبيوت جذورٌ تعود بسكانها دائماً
نحو نفس المكان الذي فارقوهُ
لتعصمهم شمسها من دوار الأعالي
ومن طرقاتٍ تشرّدهم في كسور المكانْ
والبيوتُ زمانْ
يقسّم دقاتهِ بالتساوي على ساكنيهِ
لكي يسبحوا بين بيتين:
بيت الوجود وبيت العدمْ
وكي يعبروا خلسة بين ما يتداعى وما يلتئمْ
والبيوت رحِمْ
توقنا للإقامة في أرخبيل النعاس،
للتماس مع البحر من دون ماءٍ
لكي نتشاكى حرائقنا الأوليةَ،
أو نتباكى على زمنٍ
لن يعود إلى الأرض ثانيةً
والبيوت فراديسنا الضائعه
تواصَوا إذن بالبيوت،
احملوها كما السلحفاةُ على ظهركمْ
أين كنتمْ، وأنّى حللتمْ
ففي ظلها لن تضلّوا الطريقَ إلى بَرّ أنفسكمْ
لن تملُّوا حجارتها السودَ
مهما نأتْ عن خطاكمْ مسالكها اللولبيةُ،
لن تنحنوا فوق مهدٍ أقلّ أذىً
من قناطرها المهمله
ولن تجدوا في صقيع شتاءاتكمْ
ما يوازي الركون إلى صخرة العائله
وحرير السكوتْ
تواصوا إذن بالبيوت
استديروا ولو مرةً نحوها
ثم حثُّوا الخطى
نحو بيت الحياةِ الذي لا يموتْ