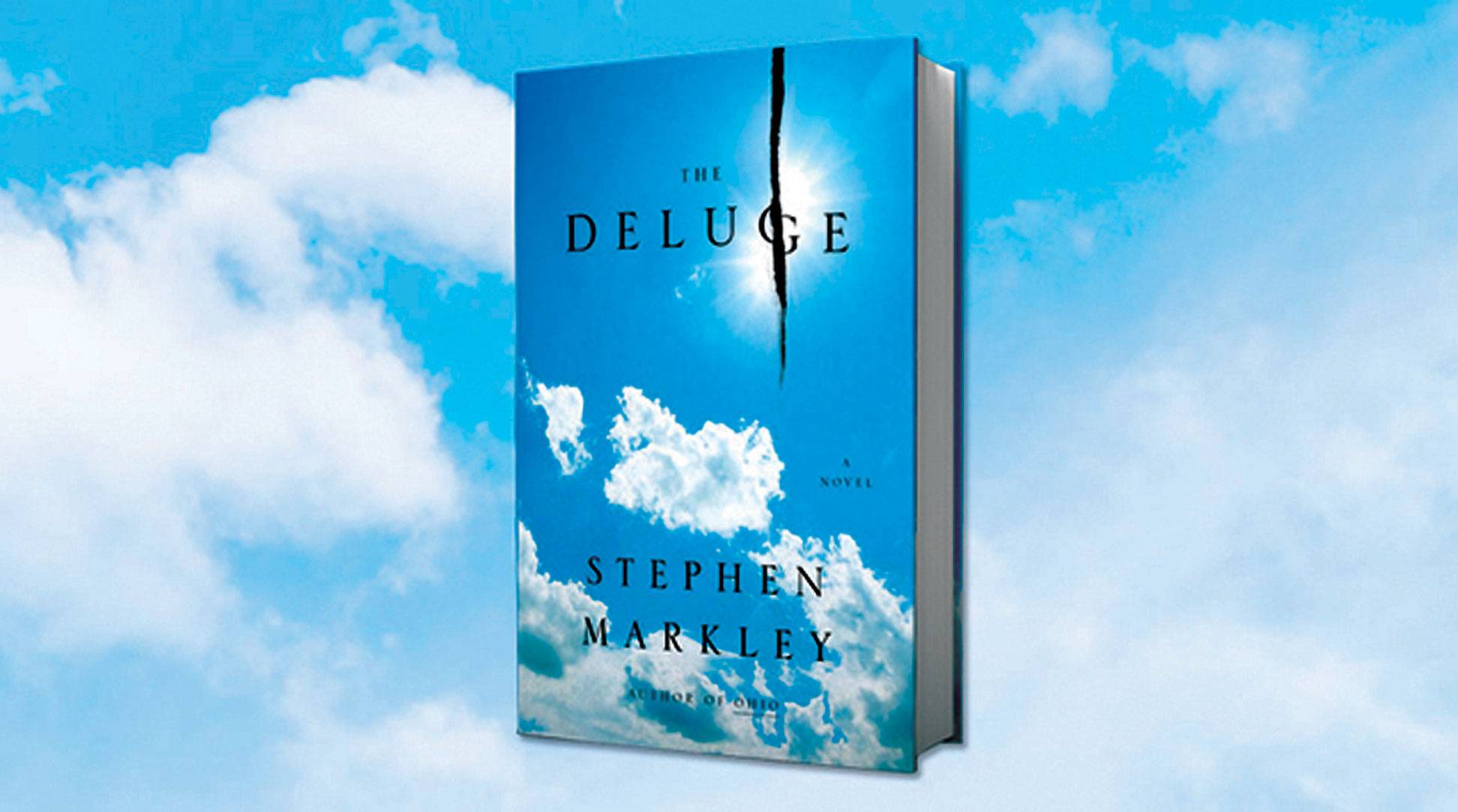أكبر خطيئة نرتكبها نحن المثقفين العرب هي إقامة المقارنة بين مجتمعاتنا العربية الإسلامية الحالية ومجتمعات الغرب المتطورة التي تجاوزت كلياً مشكلة الأصولية الدينية الطائفية. هذا ما يدعوه المؤرخون بالمغالطة التاريخية. ينبغي أن نقارن ما تمكن مقارنته، لا ما تستحيل مقارنته. بمعنى آخر، وبالعربي الفصيح، ينبغي أن نقارن أوضاعنا الحالية بأوضاعهم قبل 300 سنة حتى 400 سنة عندما كانوا لا يزالون يتخبطون في صراعاتهم الطائفية والمذهبية... عندئذ تصبح المقارنة ممكنة ومشروعة. ففي القرن السادس عشر أو السابع عشر، كانوا يعانون مما نعاني منه نحن حالياً؛ أي الحروب الطائفية والأحقاد المذهبية والذبح على الهوية. وأكبر دليل على ذلك سيرة حياة المفكر الفرنسي البروتستانتي بيير بايل الذي عاش في نهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر (1647 - 1706). في ذلك الوقت كانت فرنسا كاثوليكية في غالبيتها الكبرى. ولكنها كانت تحتوي على أقلية بروتستانتية لا يستهان بها وتحاذي 20 بالمائة. وقد شاء له الحظ العاثر أن يولد في أحضان الأقلية لا الأكثرية. ولذلك هرب من الاضطهاد الطائفي من بلد إلى بلد حتى استقرت به الأمور في بلاد بروتستانتية مثله، هي هولندا. لقد عانى هذا المفكر الكبير من التعصب الديني إلى درجة أنه أمضى حياته كلها في مكافحته وتحليله وتفكيكه بغية الخلاص منه. فمن هو بيير بايل يا ترى؟ إنه الرائد الأول الذي سبق فلاسفة التنوير الكبار وأرهص بهم. فقد جاء قبلهم بقرن من الزمن. لقد مات عام 1706 في حين أن فولتير ولد عام 1694، أي قبل 10 سنوات من وفاته أو أكثر قليلاً. ومعلوم أنه كان يحبه كثيراً ويستشهد به كمرجعية فكرية كبرى بالنسبة له. ولكن الشهرة ذهبت لفولتير، لا إلى بيير بايل. فمن يعرف اسم بيير بايل في العالم العربي؟ لا أحد تقريباً. لقد كان بيير بايل مع الفيلسوف الإنجليزي جون لوك أحد المفكرين الكبار الذين ساهموا في انبثاق فكرة التسامح الديني وتجاوز الطائفية والمذهبية في أوروبا. وكان ذلك إبان احتدام الصراعات المذهبية بين البروتستانتيين والكاثوليكيين. وكان أول منظر يدعو إلى التسامح مع الجميع، بل كان يدعو إلى التسامح مع غير المتدينين، أي الأشخاص الذين لا يلتزمون بالطقوس والشعائر المسيحية. وبالتالي، فقد كان سابقاً عصره كثيراً. ومعلوم أن الرواد يجيئون قبل الأوان لكي يشقوا للآخرين الطريق. ولكنهم يعانون كثيراً بسبب ذلك ويدفعون الثمن غالياً.
كان بيير بايل ينتمي إلى الأقلية البروتستانتية الفرنسية. بل كان أبوه رجل دين، أي قساً بروتستانتياً. ولكن بايل الشاب غيّر مذهبه عام 1669 عندما أصبح طالباً في المعهد اليسوعي الكاثوليكي بمدينة تولوز. وذلك لكي يلتحم بالأغلبية الكاثوليكية وينجو من الاضطهاد والاحتقار الطائفي الذي تمارسه عادة الأغلبية على الأقلية. ثم اكتشف بعدئذ أنه أخطأ، لأن المذهب البروتستانتي كان أكثر تقدمية واستنارة من المذهب الكاثوليكي آنذاك. فعاد إلى مذهبه الأصلي بعد 18 شهراً فقط من اعتناقه للكاثوليكية البابوية. وهكذا خاطر بنفسه، لأن الملك لويس الرابع عشر كان يرفض أي ارتداد عن الكاثوليكية التي تشكل المذهب الرسمي للبلاد. وبالتالي، فقد أصبح الرجل مرتداً لأنه عاد إلى حضن «الهرطقة والزندقة» من جديد. وويلٌ لمن يفعل ذلك في فرنسا الكاثوليكية. سوف يباح دمه مباشرة.
ينبغي العلم أن صاحب المذهب البروتستانتي كان يعدّ زنديقاً مهرطقاً في ذلك الزمان، على الرغم من إيمانه بالمسيح والإنجيل كالكاثوليك. ولكن كانت هناك بعض الخلافات اللاهوتية التفصيلية الهامة مع الكاثوليك. علاوة على ذلك، فقد كان تفسيره للدين المسيحي أكثر عقلانية واستنارة، كما ذكرنا. ولذلك كانوا يكفرونه ويكفرون أتباعه ويحلّون دمهم. وقد عانوا من المجازر ما عانوه، ثم اضطروا إلى الفرار بمئات الألوف إلى الدول البروتستانتية المجاورة كإنجلترا وألمانيا وهولندا... ينبغي العلم أن جميع ملوك فرنسا كانوا يعتلون العرش، ويتم تنصيبهم الرسمي والشرعي في كاتدرائية مدينة «رانس» الشهيرة، التي طالما مررت أمامها وتأملت بمعانيها وشموخها، عندما كنت أقيم في تلك المدينة الصغيرة الوديعة التي تبعد عن باريس مسافة 45 دقيقة بالقطار. كانوا جميعاً يحلفون القسم التالي أمام الجمهور الكبير المحتشد داخل الكاتدرائية: «أقسم بالله العظيم سوف أستأصل الأقلية البروتستانتية المهرطقة الكافرة عن بكرة أبيها. سوف أنظف أرض المملكة الفرنسية الكاثوليكية الطاهرة من رجسهم وضلالهم». بهذا المعنى. كان آخر من أقسم هذا اليمين هو لويس السادس عشر، الذي أطاحت به الثورة الفرنسية عام 1789. وعندئذ أخذ البروتستانتيون حقوقهم كمواطنين لأول مرة في التاريخ الفرنسي. عندئذ نصّ الإعلان الشهير لحقوق الإنسان والمواطن على ما يلي: ممنوع بعد اليوم منعاً باتاً أي تمييز بين إنسان وآخر على أساس طائفي. ممنوع إقلاق أي شخص أو إرعابه بسبب انتماءاته الدينية أو المذهبية. ممنوع تعييره واحتقاره لأنه لم يولد كاثوليكياً. الجميع أصبحوا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، بمن فيهم البروتستانتيون، حتى اليهود. هذا ربيع حقيقي، هذا ربيع أنواري وتنويري. هذه ثورات حقيقية تقذف بك إلى الأمام، لا كذلك الربيع العربي القرضاوي التكفيري، الذي أوشك أن يعيدنا قروناً إلى الوراء.
لكن لنعد إلى بيير بايل وقصته. بعد أن تراجع عن المذهب الكاثوليكي وعاد إلى مذهبه الأصلي البروتستانتي عرف أنه أصبح مهدداً بالقتل فهرب إلى هولندا البروتستانتية مثله، واستقر في مدينة روتردام. وهناك وجد وظيفة كمدرس لمادتي الفلسفة والتاريخ. وراح ينشر مجلة أيضاً تحت عنوان «أخبار جمهورية الآداب». ومعلوم أن هولندا كانت في ذلك الزمان أكثر بلدان أوروبا تسامحاً وحرية، بالإضافة إلى إنجلترا. وإليها كان يلجأ الفلاسفة لكي يعبروا عن أفكارهم وينشروا كتبهم، كما فعل ديكارت مثلاً. نقول ذلك على الرغم من أنه كان كاثوليكياً ينتمي إلى مذهب الأغلبية، ولا يعاني في فرنسا من الاضطهاد الطائفي الذي أصاب بيير بايل وبقية أبناء الأقليات. ولكن ما كان يستطيع أن يتنفس بحرية ويبلور فلسفته الجديدة داخل جدران المملكة الفرنسية الكاثوليكية البابوية، التي كانت ظلامية متزمتة جداً في ذلك الزمان.
إن تجربة بيير بايل الشخصية في تغيير مذهبه واعتناق المذهب المعادي ثم العودة إلى مذهبه من جديد برهنت له على عبثية الإكراه في الدين. فالإنسان يعتقد أن دينه أو مذهبه هو وحده الصحيح، ولكنه لو ولد في الدين الآخر أو المذهب الآخر لاعتقد ذات الشيء أيضاً. المسيحي لو ولد في الهند لكان بوذياً أو هندوسياً براهمانياً، ولو ولد في الصين لكان كونفشيوساً... إلخ. ولهذا السبب عدّ بيير بايل أن الأمور نسبية وراح يتبنى مبدأ التعددية وحرية الضمير فيما يخص المعتقد الديني.
لقد ألف بيير بايل عدة كتب، شهرته وجعلته مقروءاً بكثرة طيلة القرن الثامن عشر، أي عصر التنوير الكبير. فقد راح فلاسفة التنوير من أمثال فولتير وديدرو وجان جاك روسو والموسوعيين يستشهدون بها لدعم مواقفهم المضادة للتعصب الديني والأصولية الكاثوليكية البابوية. نذكر من بين مؤلفاته كتاباً بعنوان «ما معنى فرنسا الكاثوليكية المتعصبة في عهد لويس الكبير؟» أي لويس الرابع عشر أعظم ملوك فرنسا وباني قصر فرساي الشهير. وفي هذا الكتاب يشنّ بيير بايل حملة شعواء على هذا الملك الجبار، الذي حاول استئصال البروتستانتيين عن بكرة أبيهم... كما انتقد بعنف التعصب المذهبي الذي كان سائداً في فرنسا آنذاك. وصبّ جام غضبه على الإخوان المسيحيين الكاثوليكيين الذين كانوا يكفرون الآخرين في كل أرجاء المملكة الفرنسية التوتاليتارية الإرهابية، التي تجبر الناس كلهم على اعتناق مذهب واحد غصباً عنهم. ثم نشر كتاباً آخر بعنوان «مرافعة من أجل الدفاع عن حقوق الضمير التائه» أي الضمير الحرّ في الواقع... إلخ. ولا ننسى كتابه الأكبر والأهم «القاموس التاريخي والنقدي» الذي فكّك فيه كل العصبيات الطائفية والفتاوى التكفيرية بشكل فلسفي دقيق ومقنع. وقد مارس هذا الكتاب الضخم تأثيراً كبيراً على جميع فلاسفة الأنوار اللاحقين.
كل هذه الكتب أزعجت الملك الكاثوليكي والسلطات الكنسية أيما إزعاج. فانتقموا منه عن طريق قتل أخيه «يعقوب بايل» في السجن، لأنهم كانوا عاجزين عن الوصول إليه هو شخصياً بسبب التجائه إلى المنفى الهولندي البعيد الخارج عن إرادتهم. والواقع أنهم عرضوا على أخيه اعتناق المذهب الكاثوليكي في آخر لحظة قبل تصفيته لكي ينجو بجلده، ولكنه رفض وعندئذ قتلوه. كانت الحزازات المذهبية على أشدّها آنذاك في فرنسا. ولكنها اختفت الآن نهائياً، ولم يعد لها أي وجود. وكل ذلك تم بفضل جهود الأنوار وفلاسفة الأنوار، وعلى رأسهم بيير بايل الذي سيستلم فولتير الشعلة منه، ويشنّ حرباً ضارية على الأصولية الكاثوليكية والتعصب الطائفي الأعمى كما هو معلوم.