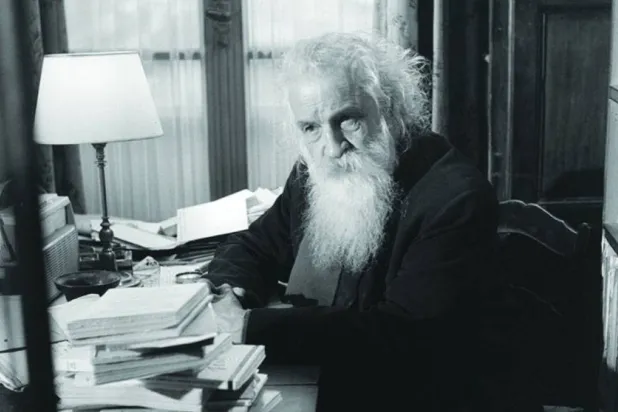أثار المفكر المرموق أنور عبد الملك في حينه (1962) موضوعاً مهماً، وهو يعرض لأزمة الاستشراق. لم يتحدث أنور عبد الملك عن استشراقين، معرفي وسياسي، كما فعلت في كتاب «الاستشراق في الفكر العربي - 1993»، كان معنياً بالأزمة التي رافقت ظهور الحركة بصفتها المعرفية التي سرعان ما اختلطت بمصالح الاستعمار. ونبّه الدارس والعالم الاجتماعي المصري المقيم في باريس في حينه إلى العوائل الفلولوجية التي ساهمت المدارس الاستشراقية في ترسيخها على أساس انقسام العالم إلى آري، وآخر سامي يشتمل العرب، واليهود، والملونين، وغيرهم. كان التوزيع بمثابة تبرير استيطاني يشتغل بوجهين: فإذا أراد نابليون مثلاً الاستحواذ على مصر قبل إنجلترا فعليه ادعاء أمرين: أنه مسلم، وأسلم بحضور علماء مسلمين في القاهرة؛ ولكن أيضاً على أساس أن مصر شرق متوسطية، وبالتالي فهي تعود لفرنسا، لا إلى إنجلترا في التوزيع الاستعماري للمعمورة. ولذا كان فريقه من العلماء والباحثين يكتب «وصف مصر»، المجلد الواسع الذي تصدرته مقدمة تقول إن على مصر أن تتجاوز قروناً من «إسلاميتها» لتعود إلى الحضن المتوسطي - الفرنسي. هكذا تأتي المقدمة التي استدرجت مثقفين عرباً، من بينهم طه حسين. لم يذهب عبد الملك إلى هذه المساحة، ولم يذهب إليها الراحل المرموق المفكر إدوارد سعيد. كان إدوارد سعيد معنياً بالمكونات المعرفية لحركة تمايزية تمييزية تدعي المعرفة بالشرق، أي بالشرق الأوسط، والعرب والمسلمين تحديداً، قبل أن ينتقل مفهوم «الشرق» إلى جنوب شرقي آسيا. الشرق الأوسط الذي التقليدي يصر «الدارس التقليدي» ورحالة الإمبراطوريات الناهضة هو الذي يعنيه سعيد؛ أي أنه مجموعة الانطباعات السطحية العائمة التي تعرض لسكان كتل بشرية عظيمة على أنهم كسالى مخدرون ثابتون على فكرة واحدة، لا أمل في تغييرهم إلا بنابض وحاضر أوروبي يديره الرجل الأبيض. من المفارقات التي لم يذكرها الراحل العظيم أن الدارس الإنجليزي المعروف صاموئيل جونسن، صاحب أول قاموس إنجليزي متكامل، كتب على لسان شخصيته المركزية «عملاق» الشاعر أن «إيثوبيا» الشرقية شأنها شأن مجاوريها تحتاج إلى رعاية «استعمار» أوروبي «شمالي» يتيح لها الخروج من وحدتها وجنوبيتها. إذ العالم منذ القرون الوسطى ينقسم إلى شمال وجنوب، ويسقط التوزيع الجغرافي سطوته على الديانات والأقوام، وكان أن عرض لهم بعض «تنويريّي» القرن الثامن عشر على أنهم يعانون سباتاً لا أمل منه من غير سطوة رجل أوروبا الأبيض. هكذا كان الذهن «التنويري» الأوروبي. علينا ألا ننسى أن «صاموئيل جونسن» هو من المبرزين في الحركة «الإنسانوية» لتمييزها عن غيرها لخصومتها مع دعاة العبودية والاستعباد. وإذا كان جونسن يميل إلى هذا المعتقد، فكيف لنا بغيره؟ علينا ألا ننسى ثانية أن جونسن قرأ ترجمات دارس الاستشراقين المبرز في المشرقيات سير وليم جونز وكتاباته، وهو الذي أطلق عليه تسمية «جونز الشرقي» Oriental Jones، بحكم انهماك الأخير في قراءة أدب العرب والفرس. وترجماته وكتاباته ذائعة ومؤثرة. وهو نفسه - أي جونز - الذي في نهاية حياته وعند مراجعته ورصده لهذا الانهماك يستنتج أن ثقافته الأم أهم من ذلك الذي قضى عمره في دراسته.

لم يتطرق الراحل سعيد إلى هذا الأمر لأنه كان معنياً بمجموعة التهيؤات والتصورات لعدد كبير من الرحّالة والكتّاب لما كان يتصورونه شرقاً رثاً ساكناً شهوانياً لا فكر له ولا مستقبل من دون اللمسة الإمبراطورية. دعني أضيف: إنهم يستكملون ما بدأه بارتياح، بالغ دانيل دفو في روايته الذائعة منذ صدورها 1703 «روبنسون كروسو» التي تعرض إلى الشرق وأفريقيا أرضاً بوراً يسكنها ويعمرها كروسو ليلقن فرايدى الأسود الطريد لغته التي تبتدئ بالرضوخ، أي بمفردة: نعم. والخلاصة: أن أرنست رينان سيقفز على حصيلة هذا التراكم. وسيستعمر هو الآخر نتاج «دي ساسي» ليعيد توظيفه في التوزيع الفلولوجي الفقهي للعالم على أساس آري - سامي، ولم يعنِ رينان بالتوزيع ما بين شمال وجنوب مستعْمِر ومستعْمَر. كان معنياً بالتوزيع المتناقض في رأيه ما بين آري متماسك تركيبي عقلاني حضاري، وآخر سامي راكد ساكن. ولكن نظرية أرنست رينان التي سادت في حينه واجهت مشكلات نهاية القرن التاسع عشر، وحصيلتها النهائية للديمقراطية الانتخابية التي فسحت المجال للهجرات والأقليات، ولا سيما الأقلية اليهودية الناشطة القادمة من ألمانيا، التي استفزتها منذ زمن نظرية العرق الجرماني الذي يسعى للمّ الشمل والتكامل على أساس نقاوة العرق الجرماني. هذه النظرية التي سيسخر منها بصراحة المثقف العراقي المظلوم، ذو النون أيوب، في روايته «الدكتور إبراهيم» هي التي تشكل البذر النازي. وإذا كان يهود أوروبا من الكتّاب ورجال المال يؤثرون إنجلترا وفرنسا هرباً من ألمانيا منذ نهاية القرن التاسع عشر، فإن الأمر الذي تمخض جراء ذلك هو أنه ليس بالإمكان الركون إلى نظرية أرنست رينان وتوزيعها العرقي الديني ما بين: آري وسامي. فكان أن ولد التوزيع: الأوروبي أو الغربي والشرقي!! ومن السخرية أن اللغة النازية العرقية تحولت إلى جزء أساس من لغة المستعمر الجديد الذي يستخدم تعبير حيوانات بشرية في الإشارة إلى العرب والفلسطينيين منهم بشكل خاص كما يتأكد في خطب المستعمر الاستيطاني اليوم!
وعندما ألقى الراحل العالم ياروسلاف ستيتكيفتش محاضرته المبكرة في كلية سينث أنتوني بجامعة أكسفورد سنة 1967 كان ينبه إلى أمر آخر قد لا يبدو متصلاً بما نحن فيه؛ كان يلوم «نحن المستشرقين» على دراسة الشرق كموضوع من دون الانتماء إليه حباً وتعاطفاً. كان ينحو باللائمة عليهم لأنهم يكتبون ويقرأون باللغات قيد الدرس، لكنهم يعجزون عن استعمالها في التخاطب والعلاقة بالعرب موضوع درسهم. كان يدعو بإصرار إلى محبة حقيقية، وليس دراسية فحسب، لكي يشعروا بالانتماء إلى ما يخصونه بالدرس. ولهذا عجزوا عن العلاقة بموضوعهم، أي العرب. ومن هؤلاء كان المستشرق مرغليوث مثلاً الذي جمع أحاديث التنوخي ورسائل أبي العلاء المعري. لكنه أيضاً رافق البعثة البريطانية التي احتلت العراق. ويذكر الشاعر الدارس محمد مهدي البصير أحد معاصريه آنذاك أنه أي «مرغليوث» قال عند التفاوض مع الوفد الوطني العراقي: «إنه لم يعرف عن العراقيين القدرة على إدارة أنفسهم» بما يعني أنهم بحاجة إلى المستعمر البريطاني أو غيره!!
اللغة النازية العرقية تحوّلت إلى جزء أساس من لغة المستعمر الجديد الذي يستخدم تعبير حيوانات بشرية في الإشارة إلى العرب والفلسطينيين منهم بشكل خاص
هذه هي نهاية المستشرق؛ فهي ليست نهاية معرفية فحسب، ولكنها سياسية أيضاً، لأنها اقترنت بالتمايزات العرقية التي رافقتها، والتي قادتها إلى النهاية. هذا لا يعني التقليل من المنجز المعرفي عند السير وليم جونز ودي ساسي وسير شارلز لايل، وغيرهم. لكن إشارة الراحل ياروسلاف إلى أهمية التخاطب ودوره في توطيد حب حقيقي لموضوع الدرس تعني ضمناً لزوم التباعد عن عقدة المستعمر، أي ادعاء السيادة على الأقوام الأخرى. لهذا انقاد الاستشراق إلى حتفه، مع ازدهار العلوم الاجتماعية، وبروز المستعرب شريكاً ثقافياً. لكنها بداية المستعرب الذي درس العرب من زوايا مختلفة، وجاء بعدة أخرى، قوامها الحب والمودة لموضوع الدرس. المستعرب ليس دارساً للأدب وحده، وقد يكون مؤرخاً وسوسيولوجياً، وفيلسوفاً وغير ذلك، إنه ابن الثقافة التي يعنى بها، إذ لا تمييز بينه وبين أهلها، ولأنهما لا يقلان جهداً وتمعناً. ولنعد إلى السؤال: ما الذي تبقى من الاستشراق؟ لا يغمط السؤال الإرث الترجمي الفلولوجي الواسع الذي قام به المستشرق، لكن التقليديين منهم الذين مضوا على جادة مرغليوث لم يحققوا غير منجز ضئيل، مقارنة بالجهد الذي يقوم به المستعرب والمستعربة، وهما يمتلكان آليات بحث وتنقيب وتحليل مستجدة، لا تغمط الأقوام درايتها ولا تعددية ثقافاتها وتلويناتها المختلفة التي تفترق عن «النمطية» الأوروبية والنظرة الاستنكارية للآخر لمجرد تباينه عما يتصوره «التقليدي» نمطاً وحيداً عقلانياً قادراً على إدارة الآخرين.
جامعة كولمبيا، نيويورك.