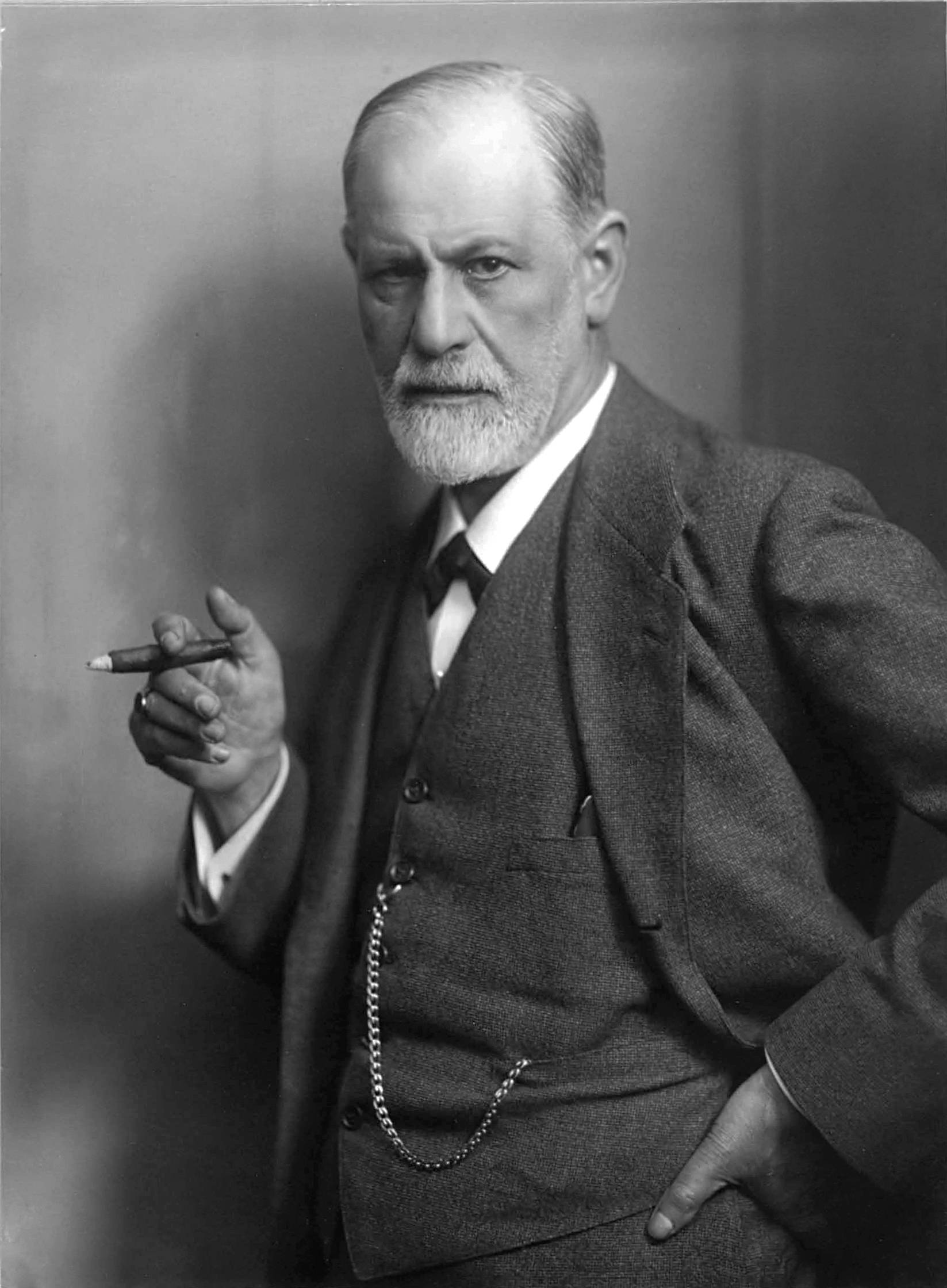يُعد الروائي الجزائري أمين الزاوي من أبرز الأصوات الأدبية في المشهد المغاربي الراهن؛ يكتب باللغتين العربية والفرنسية، وحصل على عدة جوائز دولية، منها جائزة «الحوار الثقافي» عام 2007 التي يمنحها رئيس الجمهورية الإيطالية، وتُرجمت أعماله إلى أكثر من 13 لغة، كما وصل عدد منها إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، آخرها رواية «الأصنام» (2024)، ومن رواياته بالفرنسية «الخنوع»، و«طفل البيضة». يعمل أستاذاً للأدب المقارن بجامعة الجزائر المركزية، وتولى منصب المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية حتى عام 2008. صدرت له أخيراً رواية «منام القيلولة» عن دار «العين للنشر» بالقاهرة... هنا حوار معه حولها والمحطات المهمة في تجربته الأدبية.
* في روايتك الأحدث «منام القيلولة» تتفرع من الواقع مسارات للغرابة من خلال حكاية «أم» جزائرية... حدِّثنا عن ملامح هذا العالم الروائي الجديد؟
- كتبت هذه الرواية بقلبي، بحس خاص جداً، كانت أحداثها تسكنني منذ سنوات، وهي مرتبطة، ليس بشكل مباشر، بأشخاص شكلوا جزءاً مهماً في حياتي منذ الطفولة. كل شخصية روائية في «منام القيلولة» لها معادلها الاجتماعي لكنها كُتبت بشكل أدبي بكل ما في الأدب من نزعة التخييل والمسخ والتحوير والاختراق.

تتشكل الرواية إلى قسمين متداخلين في تناوُب وتناغُم؛ قسمٌ سمعتُ جلَّ وقائعه أو رُوي لي، وهو القسم الخاص بزمن الثورة المسلحة، حيث الحديث عن الخيانة الوطنية وخيانة الصداقة، وفيها أردت أن أقول إن التاريخ هو من صناعة البشر، والبشر مُعرضون للضعف ولارتكاب الأخطاء الصغيرة والكبرى، والثورة لها منطقها المتميز بالعنف والخوف والشجاعة، كل هذه القيم تتقدم معاً مختلطةً ومتنافرةً ومتقاطعةً، وهذا هو الجو الذي يتشكل فيه شقاء وعي المناضل.
أما القسم الثاني من الرواية فقد عايشته وعشته، وفيه أعرض بعض شخوص تشبه بعض الذين قاطعتهم في حياتي، ولكنهم سردياً خرجوا وتحرروا من الحالة الواقعية ولبسوا لبوس الشخوص الروائية، وهم من يمثلون الجيل الجديد في ظل الاستقلال وشكل الدولة الوطنية وما عاشته من تقلبات سياسية وحروب أهلية.
* يُحيل عنوان روايتك «الأصنام» إلى ميراث مجازي من التطرف والتحجّر، ثم سرعان ما يحملنا إلى فضاء الرواية المكاني وهو مدينة «الأصنام». حدِّثنا عن هذا التراوح بين المجاز والمكان.
- أحياناً يكون العنوان هو النقطة التي تتشكل منها الرواية ككرة الثلج، تُحيل كلمة «الأصنام» إلى بُعدين مركزيين؛ الأول يرمز إلى هذه الأصنام السياسية والدينية الجديدة التي نُصبت في المؤسسات وأصبحت بديلاً عن الله وتتكلم باسمه وبديلاً عن الوطن وتتكلم باسمه، والبعد الآخَر هو الإحالة إلى مدينة «الأصنام» التي توجد في الغرب الجزائري، التي أصبحت تسمى اليوم «شلف»، وتغيير اسمها جاء جراء تخريجات شعبوية دينية وسياسية أفتت بها «أصنام» السياسة والدين في ثمانينات القرن الماضي، حيث تعرضت المدينة لزلزال مدمر، ففسرته «الأصنام» الدينية والسياسية الشعبوية على أن الله ضرب المدينة بهذا الزلزال بسبب اسمها الذي تحمل والذي يُحيل إلى الشرك والكفر ويضرب وحدانية الله.
بهذا المعنى فالمكان في الرواية ليس حيادياً بل هو جزء من إشكالية الرواية، وهو يحيل إلى مستوى زيف الوعي التاريخي الجمعي، اختياره له دلالاته السياسية والحضارية والعقلية.
* تحاورت عبر التخييل الأدبي مع القصة التاريخية الأولى للقتل «قابيل وهابيل» ووضعتها في سردية مضادة في روايتك. ما الذي ألهمك لتطوير تلك المعارضة الأدبية؟
- سبق لي أن نشرت رواية بعنوان «حر بن يقظان»، وفيها أقمت معارضة فلسفية لقصة «حي بن يقظان» لابن طفيل، وهي أيضاً قريبة من معارضة رواية «روبنسون كريزوي» الفرنسية، حاولت بها أن أقول إن «الحرية أسبق من الحياة والوجود»، لذا استبدلت بـكلمة «حي» كلمة «حر».
وفي رواية «الأصنام» حاولت مقاربة فلسفة الأخوة التي لم يُكتب عنها إلا القليل جداً، عدت للحكاية التي وردت في الكتب السماوية الثلاثة عن قابيل وهابيل، وكيف كانت أول عملية إجرامية في التاريخ، لكني عكست الحكاية وبنيت علاقة عشق بين الأخوين مهدي وحميميد، وكيف أن الأخ الأصغر يعطي حياته للمخاطر والأسفار والحروب بحثاً عن قاتل أخيه والانتقام منه.
* الحِس الساخر بارز كأداة نقدية في أعمالك، كالقبض، مثلاً على والد البطل في رواية «الأصنام» بسبب اسم ابنه...
- السخرية سلاح مُقاوم، في رواية «الأصنام» اشتغلت على السخرية التي تكشف مستوى الرقابة والقمع الممارَس على المواطن، فحتى الأسماء يمكنها أن تكون سبباً في توقيف وسجن مواطن بسيط، ومن ذلك أن الأب يتم سجنه لسبب بسيط هو أنه سمى ابنه الذي وُلد يوم الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد هواري بومدين ضد الرئيس أحمد بن بلة، سمَّاه باسم حميميد، وهو الاسم الذي كان يُطلق على الرئيس أحمد بن بلة. وفي السجن يتعرف على «الصرصور» الذي يرافقه في زنزانته ويكسر عنه وحدته ويصبح صديقاً حميماً له، ويظل قلبه مشدوداً له حتى بعد خروجه من السجن.
* في أعمالِك انشغال بصوت العائلات وتتبع أصواتها ومآلاتها، ما أكثر ما يؤرقك في سيرة الأجيال الجزائرية المتلاطمة بين تيارات الاستعمار والتحرر والثورات؟
- العائلة مؤسسة بقدر ما هي قامعة هي في الوقت نفسه مورِّثة لمجموعة من التقاليد تتناولها الأجيال. إنَّ الحرية لا يمكنها أن تُفهَم وتُدرَك إلا داخل الأسرة؛ فالعلاقة بين الأب والزوجة، بين الأب وابنته، بين الأخ وأخته هي مقياس أساسي لفهم الوعي الجمعي لحرية المرأة، والخطابات بين أفراد العائلة تعكس في مفرداتها كثيراً من اللامسكوت عنه واللامفكَّر فيه، لذا جاءت رواياتي، وبالأساس روايتا «الأصنام» و«منام القيلولة»، تكتب التاريخ والمجتمع من خلال تفكيك سلّم العلاقات ما بين أفراد العائلة، وفيما بينهم وبين المحيط الذي يعيشون فيه. فالأسرة تشبه في بنيتها هرم بنية السلطة السياسية بشكل واضح.
* يبدو التراث جلياً في تفاصيل أعمالك، كتلك المقاربة في عنوان «الساق فوق الساق في ثبوت رؤية هلال العشاق»، وتُصدِر إحدى رواياتك برثاء المهلهل بن ربيعة لشقيقه كُليّب... حدِّثنا عن علاقتك بالتراث العربي؟
- أعدّ نفسي قارئاً نهماً للتراث العربي والإسلامي ومهتماً به، التراث المكتوب والشفوي على حد سواء، ولكن يجب أن ننظر إلى تراثنا، ونتعامل معه، في علاقته مع التراثات الإنسانية الأخرى حتى تتجلى لنا الصورة الناصعة فيه والمتردية أيضاً، لأن التقوقع حول تراثٍ وطنيٍّ والزهو به كثيراً قد يُسقطنا في مرض الاكتفاء بالذات. حين اكتشفتْ الإنسانية قيمة كتاب «ألف ليلة وليلة» تبناه الجميع، لا لأنها من هذه الهوية أو تلك، ولكن لأنها تعكس إبداعاً خالداً يمس البشرية جمعاء.
في تراثنا الجزائري أسعدُ دائماً بقراءة «الحمار الذهبي» لأبوليوس، وأيضاً «مدينة الله» للقديس أو أوغسطين وغيرهما، ويثيرني أيضاً التراث الأمازيغي الذي هو وعاء حقيقي لذاكرة البلاد، كما أقرأ الجاحظ وأعدّه معلم الحكاية، وأقرأ المعرّي «رسالة الغفران» وأعدّه مُعلم الجرأة.
* تحمل أعمالك رؤية آيديولوجية ونقدية، هل يصعب على الروائي صاحب الموقف أن يُحيّد نفسه وموقفه وهو يكتب الأدب، أم أن الحياد هنا نزعٌ لصوته الخاص؟
- الكاتب له قناعة فلسفية وسياسية واجتماعية، وبالتالي لا كتابة خارج هذه القناعة، لكن يجب النظر إلى هذه العلاقة بشكل مُعقد وليس ميكانيكياً، فالفن ومنه الأدب لا يعكس قناعة الكاتب بشكل آلي ولكن الكتابة الإبداعية تقول تلك القناعة بقناع جمالي مُعقد ومركّب إنْ على مستوى اللغة أو من خلال تحليل نفسيات الشخوص الروائية أو من خلال البناء السردي نفسه، الرواية تحتاج إلى قول الآيديولوجيا جمالياً وتلك هي مغامرة الكتابة والتحدي الذي عليها مجابهته.
* كيف تتأمل المسافة بين اللغتين العربية والفرنسية؟ ما الذي يجعلك تختار الفرنسية لكتابة رواية؟
- أكتب باللغتين العربية والفرنسية في انسجام منذ ثلاثين سنة. نشرت 15 رواية باللغة الفرنسية، بعضها يدرَّس في كثير من الجامعات الأوروبية المختلفة، ونشرت 15 رواية باللغة العربية. تربطني باللغة علاقة شخصية-ذاتية أكثر منها موضوعية، لكل كاتب لغته، وما أُصر عليه هو أنني لا أخون قارئي في اللغتين. ما يشغلني بالعربية هو ذاته ما يشغلني بالفرنسية، والإشكالات التي أكتبها لا تفرِّق بين هذه اللغة وتلك.
حين أبدأ كتابة العمل الروائي تسكنني حالة سيكولوجية لغوية غير مفسَّرة، فأجدني أكتب من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار، ثم أغرق في شهوة الكتابة بهذه اللغة أو بتلك. ما يُفرق بين الكتابة باللغتين هو القارئ، فالقارئ بالفرنسية له تقاليد قبول كل الموضوعات والإشكاليات، لا تابوه في رأسه، وهذا ناتج عن علاقته بنصوص روائية فرنسية أو مترجمة إلى الفرنسية كُتبت في ظل حرية كبيرة وسقف قبول عالٍ، أما القارئ بالعربية، وإن كنا نلاحظ تغيرات كثيرة طرأت عليه أخيراً فإنه لم يتخلص من نصب المحاكَم للروائيين في كثير من المرات، هي في غالبيتها محاكم أخلاقية أو دينية لا علاقة لها بالأدب، وهذا العطب في الفهم وفي المفاهيم قادم من مناهج المدرسة والجامعة التي تحتاج إلى مراجعة جوهرية.