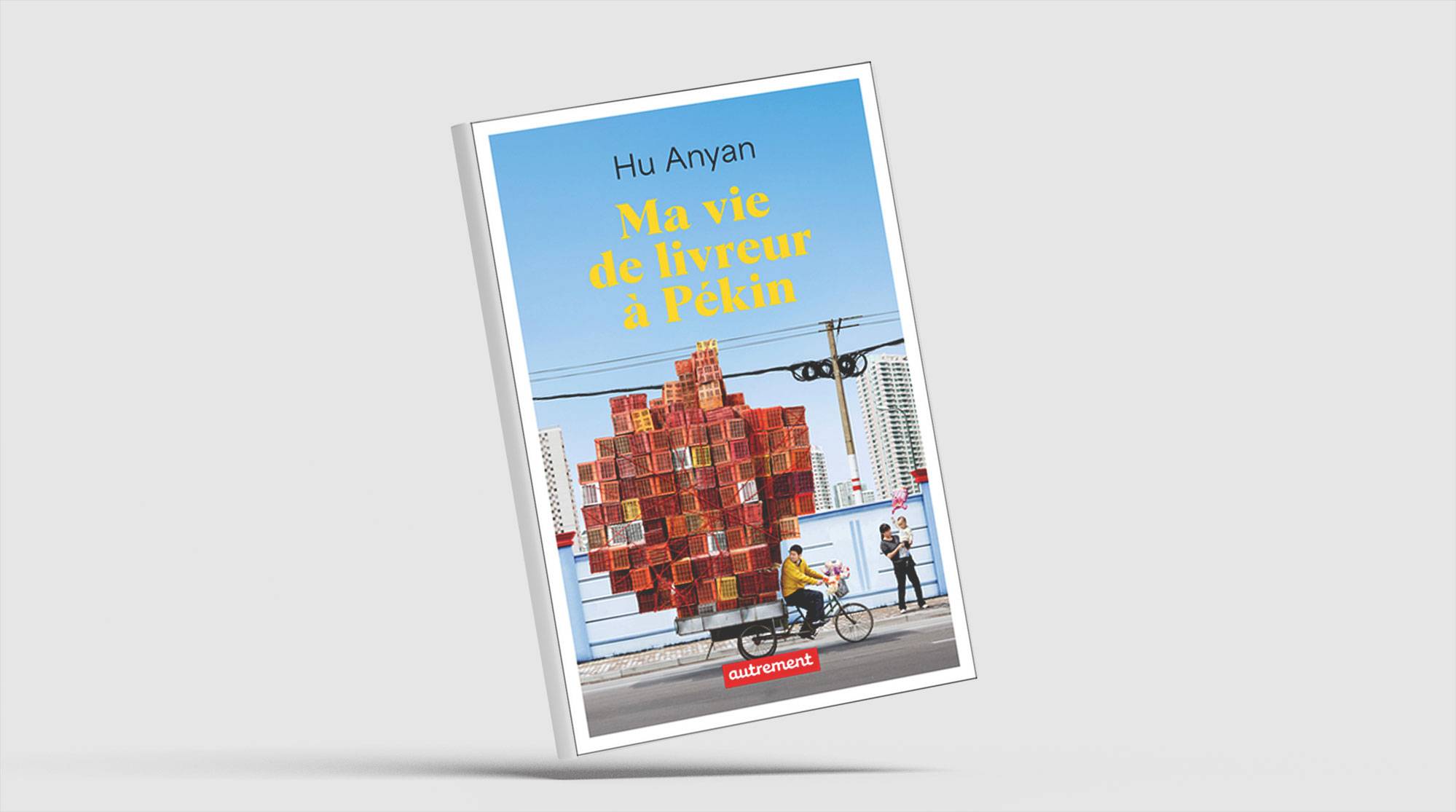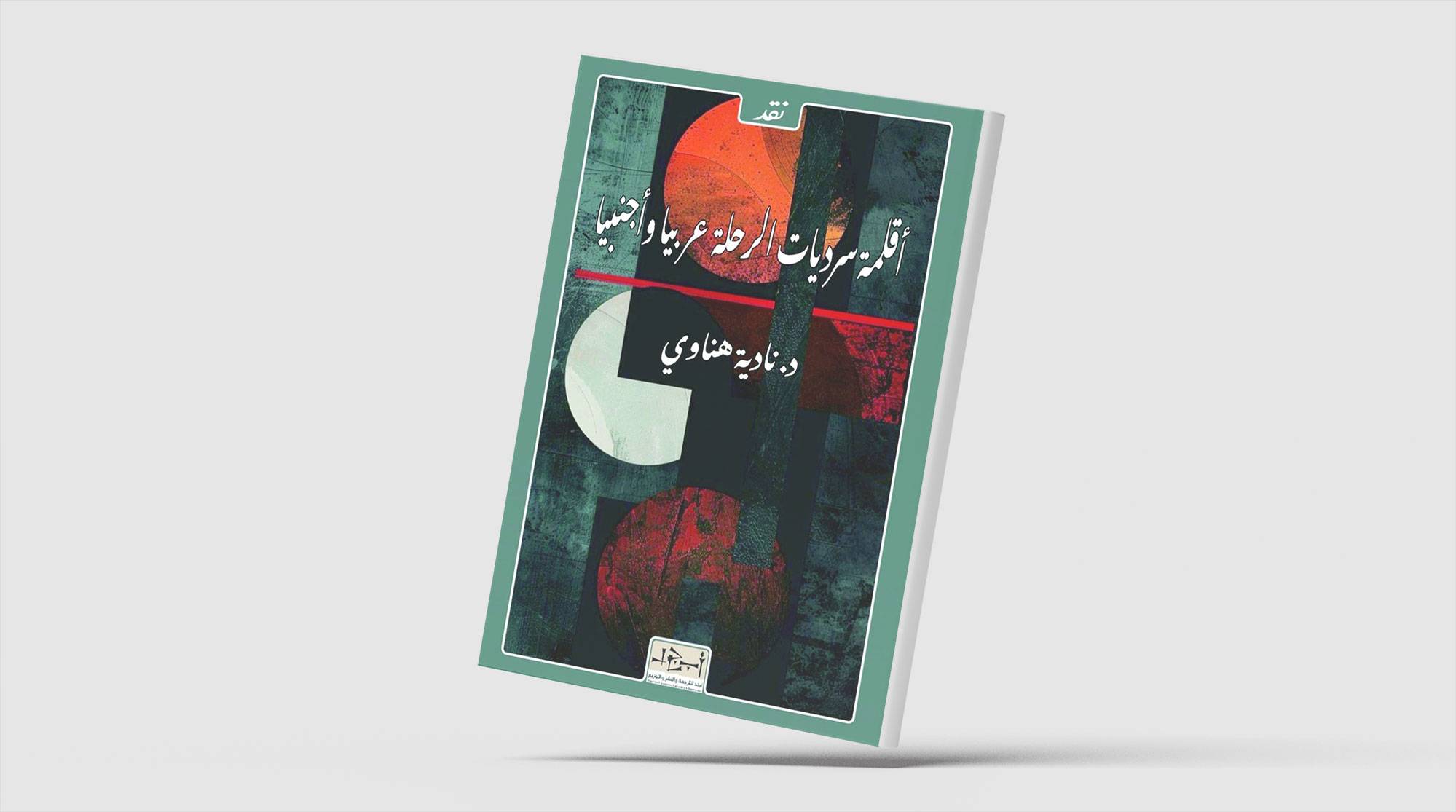بدأت الحكاية في أبريل (نيسان) 2020. كان زمن الحَجْر وغلبة العزلة، حين لمحت الصحافية اللبنانية جودي الأسمر تجّاراً في منطقتها طرابلس الشمالية يدّعون الالتزام بالإغلاق العام، وفي الواقع يواربون. من أجل اللقمة، مارسوا أشغالهم بالخفاء وواصلوا الاحتكاك بالآخرين. حرَّضها المشهد على إعداد تحقيق، ليس وشايةً، بل للسؤال عن كيفية عيش الفقراء تحت الظرف الضاغط. لفت العمل الصحافي لبنانيةً مُهاجرة في تكساس الأميركية، تُدعى مايا مسيكة، فسألت صاحبته إذا كان «بالإمكان توظيف الثقافة في خدمة المجتمع». شعور جودي الأسمر بأنها «مدانة»، حرَّك سؤالها عن دور الثقافة، وأنها لِمَ تُسلَخ عن محيطها الاجتماعي، وليست مقيمة في برجها العاجي. إصرارها على نقض هذا «الافتراء»، كان وراء ولادة كتاب «حكايا لبنانية في الأزمة» الذي صدر عن «جروس برس ناشرون»، وهو مؤلف من 15 قصة قصيرة كتبها لبنانيون مقيمون ومغتربون، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
تقول الشريكة المؤسِّسة للمشروع، جودي الأسمر، لـ«الشرق الأوسط» إنّ التجربة «غنية»، فقد حافظت على جنس القصة الأدبي، ولم تنزلق إلى الخاطرة. وتولّى المساهمون الـ15 «وهم أصحاب محاولات تشير إلى ملكة الكتابة، سواء على شكل إصدار سابق أو نصوص نُشرت في مواقع إلكترونية جادّة، أو جوائز أدبية دولية حصدوها من لبنان وفرنسا وإيطاليا» تولّوا اختيار المَحاور، مع تعمُّد تفادي نصوصهم التجارب المحض شخصية، ومحافظتها على ما يربطها بمآلات الأزمة اللبنانية.

شكَّل الوباء مُحرِّك القصص وأرضيتها. إنها ليست مجرد حكايا، كما تضيف جودي الأسمر، يمكن أن تنطوي بطيّ تلك المرحلة وإحالة مشهدياتها على الماضي. بل «استحقاقات إنسانية مطروحة عبر سرد شيّق، يمرُّ على زمن الجائحة الصعب ويتجاوزه إلى ما هو شديد التأزُّم اجتماعياً وإنسانياً».
ولكن لماذا الأزمة اللبنانية؟ تنقل جودي الأسمر، الناشطة في العمل الاجتماعي، والحائزة على ماجستير في الأدب الفرنسي، ما كتبته في المقدّمة: «في غمرة التحضير للكتاب، وتحديداً خلال مرحلة من الهبوط المعنوي، آنسنا رأي للروائي إلياس خوري خلال إلقائه محاضرة في بيروت بعنوان (الرواية بعد الحرب). كان يُنبّه إلى خسارة الأدب لحظات تاريخية غيَّرت وجه لبنان، لكنها غير حاضرة في سجلنا الأدبي. عرَّج على حروب وأزمات لم تُكتَب، لا شعراً ولا نثراً، فلم تتناولها سوى بعض المذكرات وخطابات الطوائف وبعض الإشارات الضعيفة في الأدب اللبناني. بقيت هذه المحطات جزءاً من تراث قائم على المحو».
أخافتها فكرة محو رواية «كورونا» والأزمات اللبنانية التي سبقت الوباء وتلته، فشعرت الأسمر بإضاءتها على «جزء جديد من مسؤولياتنا». بدت تحريضاً على ولادة هذه المحكيات المستوحاة من واقع أزمة تواصل التفاقُم في لبنان بمتوالية هندسية منذ خريف 2019، وفق الوارد في السطور الافتتاحية.

ومن هنا ضرورة أن تتشكَّل روافد ثقافية واجتماعية تُسهم في بلورة المخيال الشعبي للأزمة اللبنانية، بأقلام مَن عاصروا الأزمة؛ وجمعتهم الرغبة في التعبير عن ذلك الانغماس الموجع. فنقرأ عن حامل من الجنسية السورية تضع مولودها وسط التأزُّم الصحّي، فتموت ليحيا. ونقرأ عن قسوة العنف الزوجي بعدما أثَّر الحَجْر في مفاقمته، وعن التعليم الإلكتروني وصعوباته، وتنمّر هشَّم ثقة أطفال بقدراتهم.
15 حكاية تفاوتت ظروف كتابتها بين المساهمين، خصوصاً مَن هم في المهجر، فعكسوا من خلالها «ملازمة الوجع اللبناني لأبنائه خارج البلاد أحياناً، كما في داخلها، أو ربما على نحو أشدّ قد يكرّسه الشعور بذنب النجاة مما يعيشه المقيمون»، كما تقول جودي الأسمر. وبالنسبة إليهم، قد يتّفق مع تلك القصص وسم «وُلدت في المهجر، نُشرت في لبنان». وتتشعب موضوعات هذه الحكايا لتشمل مختلق القضايا الإنسانية: آلام أطفال الشوارع، والفقر الأسري، واضطهاد العاملات الأجنبيات، وانفجار المدينة، وأحوال السجين اللبناني المقتول بالوباء المتفشّي والإهمال المُتعمَّد، وأشكال تدهور الصحة النفسية، وأشدُّها تطرفاً كالانتحار.
محكيات مستوحاة من واقع أزمة تواصل التفاقُم في لبنان بمتوالية هندسية منذ خريف 2019
تستوقف الأسمر آنية المادة الصحافية وراهنيتها المفرطة، مما يُعطي للمقالة مدّة صلاحية محدودة «قد لا تتجاوز الدقائق القليلة في فضاء الدفق الرقمي». وبيَّن لها عملها الميداني والخطاب المُلقى في الفضاء العام، تذمُّر كثيرين من عناوين مثل العنف ضدّ المرأة أو التنمّر والاغتصاب. ذلك عزَّز يقينها بأنّ القالب القصصي يوظّف الخيال في تضميد معاناة الواقع، مُحقِّقاً الأثر المُضاعف. وهي تستعيد في المقدّمة تجارب أدباء كبار حملوا جذوراً صحافية مثل ماركيز وهمنغواي وكامو، لكنّ الأدب ظلَّ أفضل أشكال تعبيرهم عن الحقيقة.
يعكس الغلاف من تصميم ثراء قبطان تماسُك اللغات الثلاث مع الحفاظ على الروح الفريدة لكل قصة. وقد أبرز استخدامه الكولاج والتلاعب بالصور، قوة لبنان وقدرته على الصمود. وعبر مزيج صور المنازل اللبنانية والشوارع القديمة، ومختارات من أرشيفها، عن شعور حر بالتجوّل الحيّ في المدن والإصغاء للحكايات من كثب. أما الساعة المُجمَّدة عقاربها، فتكثّف الذهول اللبناني بعد مقتلة المرفأ، وتمهِّد لتشكيل لحظة تأمُّل تتيح تعقُّب الأمل في عمق اليأس.
من هذه المبادرة الشبابية تولد مبادرة أخرى: «يعود الريع لصيّادي طرابلس من أجل ترميم مراكبهم»، كما تذكر جودي الأسمر: «أطلقنا عليها (قوارب الحياة) كحالة مناهضة لمآسي (قوارب الموت) الممتلئة بالهاربين إلى النهايات الحزينة. نريد الكتاب مرساة أمل».