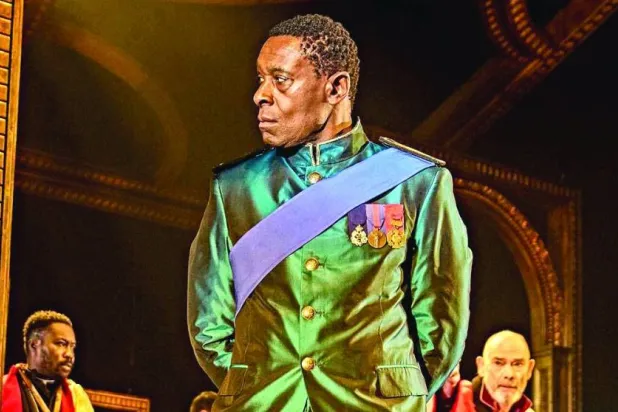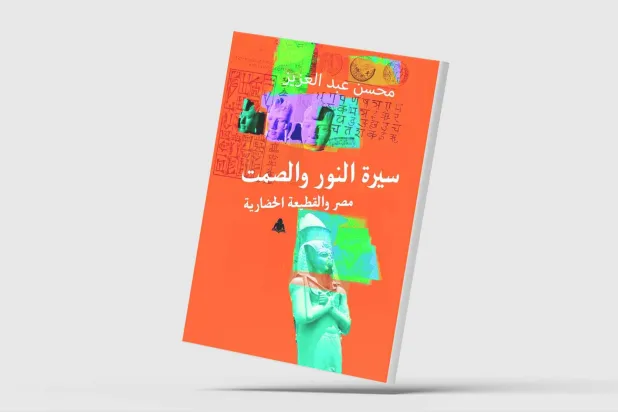قد يكون من الصعب على أي باحث في شؤون الحب والعشق، أن يتجاوز الإسهام الفريد وغير المسبوق الذي قدمه الشاعر الروماني أوفيد في معظم كتاباته، وفي كتابه «فن الهوى» على وجه الخصوص. وإذا كان الكتاب المذكور عابراً للأماكن والإثنيات والعصور، فإن الأمر ليس عائداً إلى أهمية موضوعه المتناول بالدراسة فحسب، بل إلى مقاربته الذكية لموضوعه، فضلاً عن وضوح الأفكار ونصاعة اللغة والأسلوب الساخر واتساع دائرة الخطاب الإنساني.
على أن النجاح الاستثنائي الذي أصابه أوفيد، لا يمكن أن تتم قراءته بمعزل عن الشروط الذاتية والموضوعية التي وفّر تضافرها للشاعر المولود بالقرب من روما عام 43 قبل الميلاد، لعائلة أرستقراطية مرموقة، أسباب الفرادة والتميز. فقد قُدّر للشاب الطموح والمصاب منذ يفاعته بلوثة الشعر، أن يتابع دراساته العالية في مجالات البلاغة والأدب والقانون. كما وفر له تسنمه سدة القضاء في روما لسنوات عدة، سبل «الوصاية» على العشاق، وإسداء نصائحه وتوجيهاته لكل راغب في تنكب المغامرة العشقية.

ولعل النجاح البالغ الذي لقيه «فن الهوى» في أوساط المجتمع الروماني عشية ظهور المسيح، لا يعود إلى موهبة مؤلفه البحتة فحسب، بل إلى كون أوفيد قد كتبه في سن النضج تماماً؛ حيث كان قد اكتسب مع بلوغه الأربعين قدراً غير قليل من الخبرات والتجارب الشخصية التي أحسن استثمارها ووضْعها بين يدي قرائه ومتابعيه. وهو أمر لم يكن ليتيسر له تحقيقه لو كان قد وضع كتابه في سن العشرين. ومن يتتبع فصول الكتاب المختلفة لا بد أن يلاحظ أن مؤلفه لم يكن يريد في تصديه لموضوع الحب أن يحذو حذو التراجيديات الإغريقية التي يتسلط القدر على المشاركين فيها، أو أن يتبع مسار الحب الروحاني الصوفي الذي لا ينال الجسد من خلاله أي نصيب، بل رأى إلى الحب بوصفه نوعاً من المتعة واللهو واللعبة الماكرة، الذي جهد في أن يضع لها أصولاً وقواعد.
وينوه أوفيد في مقدمة الكتاب إلى أنه أراد أن يضع خبرته وعمله المضنيين في خدمة الشبان والشابات من الأجيال كافة، لكي يساعدهم على تجاوز مكائد الحب وآلامه وعثراته، بأقل تكلفة ممكنة. كما يوضح لقرائه أن فينوس هي التي اختارته كشاعر، لكي يكون وصياً على ابنها المتحفز على الدوام لإطلاق سهامه الجارحة على العاشقين. وإذا كان قد قرر الانتقام من كيوبيد، فلأن سهامه المسمومة كادت أن تصيبه في مقتل، ذات حب جارف.
ويخصص الشاعر الجزء الأول من كتابه لإرشاد الشبان المتعطشين للحب إلى الطرق المثلى للإيقاع بالنساء، معتمداً على خبرته الشخصية وثقافته الواسعة وذكائه المتوقد. وهو إذ يستثني من استهدافاته النساء الحرائر المحصنات، فلأنه كان خائفاً من بطش الإمبراطور، رغم أنه يستطع دفعاً لهذا البطش في نهاية الأمر. وحيث يعدُّ أوفيد أن الفرق ليس شاسعاً بين الحب والحرب، أو بينه وبين الصيد، فهو يطلب من الرجل أن يحدد نوع الطريدة التي يلاحقها، لأن الفخاخ والأسلحة التي تنجح في تصيد امرأة من طراز ما لا تفلح في تصيد امرأة من طراز آخر، رغم أنه يرى في معظم النساء نقاطاً من الضعف تمكّن الرجل العاشق من الظفر بهن في نهاية المطاف.
وأوفيد الذي يُظهر معرفة واسعة بعلم نفس المرأة، لا يرى معظم حالات التمنع بوصفها رفضاً قاطعاً للرجل العاشق، بل يرى فيها اختباراً لنياته، ووسيلة ناجعة لإذكاء رغبته. ولأن نساءه المعنيات بالمخاطبة لسن أبداً من بائعات الهوى الساقطات، بل من الشرائح الاجتماعية الموزعة بين المحافظة والتحرر، فهو يوصي الشبان باستخدام المعرفة والاطلاع والأجوبة الحاذقة كأداة ناجعة للاستحواذ على إعجاب معشوقاتهن المستهدفات. كما أنه يحذر الرجال من الجمال الخادع الذي تظهر عليه النساء في حالة الشراب أو تحت أضواء المصابيح الخافتة، داعياً كل شاب طامح للفوز بقلب امرأة إلى تجاوز مخاوفه، بالقول:
المرأة في كل مكانٍ صيدٌ سهل
انصب شرَككَ وكفى
تغريد الطير قد يسكن في كل ربيع
وصرير الجندب قد ينقطع في الصيف
لكن المرأة لا تصمد
إذا انساب في أذنيها معسول الغزل
إلا أن أوفيد العارف بطباع المرأة ودواخلها يؤكد في الجزء الثاني على أن المحافظة على الانتصار أصعب من بلوغه. فالأهم في عملية العشق ليس الوصول إلى قلب المرأة، بل العمل المضني للبقاء في صميمه؛ حيث الحظ يلعب لعبته في البدء، بينما لا بد لاحقاً من استخدام الحذق والمهارة. وهو يشير إلى أن الغاية من كتابه لم تكن تلقين الأغنياء فنون الهوى، لأن أموالهم الطائلة تتكفل وحدها بإغواء من يشاؤون، مؤكداً أنه أراد الانتصار لحق الفقراء في الحب، وتزويدهم بما يحتاجونه من عدة المغامرة ومستلزماتها. وهو يدعو العشاق العازبين إلى ترك الأزواج والزوجات يغرقون في شجاراتهم المتواصلة، لجعل السلوك الحاذق والغزل الطري يقومان مقام الهدايا الثمينة. فالحب والعشق لا ينموان في رأيه إلا في أرض التدليل والأصوات الناعمة والكلام المنمق.
وفيما يؤكد أوفيد أن في كلمات الإطراء الشاعرية ما يغني العاشق عن تقديم المال لمعشوقته، يعود ليسخر من كلمات الغزل التي لا تُسمن ولا تغني من جوع، فيهتف بعاشقه الفقير قائلاً:
هل أنصحك بأن ترسل أشعاراً عاطفية؟
واأسفاه، فالشعر عظيم، لكنه لن يلقى ما يليق به
فهي قد تمتدح قصيدك
لكنّ أثمن ما تَنشدُهً هو ما تُهديه إليها
فلا تعجب إن نال الهمجي الأحمق
إعجاب فتاتكَ ما دام غنياً
أما الجزء الثالث من الكتاب فيكرسه المؤلف لتزويد النساء بالوسائل الناجعة التي تكفل لهن الاستحواذ على قلوب الرجال، وتجنب الكساد المحبِط والعنوسة البائسة. وهو إذ يخاطب النساء بقوله «ليس من العدل أن أعرّضكنّ عزّلاً من السلاح أمام عدو كامل العدة»، يرى أن على الرجال أن يشكروه على فعلته، لأنه لا يليق بهم الانتصار على كائنات ضعيفة ومجردة من السلاح. وهو لا يتردد في إطلاع المرأة على قواعد السلوك المثلى مع الرجل، وحثها على العناية بمظهرها وحماية جمالها من التلف دون مبالغة أو أفراط. ويحذر المؤلف النساء من تصديق الرجال المخادعين، من ذوي الشعور الممزوجة بالطيب والمفرطين في التزين بالخواتم، فقد يكون أشدهم أناقة لصاً لا يهيم بالمرأة لذاتها، بل بما تملكه من أموال.
أراد أوفيد أن يساعد الشباب على تجاوز مكائد الحب وآلامه وعثراته
وعلى المرأة الذكية في رأيه ألا تنام على حرير العهود التي يقطعها فتاها العاشق على نفسه، وأن تجهد في إثارة غيرته والإيحاء بأن ثمة من ينافسه على قلبها، حتى ولو كانت الحقيقة خلاف ذلك. كما ينصحها بأن تلعب على الحبال الفاصلة بين التمنع والوصال، لأن المرأة التي يظفر بها عاشقها بغير عناء، لن تكون أحبَّ النساء إلى قلبه. وهو يشعر بالرضا عن نفسه لأنه وقف في منطقة وسط على حلبة المنازلة الدائمة بين الرجال والنساء.
ولا بد من التنويه أخيراً بأن صمود «فن الهوى» في وجه الزمن لم يكن ليحدث لولا قدرة مؤلفه على المواءمة بين الشاعرية العالية وغزارة الثقافة، ولولا نفاذه البارع إلى الأعماق الأخيرة للنفس الإنسانية. وإذا كان «طوق الحمامة» قد عُدَّ أحد أكثر الكتب شبهاً بكتاب أوفيد، فإن السؤال المتعلق بأسباب ذلك التشابه يكتسب الكثير من المشروعية. فهل كان ابن حزم، المتصل عبر الأندلس بالثقافة الغربية، قد قرأ أوفيد وتأثر به؟ وهل كان كتابه المتأخر ألف سنة عن سلفه الروماني، نوعاً من التناص المقصود مع المرجع الأصلي، أم أن التشابه بين «مفتيي» الحب اللذين عمل كلاهما في سلك القضاء كان ضرباً من ضروب المصادفة التي يمكن إضافتها إلى مصادفات الزمن وغرائبه الكثيرة؟