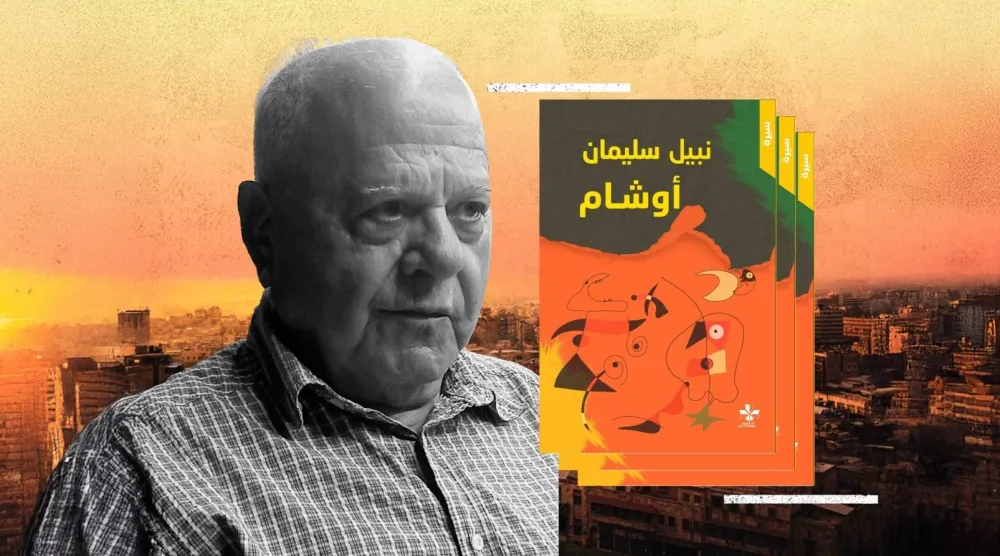لماذا كانت القافية والتكرار والروي من الأمور المهمة في الشعر؟ ما الفرق بين شكل سوناتة (قصيدة من أربعة عشر بيتاً) للشاعر الإيطالي بترارك، وسوناتة بالعدد نفسه من الأبيات للشاعر الإنجليزي شكسبير؟ لماذا تُعد قصيدة ت. س. إليوت «الأرض الخراب» من أهم وثائق الحداثة في شعر القرن العشرين؟ هذه وغيرها أسئلة يجيب عنها «كتاب الشعر» (The Poetry Book) الذي يمثل جهداً جماعياً، إذ لا يحمل اسم مؤلف أو محرر، وإنما اشترك في وضعه ثلاثة عشر ناقداً وباحثاً وأستاذاً جامعياً، وصدر في لندن خلال العام الماضي 2023، عن دار «دورلنج وكندرسلي» للنشر في 336 صفحة، في إخراج طباعي جميل مُحلى بصور ملونة تضم صوراً فوتوغرافية لعدد من الشعراء وأغلفة دواوينهم، ولقطات من أفلام، ولوحات من الفن التشكيلي بريشة كبار الفنانين.
يقدم الكتاب أهم نماذج الشعر العالمي بمختلف اللغات، شرقاً وغرباً، منذ ملحمة جلجامش السومرية، من الألفية الثانية قبل الميلاد حتى يومنا هذا. وينقسم الكتاب زمنياً إلى ستة أقسام تحمل هذه العناوين: أساطير وأبطال، عالم العصور الوسطى، الإحياء والميلاد الجديد، العقل والجليل، العصر الحديث، حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية والحقبة المعاصرة، مع نماذج من شعر كل قسم.
أساطير وأبطال (نحو 2100 ق.م - نحو 700 م)
تمثل هذه الحقبة طفولة الإنسانية وخطوها نحو الرشد، وتجسد ميل الإنسان الغريزي إلى الحكي والجمع بين معطيات الواقع وسبحات الخيال. وقد وصلتنا آثارها في هيئة لوحات طينية من بلاد ما بين النهرين، وصلوات وترانيم وأهازيج فولكلورية من الصين، وملحمة مهابهاراتا السنسكريتية، وملحمتيْ هوميروس «الإلياذة» و«الأوديسا»، وقصائد سافو أول شاعرة إغريقية عظيمة، وأناشيد الشاعر الإغريقي بندار، وأناشيد الشاعر اللاتيني هوراس، وسفر «نشيد الإنشاد» في «العهد القديم» من الكتاب المقدس، وكتاب «التحولات» (أو «مسخ الكائنات» بترجمة الدكتور ثروت عكاشة) للشاعر اللاتيني أوفيد.
من أقدم هذه الآثار ملحمة جلجامش التي تحمل اسم بطل سومري كان ملكاً على مملكة أوروك، بعد طوفان اجتاح الأرض (للملحمة ترجمة عربية بقلم طه باقر، وأخرى بقلم عبد الغفار مكاوي). عندما بلغ جلجامش طور الرجولة، استعاد مملكته بعد حصار طويل. واتسمت الفترة الأولى من حكمه لها بالصرامة والقسوة فجلب له سكان المملكة رجلاً يُدعى إنكيدو كي يصرفوه عن البطش بهم. ونشأت صداقة عميقة بين الرجلين، كانا يذهبان معاً إلى الغابات لقطع الأشجار كي يزوّدا المدينة بما تحتاج إليه من أخشاب. ولكن الكوارث لا تلبث أن تنهال على المدينة، خصوصاً بعد أن بعثت الإلهة عشتار بثور السماء الذي يتسبب في جفاف الأرض سبع سنوات. ويلقى إنكيدو مصرعه فيضحى جلجامش وحيداً. وينطلق باحثاً عن حكمة الأسلاف، ويخوض عدة مغامرات قبل أن يقفل راجعاً إلى مملكته.
عالم العصور الوسطى (نحو 700 م- 1450 م)
غلب الطابع الديني - إلى جانب قصائد البطولة والفروسية - على شعر هذه الفترة. وضمت ملحمة أنجلو-سكسونية عنوانها «بيولف» عن بطل يصرع وحشاً بحرياً، وقصائد صينية من عصر أسرة تانج الملكية في القرن الثامن، وقصائد يابانية، وأشعار التروبادور في بلاط الأمراء الإقطاعيين في جنوب فرنسا وأجزاء من إيطاليا وإسبانيا، وترانيم دينية في مدح السيدة العذراء مريم والسيد المسيح، وغزليات الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي، وقصيدة دانتي «الكوميديا الإلهية» بأجزائها الثلاثة (الجحيم، المطهر، الفردوس)، وقصيدة تشوسر القصصية «حكايات كانتربري».
وفي الصين أخرج الشاعر لي باي قصيدته المسماة «قتال» (نحو عام 750 م) في عصر أسرة تانج الملكية (618- 907) وهو العصر الذهبي في تاريخ الفن والأدب في الصين. وكان لي باي - وكذلك صديقه دوفو- أبرز شعراء ذلك العصر، كتبا عن الصداقة والأسفار وعن خبراتهما الشخصية.
كان لي باي من رجال الفعل قبل القول؛ فهو فارس بارع في المبارزة والصيد وركوب الخيل. ولكنه - وهنا المفارقة - كتب قصيدته «قتال» ليدين الحرب ويبين ما تنطوي عليه من غباء وقصر نظر، وكيف أنها لا تخلف إلا جثثاً: «الغربان والصقور تنقر أحشاء الآدميين/ وتحملها معها في مناقيرها». فالحرب عنده عقيمة بلا معنى لا بطولة فيها.
الإحياء والميلاد الجديد (1450- 1700)
هذا هو عصر النهضة الأوروبية الذي شهد إحياء لآثار الإغريق والرومان، وازدهاراً للفنون من تصوير ونحت وموسيقى. وأهم معالمه ملحمة «جنون أورلاندو» للشاعر الإيطالي آريوستو، وحركة الإصلاح الديني البروتستانتي التي قادها مارتن لوثر ضد البابوية الكاثوليكية، وازدهار المسرح في عصر الملكة إليزابيث على أيدي كريستوفر مارلو وشكسبير وبن جونسون، وترانيم القديسة تريزا الأبيلية في إسبانيا، وظهور أول شاعرة أمريكية في العالم الجديد هي آن برادستريت في القرن السابع عشر، وملحمة ملتون «الفردوس المفقود»، وقصائد الهايكو (شعر غنائي من سبعة عشر مقطعاً) للشاعر الياباني باشو.
وتبرز في هذه الفترة ألغورية (أمثولة رمزية) شعرية للشاعر الإنجليزي إدموند سبنسر هي «ملكة الجان» (أو بترجمة لويس عوض: «الملكة الحورية») (1552- 1599). وملكة الجان رمز للعذرية والنقاء يقصد بها الشاعر هنا الملكة إليزابيث التي لم تتزوج ولم تعقب ولداً. ويعمد سبنسر إلى التوفيق بين الأضداد: الماضي والحاضر، والوفاق والشقاق، الخير والشر، الزمن والأبدية، النور والظلمة، مستخدماً منهج القص الرمزي ومستوحياً العديد من المصادر الأدبية: «تحولات» أوفيد الأسطورية، ومواضعات الشعر البطولي، والرومانثه (قصص العاطفة والمغامرات).
العقل والجليل (1700- 1900)
القرن الثامن عشر هو عصر التنوير الذي حمل لواءه رجال من طراز كانط وجوته في ألمانيا، وفولتير وروسو وديدرو ومونتسيكو في فرنسا، وإدوارد جبون وألكسندر بوب وصمويل جونسون وديفيد هيوم في بريطانيا.
وقد فرق بعض مفكري ذلك العصر – كالفيلسوف والسياسي الآيرلندي إدموند بيرك - بين «الجميل» و«الجليل»، وهما في فلسفة الجمال يشيران إلى الأشياء الرقيقة المرهفة، مثل زهرة أو حلية ذهبية دقيقة الصنع من ناحية، والأشياء التي توقع الرهبة في النفس بجلالها وعظمتها مثل بحر هائج أو هوة سحيقة أو جبل شاهق من ناحية أخرى. وانعكست هذه التفرقة على الشعراء فمنهم من صور ما هو جميل مثل كيتس، ومن صور ماهو جليل مثل وردزورث.
ومن آثار النصف الأول من القرن التاسع عشر الشعرية «يوجين أوينجين» (1833) للشاعر الروسي ألكسندر بوشكن وهي رواية منظومة (حدثني الشاعر صلاح عبد الصبور يوماً أنه ينوي أن يكتب رواية منظومة، ولكن العمر لم يمتد به حتى يحقق هذه الرغبة).
العصر الحديث (1900- 1940)
شهدت هذه الفترة حربين عالميتين وصراع الآيديولوجيات ما بين رأسمالية وشيوعية ونازية وفاشية، وظهور أعمال شعرية كبيرة لإليوت وييتس وباوند، و«مراثي قلعة دوينو» للشاعر الألماني ريلكه، وقصيدة «المقبرة البحرية» للشاعر الرمزي الفرنسي بول فاليري، واستيحاء الشاعر الإسباني لوركا لموروث الأندلس وقصائد الغجر، والشعراء الأفرو- أمريكيين في هارلم بمدينة نيويورك، وقصائد و. ه. أودن التي أرَّخت للحرب الأهلية الإسبانية واندلاع الحرب العالمية الثانية.
ومن أبناء العصر الحديث الشاعر البنغالي رابندرانات طاغور أول شاعر آسيوي يحصل على جائزة نوبل للأدب في 1913. ومن أعماله التي أهلته للحصول على تلك الجائزة: ديوان «جتنتجالي» (ومعنى الكلمة: «القربان الغنائي»). يضم الديوان 130 قصيدة أشبه بقرابين تعبدية يتقدم بها الشاعر إلى الله. ولكنه يعالج أيضاً موضوعات من قبيل: الطبيعة والحب والفراغ والفقدان. ولا تخلو بعض القصائد من هجاء ساخر لنقائص البشر.
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية والحقبة المعاصرة (1940- الحاضر)
هذه خاتمة المطاف في رحلتنا مع الشعراء، شهدت هذه الحقبة ازدهاراً للشعر في أسكوتلندا وويلز وآيرلندا، والشعر الزنجي تزامناً مع سعي بلدان أفريقية إلى الاستقلال عن الاستعمار الأوروبي، وشعراً اعترافياً أميركياً لأمثال روبرت لويل وسيلفيا بلاث، وثقافة - ضد يمثلها متمردون على الحضارة الغربية - وقصائد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا النابعة من معاناتها في ظل ديكتاتورية ستالين، وروايات الكاتب النيجيري تشنوا آتشتى على وقع حرب بيافرا 1967- 1970، والشعر النسوي المتمرد على القيم الأبوية، وشعراء من منطقة البحر الكاريبي.
يمثل هذه الفئة الأخيرة الشاعر ديريك والكوت الحاصل على جائزة نوبل للأدب في 1992 وقد ولد في جزر الهند الغربية (جزر الأنتيل الصغرى) منحدراً من سلالة تمتزج فيها الدماء الزنجية والهولندية والإنجليزية. ومن أهم قصائده قصيدة «أوميروس (هوميروس)» (1990) وهي قصيدة ملحمية طويلة، غنائية الطابع تدور أحداثها في منطقة البحر الكاريبي قبل مقدم الكولينالية الغربية وفي أثنائها وبعدها. إنها صورة تجمع بين الجمال والألم، خاصة صدمة نظام الرق. وتبدأ بوصف حي لمجموعة من الصيادين تقطع الأشجار لتصنع منها زوارق للصيد.
والقصيدة مقسمة إلى سبعة كتب تضم أربعة وستين فصلاً. وكل فصل مقسم بدوره إلى ثلاثة أناشيد متفاوتة الطول، وكل أنشودة مكونة من مقطوعات من ثلاثة أبيات على نحو ما نجد في كوميديا دانتي الإلهية. والأبيات سداسية التفاعيل بمعنى أن كل بيت يحتوي على ست نبرات، والقوافي متنوعة.
وينتهي «كتاب الشعر» – أي ثروة باذخة!- بتعريفات قصيرة بأعمال شعراء آخرين مثل هسيود (اليونان)، وكاتولوس (روما)، ورونسار (فرنسا)، وهايني (ألمانيا)، وكافافي (اليونان/ الإسكندرية)، وجابر يلا ميسترال (شيلي) مع ثبت بأهم المصطلحات النقدية، وتراجم قصيرة لسير الشعراء، مما يجعل من الكتاب واحداً من أهم الإصدارات وأكثرها جاذبية - شكلاً ومضموناً - في السنوات الأخيرة.