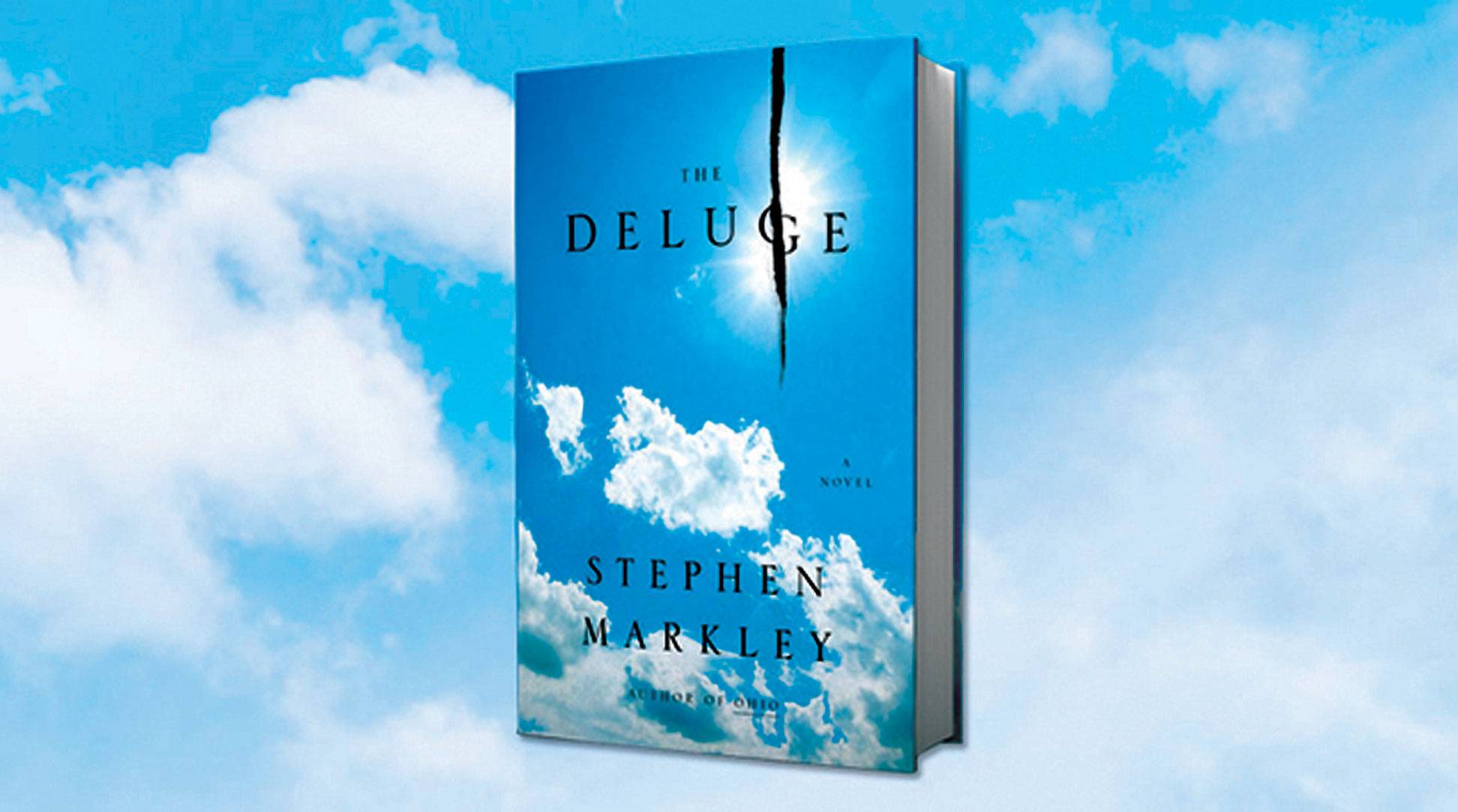ليس من الإنصاف في شيء، أن يُبالغ في مدح رواية، تعاطفاً مع صاحبها حين تكون له تجربة أليمة، كما أنه ليس من العدل، أن يغمط أديب موهوب حقه، كي لا يقال إنه وضعه الاستثنائي كان وراء الاحتفاء به.
الرواية هي «قناع بلون السماء» وصاحبها الفلسطيني باسم خندقجي، الذي أعلن أمس (الأحد)، فوزه بالدورة الـ17 للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر).
فأنت لا يمكنك أن تقرأ رواية «قناع بلون السماء» الصادرة عن «دار الآداب» لباسم خندقجي، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عشرين عاماً، إلا وتعجب بهذا الشاب الذي يكتب بعد كل هذا العمر في الأسر، رواية يتنقل فيها بين المدن وفي الأزقة، ويحيك الخطط ويعيش قصص الحب، ويحاول أن يفهم ما يفكر به عدوه، ويتفاعل معه دون حقد، دون عدوانية، وكأنه يتخفف من نفسه، حدّ التبرؤ من الذاتية. كيف لأسير لا أمل له في الحرية، محكوم بثلاثة مؤبدات، ألا يجعل ظروف الاعتقال ومأساة الحرمان من نور الحياة، جزءاً من روايته. خندقجي يكاد لا يتطرق في روايته إلى الموضوع إلا لماماً، وكأنه يعيش حريته الكاملة التي لا تنتقص ولا تمسّ، لا بل هو وجد اللعبة الروائية المناسبة، ليتفلت من فلسطينيته ويعيش في جلد إسرائيلي لبعض الوقت.
«قناع بلون السماء» تروي قصة نور الشهدي الشاب الفلسطيني الذي تخرّج في المعهد العالي للآثار الإسلامية بجامعة القدس. تبدأ الرواية وهو يسجل رسالة صوتية لصديقه مراد القابع في السجن، يخبره فيها عن رغبته في الكتابة عن مريم المجدلية. هذه هي الإحالة الوحيدة إلى الأسر والسجون، والمناسبة التي تفسح له مجال الكتابة عن بعض ما يدور في نفس السجين أو محبيه. واهتمام نور بطل الرواية كما رغبته الجارفة في الكتابة عن مريم المجدلية، تحتل بالفعل جزءاً مهماً من رواية «قناع بلون السماء»، مما يجعلنا أمام تقنية كتابة رواية داخل الرواية، خاصة أن صديقه مراد الذي يحضّر لكتابه رسالة بحثية في السجن، يطلب منه أن يجلب له بعض المراجع، تماماً كما كان يفعل باسم خندقجي نفسه، حين يطلب من شقيقه أثناء زيارته أن يوفر له مراجع لكتابة روايته التي بين أيدينا.
لكن الموضوع الأساسي، يبدأ عند عثور نور بطل الرواية على هوية إسرائيلية داخل معطف قديم اشتراه، تحمل اسم أور شابيرا. وتأتيه فكرة أن يتقمص شخصية هذا اليهودي، مستغلاً أن ملامحه بيضاء تشبه الأشكناز، مما يجعله قادراً على العبور بسهولة إلى أماكن محظورة على الفلسطينيين. هكذا يتمكن نور من الحصول على بعض حقوقه المهدورة بسبب الاحتلال والتمييز. أما العبرية التي يتقنها فتصبح بالنسبة له «غنيمة حرب»، وهو يستخدمها ليدرأ كل شبهة يمكن أن تحوم حوله. يجد نفسه، والحالة هذه قادراً على التنقل بحرية والتجول في شوارع القدس وتل أبيب كما رام الله، وحيث يشاء، دون أن يستوقفه أحد. يقول لمراد: «عثرت على قناع واسم لأتسلل من خلالهما إلى أعماق العالم الكولونيالي... أليس هذا ما يقوله صديقك فرانز فانون حول الجلود السوداء والأقنعة البيضاء؟»، لا بل هو يشعر وقد انتقل إلى شخصية أو أنه أصبح أشبه بـ«جيمس بوند».
بعد إقامة قصيرة في منزل الشيخ مرسي في القدس، وسيرة ذاتية مزورة المضمون باسم أور شابيرا، يتمكن نور من تحقيق بعض من حلمه بالالتحاق ببعثة تنقيب يترأسها البروفسور بريان، تضم أشخاصاً من عدة جنسيات، بينهم الإسرائيلية الشرقية أيالان من يهود المزراحيم، أصولها حلبية، تعجب به وإن اتهمته باستمرار بالتشاوف بسبب أصوله الأشكنازية. وضمن فريق التنقيب هذا سما إسماعيل من الداخل الفلسطيني، من حيفا تحديداً، وهي التي ستفتنه أول ما يسمع صوتها، وتوقظ فيه بفضل حسّ الهوية العالي لديها، إحساسه الكبير بالانتماء.
في مستوطنة مشمار هعيمق التي أقيمت على أنقاض قرية أبو شوشة الفلسطينية وزرعت فيها غابة لإخفاء كل أثر سابق، يدور جزء من الأحداث. هناك يقع نور في حب سما، ثم يكشف القناع عن وجهه الحقيقي، لكنها لا تصدقه، وتستغرب كيف له أن يتبنى الهوية التي أنفت منها وكافحت ضدها. لكن حين تتصاعد الأحداث في القدس، ويبدو نور على سجيته أمام سما، ويشعر الاثنان أنهما يقتربان من بعضهما بما لا يسمح بالافتراق.
التفاصيل في العمل كثيرة وباسم خندقجي مولع بهذا. لكنه ربما يتعمق ويكثر في سرد حكاية المجدلية وقضايا إيمانية مسيحية، حتى تستغرقه أكثر مما يحتمل قارئ رواية. نور في النهاية شغوف بكشف ما خفي من قصة المجدلية، يبحث دون كلل يريد أن يردّ على دان براون، وما جاء في روايته «شيفرة دافنشي» من أخطاء لا بد من تصحيحها، بينما يبحث أصحاب البعثة التي انضم إليها عن أشياء أخرى مختلفة تماماً.
البحث هو أحد أعمدة الحكاية. نور يبحث عن نفسه، عن هويته، عن المزاعم التي تنطوي عليها السردية الإسرائيلية، عما يدور في خلد أور، وكيف أنه مختلف عن نور، رغم أنهما يحملان الاسم نفسه بلغتين مختلفتين. هو في حالة بحث عن وقائع تاريخية، عن الآثار التي تخصص من أجلها، وصديقه مراد يبحث في العلوم السياسية، وكل يبحث عما يجعل حياته أكثر وضوحاً.
تذهب الرواية إلى الماضي، إلى التاريخ، لكنها تعود بنا إلى الزمن الحاضر، إلى أجواء سادت أثناء وباء «كوفيد»، والأحداث الأليمة التي رافقت محاولة تهويد حي الشيخ جرّاح، إلى «حماس» التي تهدد وتتوعد، بسبب ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في القدس.
لعل التفاصيل جميعها، تصبح في نظر القارئ هامشية أمام المقاطع القوية التي تدخلنا إلى خوالج نور وهو يلبس جلد أور، يتحاور معه، ويتصادم، يعيش صراعاً عميقاً وعنيفاً. حقاً هي المقاطع الأمتع والأكثر تشويقاً، بحيث نلحظ أنه قادر على أن يتقمص شخصية أور، من دون أحمال مسبقة. الكثير من السماحة والكبر، والقدرة على لبس قناع الآخر، حتى ولو كان عدواً يضع الأصفاد في يديك، يقيدك ويضعك خلف الجدران نصف عمرك.
أسلوب سردي منساب، لكن الحيل الروائية، تخرجه من بساطته وتأخذه إلى حبكات متوالية، وكأن نور بقناعه يجتاز اختبارات واحدها تلو الآخر، ليترك لنا نهاية مفتوحة. وهي الخاتمة التي تبقى مشرعة، لتفسح لخندقجي الفرصة ليكمل رباعيته التي وعد بها. هكذا تصبح «قناع بلون السماء» مجرد جزء أول من سلسلة ستتوالى أحداثها. وهو ما يفسر، الحرص على بناء أحداث مركبة تساعد في فتح أبواب كثيرة قادمة. فكل تفصيل يمكن أن يكون ممراً إلى مكان جديد، يأخذنا إليه الكاتب بحنكته الروائية.
باسم خندقجي الذي لا يزال يقبع في سجون الاحتلال، تتم محاربته بسبب كتابه هذا بوسائل عدة، ويهاجم في الصحف العبرية، فقط لأنه افلح في نشر روايته ولاقت نجاحاً. وتعمل سلطات الاحتلال على مراكمة المخالفات عليه، كي تجبره على دفع ما فاز به ولا تترك له أي مكافأة مالية يحصل عليها، بعد أن فاز على اللائحة الطويلة ومن ثم القصيرة، لجائزة الرواية العربية. وهذه ليست روايته الأولى، كما أن خندقجي الذي اعتقل في 2 نوفمبر عام 2004 وكان لا يزال في التاسعة عشرة من عمره، اصدر ديوانين، ونشر اكثر من مئتي مقالة، وهو يتغلب على سجنه بالحلم والبحث والتعلم، والترفع عن الألم، والكتابة وكأنه يعيش حياة الأحرار. وربما نفهم اكثر حين نقرأ ما كتبه في روايته، مخاطباً صديقه مراد الموجود في الأسر: «كم أحسدك يا مراد على سجنك الأصغر، لأن واقعك الحديدي هذا واضح الملامح مكون من معادلة بسيطة، لكنها قاسية: سجن، سجين، سجان... ولكن هنا في السجن الأكبر الأمور لم تعد واضحة».
الرواية تقع في 240 صفحة، جهد كبير صرفه الكاتب على جعلها غنية بالحيل الروائية، والمعلومات التاريخية، كما الاستشهادات الأدبية، ومحملة برموز ذات دلالات تزيد النص دسامة.
حين تقرأ كتابات باسم خندقجي، وأسامة العيسة، وعدنية شبلي وغيرهم من الكتاب، لا بد أن تعرف الأدب الفلسطيني الجديد، من ميزته وسط غابات الروايات العربية، إنه يتسم بالجدية، والحفر في المعاني، والحرص المستميت على جعله يليق بالواقع الفلسطيني.