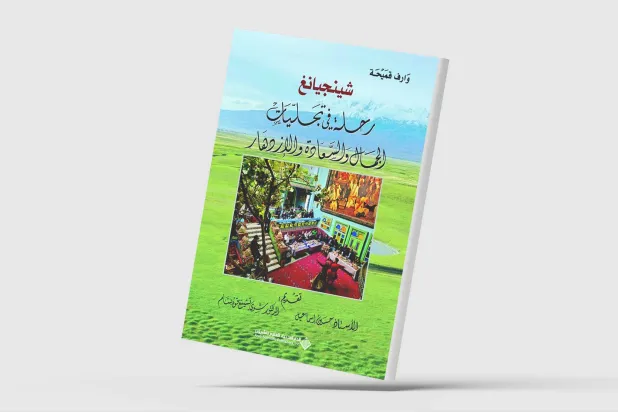يسعى كتاب «الحب والإدمان» لمؤلفيه ستانتون بيلي وآرتشي برودسكي، بترجمة نيفين بشير «آفاق للنشر والتوزيع بالقاهرة»، إلى فتح نقاش معرفي ونقدي حول الصلة بين عالمي الحب والإدمان، ليس بالصورة المجازية التي ترتبط برومانسية العلاقة بالحبيب، بقدر ما يُقصد بها إدمان علاقات عاطفية اعتمادية رغم ما تتسبب فيه من عواقب غير حميدة، كالوِحدة والعزلة والشعور بعدم الأمان.
يرى مؤلفا الكتاب أن العلاقات الشخصية الوثيقة يمكن أن تسبب الإدمان، وأن هذا النوع من الارتباط هو عكس علاقة الحب تماماً، حيث «الحب الحقيقي عكس التجربة المُقيدة لإدمان الحب»، حسبما يشير المؤلفان.
ويُعد ستانتون بيلي خبيراً ومُحاضراً في مجال الإدمان لما يزيد على 40 عاماً، وعُدَّ رائداً في وضع مجال الإدمان أمام فهم تجريبي وثقافي، أما آرتشي برودسكي فهو المؤلف المشارك لأعمال ستانتون البحثية، وقد ترأس لجنة حقوق الإنسان في «مركز ماساتشوستس للصحة العقلية».
إدمان الحب
حسب الكتاب، الذي يقع في 463 صفحة، فإن إدمان العلاقات الشخصية «إدمان الحب»، يعد أكثر أشكال الإدمان شيوعاً، وإن كان أقلها شهرة، ولعل تسليط الضوء عليه يساعد على كسر الصورة النمطية عن المدمن، والتوّصل لفهم أفضل للطريقة التي يؤثر بها الإدمان علينا جميعاً، حيث نقيض الإدمان هو الارتباط الحقيقي بالعالم.
يُفند الكتاب أوجه التشابه الجوهرية بين العلاقات الاعتمادية وإدمان المخدرات، عبر استكشاف ماهية الإدمان نفسياً واجتماعياً وثقافياً، من خلال طريقتين: الأولى إظهار ما يحدث بالفعل عندما يكون الشخص معتمداً أو يقاوم الاعتماد على عقار ما، وثانياً من خلال إظهار كيف يمكن أن تحدث العملية نفسها في مجالات أخرى من حياتنا اليومية، خصوصاً في علاقاتنا مع أكثر المقربين لنا، فأوجه التشابه بين إدمان الحب وإدمان المخدرات جوهرية، بما فيها ظهور أعراض الانسحاب كنتيجة للانفصال، وهي فكرة بدا للكثيرين أنها من غير المعقول أن يكون لها سند علمي، ولكنها واقعية.
اعتمد الباحثان في بناء عالمهما البحثي على تواشج قصص أفراد عاديين، مع آراء فلسفية ونفسية، وتحليل لسرديات أدبية حول الحب والتعلّق، في محاولة لفهم جوهر الحب ونوازع الارتباط العاطفي، بصورة كشفت عن تناقضات شاسعة في فهم علاقة الذات بالآخر، والتوازن في مقابل الاحتياج، فيشير الكتاب، على سبيل المثال، لمقطع للكاتب البريطاني ديفيد هربرت لورانس ورد في روايته «نساء عاشقات» يقول: «ما أريده هو ارتباط غير مألوف معك، ليس التقاءً أو اختلاطاً، لكنه توازن، وتناغم نقي لكائنين منفردين، كما تتوازن النجوم بعضها مع بعض»، وهو مغزى يختلف عن ماهية الحب التي وردت في قصيدة لوليام غاريت يقول فيها:
«أحتاج إلى حبك من أجل البقاء
من دونه أنا بالكاد أحيا..».
يعد إدمان الحب أكثر أشكال الإدمان شيوعاً وإن كان أقلها شهرة
مبدأ التكامل
يشير الكتاب لتعبير عالِم النفس والفيلسوف إريك فروم، عن مبدأ التكامل في الحب، بما يكفل للطرفين تحقيق الذات وعزة النفس، فالحب بالنسبة لفروم هو نقيض لإدمان الأشخاص، حيث الحب نمو وتوسيع للعالم وليس محض «ارتباط تكافلي أو أنانية مفرطة». ويذكر الباحثان كتاب إريك فروم البارز «فن الحب» الذي يقول فيه إنه لا يمكن للرجل أو المرأة تحقيق الرضا بالحب إلا عندما يدركان نفسيهما إلى الحد الذي يُمكّن كل منهما من الوقوف كشخص كامل وآمن، وهو أمر لا يمكن فهمه دون فهم الفرق بين النهج الإدماني وغير الإدماني في الحياة، ويعدُّ فروم أن جوهر الإدمان هو الإحساس المتضائل بالذات.
حسب الكتاب، فإن الإدمان ليس فقط الصورة النمطية المرتبطة بالإدمان الكيميائي كما هو شائع، بل إن الإدمان «تجربة» تنشأ عن استجابة الفرد الروتينية لشيء له معنى خاص لديه، شيء يجده آمناً ومطمئناً لدرجة لا يمكن الاستغناء عنه «الإدمان ليس شيئاً غامضاً إنما نمو خبيث ومظهر متطرف وغير صحي للميول البشرية الطبيعية».
ومن الناحية النظرية، كما جاء في الكتاب: «لا علاقة للحب بالإدمان على الإطلاق، فهما نقيضان»، حيث لا شيء يمكن اختزاله من الحب الحقيقي المتعارف عليه، سوى التبعية اليائسة المتمركزة حول نفسها، التي نسميها في حالة المخدرات بالإدمان، وعلى الرغم من أن التجاور بين المصطلحين «الحب» و«الإدمان» غريب، إلا أنهما متداخلان، وأحياناً ما نقول «حب» عندما نعنى حقاً «إدمان».
يبقى اللافت في هذا الكتاب أن الباحثين اتكآ في بحثهما على قصص لأفراد «يُحبون من موقع قوة، وليس احتياجاً، مقابل أفراد محاصرين داخل علاقات إدمانية مُؤذية. وتبدو معظم قصص حبهم نتائج لعزلة حياتهم العائلية في مرحلة الطفولة»، حيث «لعائلاتنا تأثير هائل على قدرتنا الإدمانية أو غير الإدمانية، لأنها إما تعلمنا الثقة بالنفس أو العجز أو الاكتفاء الذاتي والتبعية»، وصولاً لعلاقاتنا بالمؤسسات الاجتماعية التي يمكن أن تغرس بداخلنا شكوكاً جدية حول قدرتنا على إدارة حياتنا، أو التفاعل بشكل خلاق مع بقية العالم، ما يجعل من أبرز الطرق لحماية أنفسنا من الإدمان فهم كيفية تأثير بيئتنا الاجتماعية علينا، والوعي الذاتي النقدي، وتعلم طرق أفضل للتعامل مع الأشخاص، ليس فقط في العلاقات الرومانسية، ولكن ينطبق على الروابط العائلية والصداقات.