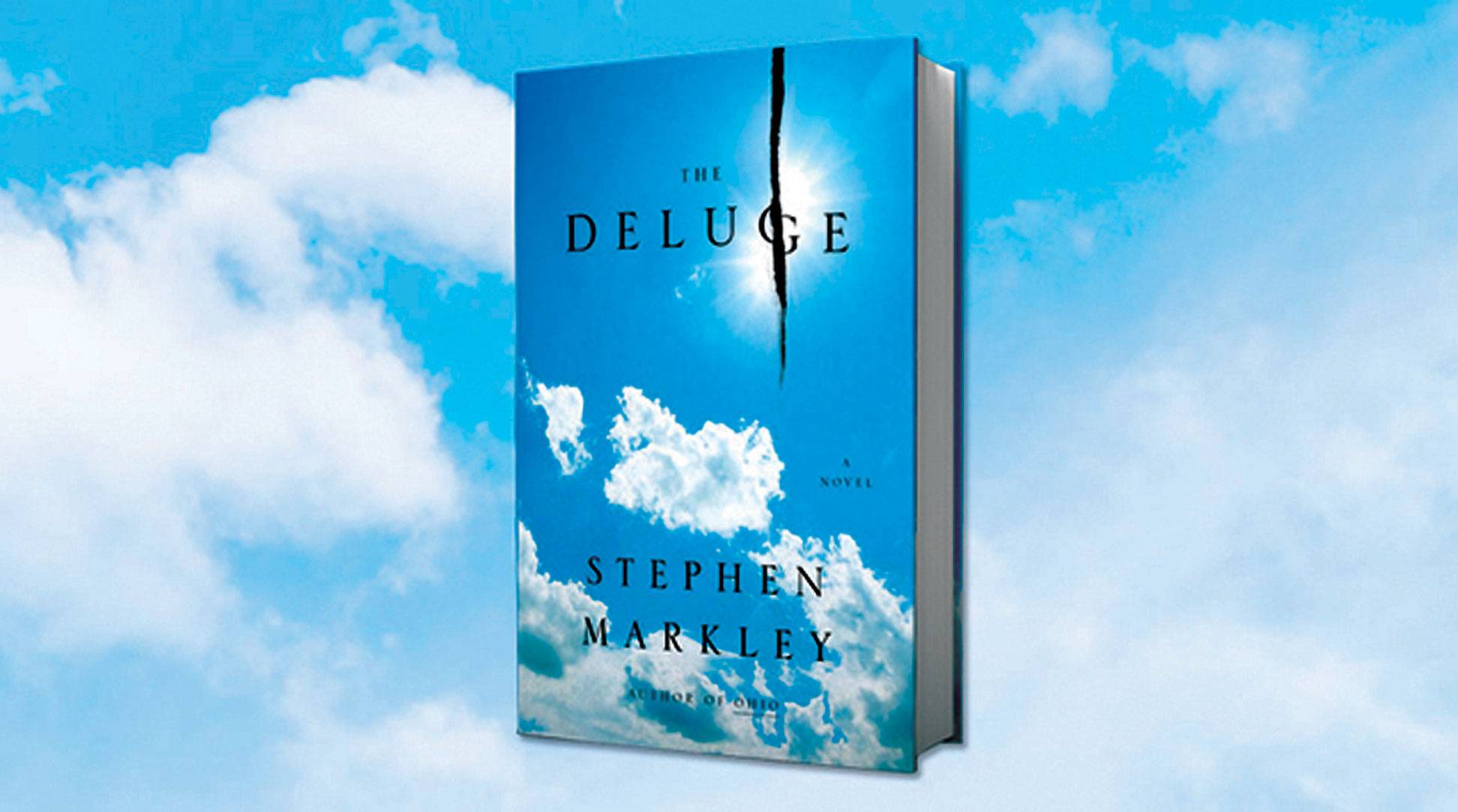عندما دخل مارك دوكس ديراً للأرثوذكس الشرقيين في تكساس عام 1987، خالجه اعتقاد بأنه ربما يمتهن العمل راهباً. وبعد مرور عام، أدرك أن ذلك لن يحدث، لكنه وجد شيئاً آخر داخل كنيسة الدير: صوراً ليسوع المسيح ومريم العذراء مرسومة على الطراز البيزنطي، ووجهاهما الهادئان محاطان بهالات ذهبية كبيرة. وقال: «كان الأمر أشبه برؤية جسدية».
وعليه، قرر دوكس في ذلك الوقت أن يصبح رسام أيقونات، لكن بوصفه رجلاً أسود نشأ في الستينات، صارع دوكس العنصرية التي عاشها داخل المجتمع والكنيسة - والآن، دخل في صراع جديد مع احتمال تشييده أيقونات ليسوع أبيض البشرة.
وعن ذلك، قال: «قلت لنفسي: أليس من الرائع أن تكون قادراً على التعبير عن هذه الروحانية، لكن مع التعامل في الوقت ذاته مع المآزق الوجودية لما يعنيه أن تكون أسود اللون في أميركا؟».

بعد مغادرة الدير، واصل دوكس الاضطلاع بذلك، وتولى بناء أيقونات لدارين فريدين للعبادة في سان فرانسيسكو: كنيسة سانت جون كولترين، التي يُعدّ قديسها أسطورة بعالم موسيقى الجاز، وكنيسة القديس غريغوريوس أسقف نيصص القريبة، التي تضم مجموعة القديسين الخاصة بها 90 شخصاً و4 حيوانات، جميعهم يرقصون معاً.
وغطى دوكس جدران كنيسة القديس غريغوريوس أسقف نيصص في سان فرانسيسكو، بصور العشرات من القديسين يرقصون معاً.
بوجه عام، تميل أعمال دوكس الكنسية نحو التوقير، وغالباً ما يصور أشخاصاً ببشرة داكنة بوصفهم شخصيات مقدسة، أو يصوِّر شخصيات مقدسة في صورة أشخاص داكني البشرة. وفي خضمّ بنائه لهذه الأعمال المقدسة لحساب الآخرين، كان دوكس يصوغ قصته العبثية الخاصة التي أثمرت كتاباً فنياً مصوراً بعنوان «ذي إن وورد أوف غود» (كلمة «زنجي» من الله).
صدر الكتاب المؤلف من 366 صفحة عن دار «فانتاغرافيكس» في 27 فبراير (شباط). ويتمحور حول شخصية تدعى سانت سامبو، وهو رجل داكن البشرة يرتدي قبعة مرتفعة وسلاسل، بينما يحمل وجهه ابتسامة مبالغاً فيها محددة باللون الأبيض، ما أثار بالأذهان صورة الشاعر المنشد المرتبطة بالقرون الوسطى. وفي الكتاب، يتحول سانت سامبو من مادة للسخرية إلى المخلص الحقيقي للشعب.
تضمنت القصة لوحات للسيدة مريم، في دور العمة جيميما، وكذلك صور أخرى للعذراء وطفلها يسوع المسيح بوجهين أسودين؛ ما شكل استفزازاً لكثيرين.
في هذا الصدد، قال دبليو غابرييل سيلاسي، أستاذ الدراسات الأفريقية في جامعة ولاية كاليفورنيا، نورثريدج: «يصور مارك بشكل كاريكاتيري فكرة الشاعر المنشد التي فُرضت على السود، بل وتبنوها، إلى جانب فكرة المسيح الأبيض».
وفي مقابلة معه، قال دوكس، 65 عاماً، إن كتابه الجديد يُعدّ أول كتاب لرسوم الأيقونات، ويمثل تتويجاً لرحلة روحية خاضها لأكثر من ثلاثة عقود. وأضاف: «إنه تحقيق للرؤيا الأصلية التي رأيتها في الكنيسة الأرثوذكسية الصغيرة داخل الدير».
جدير بالذكر أن دوكس، الأصغر بين ثلاثة أشقاء، وُلِد ونشأ في كولومبوس بأوهايو في عائلة فقيرة للغاية. وكان والده يعمل في وظيفة ثابتة بشركة كهرباء، بينما عملت والدته خادمة.
وعندما أشاد أحد معلمي المدارس الابتدائية بقراءة دوكس ذات يوم، قال الفنان إن والدته فرحت كثيراً، لأنها كانت أمّية. وبمرور الوقت، أصبح دوكس قارئاً متحمساً للكتب المصورة وكتب الخيال (كان كورت فونيغت كاتبه المفضل). وانضم لاحقاً إلى فرق الشطرنج والتنس في مدرسته الثانوية. يقول: «لقد كنت الطالب الذي يذاكر كثيراً، لكنني رغم كوني طالباً مجتهداً، كان يُحسَب لغضبي ألف حساب».
بعد المدرسة الثانوية، التحق دوكس بكلية كولومبوس للفنون والتصميم. وأثناء وجوده هناك، دعت امرأة دوكس لحضور كنيستها، التي كانت رائعة، لذلك قرر الذهاب بالفعل. وهناك، سرعان ما وجد دوكس نفسه وجهاً لوجه أمام يسوع «هذا الكائن الغامض المحب»، كما قال. وبعد ذلك، قرر ترك مدرسة الفنون إلى الأبد.
يقول: «لقد خرجت في رحلة بحث»، واصفاً حالة من البحث الروحي المستمر عايشها، توقف خلالها عند محطات الهندوسية وحركة «هاري كريشنا»، من أجل أن يعاود معايشة هذا الشعور بالحب الشامل الذي اختبره للمرة الأولى داخل مدرسة الفنون.
وفي وقت لم يكن لديه سوى 12 دولاراً في جيبه، توجه دوكس إلى كاليفورنيا، واستقر في النهاية في سان فرانسيسكو، حيث وجد نفسه يعيش في الشوارع ويساعد في مطبخ للفقراء. رأى القس الذي يدير المكان أن دوكس ربما لديه مهمة أعلى من الحساء، وهذا السبب الذي جعل دوكس ينتهي به الأمر في دير تكساس، حيث تعلم كيفية نحت صور القديسين على سطح بيض الإوز.
عندما عاد إلى سان فرانسيسكو، زار دوكس، حاملاً البيضة في يده، كنيسة سانت جون كولترين. ولحسن الحظ، كان القس هناك يبحث عن شخص ليرسم أيقونات لعازف الساكسفون الشهير الذي تحمل الكنيسة اسمه.
وقال رئيس الأساقفة فرانزو كينغ، أحد مؤسسي الكنيسة: «في أحد أيام الأحد، ظهر هذا الشاب ومعه بيضة إوز عليها أيقونة. فقلت: أخي. لقد كنا في انتظارك». وأضاف كينغ أن دوكس بدا عليه التردد، وظهر أنه غير واثق ما إذا كان كولترين «يستحق التبجيل». وأضاف: «لم يكن مارك عازف جاز، ولم يكن يعرف شيئاً عن كولترين». في النهاية، جاء دوكس وربط بحثه عن إله الحب مع فكرة كولترين المثالية عن «الحب الأسمى»، عنوان ألبومه الموسيقي الشهير الصادر عام 1965.
في أيقوناته، عمد دوكس إلى تصوير كولترين في ثياب بيضاء متدلية، ورأسه محاط بهالة ذهبية، ولهيب إلهي مشتعل داخل ساكسفون عازف الجاز. وحتى الآن، تُعدّ هذه الصور من بين أعمال دوكس الأكثر شهرة، وظهرت على صفحات مجلة «ذي نيويوركر» و«تي: ذي نيويورك تايمز ستايل مغازين».
وعكف دوكس على الرسم في سقيفة تخزين غير مستخدَمة، على أرض ما أصبح فيما بعد كنيسة القديس غريغوريوس النيصي. وسمح دونالد شيل، المؤسس المشارك لكنيسة سانت غريغوري، لدوكس بالعمل هناك في الأوقات التي لم يكن الفنان فيها متطوعاً في مطبخ إعداد الحساء.
عام 1998، وبمجرد الانتهاء من بناء كنيسة القديس غريغوريوس، تواصل مسؤولون مع دوكس بشأن خطة لملء الكنيسة بأيقونات القديسين الراقصين. وقال أحدهم: «قال مارك، وأنا هنا أقتبس نص كلامه: (أعتقد أنني أحمل رسالة للاضطلاع بهذا العمل)».
ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2008، رسم دوكس عدداً أكبر من الصور المستوحاة من واقع الحياة لـ«القديسين» المحبوبين، ومن بينهم سيزار شافيز، وسوجورنر تروث، وآن فرانك؛ وشكلت صورهم الراقصة دائرة حول القاعة المستديرة للكنيسة.
رؤية السود على أنهم بشر أمر مدمر للعقل الأميركي لأنه عليك أن تقول: «ماذا فعلنا؟ كيف تعاملنا معكم؟ ولا يوجد كثير من الأشخاص يريدون التحدث عن ذلك»
وفي الأوقات التي أوقفت فيها الكنيسة العمل لجمع الأموال لمرحلتها التالية، عمل دوكس بمجال توريد قطع غيار السيارات لشركات مختلفة.
عام 2009، التقى دوكس بكيري جيمس مارشال، الرسام والنحات الشهير، في أثناء محاضرة كان مارشال يلقيها داخل متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث. وأثمر الاجتماع سلسلة من التوجيهات تلقاها دوكس على مدار 4 أشهر، وينسب إليها الفضل في مساعدته على تطوير النهج البصري الذي يطلق عليه «بيزادا»، وهو مزيج من الصور البيزنطية وعناصر ساخرة مستوحاة من حركة الدادية الفنية.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت أعمال دوكس في فيلم وثائقي عام 2021 («سانت كولترين: الكنيسة المبنية على الحب الأسمى» على قناة «إن بي آر»). كما جرى تحليل أعماله في دراسات أكاديمية.
كما ظهرت أعمال دوكس الفنية على الملصقات واللافتات في الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة. (لوحة «سيدة فيرغسون» التي تتخيل مريم العذراء السوداء في مرمى البندقية، ويداها مرفوعتان ليس في وضع الدعاء، وإنما الاستسلام) معروضة في الوقت الحاضر بكاتدرائية القديس يوحنا في نيويورك.
أما فيما يخص الكتاب الجديد: «كلمة (زنجي) من الله»، فإنه عبارة عن مجموعة من أعظم أعمال دوكس. ومع ذلك، فإن موضوعاتها وصورها الاستفزازية شكلت تحدياً حتى للأصدقاء والحلفاء.
من جهته، يعترف دوكس بأن عمله قد يكون صعباً. ويقول إن رؤية السود على أنهم «بشر أمر مدمر للعقل الأميركي، لأنه عليك أن تقول: ماذا فعلنا؟ كيف تعاملنا معكم؟ ولم أرَ كثيراً من الأشخاص يريدون التحدث عن ذلك».