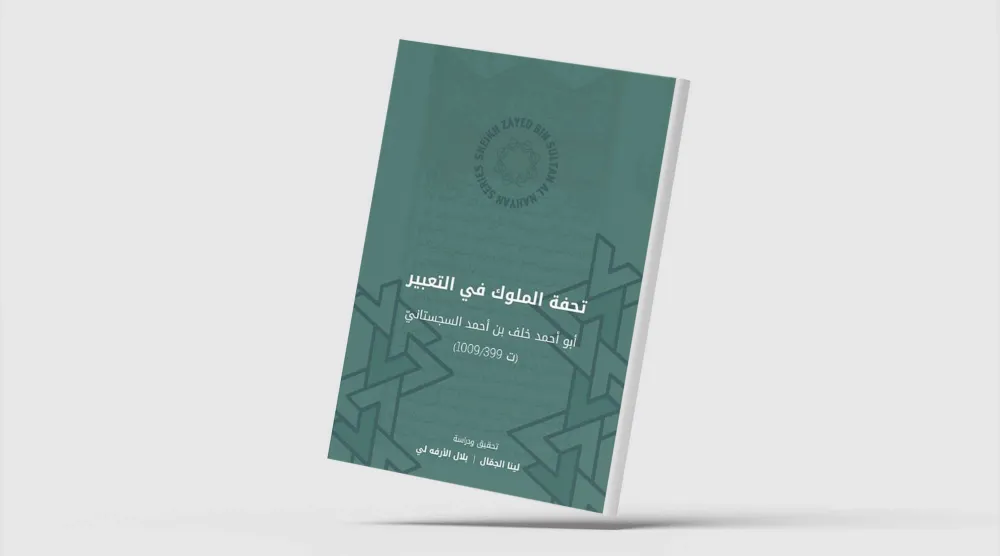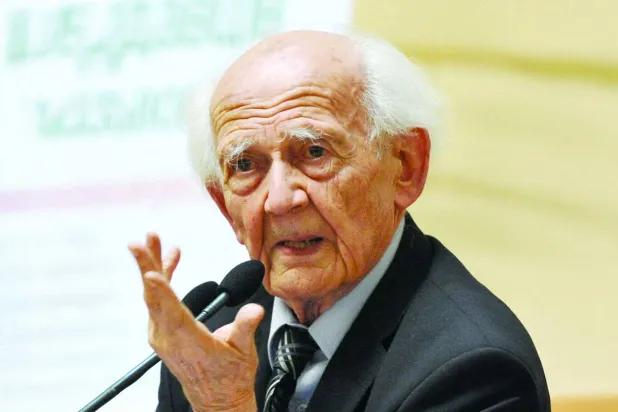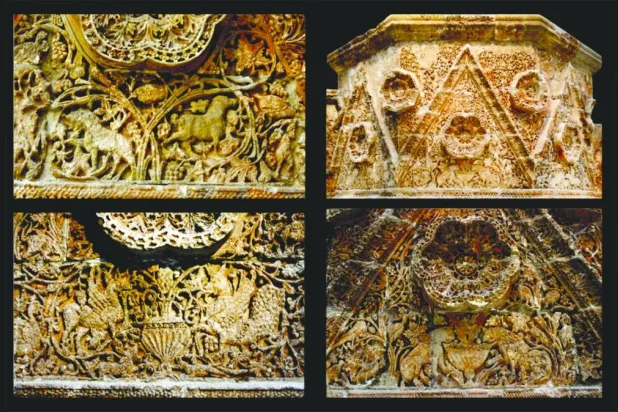(نشرنا يوم الأحد 25/2 مقالاً بعنوان «ماذا بقي من دولة فلسطين الشعرية؟» للدكتور أحمد الزبيدي، وهنا رد على المقال)
* يزعم الزبيدي أن إسرائيل قد نجحت، خلاف العرب، بتأسيس سردية لها، سمّاها سردية إسرائيل. ولا أعرف ما أدلة الناقد على هذا الزعم العجيب
بعد ست وسبعين سنة من تأسيس إسرائيل في فلسطين، وما أعقبها وتأسس على أساسها من حوادث تاريخية كبرى «النكبة: 1948، العدوان الثلاثي: 1956، هزيمة حزيران: 1967، حرب تشرين: 1973، وقبلها تأسيس منظمة فتح الفلسطينية (1957) ثم منظمة التحرير الفلسطينية، وما بين الحدثين من تأسيس منظمة الجبهة الشعبية (1967) ثم الديمقراطية (1968)، ثم الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان: 1982، وطرد المسلحين الفلسطينيين من لبنان لتونس»، وبعد انتفاضات فلسطينية كبرى ذات طابع شعبي، أو مسلح «كما يجري الآن في قطاع غزة» ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، نقرأ أسئلة مشكِّكة ترد في سياق مقالة كُتبت بلغة منفعلة عن «نهاية دولة فلسطين الشعرية» أو حسب العنوان المنشور في جريدة «الشرق الأوسط» الغراء «ماذا بقي من دولة فلسطين الشعرية؟ بعد غياب أبرز شعرائها الكبار: 25 فبراير (شباط) 2024». ولا بأس بالعنوان؛ لا بأس بالصياغات المشبعة بالانفعال والرغبة بالاعتراف، أو قل الجهر بأمر ما في سياق قضية كبرى مثل القضية الفلسطينية. أقول لا بأس؛ فهذا شأن المثقفين الجادين، كما هو حال الناقد الدكتور «أحمد الزبيدي»، الأكاديمي العراقي المختص بقضايا الشعر العربي الحديث. لكن المقالة لا تقف عند حدود «التحسُّر» المتحصل من استعادة كلمات منبرية قالها شاعر فلسطيني عاش ومات ببغداد اسمه خالد علي مصطفى عن شهداء يسقطون الآن «الحديث عن انتفاضة الأقصى: 2000» ولا شعراء كباراً يرثونهم؛ ولا نعرف كيف أمكن لـ«مصطفى» أن يُسقط من حسابات الشعر العربي، والفلسطيني خاصة، أسماء شعرية فلسطينية وعربية كبرى كانت موجودة في وقتها «2000»، ولم تصمت أو تموت، مثل محمود درويش «2007»، وسميح القاسم «2014»، وفدوى طوقان «2003»، وأمجد ناصر «2019»، بل إن الشعراء العرب المذكورين في كلمة «مصطفى» المنبرية ما زال بعضهم أحياءً حتى ذلك الوقت: مظفر النواب مثلاً «2022»، ومثله شعراء عرب كبار آخرون كرسوا قدراً لا يستهان به من شعرهم في تأسيس «سردية» كبرى اسمها فلسطين. أذكر منهم هنا: سعدي يوسف، وأحمد عبد المعطي حجازي وأغلب شعراء مصر الكبار. لماذا سقط هؤلاء من ذاكرة الأكاديمي العراقي، ومن قبله الشاعر خالد علي مصطفى!

لا «سردية» عربية سوى قصة «حقيقية» اسمها فلسطين
لكن المفارقة لا تنتهي عند حدود التحوّل من «منطق» التحسر على «موت» دولة فلسطين الشعرية، أو في الأقل تحوّلها لحالة اليأس، إلى «منطق» الحكم على فلسطين بوصفها «سردية» غير موجودة في الرواية العربية، أو حسب ما كتب «الزبيدي» نفسه: «إنما أعني التكوين التخييلي لدولة فلسطين عبر (اللغة)، وأي لغة؟ إنها اللغة الشعرية التي أَعذبها أَكذبها»؛ فهل «السردية» حكر على الرواية أو السرديات عامة؟ واقع الأمر، أو كما كان العرب يعبرون بقولهم: إنه من نافلة القول، إن «السردية» هي مقولة «لسانية» و«معرفية» ذات بعد رمزي؛ لنقل إنها القصة الرمزية، أو الأمثولة، ولها أن تتحقق في الشعر كما لها أن تتحقق في أرضها الخصبة الرواية والقصة عامة، ولا فرق أبداً في الحالتين، ما دمنا نتحدث عن «السردية» بصفتها مقولات رمزية. ولأن اللغة، شعرية كانت أم سردية، لا يمكنها أن تحجب أو تبطل عمل «السردية» بوصفها أمثولة. ولا بأس سوى أن الناقد العراقي يمضي بعيداً في تأكيد كلامه فيذكر الناقد أسماء ثلاثة كتاب رواية عرب، اثنان منهم عراقيان، وهم: نجيب محفوظ وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي. والواضح لي أن اختيار هذه الأسماء جاء متعمداً لأن رواياتها، حسب ما يقول، لم تسعَ إلى تجسيد «فلسطين في تشكلها الوجودي التاريخي بوصفها رواية تاريخية». أقول كان بإمكان الناقد أن يوسِّع أفقه وينظر إلى خريطة «بل خرائط الرواية العربية بطبعاتها الوطنية المتعدِّدة» بعين منصفة. وفي بالي اسمان راسخان كان لهما مساهمة كبرى في تأسيس أمثولة فلسطين، وهما إلياس خوري في رواية «باب الشمس»، ورضوى عاشور في رواية «الطنطورية». ولن أذكر الأسماء الفلسطينية الأساسية، وفي طليعتها غسان كنفاني، لا سيّما روايته «عائد إلى حيفا: 1969» التي أسست لأمثولة العائد المتخيلة في سياق رواية الشتات الفلسطينية. لنعد إلى الأسماء الثلاثة التي اعتمدها الناقد حجة ودليلاً على موت أو تلاشي فلسطين بوصفها سردية، ولنبدأ بمؤسس الرواية العراقية الرائد غائب طعمة فرمان، وقد زعم الناقد «الزبيدي» أن روايات الكاتب العراقي الشهير قد خلت من التجسيد الوجودي التاريخي لفلسطين، وهذا زعم ترفضه القراءة الموضوعية لرواية المخاض، وهي الثالثة في رصيد فرمان، والمؤسسة لقصة المنفيّ العائد في الرواية العراقية. ونجد فيها أن فرمان يضع أمثولة الفلسطيني في مقابل قصة العائد العراقية، ونزيد بالقول إن «إسماعيل»، الشاب الفلسطيني، الذي يرفض الذوبان في المجتمع العراقي بزواجه من ماجدة، هو مرآة يرى فيها «كريم داود» نفسه وشخصه ومجتمعه. ولا نتحدث، هنا، عن صور الفلسطيني في الرواية العراقية، فهذا موضوع آخر نجد أصوله في دراسات وكتب ومقالات كثيرة، إنما نحن، هنا، في صلب سردية «الفلسطيني» من الشتات.

نعم، لم يكتب نجيب محفوظ، ولا فؤاد التكرلي رواية تاريخية تجسد السردية الفلسطينية، نعم؛ هذا أمر مؤكد، لكن هذا التأكيد يسري على وقائع روايات محفوظ المباشرة، أو قل الأولية. فلا يسري، من ثمَّ، على إشكالية التأويل لمدونة محفوظ. إذ إن المعروف أن روايات محفوظ كتبت على مراحل؛ المرحلة التاريخية، والمرحلة الواقعية، والمرحلة الفلسفية وهكذا. وكل مرحلة ارتبطت أو تولَّدت عن السياق التاريخي للمجتمع المصري المرتبط، حتماً، بتحولات السلطة. فكان محفوظ يراقب مجتمعه مثلما يراقب السلطة المتحكمة به. هكذا كانت الثلاثية الشهيرة تتويجاً للمرحلة الواقعية، بحياتها المنتظمة ومسار السلطة الرتيب المتحكم بها، فيما ستختلف روايات المرحلة الفلسفية، وقد ارتبطت بنقد التجربة الناصرية القائمة على سردية الدولة الوطنية المستقلة الطامحة لضرب وتدمير «السردية التوراتية» في «إسرائيل»، واستعادة السردية الفلسطينية المزاحة، أو التي جرى إسكات صوتها، كانت بدايتها برواية «اللص والكلاب» «1961»، وهي الصياغة الأولى لقصة القاتل في الرواية العربية. فرقاً، أو قل تعويضاً عن نشوء الرواية البوليسية التي غابت بسبب عدم تطوّر مؤسسات الدولة الحديثة من بوليس جنائي إلى ضابط تحرٍّ، إلى مستلزمات رئيسة أخرى ظلت حركات الحداثة العربية تبشر بها من دون أن تصل إلى مرحلة تطبيقها. وفي رواية القاتل المحفوظية ثمة تقصٍّ لمصائر القاتل وضحاياه. والقصة تتولى، من ثمَّ، فضح مكيدة القاتل وسرديته بتجريده من سلطته القائمة على امتلاك السردية المغيبة، مما يجري المتاجرة بها وقمع الأصوات الفلسطينية الحقة. ولقد مهَّد محفوظ بنقده الجذري للقاتل العربي الذي حكمنا لرواية ما بعد هزيمة يونيو (حزيران) الشنيعة، وهذه وحدها كانت سردية فلسطينية كبرى. أتذكَّر، هنا، روايات رئيسة كانت محطة وقفت عندها أغلب الدراسات العربية والأجنبية. في طليعتها «عودة الطائر إلى البحر: حليم بركات/ 1969»، و«الزمن الموحش: حيدر حيدر/ 1973»، و«الزيني بركات: جمال الغيطاني/ 1974». هذه الروايات وغيرها أعادت التأسيس الرمزي لفلسطين بوصفها سردية عربية فلسطينية كبرى.

السردية الإسرائيلية... أي نكتة سمجة!
يزعم «الزبيدي» أن إسرائيل قد نجحت، خلاف العرب، بتأسيس سردية لها، سمّاها سردية إسرائيل. ولا أعرف، حقاً، ما أدلة الناقد على هذا الزعم العجيب. فالسردية تعني تأسيس قصة رمزية متكاملة، وهذا ما لم يحصل مطلقاً في حالة إسرائيل. إنما هناك خلط بين السردية التوراتية المشبعة بالبكائيات الناتجة عن قرون طويلة من الشتات، والصيغة الإسرائيلية الحديثة القائمة على تشريد شعب كامل، هو صاحب الأرض ومالكها الأول والحقيقي. هذا الخلط العجيب يُغري بعض الليبراليين العرب الناقمين على حكومات بلدانهم؛ فيزعمون أن الآلة العسكرية يمكنها أن تنتج سردية ظافرة. وليتفضل الدكتور الزبيدي ويقرأ ما ترجم إلى العربية من نصوص سردية إسرائيلية أذكر منها ما ترجم، مثلاً، لعاموز عوز، وليترك أذنه عند شخصيات تلك الروايات ليسمع أصوات الذات الجريحة التي لم تنته، بعد، من إسكات صوت ضحاياها. ولن ندعو أحداً ليشرح لنا كيف يمكن لشعب معين أن ينتج سردية، كيف لنا أن نفهم البناء الرمزي للقصص السردية. لنترك التاريخ يحكم ويقول رأيه. وعندي أن العرب لم يملكوا، في عصرهم الأحدث، قصة كبرى غير قصة فلسطين. وهذا ليس مدحاً للقضية أبداً، إنما هو تقرير واقع الحال العربي. فالعسكر استولوا على الحكم في دويلات العالم العربي بحجة رغبتهم بتحرير فلسطين، وأعادوا موضعة كل شيء على أساس هذه المزاعم، فلا صوت يعلو على صوت المعركة، لا حرية سوى «لغو» القائد الظافر. لا ديمقراطية ولا دول ولا مؤسسات سياسية أو ثقافية أو صحافية. لا قصة سوى قصة القائد، ولا قاتل سوى السيد الرئيس. لا شيء سوى الاتِّجار الرخيص بقضية شعب كامل اسمه شعب فلسطين. قرن كامل ليس للعرب من قصة سوى قصة فشلهم في امتلاك سردية فلسطين. نعم، هناك سردية فلسطين كبرى ولا نفع، أبداً، أن ننكر وقائع هذه السردية بكمٍّ من الجمل المنفعلة، وقد كان هذا شأن خطب السيد الرئيس، أو القائد الضرورة؛ فما عدا مما بدا!. علينا أن نواجه وقائع القصة، أن نضعها أمامنا، وأن نتوقف عن منح «عودنا» نصراً مجانياً بأن نمارس المهنة العربية الوحيدة التي نجيدها، وهي مهنة جلد الذات.