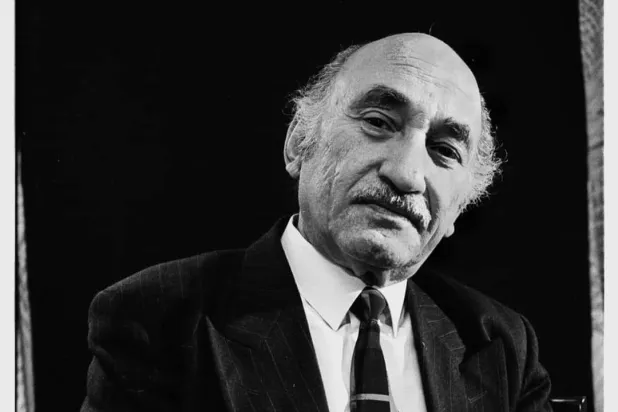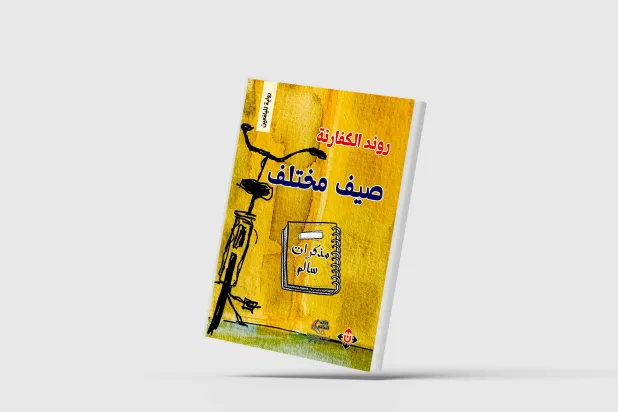إذا كان لكل لغة من لغات العالم الحية ما تمتاز به عن سواها من اللغات، على مستويات الدلالة والبنية النحوية والإيقاعية والقدرة على التطور، فإن ما يميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات، هو غناها المفرط بالمرادفات، إضافة بالطبع إلى جرسها الخاص وثرائها الصرفي والبلاغي. إذ قلما نجد بين لغات الأرض من تُفرد عشرات الأسماء للجمل أو الأسد أو السيف أو الصحراء أو الحب، كما هو الحال مع لغة الضاد. ومع ذلك فإن تبحُّراً عميقاً في معاني الكلمات ودلالاتها، يوصلنا إلى الاستنتاج بأن هذا الغنى المعجمي لا يندرج برمته في خانة الحشو وفائض الإنشاء والترف التعبيري البحت، بل ثمة في بعض الحالات رفعٌ للنعوت والصفات إلى رتبة الأسماء. وفي حالات أخرى تتجه التسميات من التعميم إلى التخصيص؛ حيث للمدلول رتبه وسلّمه ودرجاته، كما هو حال الحب الذي تتراوح تسمياته بين العشق والهوى والصبابة والكلَف والولع والجوى والوله والوجد والهيام وغير ذلك، تبعاً للمراحل التي يقطعها المحبون على الطريق الشائك للعشق والافتتان بالآخر.
وأغلب الظن أن ما أصابته هذه المفردة من الشيوع، لا يعود إلى خفتها البالغة فحسب، بل إلى ما تحمله في الوقت ذاته من مضامين ودلالات. وبالعودة إلى «لسان العرب»، نلاحظ أن المعجم العربي الأشهر لا يشير إلى فارقٍ يُذكر بين الألِفين الممدودة والمقصورة، بل يربط الفعل الثلاثي «هوى» بنظيره المكتوب بالألف الممدودة، أي بالهواء. فكل فارغٍ في «لسان العرب» هواء، والهواء والخواء واحد في المعنى. وقد يأتي الهواء بمعنى الخفة والطيش وانحراف السوية. فالقرآن الكريم يصف الضالين من البشر بأن «أفئدتهم هواء»، أي جانحة وطائشة وخالية من التعقل، فيما يستلهم أحمد شوقي العبارة القرآنية نفسها في معرض الإشارة الملطفة إلى تبدل مشاعر النساء وتقلبهن العاطفي، فيقول:
فاتقوا الله في قلوب العذارى
فالعذارى قلوبهنّ هواءُ
ومن معاني الهوى الانقضاض والحركة السريعة، فيقال: «هوت العقاب وتهوي هويّاً»، إذا انقضت على صيدٍ أو غيره، بحيث يصبح الحب من بعض زواياه هواءً وقبض ريح، ويصبح من زوايا أخرى انقضاضاً على قلب العاشق وإدماءً لقلبه بمخالب العاطفة الكاسرة التي مشى إلى نعيمها برجليه، قبل أن تميط اللثام عن مواجعها اللاحقة. كما يرتبط الهوى بالهوّة والهاوية، باعتباره سبباً للسقوط السريع وصولاً إلى القاع الأخير للمأساة. وإذا كانت الأصوات والألفاظ، هي في الكثير من وجوهها صدى للمعاني وواحدة من تجلياتها، فإن حروف الهوى الثلاثة تترافق في نطقها مع حركة الزفير؛ حيث الهاء الخارجة من المصدر العميق للأنفاس تتحول إلى تنهيدة مشوبة بالأسى، فيما يتماهى الواو والألف مع صيغة النداء المتصلة بحرقة الفقدان. هكذا تصبح اللفظة تفريغاً لجسد العاشق من الطاقة المختزنة في داخله، وصولاً إلى هلاكه المحتوم، ما لم يمكنه حضور المعشوق ووصاله من التقاط أنفاسه من جديد.
ومع أن الشعوب القديمة كانت تجد في عنصري الماء والهواء نوعاً من التكامل الطبيعي مع مبدأ الحب؛ حيث يعمل الأول على الخطين المتصلين بخصوبة الأرض ونطفة الخلق، فيما يعمل الثاني على رفد الكائنات بأسباب البقاء، والمحبين بأسباب الحنين، فلا بد من ملاحظة أن الفارق الأهم بين العنصرين يتمثل في البعد العمودي للأول، والأفقي للثاني. فإذ ينزل الأول من الأعلى إلى الأسفل، محققاً معادلة الرجل السماء والمرأة الأرض، يبدو في إطاره التأويلي متناغماً مع الترجمة الجسدية للحب الصريح، فيما الهبوب الأفقي للثاني يجعله وثيق الصلة بالحب العذري، ويحوله في ضوء المسافة الفاصلة بين العاشقين، إلى حاملٍ للّقاح الذي تحتاجه العلاقة لكي تؤتي ثمارها، أو إلى ناقل إلزامي لرسائل الوله العاطفي والرغبات المعطَّلة. ولن نُعدم في هذا المجال العثور في ثنايا الشعر العربي القديم على ما نحتاجه من الشواهد، وبينها قول جميل بن معمر:
أيا ريح الشمال ألم تريني
أهيمُ، وإنني بادي النحولِ
هَبيني نسمة من ريح بَثْنٍ
ومُنّي بالهبوب على جميلِ
وقولي يا بثينة حسبُ نفسي
قليلكِ أو أقلّ من القليلِ
كما حاول الشعراء العشاق الذين انفصلوا عن حبيباتهم بالإكراه، أن يخففوا عن كواهلهم وطأة الفقد، عبر العثور على قواسم مشتركة تجمعهم بهن، كأن ينظر الطرفان إلى النجوم ذاتها، أو يواريهم الثرى إياه. وكذلك هو الحال مع الهواء والشمس، اللذين يلفان العاشقين المتباعدين بملاءة واحدة من الهواء والضوء؛ حيث يعلن قيس بن ذريح:
فإن تكُ لبنى قد أتى دون قربها
حجابٌ منيعٌ ما إليه سبيلُ
فإن نسيم الجو يجمع بيننا
ونبصر قَرن الشمس حين تزولُ
كما يتحول الهواء من بعض وجوهه إلى جزء من المشهد الطللي الذي يستعيد العشاق من خلاله صورة المنازل الدارسة، وصورة ساكنيها الذين تحولوا مثلها إلى أطلال. وعلى قاعدة التزامن أو الانعكاس الشرطي، كان عرب الجزيرة يتطلعون إلى مصادر الرياح بوصفها مسرح حيواتهم الاستعادي والخلفية الأمثل لتفتح صباباتهم، وبينها ريح الشمال ذات البرودة المنعشة، وريح الصَّبا التي تمتد «من مطلع الثريا وتتجه إلى بنات نعش»، ثم تصبو إلى جهة القِبلة؛ حيث تقع الكعبة المشرفة. ولأنها لم تكن بالنسبة لهم الريح الطيبة التي تلقح الأشجار والسحاب فحسب، بل التي تثير كوامن الشغف، فقد باتت «الصَّبا» المنادى الذي يستعين به الشعراء لاستعادة ما خسروه من حدائق الماضي وحرائقه العاطفية المؤنسة. وقد بدا ابن الدمينة وكأنه ينوب عنهم جميعاً في مناجاته الشهيرة:
ألا يا صَبا نجدٍ متى هجتَ عن نجدِ
وقد زادني مسراكَ وجْداً على وجْدِ
ولم تقتصر مفاعيل النسيم على سكان الصحارى وشعراء المشرق الوالهين وحدهم، بل وجدت تلك المفاعيل أصداء لها في البيئة الأندلسية، رغم ما وفرته تلك البيئة للعشاق من مناخات الحرية والانفتاح والمتع الحسية، فضلاً عن جمال الطبيعة الخلاب. فالحب في مراحل تمكُّنه، يستطيع أن يفتك بقلوب المحبين، بصرف النظر عن طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية وحياتهم الزريّة أو المترفة، وهو ما عكسته بوضوح علاقة ولادة بنت المستكفي بابن زيدون. فحين بلغت العلاقة بينهما مآلاتها المحزنة، بسبب تفاقم الغيرة والشكوك المتبادلة، لم يجد الأخير ما يستعين به على آلام الفراق سوى الشعر، متوائماً في استعطافه الموجع للحبيبة النائية، بين اعتلال النسيم ووجيب قلبه المعتل:
واهاً لعطفكِ والزمان كأنما
صُبغتْ غضارتُهُ ببرد صباكِ
ولطالما اعتلّ النسيمُ فخلتُهُ
شكواي رقّتْ فاقتضتْ شكواك
وإذ يندلع الهواء في بعض الحالات من أعمق تجاويف الذاكرة، يتقمص سمات النسيم ورقّته وترجيعاته، ويغادر مسرحه المكاني ليصبح ارتداداً بالزمان إلى مرابع الحب ومراتع الصبا. وهو ما يجد تمثلاته الأبلغ في قول المتنبي:
وكيف التذاذي بالأصائل والضحى
إذا لم يَعُد ذاك النسيمُ الذي هبّا
ذكرتُ به وصْلاً كأنْ لم أفزْ بهِ
وعيشاً كأني كنت أقطعهُ وثبا
غير أن الهوى من جهة أخرى لا يأخذ شكل النسيم إلا في حالتين اثنتين، تتمثل أولاهما بصفو الزمان وخلوّ العلاقة بين العشاق من المنغصات، فيما تتصل ثانيتهما بالأشكال الوادعة من الفراق؛ حيث التموجات الناعمة للهواء المسافر في الزمن، ترفد العشاق المهجورين بأسباب الحنين والتذكر الشجي لمسرح الهناءة الأرضي. أما في الحالات الأخرى فقد يلبس الهوى لبوس العواصف أو الأعاصير، مطيحاً في طريقه بالعاشقين معاً أو بالطرف الأكثر تعلقاً بالآخر. وإذا كانت الباحثة الأميركية لورا موتشا قد شبهت نزاعات العشاق بالعاصفة الرعدية التي لا بد من حدوثها لتنقية العلاقة من الشوائب، فإن الأمور لا تسير دائماً على هذا النحو، فحين يضيق الخناق على العلاقة لأسباب شتى، لا يبقى للطرفين سوى الترنح المأساوي على «جسر البِلى»، وفق تعبير أبي فراس الحمداني، أو السقوط في هاوية الموت كما حدث لأدونيس وأوريديس في الأسطورة اليونانية؛ حيث كان على أورفيوس وعشتروت أن يهبطا إلى العالم السفلي، لكي يعيداهما ولو بشكل مؤقت إلى الحياة.
من معاني الهوى الانقضاض والحركة السريعة، فيقال: «هوت العقاب وتهوي هويّاً» إذا انقضت على صيدٍ أو غيره، بحيث يصبح الحب من بعض زواياه هواءً وقبض ريح
وإذا كان الغرب في عصوره الحديثة قد شهد الكثير من عواصف الحب التي أوقفت العشاق على شفير الهُوى المتربصة، ودفعت آخرين إلى جوفها الفاغر، فقد تكون المغامرة العاطفية التي عاشها كل من نيتشه وريلكه مع الشابة الروسية لو سالومي، ذات الجمال والذكاء المفرطين، هي النموذج الأكثر دلالة على سطوة الحب، وعلى نتائجه المدمرة والخلاقة في آن. فنيتشه الذي قابلت سالومي افتتانه بها برفضها الزواج منه، غير آبهة بعبقريته الفذة، لم يلبث أن وقع في الهاوية نفسها التي حذر منها غيره من العشاق، بقوله «لا تحدق طويلاً في الهاوية حتى لا تلتفت إليك». أما ريلكه الباحث عن وجه للحقيقة مستحيل المنال، الذي ناشد من يحبونه بمن فيهم سالومي نفسها، ألا يُفسدوا عليه وحدته، فقد كتب، وهو المتناهب أبداً بين عاصفتي الحب والكتابة:
أشعر ببعض الأعاصير وكأنها ولدٌ لي
أتعرفني أيها الهواء؟
يا من ستحلّ مكاني ذات يوم
ويا من ستكون لي وعاءً وحاضراً زلِقاً
وديواناً للأشعار