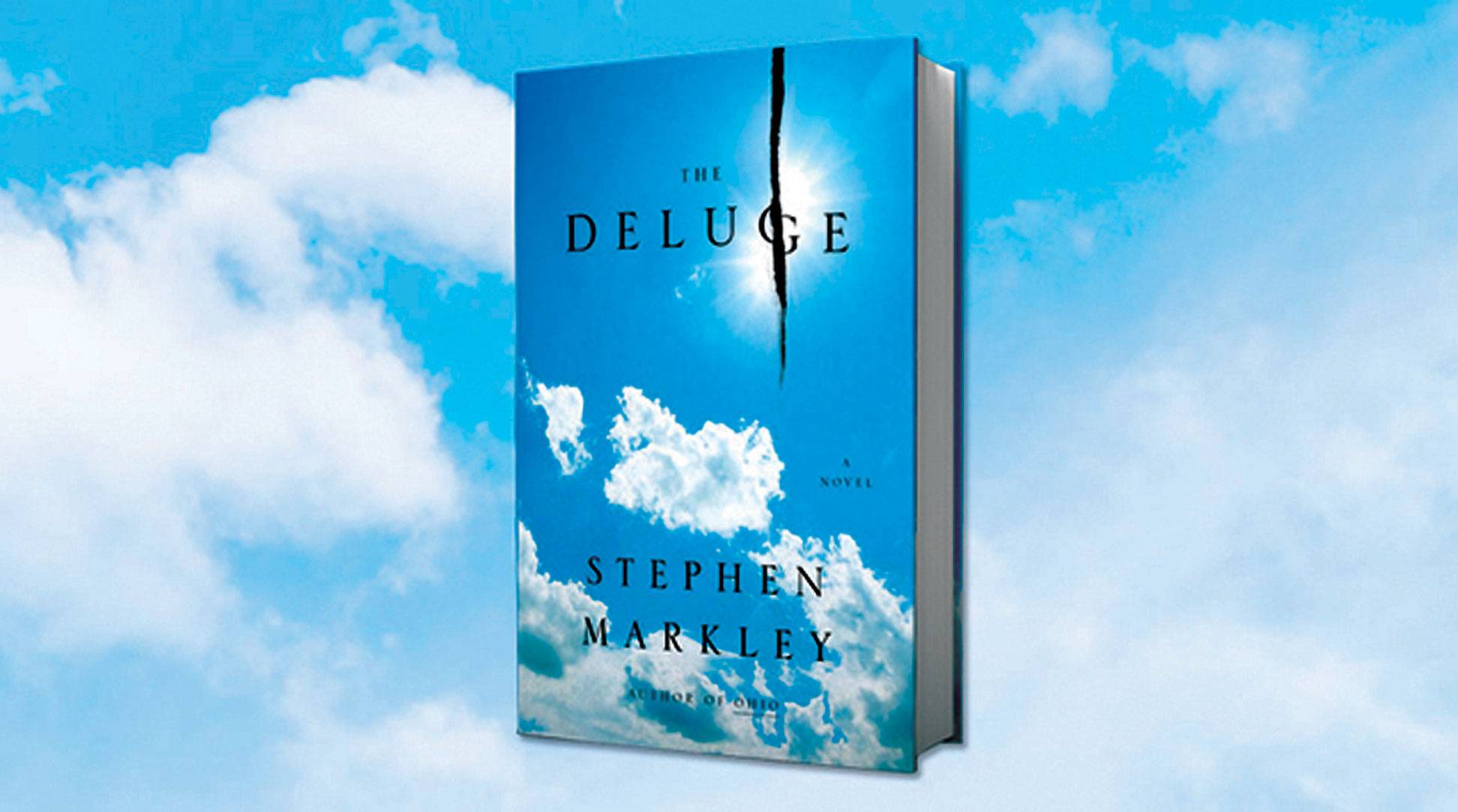صمم الفنان التشكيلي المصري حلمي التوني (مواليد 1934) ما يزيد على أربعة آلاف غلاف كتاب، خلال مسيرته الإبداعية. وبذلك فهو مع بداياته في نهاية خمسينات القرن الماضي، ومن خلال عمله مع كبار دور النشر والمطبوعات الصحافية العربية، تمكن من أن يكون واحداً من جيل المؤسسين لهذا الفن، الذي بقي إلى اليوم، مثار تساؤل، حول دوره وأهميته، وجدوى الإنفاق عليه عربياً، فيما أصبح جزءاً عضوياً رئيسياً من عملية طباعة الكتاب ونشره وتسويقه في العالم.
المعرض الاستعادي لأغلفة الكتب التي صممها حلمي التوني، الذي أُقيم مؤخراً ليصاحب «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»، فتح شهية الزائر، على معرفة أعمق، بفن تصميم الأغلفة العربية، ومسار التوني الفني بشكل خاص.
حلمي التوني فنان متعدد، رسم اللوحات الزيتية والأعمال الكاريكاتورية، وكذلك صمَّم أفيشات أشهَر الأفلام المصرية، والإعلانات، وصفحات المجلات والصحف وأغلفة الكتب، وشكلّ جزءاً من نهضة فنية في عالم الجمال الطباعي، الذي كان يبحث عن هوية وطنية وخصوصية.

ألف كتاب وأكثر
وتسمية المعرض في بيروت بعنوان «التوني... ألف كتاب وكتاب» جاء في الصميم. لكنَّ الزائر لم يكتشف أكثر من 300 تصميم، بسبب ضيق المكان، أعطت فكرة سريعة عن مسار الفنان، وبقي المتفرج على عطش، لأن التصاميم لم ترافقها شروحات أو إيضاحات تصل الزائر بتاريخ الغلاف، ورحلة رواده، ومكانة التوني تحديداً في هذا المسار الشيق.
عكف التوني في البدء على تصميم مجلّة «الكواكب» المصرية، ثم تسلم الإدارة الفنيّة في «دار الهلال». وهو من وضع أجمل أغلفة نجيب محفوظ، ووضع لمساته الخاصة على صورة نسائه التي رسمها بشكل لا ينسى. كما صمم غالبية أغلفة روايات إحسان عبد القدوس التي التصقت بالذاكرة. فعمله مع «دار الشرق» للنشر جعله على تماسّ مع نصوص كبار الكتّاب، ووضع أغلفة لأنيس منصور، وعبد الوهاب البياتي، وإبراهيم عبد المجيد، ورضوى عاشور، وآخرين.
والتوني هو مَن وضع حلّة كتب محمود درويش التي صدرت عن «مؤسسة الدراسات العربية» يوم كان ركناً منها، وزيَّنها بالخط الجميل الطاغي على كل ما عداه في الغلاف، وهو أيضاً مسهم أساسي في صنع هوية كتب «دار العودة» و«دار ابن رشد».
حصل حلمي التوني على بكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، تخصص يومها في الديكور المسرحي، وتخرج عام 1958. في استعادةٍ لرحلته الفنية، يعد الرجل أن تكوينه الأكاديمي طوال تلك الفترة كان غربياً، والتحول الحقيقي في مساره، جاء بعد إقامته البيروتية التي استمرت ثلاثة أعوام، وانتهت مع بدء الحرب الأهلية عام 1975، إذ شعر بأن استمرار إقامته خلالها أصبح عسيراً.
تجربة بيروت
حين كان حلمي التوني في القاهرة مديراً فنياً في «دار الهلال»، أصدر الرئيس أنور السادات قراراً بطرد أكثر من 100 صحافي لمطالبتهم بإنهاء حال المراوحة مع إسرائيل التي تأرجحت بين السلم والحرب. هكذا طرد التوني من عمله بتهمة الشيوعية، مع أنه لم يكن كذلك، ووجد نفسه بلا عمل لشهرين، قبل أن يقرر التوجه إلى بيروت. حينها لم تقبل حتى صالات العرض أن تستقبل لوحاته في القاهرة، ولم يعد أمامه سوى المغادرة. وكانت العاصمة اللبنانية في حالة غليان ثقافي.
يقول التوني إنها كانت فترة خصب كبرى، بسبب الانفتاح على الغرب، وتطور الطباعة، والتحاقه بـ«المؤسسة العربية للدراسات والنشر» مما أضاف له الكثير. من أوائل ما صمَّمه عند وصوله إلى العاصمة اللبنانية، كان شعار «معرض بيروت للكتاب» الذي لا يزال صامداً إلى اليوم، لذلك لا غرابة في أن يحتفي به هذا المعرض ويعرض أعماله، ويخصص له ندوة خاصة، لم يتمكن من حضورها، وعُرضت مقابلة معه سُجلت خصيصاً لهذه الغاية، قال فيها: «استفدتُ من انفتاح لبنان على الغرب وكانت الطباعة متقدّمة، والإمكانات متوافرة، التحقتُ بالمؤسسة العربية بسبب علاقتها بالناشر عبد الوهاب الكيالي، وبالمقاومة الفلسطينية التي كانت قد انتقلت أيضاً إلى بيروت». ولا بد من التذكير بأن التوني كانت له لمساته المهمة على صفحات جريدة «السفير»، سواء في تقسيم موادها، أو في ملاحقها، وما لا يمكن أن ينسى هو شعارها الذي صممه لها وبقيت تحمله وتُعرف به حتى توقفت عن الصدور. فهو الذي قال: «أنا أعمل في حقلين... حقل اللوحة وحقل غلاف الكتاب، وأظن أننا في واقعنا الثقافي، الفني، محتاجون إلى هذه المدارس المتنقلة... مدرسة اللوحة وغلاف الكتاب».
العودة إلى القاهرة
مع عودته إلى القاهرة، وقد اجتاحت بيروت الحربُ، كان التوني لا يزال تحت تأثير تكوينه الأول. فهو تتلمذ على أعمال فناني عصر النهضة، ومثله الأعلى ليوناردو دي فنشي وأعمال بيكاسو. لكنه بدءاً من الثمانينات سيطرح على نفسه أسئلة: «هل أنا قبطي، أم يوناني روماني؟ قلت طيب مصر هي خلاصة كل هذا. الفنان الشعبي، قام بكل هذا بمزاجه بلا تخطيط. أصبحتُ تلميذ الفنان الشعبي، الذي رسم على الزجاج والجدران ورسم الوشم على الجلود». خطر له يومها لماذا يفترض أن يسير خلف ثقافة، ويبقى درجة عاشرة بالنسبة لها؟! من هنا بدأ التوني بحثه الذي لم يتوقف في الفن الشعبي، يدرسه ويتعمق برموزه، متأملاً في بيئته، والمكونات الثقافية لمصر، ناهلاً من الأغنية والمحفورات والآثار، وكل ما تقع عليه حواسه.
لكن ربما أن حلمي التوني يظلم نفسه بهذه الأحكام، فحتى أعماله الأولى لم تكن استشراقية، ولا غريبة عن بيئتها، لكن هذا المنحى الوطني، أخذ يتعمق بمرور الوقت، وهو ما يبرز جلياً في التصاميم واللوحات.
يصف نفسه بأنه رسّام غنائي: «أنا مواطن أغنّي لبلدي وأرسمها... أحب الرومانسية وأريد أن أُفرح الناس». لا بل إن أغلفته ولوحاته هي انعكاس لأغنيات سمعها. «أنا بتاع الحب والوطنية، مش ندّابة». لهذا لا يمكن للناظر إلى مختلف أعمال التوني إلا أن يرى البهجة في اللون، والبشاشة في الوجوه، والحيوية في اللوحة أو الغلاف.
عاشق للمرأة وقضاياها وحريتها، لا بل يعد نفسه نصير كل مظلوم وأقلية ومستضعَف. لهذا رسم الفلاحة المصرية دون كللٍ بنت البلد بملامحها الودودة. «كلهن على اختلاف وجوههن هنّ بهيّة»، يقول عن نسائه. ثمة رموز تتكرر في لوحاته، ولا بد أن تعثر على أحدها في كل مرة، كأنها توقيعه الخاص. السمكة التي تجدها تارةً على الرأس أو على اليد، وربما إلى جانب المرأة، وهي رمز الخصب والإنجاب. تجدها على غلاف كتاب نوال السعداوي «الأنثى هي الأصل» في طبعته الأولى التي مُنعت في مصر. هذه المرأة التي تستعدّ للطيران، سيرسمها الفنان عشرات المرات بعد ذلك، في سياقات مختلفة.
كذلك تجد في أعماله الأسد كنايةً عن الشجاعة والقوة، أضف إليها الأواني المنزلية، والعقد حول أعناق النساء، والطفل الذي يحمل الشمعة، لكنك قليلاً ما ستعثر على رجل، فهو لا يحب رسم الرجال، ويفضل بدلاً منه الحصان، كما وضعه جامحاً، على غلاف كتاب «دار الشروق» المعنون «أجمل الحكايات الشعبية». ولا بد أن يلفتك في كثير من أعماله القمر. أما الميزة التي يعدها أساسية، التي تضاف إلى الغنائية والفرح، فهو «أن شخصياتي تنظر دائماً في عين المتفرج» هذا يمنحها القوة والنبض، ويعطي المتلقي إحساساً بأنها رُسمت من أجله هو.
وتحية لتلك الفترة التأسيسية في تصميم الغلاف العربي، التي كانت قبلها أغلفة الكتب مجرد كرتون ملون عليه بعض الزخرف، أرشف الباحث المصري محمود الحسيني آلاف الأغلفة التي صُمِّمت منذ أربعينات القرن الماضي، واستطاع جمعها على منصة إلكترونية، ليعود إليها كل مهتم. لكن لا تزال مسألة تطور الأغلفة، ومساهمة كل من روادها منقوصة، ولم تجد العناية الكافية من البحاثة.
وربما أن العودة إلى واحد من هؤلاء المؤسسين يعطي فكرة، ويشكل إضاءة على هذا التاريخ الفني الذي سعى رواده إلى إبراز الهوية العربية الخاصة بعناصرها ورموزها، وفرادتها.