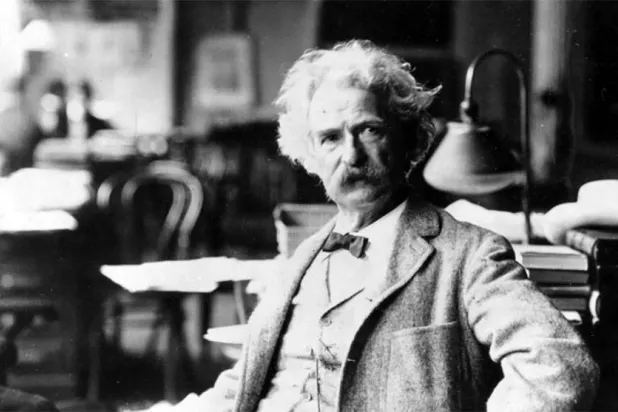لطالما كانت العلاقة بين الحب والزمن مثار اهتمام الكثير من الفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع، وصولاً إلى الكتاب والفنانين الذين رأوا إلى هذه المغامرة من موقع الاختبار الشخصي لا من موقع التنظير المجرد. ولم تكن الأسئلة المطروحة حول تلك العلاقة مقتصرة على ديمومة الحب، والمساحة الزمنية الافتراضية لاشتعاله أو تحلله، أو عند الأعمار الأكثر ملاءمة للوقوع في أتونه، بل توقف الدارسون ملياً عند الإشكالية المتعلقة بفارق العمر بين العاشق والمعشوق، وما إذا كان بوسع الحب أن يردم الفجوة الزمنية الواسعة التي تفصل بين الطرفين.
قد يكون الفيلسوف الروسي فاسيلي روزانوف أحد أكثر الباحثين تفاؤلاً في ما يخص قدرة الحب على هزيمة الزمن، وصهر المتحابين داخل بوتقته الرائعة. فالحب وفق روزانوف تقتله التشابهات وتحييه الفوارق. وإذا كانت قوة الحب كامنة في تباعد طرفيه، بحيث أن تأنث الرجل لا يثير بأي وجه إعجاب المرأة، والعكس صحيح أيضاً، فما الذي يمنعنا أن نتصور الأمر نفسه بالنسبة لأعمار المحبين التي تزداد جاذبيتها كلما تباعدت بينها فجوات الزمن. ويعتقد روزانوف أن الحب الحقيقي هو ذلك الذي يتفتح خارج كل قيد، «ففيما نكبر نحن البشر ونقترب من اللحد، يكاد حب غريب لم نعهده من قبل أن يتملكنا نحوه»، كما أن حالات الحب على عتبة القبر، هي بالذات دليل سيادة الحياة على الموت، أو كسرٍ لنداء الموت الذي يمض الكائن ويضنيه، بما يمكّن العاشق العجوز من أن يصرخ «أيها الموت، أين إبرتك السامة؟».

لكن جمالية الاختلاف عند روزانوف لا تسير على خط واحد بل على خطين اثنين، بحيث أن المهد يتوق إلى اللحد بالطريقة ذاتها، «حيث تخترق نجمة الموت ونجمة الولادة، المسافة الفلكية التي تفصلهما، وتندفع كل منهما بشوق بالغ لملاقاة الأخرى». ومع أن الهناءة التي يعيشها العاشق العجوز ذو الوجه المتغضن، والمتأتية عن اتحاده بصورة الجمال الأسمى التي تمثلها حبيبته الشابة، ستكون محل استنكار وسخرية وازدراء من قبل محيطه الاجتماعي، إلا أنه لن يأبه بكل ذلك، معلناً من خلال عشقه المستهجّن انتصاره الأبدي للغد على الأمس وللمستقبل على الماضي.
وكغيره من الشعراء والمبدعين، لم يكن محمود درويش بمنأى عن الشعور المأساوي بتسرب الزمن من بين أصابعه، وهو الذي لم تصرفه التراجيديا الفلسطينية وصقيع المنافي عن التشبث بأهداب العيش، وتصيّد ما أمكنه من طرائد الفرح والمتعة والجمال الكوني. إلا أن تقدم الشاعر في السن ورزوحه تحت وطأة المرض انعكسا في أعماله الأخيرة على شكل رثاء للذات المكتهلة، وشعور ممض باتساع الفجوة بينه وبين الحياة التي تمور، أبعد من ذراعيه، بكل أنواع المباهج والثمار. وهو ما يظهر بشكل واضح في قصيدته «ليتني كنت أصغر» التي تأخذ شكل حوار موارب بينه هو الكهل، وبين الفتاة اليانعة التي رأت فيه فارسها المتخيل، محاولة بذكاء ماكر أن تضيق الفجوة الزمنية الواسعة التي تبعد أحدهما عن الآخر:
قال لها: ليتني كنتُ أصغرَ،
قالت له: سوف أكبر ليلاً
كرائحة الياسمينة في الصيف،
ثم أضافت: وأنت ستصغر حين تنام
فكلّ النيام صغارٌ،
وأما أنا فسأسهر حتى الصباح
ليسودّ ما تحت عينيّ..
خذني لأكبرَ، خذني لتصغرْ

وإذا كان الروائيون من جهتهم قد توقفوا ملياً عند موضوع التقدم في السن وعلاقة الحب بالزمن تراجيديا، فإن «الجميلات النائمات» لكاواباتا، هي إحدى أكثر الأعمال الروائية تعبيراً عن فوات الأوان ومأساة التقدم في السن. صحيح أن النساء اليافعات اللواتي يتم تخديرهن في النزل الياباني، يتيح للرجال العجائز فرصة الاستمتاع بالجمال النائم، وتذكّر حيواتهم المنقضية وماضيهم العاطفي الغابر، ولكن وضع الأجساد العارية للفتيات الفاتنات، في مواجهة مباشرة مع العيون الجاحظة للعجائز الممنوعين من لمسهن، يعطي للمفارقة بُعدها المؤلم ويوصل التراجيديا الإنسانية إلى ذروتها.
أما غابرييل غارسيا ماركيز الذي رأى في رواية كاواباتا واحدة من الذرى السردية الإبداعية التي تمنى لو كانت من تأليفه، فهو حين كتب روايته اللاحقة «ذاكرة غانياتي الحزينات»، ناسجاً على منوال كاتبه الأثير لم يستطع تحمل القسوة البالغة للرواية التي افتتن بها، فعمد إلى جعل العلاقة بين بطله التسعيني والفتاة المراهقة التي تصغره بسبعة عقود ونصف العقد، أمراً قابلاً للتحقق وممكن الحدوث. ولعل نزوع ماركيز التفاؤلي وإيمانه المفرط بقوة الحب، هما اللذان دفعاه إلى أن يجعل من روايته تلك نشيداً للتفاؤل ووصفة شافية للتعلق بأهداب الأمل، حتى بالنسبة للمسنين الذين يقفون مرتعدين في مربع حياتهم الأخير. كما بدت «لوليتا» رائعة فلاديمير نابوكوف الروائية تجسيداً حافلاً بالمفارقات للعلاقة الشائكة التي ربطت بين همبرت أستاذ الأدب المهجوس بحب الفتيات الصغيرات، وبين ابنة زوجته دولوريس، التي لم تتجاوز الثانية عشرة من العمر. صحيح أن زوج الأم لم يكن عجوزاً بما فيه الكفاية، ولكنه وهو في منتصف العمر رأى في دولوريس، متجاوزاً إثم سفاح المحارم، فرصته الثمينة لاسترداد شبابه المنصرم وأهليته المتراجعة للإغواء، فيما كانت الفتاة التي أدركت البلوغ باكراً ترى فيه فرصتها المناسبة للعثور على كنف أبوي، كما لتحقيق هويتها الأنثوية. إلا أن المغامرة العاطفية المثخنة بحمّى الشهوات ما لبثت أن أخذت طريقها إلى الخمود، حيث أنهت الفتاة العلاقة «المحرمة»، إثر تعلقها بشخص آخر يناسبها سناً وحيويةً، فيما هبط همبرت حزيناً ومنكسراً، من السماء الباذخة للأحلام إلى أرض الواقع المتواضعة.
ولم تكن الحياة الواقعية للمبدعين لتختلف اختلافاً بيّناً عما أظهروه في أعمالهم الأدبية والفنية من هواجس وإشكاليات. وهو أمر ليس بالمستغرب، ما دام كلٌّ من الأدب والحياة يقلد الآخر ويعكسه على طريقته. اللافت هنا أن المبدعين العشاق لم يكتفوا باعتماد الأدب والفن وسيلةً ناجعةً لتحقيق حلمهم بالخلود، بل رأوا في امتلاك الجسد الغض، ما يصلهم بحيواتهم المنصرمة، وبماهيهم مع «صورة الفنان في شبابه»، على حد تعبير جيمس جويس.
هناك عشرات الشواهد على شغف الكتاب والفنانين المسنين بالشركاء الأصغر سناً مستفيدين من عقد النقص العاطفية التي يتركها غياب الأب أو الأم في نفوس الشركاء
ويكفي أن نعود قليلاً إلى سيَر الكتاب والفنانين، لكي نعثر على عشرات الشواهد التي تقودنا إلى شغف المسنين منهم بالشركاء الأصغر سناً، مستفيدين من عقد النقص العاطفية التي يتركها غياب الأب أو الأم في نفوس هؤلاء الشركاء، ومن البريق الذي تشيعه العبقرية في نفوسهم الباحثة عن مثال أعلى. فالكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هيغو الذي عرف عنه ولعه بالنساء الذكيات والمثيرات، لم يجد حرجاً في إغواء ابنة الكاتب تيوفيل غوتييه التي لم تتجاوز الثانية والعشرين من العمر والدخول معها في مغامرة عاطفية لم تعمر طويلاً. وحين دخل عليه حفيده بشكل مفاجئ وهو يعانق في الثمانين غاسلة ثيابه الشابة، خاطب الفتى المذهول بالقول «انظر يا جورج الصغير، هذا ما يدعونه العبقرية».
ورغم أن ما أنجزه غوته من أعمال ومؤلفات كان كافياً لوضعه في أعلى درجات الشهرة والمجد، فقد بدا لقاؤه، وهو في الثالثة والسبعين، بالمراهقة الحسناء أولريكه فون ليفتسو، بمثابة زلزال عنيف خلخل بالكامل ركائز حياته الجسدية والروحية. ومع أن ابنة الثمانية عشر عاماً بادلت شاعر ألمانيا الأكبر المشاعر نفسها في بداية الأمر، إلا أنها ما لبثت أن تخلت عن عاشقها العجوز، لتدخل في مغامرة عاصفة مع دون جوان أوروبا الشاب جوان دو رور.

ولم يقتصر الافتتان بالجسد الفتي على الرجال وحدهم، بل قدم لنا التاريخ شواهد كثيرة تدل بالمقابل على وقوع المبدعات المسنات، في شرك هذا الافتتان. فبعد أن خاضت الكاتبة البريطانية جورج ساند علاقات متعددة مع رجال مختلفي المشارب، بينهم الشاعر الرومانسي ألفرد دي موسيه والرسام فريدريك شوبان، دخلت وهي في الستين من عمرها، في علاقة مشبوبة مع الرسام شارل مارشال الذي كانت تدعوه «طفلي البدين»، والذي كان في أواخر ثلاثيناته. كما ارتبطت الممثلة الأميركية سارة برنار مع الشاب الهولندي ليو تيليغين، الذي كان يصغرها بخمسة وثلاثين عاماً. ومع ذلك فقد عدَّ بعد أربع سنوات من العلاقة، بأن الفترة التي قضاها إلى جانب برنار كانت الأروع والأعظم في حياته.
وأياً تكن قدرة الحب على ردم الهوة الزمنية الفاصلة بين العاشقين، فإن ثمة طرفاً يحاول ما أمكنه، الخروج من جلده المتغضن ليقتات من نضارة الآخر ويناعته ودمه الطازج، فيما يقدم الآخر نفسه كأضحية خالصة على مذبح التعلق بصورة الأب البديل أو الأم المعشوقة. وهو ما يعكسه قول الشاعر الفرنسي بول إيلوار مخاطباً الفتاة الشابة التي أحبها في كهولته بالقول «لقد وقفتِ حائلاً بيني وبين الموت، ولكنني بالمقابل وقفت بينك وبين الحياة».