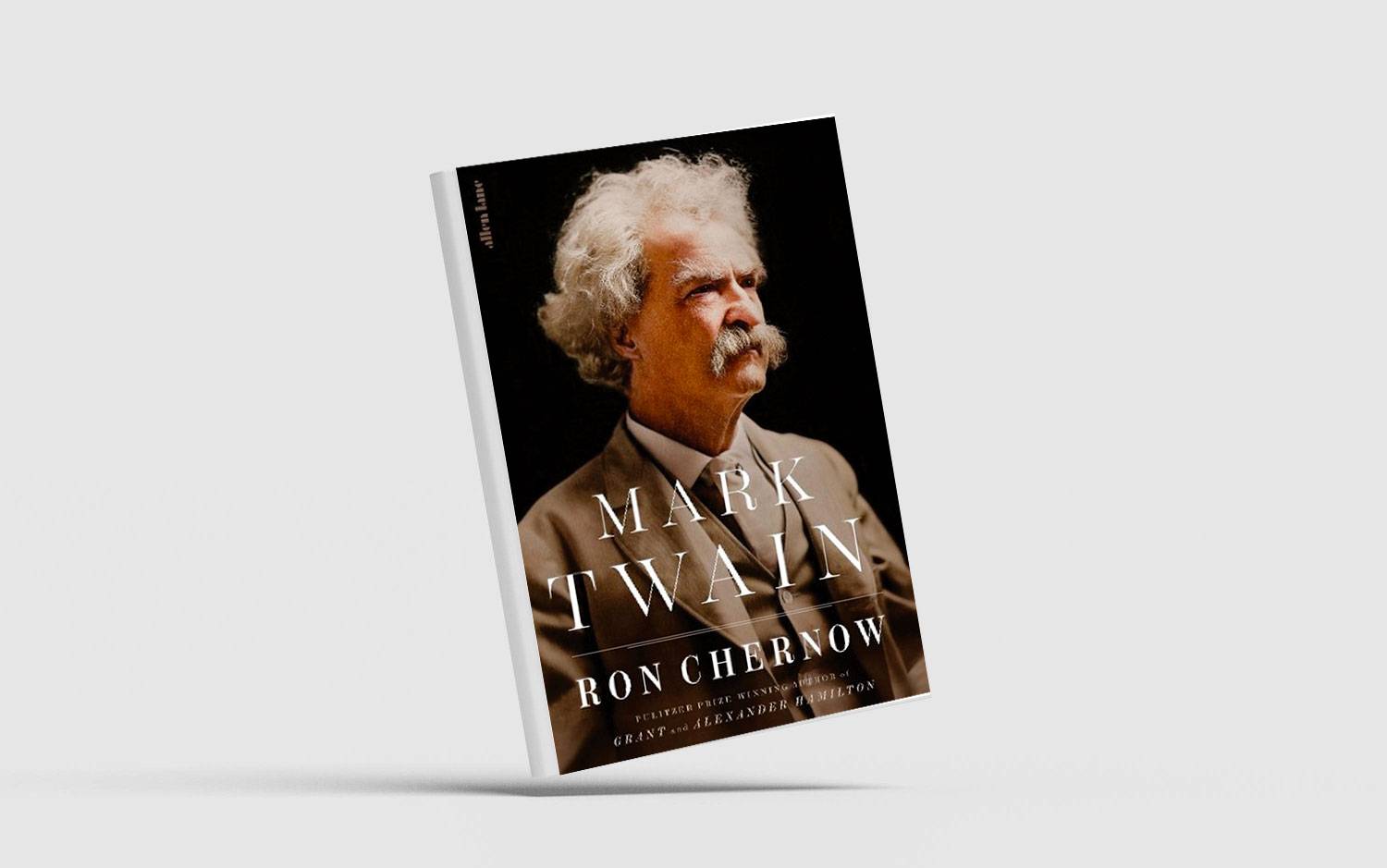من الصعب تخيل الأميركيين، بجبروت بلادهم وظلها المهيمن على العالم اليوم، رازحين تحت احتلال شرس ناضلوا للتخلص منه. لكن التاريخ الأميركي محتشد بحكايات النضال والمعارك وأشكال المقاومة. في أواسط القرن الثامن عشر كان ما يعرف الآن بالولايات المتحدة الأميركية مجموعة مستوطنات تحت سيطرة التاج البريطاني. كانت منتجات الأرض التي كانوا قد احتلوها بوصفهم مهاجرين من بريطانيا ودول أوروبية أخرى تذهب إلى الخزينة البريطانية، والذين ذهبوا ليحتلوا أراضي السكان الأصليين في القارة الأميركية المكتشفة، ويمارسوا ضدهم كل أنواع الطرد والاستيلاء الوحشيين لم يلبثوا أن صاروا مناضلين ضد البلاد التي هاجروا منها وهم يرون تلك البلاد تستغل بلادهم وتذلّهم. صار المحتلون محتلين. أو هكذا رأوا أنفسهم بعدما تنامت لديهم الرغبة في الاستقلال عن بريطانيا التي لم تجد بداً من قمع تلك الرغبة. وفي عام 1775 بدأت الثورة الأميركية ضد التاج البريطاني، وبعد ذلك بعام واحد أعلن استقلال المستوطنات بقيادة جورج واشنطن، لكن الإعلان لم يعن الانتصار وإنما بدء المقاومة التي تضمنت معارك نصر ومعارك هزيمة. إحدى الهزائم كانت ما لقيه واشنطن وجنوده في نيويورك في أواخر عام 1776، لكن في تلك اللحظة جاء من يبعث الأمل، ويشحن النفوس بالعزيمة لتنقلب المعادلة تدريجياً.
في ديسمبر 1776 بدأ إنجليزي هاجر إلى أميركا للتو اسمه توماس (توم) بين Paine سلسلة من المقالات في مجلة «بنسلفانيا» تحت عنوان «الأزمة الأميركية» بدأ أولها بالعبارة الشهيرة: «هذه هي الأوقات التي تختبر فيها الأرواح» والتي ألهب فيها حس المقاومة، وهاجم المتكاسلين أو القاعدين، من سماهم «جنود الصيف ووطنيي الشمس المشرقة». توم بين هو دون شك أحد أبطال الثورة الأميركية والفاعلين في تحقيق انتصار المستوطنين ضد التاج البريطاني. ذلك وهو مثل كثير من الأميركيين، قادة ومواطنين، مواطن بريطاني أصلاً. هاجر إلى ما عرف عندئذٍ بالعالم الجديد عام 1774، وكان على مشارف الأربعين من عمره. هاجر فقيراً معدماً وخارجاً من سلسلة من المحاولات الفاشلة لتحقيق النجاح في حياته العلمية والعملية، ولكن لم تمض سنتان حتى كان يتألق في أرض المستوطنات التي بناها من سبقه من المهاجرين، المهاجرين المحتلين لأرض غيرهم والذين أرادوا بعد قرن ونيف من بدء هجراتهم أن يستقلوا عن البلاد التي جاء منها أكثرهم.
توم بين هو الذي عُرف فيما بعد بمؤلف كتابين شهيرين هما «المنطق السليم (Common Sense)» (يناير 1776) و«حقوق الإنسان» (1791-1792)، ليتلو هذين كتابٌ ثالث ربما يكون أقل شهرة وإن كان قد تسبب في انحدار سمعته وتردي حياته وسيرته، كان ذلك كتاب «عصر العقل» ((1794 - 1796). كان السبب في ذلك المآل المظلم هو هجوم توم بين على الأديان بوصفها لا عقلانية، وسبباً في الشرور والمآسي التي ابتلي بها الإنسان. كان توم بين قد اعتنق المذهب الربوبي «دايزم (Deism)» الذي ينكر الوحي الإلهي، ويؤكد أهمية العقل البشري بوصفه الهادي إلى وجود الله بدلاً من الوحي. ذلك المذهب الذي تطور في عصر النهضة تحول إلى إلحاد ينكر وجود الإله، وصار علامة كبرى على التنوير الأوروبي خصوصاً في فرنسا.
أدى إعلان توم بين عن رؤيته الربوبية إلى رفض عام له ولأفكاره في البلاد التي شارك في النضال من أجل استقلالها، لكنه قبل نشر الكتاب كان قد واصل ذلك النضال بالرحيل إلى فرنسا بحثاً عن الدعم المالي للثوار الأميركيين. وصل فرنسا في أثناء تصاعد الهياج الاجتماعي والسياسي الذي وصل ذروته في الثورة الفرنسية عام 1789، فانتقل الإنجليزي «بين» من ثورة إلى أخرى، ومن نزعة استقلال إلى أخرى، وهو بين هذه وتلك مرحَّب به ومتوَّج بالإجلال. وكان من مظاهر إجلال الفرنسيين له أن عينوه عضواً في المجلس الوطني الفرنسي. ولكن بين لم يلبث أن «خربط» الدنيا باحتجاجه على إعدام الثوار الفرنسيين الملك لويس السادس عشر وأسرته، فخرج من فرنسا إلى بلاده بريطانيا ليُتهم هناك بإثارة الفتنة، ويعود مرة أخرى إلى أميركا.
قصة توم بين هي قصة الثورة الأميركية، قصة الاستقلال ضد محتل، وهي متداخلة وعجيبة كما هو واضح: إنجليزي يذهب إلى بلاد غير بلاده ليشارك في الثورة ضد بلاده، ثم يذهب ليشارك بلاداً أخرى ثورتها ضد نظامها ليطرد من هناك ومن بلاده، ثم يعود من حيث أتى ليواجه رفضاً لأفكاره وينكسر في أواخر حياته، ويموت معدماً كما بدأ، ويُدفن دون حتى أن يُعرف قبره.
لكن ما يسترعي الانتباه بذات القوة هي القدرة التي استطاع بها ذلك الإنجليزي الهارب من بلاده أن يلهب بها حماسة الثوار الأميركيين ويشاركهم النضال. لقد وجد أناساً مهزومين ومستضعفين فألهب حماسهم ضد حكومته نفسها، وحين شكره الأميركيون بتخصيص مرتب سنوي مجزٍ له واصل كتابة سلسلة مقالاته تحت عنوان «الأزمة الأميركية» ليواصل الدعم المعنوي، وإلهاب الحماسة.
غير أن الأمور أتت فيما بعد بما لم يتوقعه توم بين حين انتصر الأميركيون، وأداروا ظهورهم لأفكاره التي لم تعد تلقى قبولاً، أفكاره المتعارضة مع الثقافة الأميركية العامة ذات الجذور الدينية العميقة؛ فالمستوطنات التي نشأت على ساحل المتوسط في ماساتشوستس وما حولها من ولايات إنما نشأت على أسس دينية متشددة لا نزال نرى أثرها إلى اليوم في الشعبية الجارفة للوعاظ الذين يلقون خطبهم في ملاعب كرة القدم الضخمة والممتلئة بالحضور، كما في من يُعرفون بالصهاينة المسيحيين. الأميركيون الأوائل، المستوطنون والثوار، كانوا أبعد من أن يتخيلوا ما آلت إليه بلادهم من قوة وجبروت، ومن تطور في مختلف المجالات، فقد كانوا من المستضعفين في الأرض وبحاجة لمن يشد أزرهم معنوياً ومادياً. وقف ذلك الإنجليزي المستضعف هو نفسه معهم ليكتشف من خلالهم مواهبه، وتتحسن أحواله قبل أن تسوء مرة أخرى، ليدعمهم الفرنسيون بقيادة بالجنرال دي لافاييت الذي كان قد استقبل توم بين في باريس في فترة الثورة الفرنسية. جاء دو لافاييت بقوات شدت من أزر المقاومين الأميركيين ضد البريطانيين أعداء فرنسا التقليديين فانقلبت الموازين، وانتصر المقاومون الضعفاء. ومن اللافت أن توم بين في بثه الحماسة بين المقاومين الأميركيين يذكّر بأن الإنجليز سبق أن هُزموا على يد الفرنسيين بقيادة امرأة هي جان دارك في القرن الخامس عشر.
إن تاريخ الثورة الأميركية ثم الاستقلال الذي أدت إليه هو تاريخ مقاومة لمحتل، تاريخ ينساه الأميركيون فيما يبدو وهم يدعمون محتلاً آخر أقام المستوطنات التي أقاموا مثلها من قبل. لكن هل نسوا فعلاً؟ لا أظن وإنما هي المصالح التي توصف عادة بالعليا، وهي مصالح فئات معينة لا مصالح بقية أفراد المجتمع؛ فالعدالة والحرية والاستقلال شعارات رفعها المقاومون الأميركيون، مثلما رفعها أو رفع ما يشبهها الفرنسيون بعد ذلك بقليل، ثم كتبوا بمقتضاها وثيقة استقلالهم، وأقاموا دولتهم، لكنها كانت لتحقيق مصلحة وطنية وقومية، وبمجرد أن انتهت جاءت شعارات أخرى ومصالح أخرى تحوَّل نتيجتها المقاومون المستضعفون في السابق إلى مهيمنين مستقوين على غيرهم، و«تلك الأيام نداولها بين الناس».