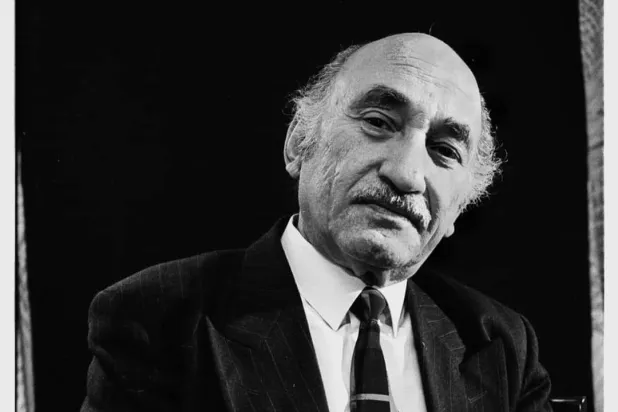قلّ أن عرفت قصة من قصص الحب عند العرب ذلك القدر من الشيوع والانتشار الذي عرفته قصة ليلى بنت المهدي وقيس بن الملوّح. ومع أن القصة المذكورة كانت واحدة من قصص الثنائيات العاشقة التي ارتبطت أسماء أبطالها الذكور بحبيباتهم، كما هو حال عروة عفراء وجميل بثينة وقيس لبنى وكثيّر عزة، إلا أنها استطاعت أن تتعدى كونها جزءاً لا يتجزأ من الأساطير المؤسسة للذاكرة والوجدان عند العرب، لتصل تردداتها لمسامع الأمم الأخرى وتؤثر بشكل واضح في آدابها ومخيلة كتّابها وتصوراتهم عن الشرق.
ومع أن قصة قيس وليلى تتقاطع من حيث وقائعها وتفاصيلها مع القصص المختلفة لشعراء بني عذرة، فإن ما انفردت به عن سواها هو جنون بطلها العاشق واختلاط عقله، ثم التوحد والانفصال عن الواقع وملازمة الوحوش في البراري. وإذا كان شعراء بني عذرة أحيطوا بالكثير من الشكوك من قبل بعض الدارسين، وفي طليعتهم طه حسين؛ حيث ذهب إلى التشكيك في أن يكون قيس بن الملوح شخصاً تاريخياً وُجد وعرفه الناس واستمعوا إليه: «أزعم أن قيس بن الملوح هو شخص من الأشخاص الخياليين الذين تخترعهم الشعوب لتمثيل فكرة خاصة، أو شخص اخترعه نفر من الرواة ليلهو به الناس أو ليُرضوا به حاجة أدبية أو خلقية».
إلا أن شخصية المجنون المولود وفق معظم الروايات عام 645 م لا تعود لتاريخ بعيد ليسهل التشكيك بوجودها. وإذا كان بعض أخباره وأشعاره اختلط بأخبار الآخرين فهذا الاختلاط لا يمس وجوده بالذات، خصوصاً أن من نقلوا أخباره ووقائع حياته كانوا رواة موثوقين ومشهود لهم بسعة الاطلاع، من أمثال إسحاق الموصلي ومصعب الزبيري وأبو عمرو الشيباني والمدائني. في حين أن تداخل نصوصه مع نصوص أترابه من شعراء الحب ليس أمراً محصوراً بالشعر العذري وحده، بل ظاهرة تنسحب على نصوص الكثير من الشعراء الأقدمين، إما بسبب اختلاف أهواء الرواة ونقص مصداقيتهم، أو لتأثر بعض الشعراء بالبعض الآخر لحد السرقة والانتحال.
اللافت أن صاحب «حديث الأربعاء» استند فيما أبداه من شكوك بشأن المجنون لكتب التراث نفسها بخاصة ما ورد في كتاب «الأغاني» من شواهد ومرويات. فالأصفهاني يشير إلى أن غير واحد من بني عذرة ادعى عشقه لليلى، وبينهم قيس بن معاذ ومهدي بن الملوح، فيما يزعم ابن الكلبي أن الشعر المنسوب إلى قيس وضعه فتى من بني أمية كان يهوى ابنة عم له، وكان يكره أن يُظهر للناس ما بينه وبينها فوضع حديث المجنون. كما ينقل عن أحد رجال بني عامر قوله «أوَقد فرغنا من أشعار العقلاء حتى نروي أشعار المجانين؟»، وحيث يظهر هذا النوع من الحب بوصفه هشاشة و«تخنثاً» لا يليقان بقبيلته، يضيف الرجل مستنكراً: «بنو عامر أغلظ أكباداً من ذاك، إنما يكون هذا في اليمانية الضعاف قلوبها والسخيفة عقولها، وأما نزار فلا». وإذ يرى الأصمعي بأن ما أصاب قيساً هو نوع من اللوثة العقلية وليس جنوناً كاملاً، يروي أنه سأل أحدهم عن المجنون فأجابه: «لقد كان فينا جماعة رُموا بالجنون، فعن أيهم تسأل؟ فقلت عن الذي كان يشبب بليلى، فقال كلهم كان يشبب بليلى»، ثم أنشده أبياتاً متفرقة لكل واحد منهم. ويحرص الأصفهاني على نقل الحقيقة من زاويتها الأخرى، فينقل عن أبي ثمامة الجعدي قوله: «لا يُعرف فينا مجنون سوى قيس بن الملوح».
يتناول الكتاب قصة الحب الشهيرة بين قيس بن الملوّح وليلى بنت المهدي، ويفند الشكوك الكثيرة التي أحاطت بها من قبل بعض الدارسين، وفي طليعتهم عميد الأدب العربي طه حسين، حيث ذهب إلى التشكيك في وجوده، وزعم أنه شخص من الأشخاص الخياليين الذين تخترعهم الشعوب لتمثيل فكرة خاصة، وللهو أيضاً.
أما عن نشأة قيس وصباه، فإن المصادر التراثية لا تنقل عنه سوى ما اتصل بعلاقته بليلى، كما لو أن هذه الأخيرة هي التي منحته ولادته الحقيقية، فضلاً عن اسمه وشعره ومعنى وجوده. وتجمع هذه المصادر على أن قيساً بن الملوح وليلى بنت مهدي العامرية، وكنيتها أم مالك، كانا يرعيان في صغرهما مواشي ذويهما، إلى أن تمكن كل منهما من قلب صاحبه. وفي ذلك يقول قيس:
تعلقتُ ليلى وهي غرٌّ صغيرة
ولم يبدُ للأتراب من ثديها حجمُ
صغيرين نرعى البُهم يا ليت أننا
إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهمُ
وحيث لم تشر المصادر إلى علاقة المجنون بنساء سوى ليلى، يروي السراج في «مصارع العشاق» أن قيساً كان يرتبط بعلاقة غرامية مع امرأة من بني الحريش مات زوجها، وأنه كان يبعث بها إلى ليلى لتسهيل لقاءاته بها. وحين علم ذوو ليلى بما يحدث عمدوا لزجر المرأة ونهيها عما تقوم به، ثم شكوا قيساً إلى مروان بن الحكم الذي طلب من عامله إبلاغه بالكف عن رؤية الفتاة، مهدداً بهدر دمه ما لم يمتثل للأمر.
كما تتعدد الروايات حول جنون قيس واختلاط عقله، فيشير بعضها إلى أن ذلك الجنون لم يحدث دفعة واحدة، بل بدا مع حرمانه من رؤية ليلى، ثم تدرج صعوداً مع رفض والدها تزويجها منه بدعوى تشبيبه بها. وقيل إنها حين تقدم لخطبتها كلٌّ من قيس وورد العقيلي أجبرها أهلها على اختيار الأخير، قائلين: «والله لنمثلنّ بك إن لم تختاري ورداً». وتنسب إحدى الروايات إلى أبيه قوله إن ابنه كان أجمل الفتيان وأظرفهم وأرواهم لأشعار العرب، ولكن ما أصابه من أعطاب في جسده وعقله، كان بسبب إعراض ليلى عنه وإقبالها على سواه. وقيل إنه بعد اختلاطه «كان لا يلبس إلا خرقة، ولا يمشي إلا عارياً ويجمع العظام من حوله، حتى إذا ذُكرت ليلى أنشأ يحدّث عنها بكامل عقله». وحين أخذه أبوه إلى مكة لقضاء فريضة الحج، سمع صائحاً في الليل يصيح يا ليلى، فصرخ صرخة كادت تتلف معها نفسه، وأنشد قائلاً:
وداعٍ دعا إذ نحن بالخيفِ من مِنى
فهيّج أحزان الفؤاد وما يدري
دعا باسم ليلى غيرها فكأنما
أطار بليلى طائراً كان في صدري
ثم طلب أبوه إليه أن يتعلق بأستار الكعبة ويدعو الله طالباً شفاءه من بلائه، فلم يكن منه إلا أن هتف بحرقة: «اللهم زدني لليلى حباً وبها كلفاً ولا تُنسني ذكرها أبداً». وحين تفاقم اضطرابه بدأ يهيم في البرية فيأكل من نبات الأرض ويشرب من ينابيعها وطال شعر رأسه حتى ألفته الظباء والوحوش ولم تعد تنفر منه. وذكر هيثم بن عدي أن المجنون التقى صدفة بزوج ليلى، وإذ فاجأه بالسؤال:
بربّك هل ضممت إليك ليلى
قبيل الصبح أو قبّلت فاها
وهل رفّت عليك قرون ليلى
رفيف الأقحوانة في نداها؟
أجابه زوجها بالقول: «اللهم إذ حلّفتني فنعم»، فقبض المجنون بكلتا يديه قبضتين من الجمر وما فارقهما حتى سقط مغشياً عليه، وسقط الجمر مع لحم راحتيه وعض على شفته فقطعها. وقام زوج ليلى مغموماً بفعله متعجباً منه، ومع أن علاقة قيس بفتاته تكاد تخلو من الطابع الجسدي والشهواني، فقد حُكي أنه حين بلغه تعرّض ورد له بالسوء لم يتردد في أن يرسل له أبياتاً فضائحية تكشف عن علاقته الجسدية بزوجته ويقول فيها:
وأشهد عند الله أني رأيتها
وعشرون منها إصبعاً من ورائيا
أليس من البلوى التي لا شَوَى لها
بأن زُوّجت كلباً وما بُذلت ليا
وأغلب الظن أن المجنون قد نظم هذه الأبيات تنفيساً عن شعوره بالغيرة والغضب وإغاظة للزوج الشامت، وقد تكون منحولة من قبل الرواة.
أما فيما يخص أيامه الأخيرة، فرُوي أن المجنون كان يتردد إلى جبل يقال له التوباد؛ حيث كان هو وليلى يرعيان غنم أهلهما، وحين ذهب عقله بات يهيم على وجهه ويذرع القفار الشاسعة بين بلاد الشام وتخوم اليمن، متسائلاً عن موقع التوباد. فلما اهتدى إليه أنشد قائلاً:
وأجهشتُ للتوباد حين رأيته
وكبّر للرحمن حين رآني
وأذرفت دمع العين لما عرفته
ونادى بأعلى صوته فدعاني
فقلت له قد كان حولك جيرة
وعهدي بذاك الصرم منذ زمانِ
فقال مضوا واستودعوني بلادهم
ومن ذا الذي يبقى على الحدثانِ
وقد بلغ نفوره من البشر حد أنه لم يعد يأنس إلى أي منهم باستثناء من يردد على مسامعه اسم ليلى وأشعاره عنها. كما نُمي عنه أنه كان يدخل في بعض حالات الوجد القصوى في نوع من الحلول الصوفي فيظن نفسه ليلى وينادي على قيس. وقد ظل ذووه يجرون خلفه في القفار ويتركون له الطعام ثم يتوارون عن مدى ناظريه حتى وجدوه ميتاً في وادٍ كثير الحجارة: «لم تبق فتاة من بني جعدة وبني الحريش إلا وخرجت حاسرة، فما رؤي من باكين وباكيات على رجل ميت أكثر مما رؤي في ذلك اليوم».