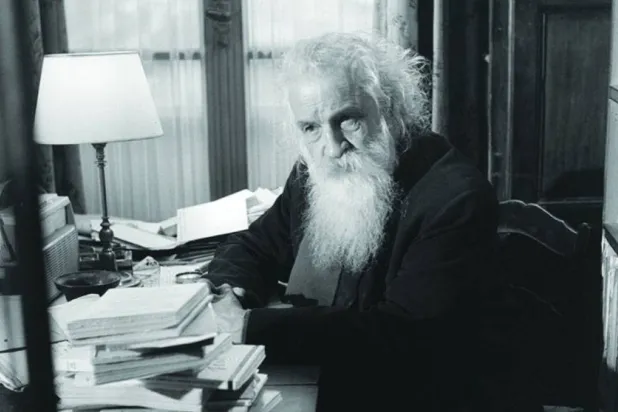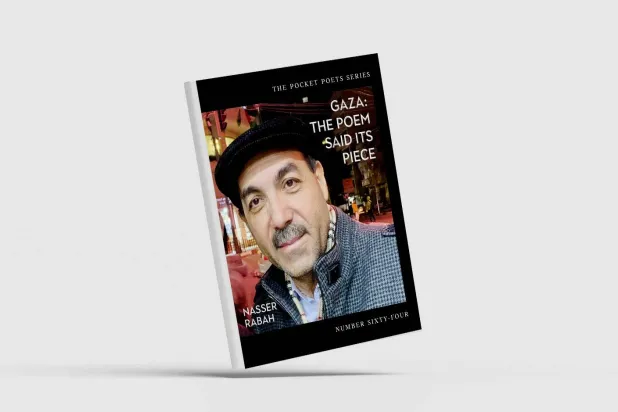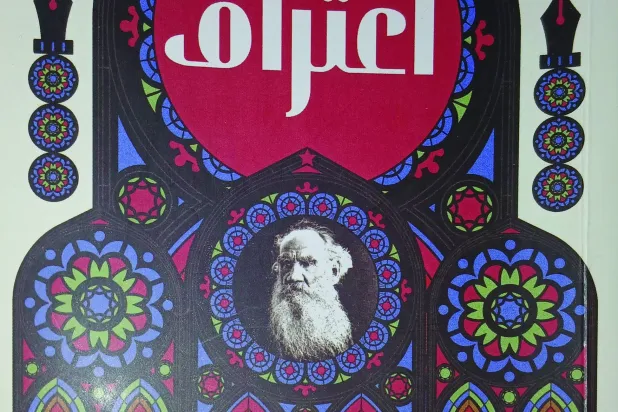يشير الباحث د. أحمد سعد الدين عيطة في كتابه «الإنشاد الديني - دراسة مقارنة بين مصر والمغرب» الصادر أخيراً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى أنه يُقصد بالإنشاد الديني هذا الأسلوب أو تلك الطريقة الخاصة التي تنطوي على أداء صوتي يتناول موضوعات لها سمات روحانية ودينية؛ كالتسابيح والأدعية والمدائح النبوية. ويتخذ الإنشاد من حلقات الذكر أو «الحضرات» سواء كانت خاصة أو عامة فضاءً خاصاً له، كما أنه يرتكز كفن على قوة وجمال صوت المنشد وطبقاته ومعرفته بالمقامات الشرقية واختيار ما يناسب منها للقصيدة. إنه فن يعتمد على الحناجر البشرية مع محدودية تدخل بعض الآلات الموسيقية أحياناً، التي يمكن أن تضيف لمسة جمالية تندمج وتخضع لأصوات المنشدين وقصائدهم لتعطي فرصة للإبداع والوصول بالمنشد والحضور إلى حالة روحانية نقية ذات عمق. ويمكن القول إنه من المتطلبات الأساسية التي يتطلبها هذا الفن قصيدة أو مجموعة قصائد باللغة الفصحى ذات وزن عروضي وإيقاع موسيقي.
ويذكر الباحث أن كتب التراث الإسلامي تشير إلى أن بداية الإنشاد الديني كانت على أيدي مجموعة من الصحابة في عهد الرسول (ص) ثم مجموعة من التابعين. وكانت قصائد حسان بن ثابت «شاعر الرسول» تعدُّ أساساً لكثير من المنشدين، ومن أشهر قصائده في المديح النبوي:
«وأحسن منك لم ترَ قط عني
وأجمل منك لم تلد النساءُ
خُلقت مبرأً من كل عيب
كأنك قد خلقت كما تشاءُ»
وحين جاء القرن العشرون، أصبح للإنشاد الديني والتواشيح أهمية كبرى، حيث تصدى لهذا اللون من الغناء كبار المشايخ والمنشدين الذين كانوا يحيون الليالي الرمضانية والمناسبات الدينية بصوت جميل ندّي يجمع الآلاف من عشاق هذا الفن حوله. وتطورت قوالب هذا الفن فأصبحت له أشكال متعددة وأسماء كثيرة تمجد الدين الحنيف وتدعو لوحدة المسلمين، وتنبذ الرذيلة، وتعلي من شأن الفضيلة، وتمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت. وبرز العديد من المنشدين وتربعوا على عرش هذا الفن، ففي مصر برز الشيخ طه الفشني والشيخ النقشبندي والشيخ علي محمود والشيخ أحمد التوني وحالياً الشيخ ياسين التهامي والشيخ أحمد عبد الفتاح الأطروني والشيخ سعيد حافظ. ومن المغرب برزت أسماء منها الشيخ محمد بجدوب والشيخ محمد بنيس والشيخ عبد الفتاح بنيس، ومن المنشدين المعاصرين الشيخ حكيم فيلالي والشيخ كاميل بنانا والشيخ يوسف كوندري.
ويؤكد المؤلف أن هناك تنوعاً للمعرفة الفنية وتقنياتها لدى المنشدين، الكبار منهم والشباب، فالكثير منهم يستخدمون المصطلحات والتسميات الحرفية المرتبطة بالموسيقى الأكاديمية ويدركون معاني هذه المصطلحات والتسميات، بخاصة التي يتصل منها بصورة مباشرة بعملهم وبأدائهم، وهي المقامات الموسيقية حيث اتسع نطاق استخدام المنشدين لها ولم تعد قاصرة على مقامات بعينها مثل «الراست» و«البياتي» و«السيكا».
وهناك كذلك الكثير من المنشدين ممن لديهم فهم صحيح للسلم الموسيقي وتكوين درجاته.
ومن المقامات الموسيقية التي يفضلها المنشدون المصريون مقارنة بنظيرتها المغربية مقام «البياتي»، الذي يقابله مغربياً مقام «رمل المايا» ومقام «الراست»، الذي يقابله مغربياً «الرصت». أما «العجم» فيقابله «استهلال» و«الحجاز الشرقي» يقابله «الحجاز الكبير»، في حين أن مقامي «الكورد» و«الصبا» ليس لهما مقابل في المقامات المغربية ذات الجذور الأندلسية.
ويوضح الكتاب تنوع أساليب ومدارس الإنشاد الديني في كل من مصر والمغرب بتنوع الأجيال حيث توجد في مدينة «فاس» المغربية على سبيل المثال مدرستان إحداهما تقليدية والأخرى معاصرة. ونجد أن المنشد التقليدي قليل الاستخدام للآلات الموسيقية وله هيبة أثناء الأداء ورصيده من القصائد المحفوظة كبير للغاية، ويتمتع بخبرات تجعله يؤدي ليلة كاملة متواصلة بنفس التميز والقوة في الأداء. أما المنشد المعاصر أو «المودرن» فيتميز بكثرة استخدام الآلات الموسيقية، ولا يمتلك رصيداً كبيراً من القصائد المحفوظة، وهناك شك في قدرته على إحياء ليلة كاملة دون تراجع في مستوى الأداء.
ويلفت المؤلف إلى اختلاف أساليب أداء المنشد باختلاف النطاق الجغرافي، ففي الوجه القبلي بمصر، أي محافظات الصعيد يصبح المنشد هو المتحكم في حالة الذِكر فيجعل الإيقاع الصوتي عالياً تارة، ومنخفضاً تارة أخرى. وغالباً ما يعتمد المنشد الصعيدي على أربع آلات موسيقية فقط هي: الدُّف والطبل والكمان والكولة. أما المنشد في وجه بحري فلا يتحكم في إيقاع الليلة ويترك نفسه منجرفاً وراء «الحالة» العامة التي تشيع في حلقات الذكر أو الحضرة، وغالباً ما يرفض اللجوء إلى الآلات الموسيقية ويعتمد على ما يسمى بـ«التخمير الصوفي» ويُقصد به الانخراط في عملية من الابتهالات، التي تشبه الارتجال، ولا يعتمد فيها المنشد على وزن أو قافية، وقد يردد خلفه بعض الصبية ما يقول فيما يشبه «الكورال».