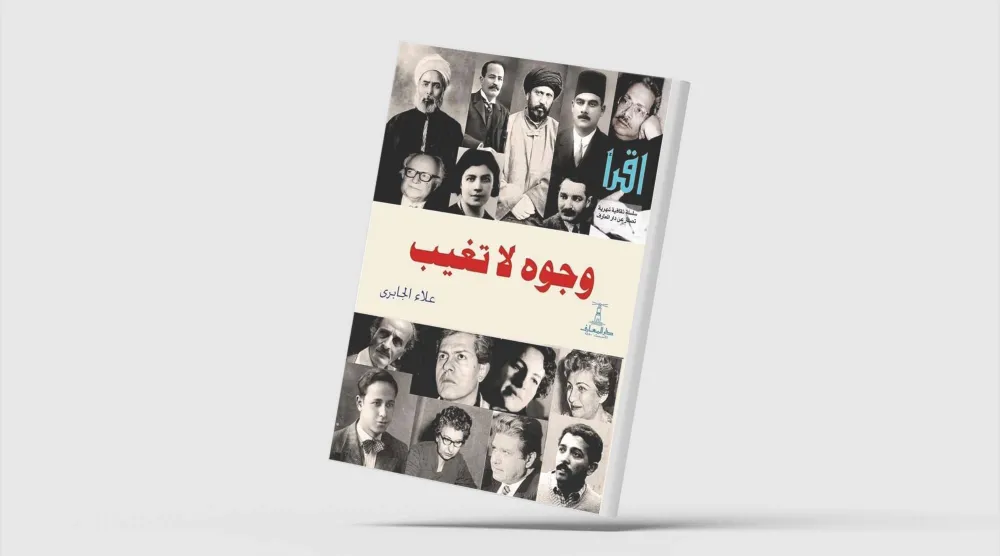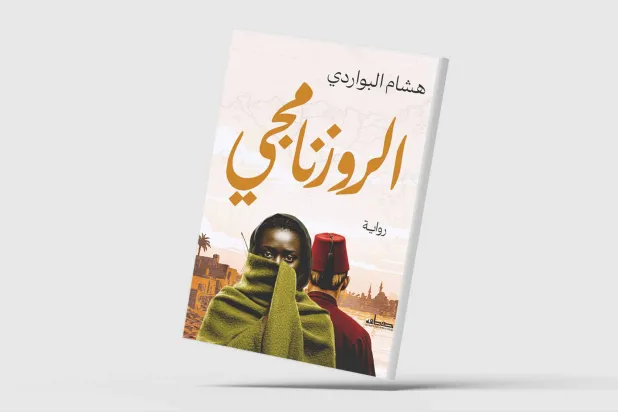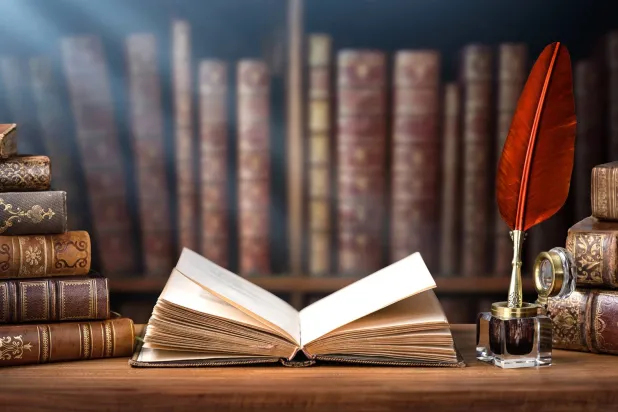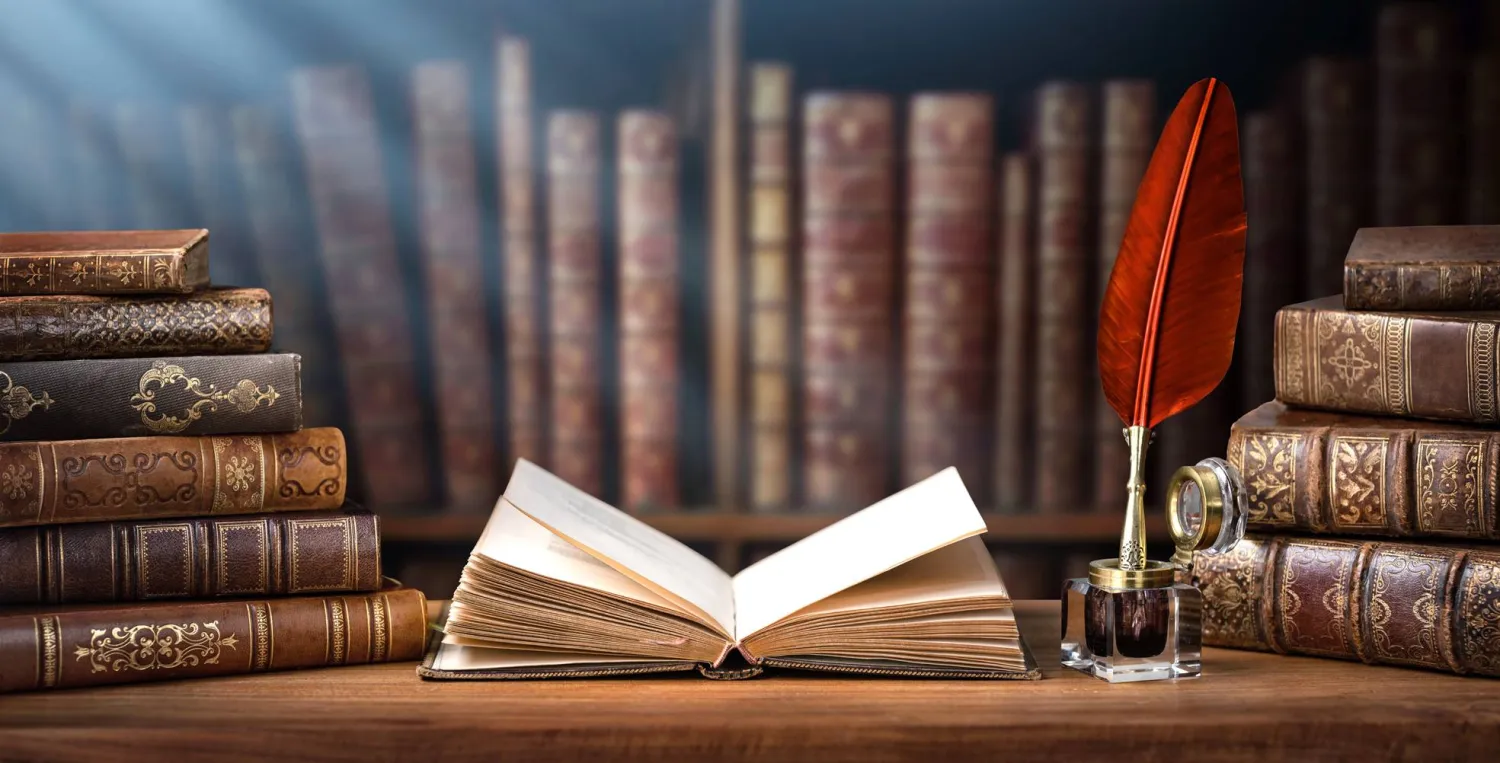لعل من أكثر الظواهر لفتاً للانتباه اليوم بصدد الممارسة النقدية العربية أنها أمسَتْ أسيرة هويتها الضيقة، بحيث صار من النادر أن تجد ناقداً عربياً مهموماً بمتابعة ما يصدر خارج محيطه الوطني، بالغزارة التي كانت قبل 3 عقود على الأقل، إلا في سياق المؤتمرات والندوات ذات الصبغة العربية. ولم يعد بالإمكان الحديث عن نقد متصل بأجناس بذاتها بصيغة التعميم، من مثل «الرواية العربية» و«المسرح العربي» و«التشكيل العربي»، أضحى الاستعمال الصحيح والمقبول هو المتصل بأقطار بعينها، هل هي نهاية مدوَّنة الوعي النقدي الحديث الآتي من الفكر العروبي؟ أم تراجع للعقائد النقدية ذات العمق الإنساني المفتوح؟ ربما هما معاً، لكن الشيء الأكيد أن نظرتنا للأدب والفن محكوم عليها بمسايرة انجرار العالم إلى عقيدة الانعزالية والانغلاق. هكذا ستتكوَّن تدريجياً مواصفات «انعزالية نقدية» اتخذت لها تسميات وتجليات متباينة، ما بين الانغلاق في حدود الجنس التعبيري، أو البلد، أو العقيدة، أو اللغة. لكن هل يحتاج الناقد والباحث في الأساليب الأدبية والفنية لأن يكون أسود ليكتب بصدق وعمق عن الأدب الأفرو - أميركي مثلا؟ أو موسيقى الزنوج في المغرب خلال القرن التاسع عشر؟ أو معتقَلاً سياسياً سابقاً ليكتب عن روايات السجن السياسي؟ أسئلة من المفترض أن الخيال النقدي العالمي قد تجاوزها بعد نشوء حقول معرفية بذاتها تتناول نظائر لتلك الأسئلة في سياقات ثقافية متنوعة، وأثر التخفف من هيمنة النزوع الذاتي المرتبط بالهويات الصغرى، في الدراسات الأدبية المعاصرة.

في دراسة للناقدة المصرية شيرين أبو النجا، عن راهن النقد العربي، استحضرت واقعة تحكيمها لعدد من الأبحاث النقدية، لتقف على ما سمَّته هيمنة «النقد التطبيقي»، المفرغ من الأسئلة الفكرية، وتسرد في هذا السياق الواقعة التالية: «أرسلت لي مؤسسة ثقافية مصرية ثلاثة كتب وأوراقاً أُلقيت في مؤتمر إقليمي بمصر، وطُلِب مني أن أنتقي أفضل هذه الأبحاث... الغريب أن معظم هذه الأبحاث لم تكن سوى قراءات شخصية بحتة، مستندة إلى انطباعات، بحيث يخلص كل بحث إلى استنتاجات تنهل من البلاغة الإنشائية، أكثر من الأفكار والقرائن. عندما أعدت التدقيق في الأمر في محاولة لاكتشاف هوية هؤلاء النقاد أدركت أنهم كُتّاب الأقاليم، الذين يكتب بعضهم عن بعض، ويعرضون أبحاثهم في حضور بعض الضيوف».
يكاد يختصر هذا المقتطف أحد الملامح الأساسية لصورة الناقد العربي الهاوي، أي تقديم نصوص باختزال، والتعريف بمضامينها، خارج أي منظومة إشكالية، يخطط عبرها لاختياراته، ثم إسداء أكبر قدر من الخدمات «النقدية»، في دوائر انتماء متراكبة: المدينة، فالبلد، فالإقليم العربي، وهي دوائر انتماء أُحلت محل الانتساب الحزبي والعقائدي الذي شاع في النصف الثاني من القرن الماضي، بحيث إن الناقد المغربي (أو التونسي أو الجزائري) يكتب عن نصوص الأصدقاء، ثم مَن يقتسم معهم المواطنة، ثم كتّاب شمال أفريقيا، ثم تتدرج بعد ذلك دوائر الاختيار من الأفق العربي الممتد. من هنا يمكن أن نستوعب قصور مفهوم «الحلقية» (ذات الجوهر الفكري والثقافي) في استيعاب السلوك الطاغي على اشتغال الناقد في شتى الأقطار العربية، بحيث يمثل فهماً مبتسراً للظاهرة، إذ يمكن أن نتحدث بالأحرى عن «نزوع انعزالي» بتجليات شتى لتكوين الانحياز، تتمركز في مجملها على عقيدة الانتصار لذوات بذاتها، ثم لممارسات أدبية أو فينة مخصوصة.
ولقد شاءت صدف تاريخية عديدة أن يقترن الاشتغال على أسئلة الفن في العالم العربي بدوائر مُفرنسة أو أنجلوفونية، وهو الاقتران الذي يمكن قراءته في مستويين: الأول ينطلق من افتراض أن الفن الحديث والمعاصر نتاج غربي، ومن ثم فالكتابة عنه يجب أن تصب في المجرى العام للنقاش العالمي حوله، مع اعتماد الإنجليزية أو الفرنسية بما هي امتداد لتقاليد وافدة من مرحلة الاستعمار، حيث كان الفن اختصاصاً أوروبياً. أما المستوى الثاني، فهو المتصل بقناعة المؤسسات المرتبطة بالإبداع الفني، من المعارض إلى الإقامات الفنية وأسواق الفن، القناعة التي ترى أن اللوحة والمنحوتة والمنشأة الفنية منتج موجَّه إلى شريحة خاصة من المتلقين هي الطبقة الثرية والمتوسطة العليا ممن تمتلك القدرة على اقتناء التحف، وتجد نفسها في الفرنسية والإنجليزية، لهذا تُكتب نصوص الكاتالوغات في الغالب بإحدى هاتين اللغتين. وبصرف النظر عن النزعة «الانعزالية» لهذا الاختيار النقدي، فإن ما يبدو جلياً أن هذا الاعتقاد أنتج تمركزاً لغوياً مناهضاً للانفتاح وجد تجلياته في مئات الكتب والدراسات وأعمال الندوات، والمجلات النقدية، والمحاضرات المخصصة للفن المعاصر من المحيط إلى الخليج، وجدير بالذكر في هذا السياق أن أهم مجلة مختصة في الفن المعاصر بالمغرب (وهي «Dyptik Magazine») تعتمد اللغة الفرنسية.
أضحى الاستعمال الصحيح والمقبول هو المتصل بأقطار بعينها... هل هي نهاية مدونة الوعي النقدي الحديث القادم من الفكر العروبي؟
ولعل من أكثر الأسئلة التي يستثيرها هذا الواقع «الانعزالي» جوهرية، ذلك الذي مفاده: هل تقبل الكتابات النقدية اليوم المساواة؟ فالكتابة النقدية بمعنى ما، قبل أن تتصل بالمعارف والمفاهيم، هي قدرة على استعمال الكفاءات الوصفية والتحليلية والجمالية للغة، فبمتابعة بسيطة للخطاب النقدي، في الحقول الإبداعية المختلفة يمكن وضع اليد على حجم التفاوت الحاصل بين الأصوات النقدية، ونوعية الخطابات الوصفية، استناداً إلى قاعدة «اللغة» (أمست الفوارق تتسع يوماً عن يوم بين ما يُكتب بالعربية أو بالفرنسية والإنجليزية). وهو تفاوت بدأت تتضح ملامحه بعد إدراك الخطورة التي باتت تشكلها اللغة النقدية في إشاعة الوعي النقدي أو انحساره؛ إدراك لم يكن سائداً في مرحلة سابقة، حيث شكل المضمون المعرفي، ومطامح «العِلمية» المبالَغ فيها، غايات وحيدة للناقد، ولم يعد لأسباب «التبيين» و«التأثير»، ووسائطهما القائمة على التشغيل الجمالي للغة مكانة في عرف الناقد.
إن إنتاج الأثر النقدي لا يستقيم دون علاقة مثالية مع القارئ؛ فأول ما يقرر مصير النص النقدي هو لغته (عربية كانت أو فرنسية أو إنجليزية)، وبناء على هذا الافتراض يمكن إدراك الشعور الشائع في أوساط الروائيين والرسامين والسينمائيين برفض الموازنة بين النقاد، والمساواة بينهم، أو الحديث عنهم بصفة الجمع؛ شعور يتجلى في صور شتى، لعل أظهرها ذلك الذي يجعل «مراجعات» عديدة، لمعارض فنية، وروايات وأفلام، مِن التي ترتهن إلى «اللغة الخرساء»، لا تُحتسب نقداً، وتُحشَر مجازاً في دائرة «الصمت النقدي»، والحق أنه لا يمكن اختزال الأمر في مجرد حكم معياري، وإنما بإدراك أن مساحة الإبداع النقدي ترفض المساواة؛ ففي تخطيها وأد للقيمة، لهذا يبدو تاريخ النقد الحديث والمعاصر منطوياً على جوهر عقلاني مناهض لتسلط مجتمع الثقافة، في الآن ذاته الذي يبدو فيه مناقضاً لانعزالية الخطابات النقدية بدءاً بهوية اللغة وانتهاء بالظواهر الأدبية والفنية.
لقد صاغ الناقد العربي، عبر مسارات متباعدة صورة المشتغل برهانات متعددة، من السعي إلى التحديث المنهجي، وما يستلزمه من إعادة تمثل المفاهيم والمقولات النظرية، في المشترك النقدي العالمي، إلى التحديث المجتمعي والثقافي والسياسي المتصل بقضايا الانتماء إلى العالم المعاصر، إلى الخوض فيما استحدثته ثورة الاتصال من وسائط حولت صيغ التقويم والتقييم، وإبداء الرأي. بيد أن الاشتغال في كل هذه الواجهات انتقل من حدود الحلقية التي تستند على قاعدة فكرية، إلى انعزالية مناهضة للقيم النقدية التي من شأنها صناعة التراكم، وصونه من التبدُّد. لذا سرعان ما تتلاشى الجهود الفردية، في زحمة الإصدارات المتلاحقة والمنشورات التي لم تعد تعرف حدوداً في الشبكة، ويسهل تدريجياً إصدار أحكام: «غياب النقد» و«أزمة النقد» و«موت الناقد» وما في منوالها من مفردات تنهل من ذهنية الإنكار أو الإحباط على حد سواء.