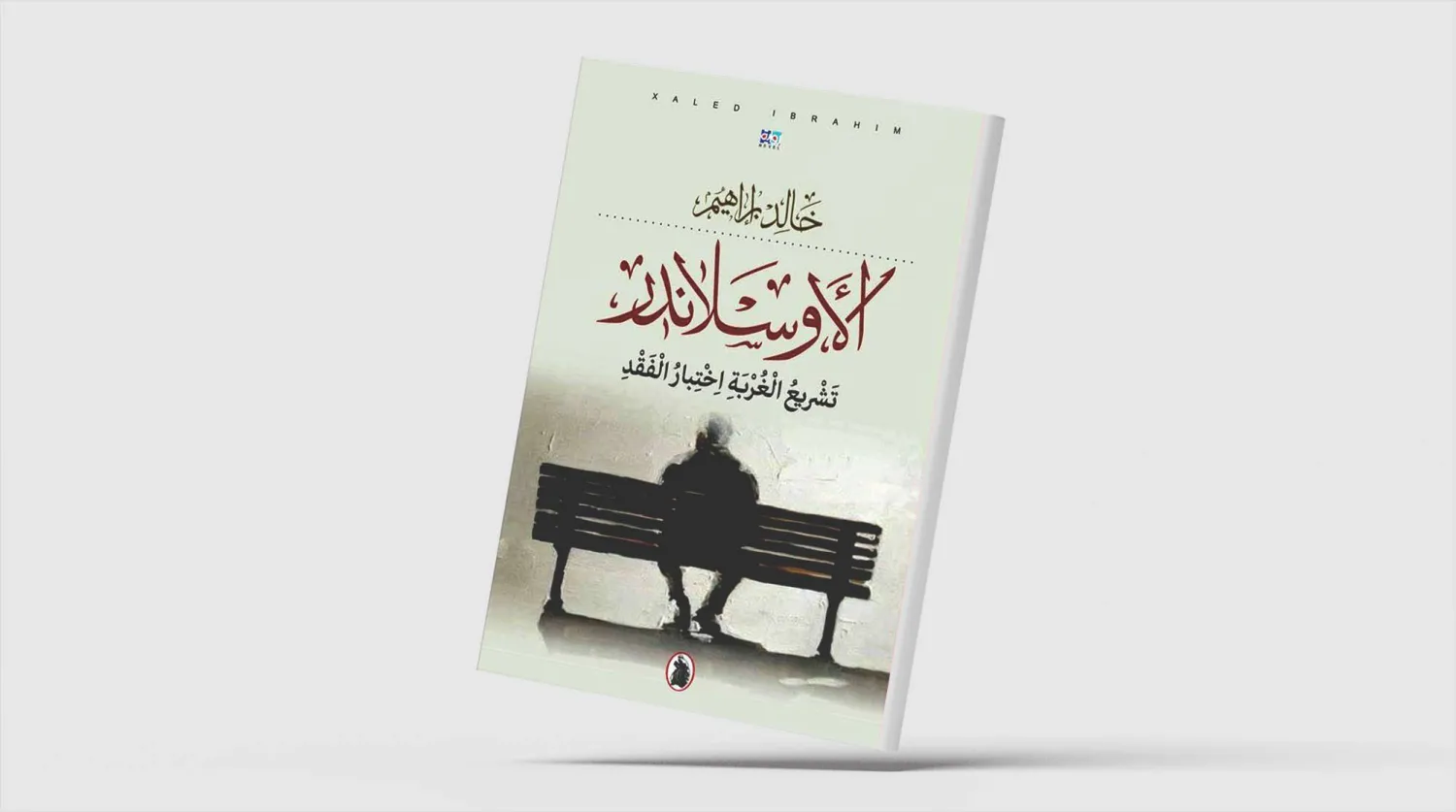ترتسم أمامنا في الإعلام العالمي ووسائل الاتصال الاجتماعي مشاهد التطرف المقيت الذي يصيب جميع المجتمعات الإنسانية، الغربية منها والشرقية على حد سواء. حين ينظر المرء في أسباب هذا التطرف يدرك أن الوعي الثقافي المحلي مصاب، في أغلب الأحيان، بأزمة الرهبة من الاختلاف. ومن ثم، أعتقد أن الناس يخافون من الآخر الثقافي الذي لا يلائم تصوره التصور السائد في الجماعة التي ينتمون إليها. والحال أن الجميع يعلم استحالة صهر أهل الأرض في بوتقة ثقافية واحدة حتى يستكين الخائفون من رهبة الاختلاف.
أعتقد أن المشكلة ليست في الاختلاف الثقافي، بل في المغالاة التي ترافق رغبة التعبير عن الهوية الذاتية. لذلك ينبغي النظر في مظاهر التطرف التي تعصف بهوياتنا الثقافية، حتى ندرك مقدار الأخطار الجسيمة التي تتربص بالإنسانية المعاصرة. قبل أن أخوض في تحليل ثلاثة مواقف تعبيرية متشنجة تهيمن على المشهد الإعلامي العالمي، أود أن أستحضر مقولة الوسطية الفلسفية التي نادى بها الفيلسوف الإغريقي أرسطو (384 ق.م. - 322 ق.م.) حين صرح بأن الفضيلة الأخلاقية تقوم في الوسط (in medio stat virtus)، أي في الاعتدال الذي يجتنب التطرف. ومن ثم، تنزل الشجاعة منزل التوسط بين تطرف التهور وتطرف الجبن، وينزل الكرم منزل التوسط بين تطرف التبذير وتطرف البخل. وهكذا دواليك حتى يبلغ الإنسان نضج الاعتدال في فكره وقوله وفعله.
كيف يمكننا اليوم أن نطبق هذه النظرية في معترك التصارع على إثبات أعظمية الهوية الذاتية وأحقية امتلاك موارد الأرض الاستراتيجية أو، على أضعف الإيمان، الاستئثار بإدارتها؟ أظن أن مسار التحدي الإقصائي الخطير الذي تسلكه المجتمعات في الزمن الراهن لن يفضي إلا إلى الاحتراب والإفناء. لذلك يجب على الجميع أن يعيدوا النظر في منظوماتهم الثقافية، حتى يستجلوا مواضع التطرف ويعالجوا الانحرافات الطارئة المنبثقة من ذهنية المغالاة في الدفاع عن أعظمية الهوية الذاتية. الفرق شاسع بين الابتهاج بفرادة الخصوصية الثقافية، والافتخار الاستعلائي بصلاحيتها الكونية القاهرة. ليس من هوية ثقافية محلية تصلح لجميع الناس. وليست المجتمعات مستعدة لاقتبال غزوة الهويات المنتفخة المصرة على ادعاءاتها الاستكبارية.
أعود إلى مقولة الوسطية الفلسفية الأرسطية، فأقترح تطبيقها على ثلاث قضايا خلافية تعصف بالمجتمعات الإنسانية المعاصرة. تتعلق القضية الأولى بتعريف هوية الإنسان وتحديد عناصر جوهره الأنثروبولوجي. يعلم الجميع أن بعض المذاهب اليسارية المتطرفة في المجتمعات الغربية أضحت تنكر على الكائن الإنساني حقه في التمتع بما انفطر عليه كيانه البيولوجي من قوام أصلي. تصعقنا، والحال هذه، مشاريع القوانين الغربية التي تمنع الأهل عن أن يعاينوا جنس أطفالهم، ويعاملوهم بحسب ما نشأت عليه ذكورتهم الأصلية أو أنوثتهم الأصلية. إذا كانت الطبيعة الهرمونية، في بعض الأوضاع النادرة، شديدة الترجح والتذبذب، فلا يستتبع هذا الأمر أن نستصدر القوانين التي تحرم قبول هبة الاصطفاء الجنسي الطبيعي العفوي في هوية الكائن الإنساني. في مقابل هذا التطرف تعمد بعض المجتمعات الشرقية الآسيوية العربية إلى قمع الحرية الكيانية الأصلية التي تسوغ لكل واحد منا أن يطور شخصيته، سواء أكانت ذكرية أم أنثوية، تطويراً يخالف ما اعتنقته هذه المجتمعات من معتقد سائد، وما تعودته من أعراف مهيمنة، لاسيما في حقل العلاقات الجنسية. بين المغالاة الغربية والمغالاة الشرقية ثمة وسط فضائلي اعتدالي ينبغي الاعتصام به؛ إذ إنه يملي على الجميع احترام الهوية البيولوجية الأصلية، وصون الحرية الكيانية التي تنمي الشخصية الذكرية والأنثوية إنماء وجدانياً مغنياً.
أمضي إلى القضية الثانية التي تتعلق بحرية المعتقد. تصر المجتمعات الغربية على مبدأ الحرية الفكرية المطلقة التي تبيح لكل إنسان أن يعبر عن اقتناعاته تعبيراً يبلغ ببعض الأفراد مستوى من الاستهتار والعبثية يفضي به إلى إهانة الرموز الدينية. أما المجتمعات الشرقية الآسيوية العربية فما برحت تحاذر الحريات الاعتقادية، فتمنع النقاش الفكري الحر، وتحظر تغيير المعتقد الديني على الملأ، وتستنكر الانتقادات الإصلاحية التي يصوغها أهل الاستنارة العقلية المزدانة بأصفى النيات وأخلصها. لا بد لنا، والحال هذه، من رفض الحريات التي تهين معتقدات الآخرين، واستنكار الاستبداد الذي يعتقل حريات الآخرين أيضاً. بين المغالاة الغربية في استباحة وجدان الآخر، والمغالاة الشرقية في قمع حريته الكيانية، ثمة وسط فضائلي اعتدالي ينبغي الاستمساك به؛ إذ إنه يفرض على الجميع مراعاة حقائق الوجدان الجماعي الثمينة، وصون حرية الكائن الإنساني في طاقاتها الإصلاحية البناءة.
أما القضية الثالثة فترتبط بمقام المرأة في الأزمنة المعاصرة. لا يخفى على أحد من أهل الاطلاع، الإسرافُ الذي تقع في حبائله المجتمعات الغربية، وقد طفقت تحرر المرأة من كل ما يقيدها، حتى بلغ التحرر مستوى من الإلغاء الكياني جعل المرأة ترفض أنوثتها ورقتها وأمومتها، أي دعوتها الوجودية وخصوصيتها الرسالية وفرادتها الاجتماعية. لا يجوز أن تتحول الحرية الجنسية، على سبيل المثال، إلى تعطيل الهوية الأنثوية تعطيلاً يجعل المرأة تتصرف تصرف الرجل، ويجعل الرجل أيضاً يتصرف تصرف المرأة. يقابل هذا التطرف تصور ثقافي شرقي آسيوي عربي يقيد المرأة ويحبسها في أحكام فقهية وأعراف مسلكية وأنماط لباسية لا تليق بكرامتها الإنسانية الأصلية. بين الغلو الغربي والتصلب الشرقي ثمة وسط فضائلي اعتدالي يليق التقيد به؛ إذ إنه يصون في المرأة حقيقتها الأنثروبولوجية الفريدة، ويعتقها في الوقت نفسه من أوهام الاستعلاء البطريركي الذكوري السلفي.
ذكرتُ القضايا التطرفية الثلاث هذه لأبيّن مقدار الالتباس الذي يجعلنا نخلط بين فرادة الخصوصية الثقافية، والحد الأدنى من أخلاقيات صون الحقوق الإنسانية الأصلية. إذا انبرى بعض الشبان والشابات المستيئسين يقرّعون أهلهم على هبة الحياة، ويقاضونهم أمام المحاكم على جريمة استقدامهم إلى الوجود بغير إرادتهم، فهل يجوز لنا أن نساير تشنجات وجدانهم المعذب ونشرع لهم أصول المحاكمة الظالمة هذه؟ لأسباب شتى نشأت الهويات الثقافية ونمت وتطورت، بحيث أضحت تعبر عن وجدان جماعات أهل الأرض. بيد أن أصول المعاملات بين الناس يجب ألا تخضع لأقبح ما في هذه الثقافة أو تلك، بل لأبهى ما تختزنه الثقافات الإنسانية المتنوعة. يبقى لنا أن نتفق على معايير القبح والبهاء في الثقافات الإنسانية. أعتقد أن نضج الوعي الكوني أفضى بالجميع إلى استحسان ضمة من فضائل الاعتدال التي تنقذ بعض الناس من غلواء تطرفهم، وتفضي ببعضهم الآخر إلى استثمار أعظم طاقات الإبداع في قرائن التسالم الحضاري الكوني. آن الأوان لكي نكف عن الانتصار العنفي لهوياتنا المتشنجة؛ إذ إن إقناع الآخرين بصوابية تصورنا لا يثمر في وعيهم الذاتي إلا إذا عاينوا رفعة المسلك الإنساني الطيب الذي يرافق مرافقة التصديق ما نعتنقه علانية من اقتناعات أخلاقية حميدة.
- - - - - - - - - - - -
* باحث لبناني