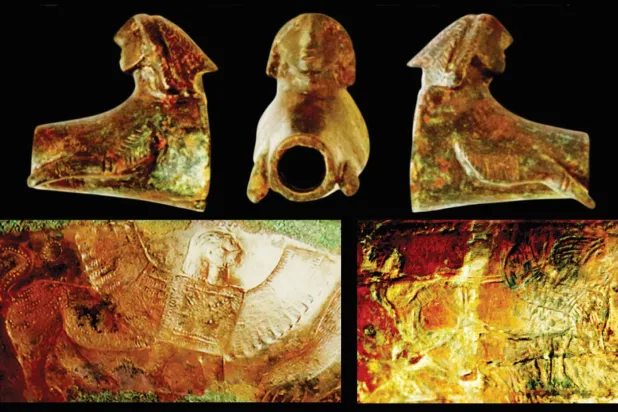نادراً ما يحتفل العرب بولادات الشعراء، إذ نجدهم دائماً يحتفلون بذكرى وفاتهم، كأننا أمم جاهزة للندب لا للفرح، لذلك جاء احتفال العراقيين هذه المرة مغايراً، حيث احتضنت بغداد فعالية كبيرة ليومين عن نازك الملائكة رعاها رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، وحضرها بنفسه وألقى كلمة بالمناسبة، وفي الوقت نفسه حضر الفعالية أكثر من ستمائة شخصية عراقية من الوسط الأدبي والثقافي فضلاً عن حضور عشر شخصيات عربية لها مكانتها وحضورها. إذاً نازك تحضر بقوة هذه المرة وتستعيد عافيتها الأدبية والفكرية من جديد، حيث تمّت طباعة أعمالها الشعرية الكاملة في مجلدين من دار الشؤون الثقافية، وكذلك طباعة عملين نقديين عن تجربتها الإبداعية، فضلاً عن إعلان الحكومة العراقية تخصيص ساحة من ساحات بغداد ونصب تمثال لنازك الملائكة في تلك الساحة، وهذا يحدث لأول مرة حيث يُصنع تمثال لسيدة عراقية ويوضع في ساحة عامة.
مبادرة غير مسبوقة
وقبل أكثر من شهرين صدر تعميم على كل مدارس العراق بأن تكون كلمة يوم الخميس لطلاب المدارس موجَّهة عن نازك الملائكة ودورها التحديثي ودور المرأة بشكل عام، وهذا أيضاً يحدث لأول مرة؛ أن يصدر مثل هذا التعميم في الحديث عن نازك الملائكة في ساعة واحدة ولكل طلاب العراق، وكذلك صدر تعميم للبريد العراقي بأن توضع صورة نازك الملائكة وذكرى مئويتها على طابع بريدي عراقي.
إذاً نازك تحضر بقوة في العراق وفي بلدان عربية كثيرة أخرى، وهذا الحضور يستدعي حضوراً نقدياً موازياً لها، ذلك أن نازك من أكثر الشخصيات الإبداعية التي تثير الجدل وتدعو لأكثر من وقفة إزاءها. نازك الشاعرة والناقدة والتنويرية والثائرة والمنعزلة أيضاً، نازك التي كسرت عمود الشعر وفحولته التي امتدت لأكثر من أربعة عشر قرناً، حيث كان أجدادها يقولون في الشواعر أمثالها (إذا صاحت الدجاجة صياح الديك فاذبحوها) وإذا بها بعد هذه المدة تمسك الديك وتنتف ريشه، وتطلق نظرية جديدة تخالف آراء أجدادها الشعراء، حيث تنظر إلى الوزن والقافية على أنهما عبارة عن سلسلة ثقيلة يجرّها الشاعر وراءه، حيث تقول:
«وقد يرى كثيرون معي أن الشعر العربي لم يقف بعدُ على قدميه بعد الرقدة الطويلة التي جثمت على صدره طيلة القرون المنصرمة الماضية. فنحن عموماً ما زلنا أسرى، تسيّرنا القواعد التي وضعها أسلافنا في الجاهلية وصدر الإسلام، ما زلنا نلهث في قصائدنا ونجر عواطفنا المقيّدة بسلاسل الأوزان القديمة وقرقعة الألفاظ الميتة»، وهذا جزء من مقدمة ديوانها «شظايا ورماد» عام 1949، فكيف بفتاة لا تتجاوز الثلاثين من عمرها تنطلق بمثل هذه الآراء الجريئة التي تتجاوز فيها على روح الثقافة العربية التي يقف الشعر في قلبها، فالمساءلة والنقد للشعر العربي والانقلاب على ثوابته يعني فيما يعنيه الانقلاب على روح الثقافة العربية ومركزيتها، فمن أين أتت نازك بهذه الطاقة والقوة لكي تقلب الطاولة على رأس الشعر التقليدي؟
تنظير متقدم
نازك خرجت من بيت مثقف ثقافةً تقليديةً لا تمرُّد فيها، بل إن أباها وعائلتها كانوا يسخرون منها حين كتبت قصائدها الجديدة، كما أن التجارب التي سبقتها ومحاولات التمرد لم تكن تشكل ظاهرة تسحب أقدام الشعراء نحوها، غير أن العالم بدأ يتغير بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والحياة بدأت تأخذ مسارات مختلفة عمّا قبلها، فالحياة التعليمية والسفر والترجمة بدأت تنمو في العالم كله، ولم يكن العراق بمعزل عن العالم، ذلك أن كبريات المجلات كانت تصل إلى بغداد، كما أن التراجم بدأت بالانتشار، والشعراء بدأوا يطّلعون على آداب العالم، ومن هنا صرحت نازك في مقدمتها لـ«شظايا ورماد»: «والذي أعتقده أن الشعر العربي يقف اليوم على حافة تطور جارف عاصف لن يبقي من الأساليب القديمة شيئاً....
أقول هذا اعتماداً على دراسة بطيئة لشعرنا المعاصر واتجاهاته، وأقولها لأنها النتيجة المنطقية لإقبالنا على قراءة الآداب الأوروبية ودراسة أحدث النظريات في الفلسفة والفن وعلم النفس، والواقع أن الذين يريدون الجمع بين الثقافة الحديثة وتقاليد الشعر القديمة أشبه بمن يعيش اليوم بملابس القرن الأول للهجرة، ونحن بين اثنين: إما أن نتعلم النظريات ونتأثر بها ونطبقها، وإما ألا نتعلمها إطلاقاً، وقد يفيدنا أن نتذكر دائماً أن التطور الذي يحدث في الفنون والآداب في عصر ما أكثر ما يكون ناشئاً عن التقاء أمّتين وأكثر».
إذاً نازك تصرّح بشكل واضح بأن التقاء ثقافات الأمم هو الذي أسهم في تغير خريطة الشعر العربي. وهذا واضح، فالأمم المغلقة لا تُنتج ولا تكرر إلا نفسها ولا تعيد إلا ما صنعه أجدادها، ولكن السؤال الأهم: هل استطاعت نازك أن تكسر فعلاً النمط التقليدي للشعر العربي؟ بمعنى هل تغيُّر عدد التفعيلات ونقصانه أو زيادته يعد كسراً للثقافة العربية ونمط تفكيرها طيلة عقود؟ أم أن التحديث لا يرتبط بالشكل فقط إن لم يكن منطلقاً من الجوهر، وأعني به التحول في الفكر ووجهة النظر والنظر إلى الآخر والمختلف عنك نظرةً معاصرةً، وإلا ما فائدة التحولات الشكلية إن لم ترافقها تحولات موضوعية وعضوية في الوقت نفسه؟

من الرومانسية إلى الواقعية
هل كانت ثورة نازك الملائكة ورفاقها ثورة عروضية فقط؟ هل أربكوا عدد التفاعيل في السطر الواحد واطمأنوا إلى أنهم أحدثوا شيئاً مهماً في تاريخ الأدب وحركته؟ أم أن الأمر أوسع من فتح أطراف البيت الشعري التقليدي وتمطيط قافيته؟ يعني هل هناك ما هو أوسع من فكرة التفاعيل؟
من حيث الموضوع، كل بدايات نازك هي امتداد للرومانسيين العرب والإنجليز من الشعراء والكتاب، ومعظم أجواء قصائدها تدور في هذا الفلك المعتم والكئيب، حيث يهيمن الليل على مناخات قصائدها، فمثلاً قصيدتها «مأساة الحياة» هي نفسها تقول عنها: «وهو عنوان يدل على تشاؤمي المطلق، وشعوري بأن الحياة كلها ألمٌ وإبهامٌ وتعقيد»، ولكنها لا تستقر على حالة واحدة، وهو جزء من تناقضات نازك وتحولاتها، فمن الذات المغلقة والعتمة والليل إلى المشاركة في الحياة العامة السياسية والاجتماعية من خلال قصائدها التي تمشي حافية القدمين في الشوارع العربية، وهنا تتحول من شاعرة رومانسية إلى شاعرة أكثر من واقعية، حيث تتبنى قضايا الأمة العربية وتدافع عن فلسطين والقدس وتدعو بقصائد ذات نبرة خطابية عالية للدفاع عن الأرض وتحريرها، حيث كرّست ديوانها الأخير «للصلاة والثورة» لفلسطين ودافعت عن القدس دفاعاً شديداً، وقد جاء هذا الديوان بعد انقطاع 3 أعوام عن الكتابة الشعرية، حيث هزّتها بطاقة تهنئة وصلت إليها، عليها صورة قبة الصخرة، فكتبت مباشرةً بعد ذلك الانقطاع:
يا قبة الصخرة
يا ورد يا ابتهالة مضيئة الفكرة
ويا هدى تسبيحة علوية النبرة
وكتبت وكتبت حتى انتهت الفسحة الفارغة على ظهر البطاقة. بعدها تواصلت بكتابة القصائد لفلسطين حتى اكتملت مجموعتها الأخيرة «للصلاة والثورة».
ولكن الذي يحدث أن النبرة الخطابية العالية والمعالجة البسيطة للقضايا الشائكة توقِع النصوص الشعرية في البرودة، والمفارقة في الأمر أن نازك الملائكة تحمل وعياً كبيراً جداً في هذا الشأن، حيث تذكر في مقدمة ديوانها «للصلاة والثورة» أن ما تكتبه لا علاقة له بالمستقبل، فهي تفترض قارئاً مستقبلياً سيأتي بعد مائة عام من ديوانها، هذا يعني في عام 2073، وتظن أن القارئ المستقبليّ لن يتفاعل مع نصوصها لأنها لم تكتب الفن لأجل الفن، إنما تكتب للدفاع عن الأرض ولتعرية الصهاينة في تلك المدة، ولكن السؤال الأهم يدور حول وعي نازك وحساسيتها تجاه الجماليات، فهي تملك حساً عالياً إزاء الجماليات الشعرية، لذلك تقول ما معناه إن نصوصها لا مستقبل لها لأنها منشغلة بالحاضر وهي لا تعير اهتماماً للمستقبل الشعري وللمتلقي المستقبلي، وهذه النظرة هي أيضاً جزء من تحولات نازك -كما ذكرنا قبل قليل- حيث تقول في مقدمة ديوانها «للصلاة والثورة»: «... هل ينبغي أن نطمس أحاسيسنا اليوم من أجل أن يتذوق قصائدنا حفيد شاعر سيعيش عام 2073؟ هل نترك دماءنا تُراق وجثثنا تُرمى من شبابيك الطابق الرابع من المباني الصهيونية دون أن نصوّرها في شِعرنا لمجرد أن نُرضي هذا الحفيد الذي يعيش أبعاداً ثلاثة أخرى غير أبعادنا الثلاثة؟
الجواب: لا. إن ذلك سيكون منّا انتحاراً، لا بل إن سكوتنا قد يقتل هذا الحفيد ويحرمه فرصةً يولَد فيها، فنحن نقاتل بشِعرنا وقوافينا من أجله»، إذاً نازك واضحة تمام الوضوح وبقصدية عالية في كتابة الشعر وبوصف الشعر لديها سلاحاً تدافع فيه، فنحن نقاتل بشِعرنا وقوافينا، على حد قولها، ولكنها في المقدمة ذاتها وبين الأسطر تناقض نفسها حين تذكر أن «القصيدة الحيّة تُديم التاريخ بكل أبعاده وتعطيه الخلود...»، إذاً هي تفكر في خلود القصيدة أيضاً، وما كلامها عن ذلك الحفيد الذي سيأتي بعد مئة عام إلا انفعال عاطفي أمْلته عليها ظروف المرحلة، إلا أن هذه النظرة المتناقضة جزء من تحولات نازك الملائكة المعروفة، فهي تقدح الشرارة العظيمة وحين تصبح ناراً يتدفأ بها الكثيرون، تأتي وتنفخ على تلك النار المتوقدة فتطفئها، ومن ثم تعود بعد أيام وتقدح ناراً جديدة.
تعاليم صارمة
وهكذا تواصل تناقضاتها واستفزازاتها الأدبية الكبرى، وهذا الأمر لا يتعلق بالشعر فقط إنما في أفكارها النقدية المهمة أيضاً، فهي الرائدة الكبيرة التي تحمل وعياً عظيماً في التنظير والتجديد والتحديث مقارنةً برفاقها الرواد، حيث قرنت كل دواوينها الشعرية بمقدمات نظرية تطرح من خلالها رؤيتها للتحولات الشعرية، وما مقدمتها لديوان «شظايا ورماد» إلا بيان نقدي للحداثة الشعرية، ومن ثم توالت رؤيتها النقدية في كتابها الأشهر «قضايا الشعر المعاصر»، ولكنها لم تستمر على هذا النمط، إنما تحولت إلى معلمة شديدة السطوة على الشعراء وبدأت تطلق تعاليمها على الأجيال الشعرية: اكتب كذا ولا تكتب كذا. ومن يعد لمقدمة «شظايا ورماد» يجدها استشهدت في السطر الأول بعبارة برناردشو «اللاقاعدة هي القاعدة الذهبية»، وتتخذ من هذه العبارة قاعدة تسير عليها ملؤها التمرد والتجدد، ولكنها تعود بعد سنوات في كتابها «سيكولوجية الشعر» لفرض قواعد على الشعراء الذين جاءوا بعدها، وبدأت تفرض قوانينها على الحركة الشعرية، مما عرّضها لموجة من النقد الشديد وُصفت بالرِّدة عن مشروع الحداثة، بل إنها وقفت في وجه الكثير من الشعراء الشباب الذين حاولوا الخروج عن أو على مشروع الريادة، وبهذا فإن مشروع التحديث لدى نازك الملائكة مربك بصراحة، فهي تملك الوعي العالي بمشكلات الشعر العربي، وتشخّصه بدقة تامة.
العودة للأصول
ولكنها بعد مدة تعود للأصول كأي عربي متمسك بأصوله التقليدية، والمسألة الأخرى هي المقدرة الشعرية، فهي مقارنةً بوعيها العالي نجد المنجز الشعري في منطقة أخرى إلا في بعض الاستثناءات التي يقول عنها عبد الوهاب البياتي إنها لو استمرت كما بدأت لكانت أعظم شاعرة عربية، ولكنّ قدرتها الشعرية لم تكن بمستوى قدرتها النقدية، وهذا يبدو جزءاً من شخصية نازك المنطوية والمنفتحة والحداثية والتقليدية والمغامرة والمترددة والصامتة والصادحة ولكنها تبقى علامة فارقة في تاريخ الأدب العربي الحديث وصوتاً مهماً عبَّر عن مرحلته أفضل تعبير، لهذا دخلت نازك لكل مناهج التربية والتعليم في الوطن العربي وحفظ قصائدها كل الفتيان والشباب بوصفها شاعرة مجددة في مرحلة من مراحل شعرنا العربي.