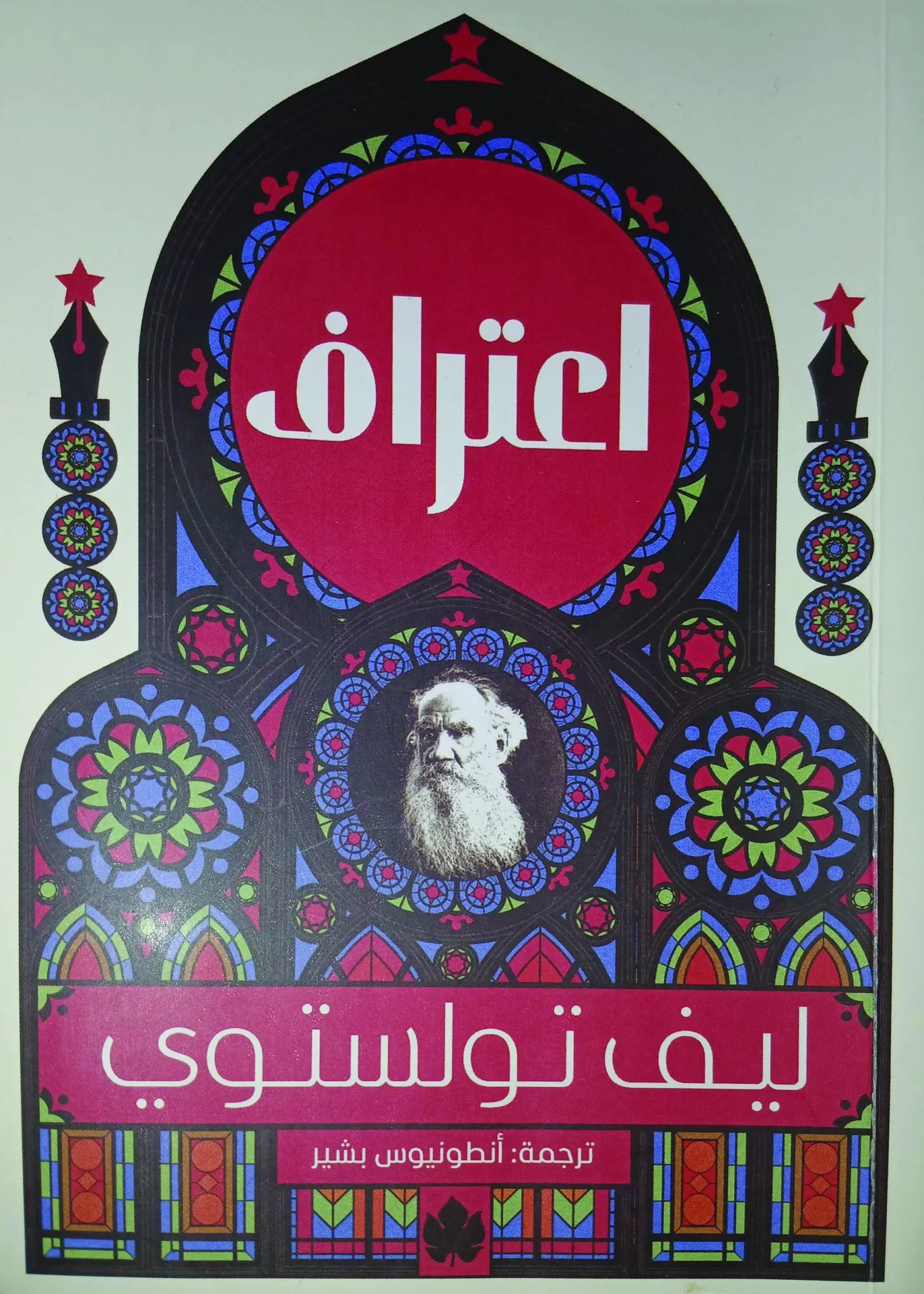يصادف يوم 6 يناير (كانون الثاني) ذكرى ميلاد جبران خليل جبران 1883، وربما من المناسب في هذه الذكرى أن نسلط شيئاً من النور على جانب من جوانب هذا المبدع الذي ترك بصمة واضحة على تاريخ الأدب والشعر والفكر في عالمنا العربي، ونعني به تصوف جبران، الذي لم يُكتب عنه الكثير، مع أنه جانب من أهم جوانب إبداعه. والتصوف ذاته يحتاج إلى الكتابة المعمقة عنه، فهو لا يزال موضوعاً غامضاً بالنسبة لكثيرين في العالم العربي، حتى على المستوى الأكاديمي. وفي الغالب يراه العموم شيئاً خاصاً بالمسلمين، وهو ليس كذلك، فهناك تصوف هندوسي وآخر بوذي وثالث طاوي ورابع يهودي وخامس مسيحي وسادس سنيّ وسابع شيعي، يقال له العرفان، وهناك تصوف أفلوطين والأفلاطونية المحدثة وهناك تصوف أفلاطون، ويختلف عنهم جميعاً تصوف آرثر كيستلر الذي يمثل التصوف الجديد.
كتاب جبران «النبي» الذي كتبه بالإنجليزية وترجمه صديقه وشريك أفكاره ميخائيل نعيمة إلى العربية، هو نص صوفي بامتياز. وهو كتاب رمزي بامتياز كذلك، فالنبي هو المتصوف وأهل أورفاليس الذين يخاطبهم الكتاب هم البشر قاطبة على تعدد أعراقهم وأديانهم، وهم المجتمع الذي يحلم به جبران ويرسم تفاصيله.
هل يشبه تصوف جبران التصوف المسيحي؟ إنه لا يؤمن بعودة المسيح ولا بقيام ملكوت السماء ولا بعقيدة البعث المسيحية، وإنما يؤمن بوحدة الوجود والتناسخ، كما يعتقد بعض المشرقيين. هو لا يشبه المسيحية، غير أنني لا أراه بعيداً عن متصوفة القرن الثالث عشر والرابع عشر من أمثال إيكهارت وتاولر ويوحنا الصليبي،

لكنه يزيد على هؤلاء باستحضار أزمة الإنسان المعاصر مع نفسه ومع العالم، أزمة الوجود في هذا العالم المادي القاسي وما جلبه على الإنسان من قلق مضاعف في أثناء غيبة الروح. لا بد من انتزاع الإنسان من هذا العذاب والعودة به إلى لحظة ميلاده الأولى، إلى الطفولة النقية التي لا تحسن التلطخ بأصباغ المدنية.
تصوف جبران ينبع من أزمته كإنسان وكشاعر مرهف الحس، أي أنه نشأ كعلاج لأزمة، ولا غرابة في ذلك فالمتصوفة في الهند لا يعرفون اسماً للتصوف، فلا هو فلسفة ولا هو علم، ولذا كان يكتفون بتسميته «طريق الخلاص». الخلاص من ماذا؟ من الحزن الذي تظهر بصمته على الوجوه والقلق الذي سرى في الدم، والخوف من المصير، والرغبة في سعادة تدوم. إلا أن شاعرنا لا يؤمن بالسعادة التي تكون بهذه الصفة، فهو يقبل بالألم، ضرورة تجعلنا نعرف ونميز طعم البهجة. ويؤمن جبران، مثل سبينوزا، أن فهم المشكلة كفيل بحلها. الفهم هو نهاية الشقاء، الفهم هو كل شيء. كلاهما لا يؤمن بحرية الإرادة بل هما جبريان تماماً فلا خلاص إلا في الاستسلام. والتسليم كلمة جيدة في قاموسهما ولا تعني الهزيمة، بل هو الحكمة عينها. هذه الحكمة تأتي كهبة ربانية لا يمكن تفسيرها ولا علاقة لها بحرية الإرادة. وكما صرح جبران في رسالة وجهها إلى مي زيادة، لولا الفهم لما خرج كتاب «النبي»، بمعنى أنه كتاب كُتب في فترة يقظة أو استنارة. التصوف هو دواء كل هذا الاغتراب عن العالم، لأن التصوف وحدة واجتماع، ولا يوجد فيه ما هو أجنبي.
هذا الإنسان مدعو إلى الدخول في رحلة بحث عن الذات، ذاته الصغرى التي ستؤدي إلى معرفة ذاته الكبرى، أي الروح التي تسري في العالم. هناك حجاب يمنع الرؤية، يراه جبران في حضارة الأسفلت التي يعيش فيها الناس في العصر الحديث. وهو هنا لا يبتعد كثيراً عن معاصره مارتن هايدغر الذي سجل خصومة مبكرة ضد التكنولوجيا، وأعلن عن حبه الخالد لعالم الفلاحين البسيط النقي.
وعذابك يكمن في شعورك بأنك وحيد في مواجهة مع العالم بلا صديق ولا أنيس، تشعر بأنك في هذا العالم لكنك لست منه، كشعور من يشعر بأنه مواطن من درجة ثانية. هذا هو شعور الإنسان في هذا العصر الصناعي المقيت. من ناحية، يكرر جبران دعوة جان جاك روسو إلى العودة إلى الطبيعة. العالم الطبيعي هو الحقيقي والعالم الصناعي هو البهرج المزيف.
وحل كل مشكلات الإنسان يكمن في شيء واحد هو شيوع المحبة بين الناس. قضية القضايا عند جبران هي هذه المحبة التي يراها شريعة تكفل بقاء الجنس البشري، وما سواها الدمار والخراب. وذات الإنسان الصغرى لن تعي ذاتها الكبرى إلا حين تتجاوز ضعفها، أي حين تتجاوز الكراهية والعنصرية والصراعات. كل هذا سيزول عند تحقيق الذات. صحيح أن الذات الصغرى تبدو ضعيفة في حال الجهل، لكن لا بأس، فهذا الضعف وقتي، وسريعاً ما ستتجلى القوة الكامنة في الإنسان، أي الإنسان كامل منذ البداية حتى عندما لا يدرك ذلك، لكن لحظة الإدراك أكمل. في كتاب «نعيمة» عن جبران، أورد أنه في لحظاته الأخيرة رفض أن يلتقي برجل دين جاء ليشاركه طقس الاعتراف الأخير قبل رحيله، إلا أنه أبى، فموقفه من رجال الدين كان موقف المخاصم، لم يكن يحبهم، لكنه لم يكن يرفض الدين، وإنما رفض حبسه في طقوس تؤدى بلا شعور، فالدين المعاملة وحسن الخلق وبث رسائل المحبة بين الناس.
* كاتب سعودي