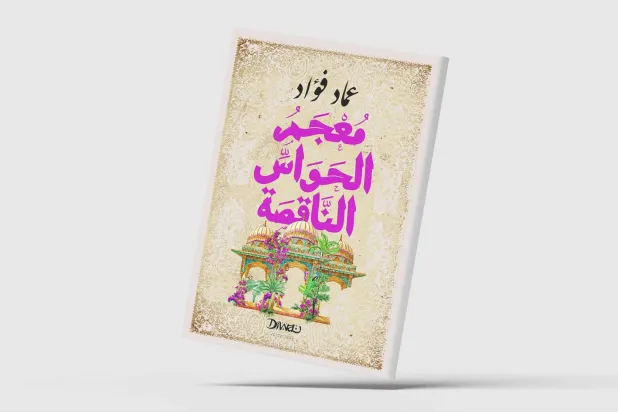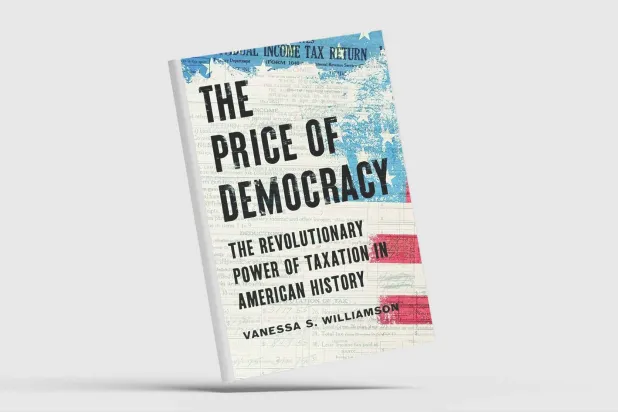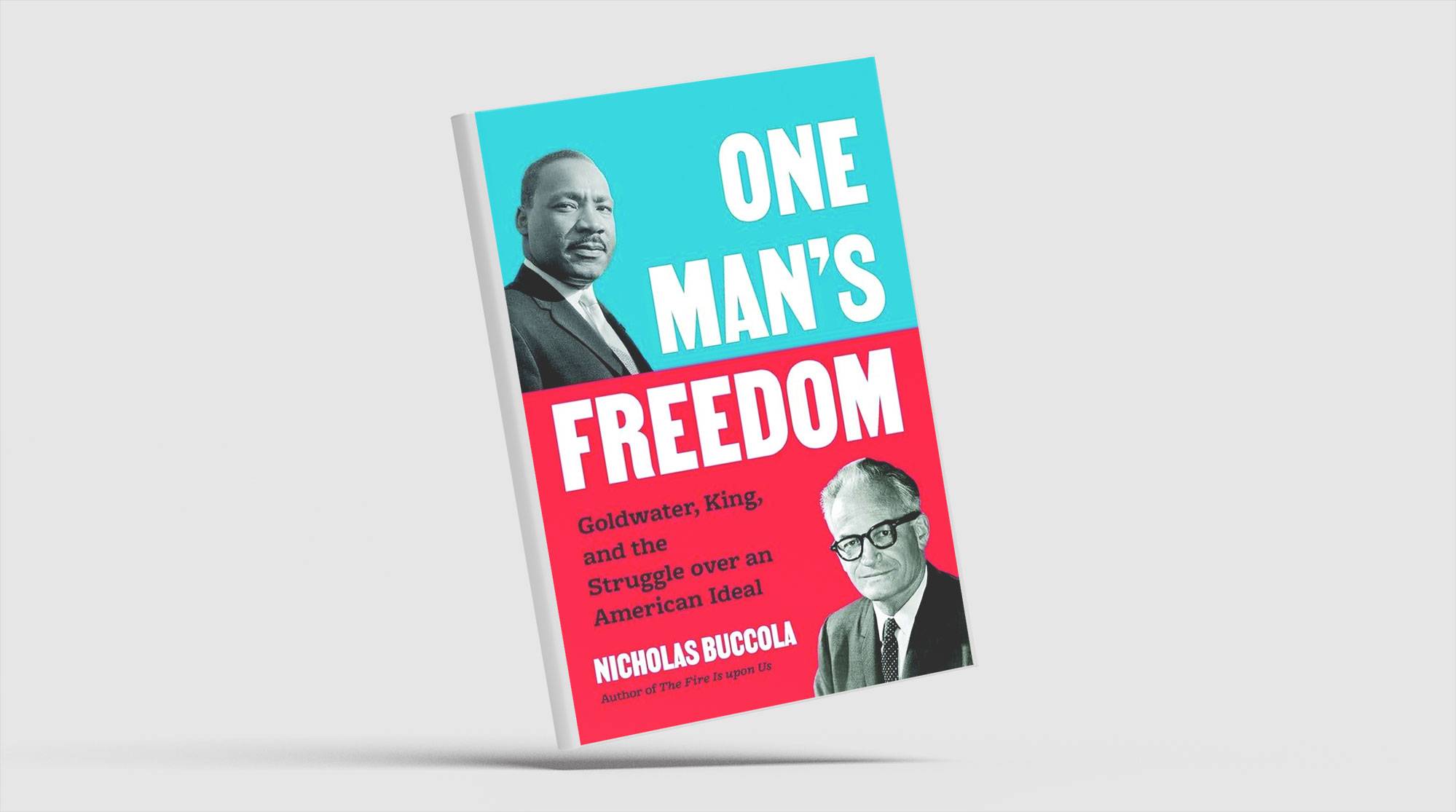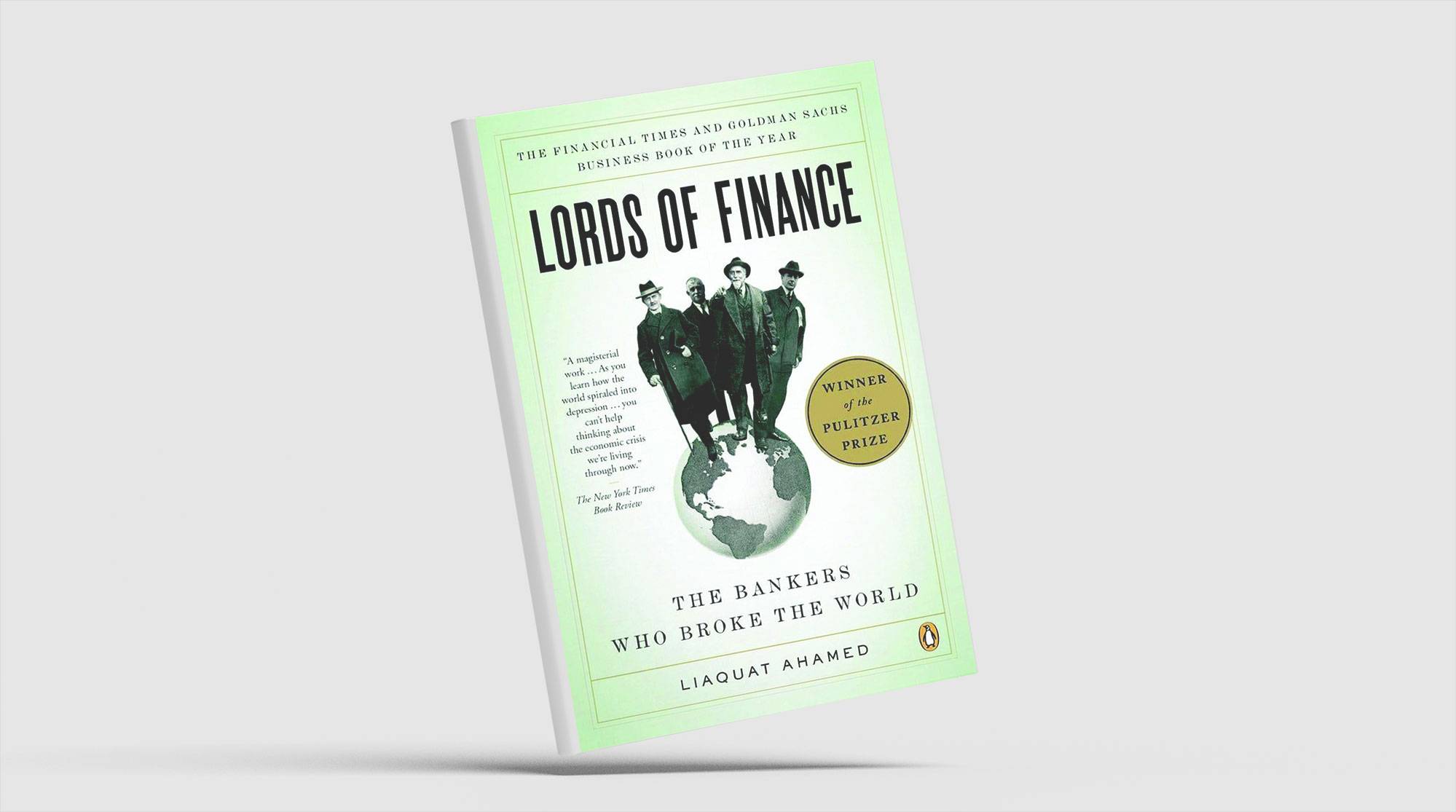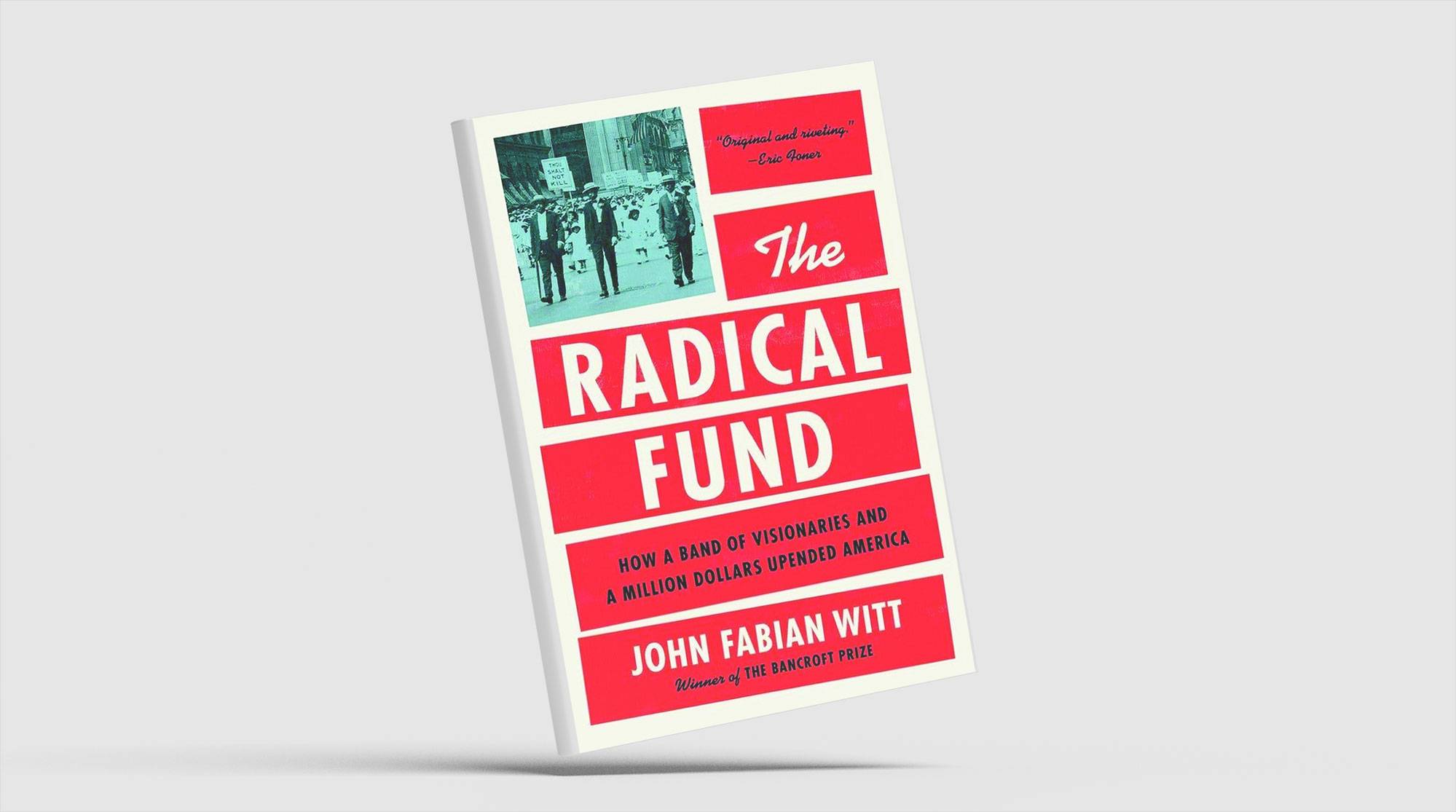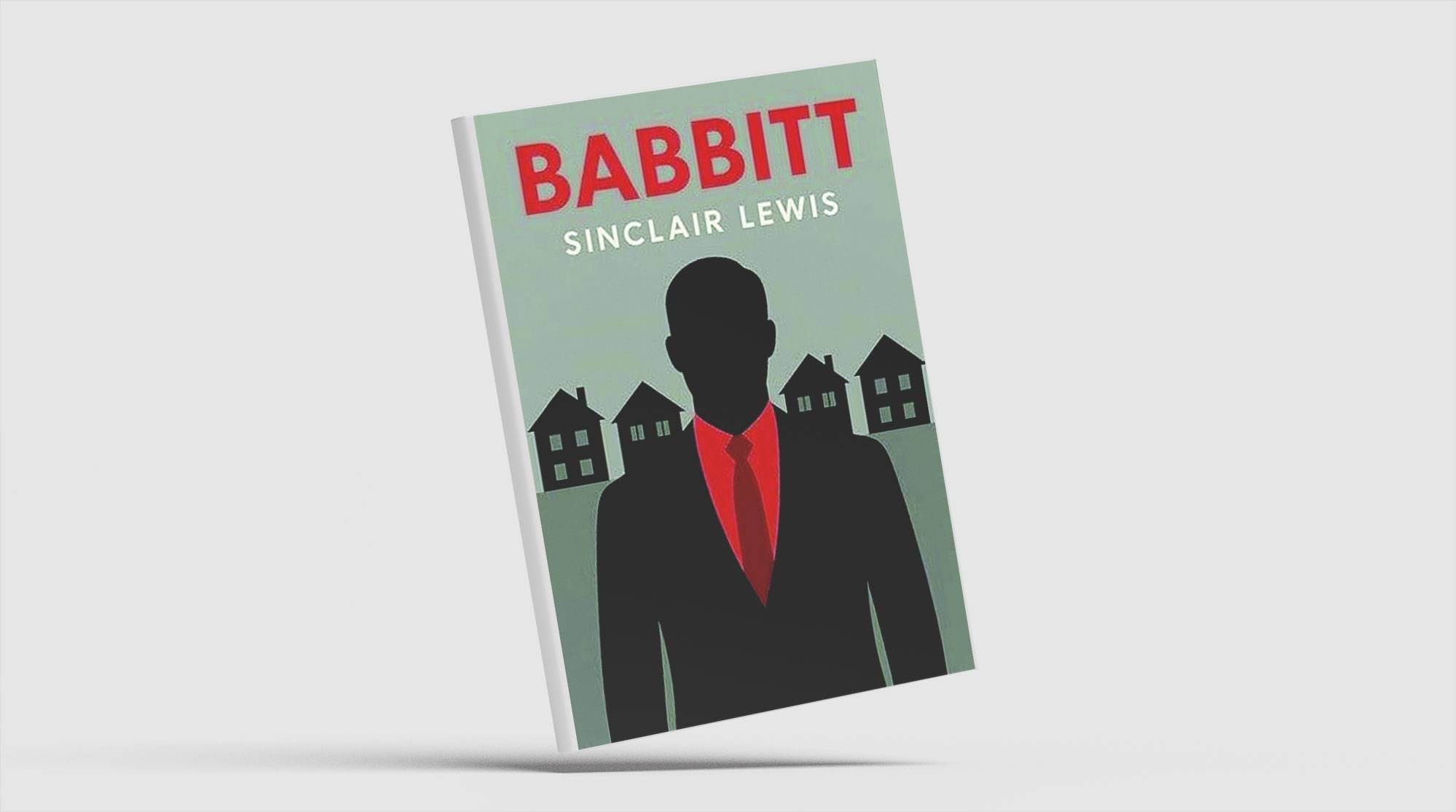في غضون خمسين عاماً من الاستقلال، شيّدت أميركا رؤيتين متناقضتين: النشوة، والحلم الأميركي. كانت الأولى مدفوعة بحماس نهاية العالم الذي رافق الصحوة الكبرى الثانية، فيما استُمدّت الرؤية الثانية من التفاؤل الجامح للمؤسسين أمثال توماس جيفرسون. وَعَدَت الأولى بأن الصالحين سيرتقون، فيما أقسمت الثانية بأن بإمكان الجميع فعل ذلك.
لكن اليوم، تبدو أسس الصعود غير ذات صلة. كل شيء أصبح أغلى ثمناً -رعاية الأطفال، والإيجار، والرهون العقارية، والتأمين الصحي، وفواتير الخدمات، والبقالة، والمطاعم، والأدوات المنزلية، وخدمات البث، وتذاكر الحفلات الموسيقية، وتذاكر الطيران، ومواقف السيارات، ناهيك بهدايا الأعياد... الرواتب ثابتة، وقوة العمال متحجرة، ومعركة مكافحة التضخم مستمرة للعام الخامس.
كيف ومتى أصبح الارتقاء الاجتماعي بعيد المنال كما يبدو؟ تتناول الكتب المعروضة هنا، هذا السؤال مباشرةً؛ إذ يتعمق بعض المؤلفين في كيفية تشكل الثغرات في طريق الحياة الأفضل؛ بينما يحدد آخرون مواطن الضغط الحالية. وتُظهر هذه الكتب مجتمعةً أن الأميركيين كافحوا لإصلاح اقتصادهم منذ تأسيس الولايات المتحدة، وأن جهود جيلٍ ما غالباً ما تؤتي ثمارها في الجيل الذي يليه.
كتاب «ثمن الديمقراطية» لفانيسا ويليامسون
من الضرائب المفروضة خلال حفلة شاي في بوسطن إلى التعريفات الجمركية في العصر الذهبي، قلّما نجد ما يُحدد التاريخ الأميركي مثل الضرائب. في هذا السرد التحليلي الدقيق للضرائب في الولايات المتحدة، تُجادل ويليامسون، الباحثة في معهد بروكينغز، بأن السياسة الضريبية تتجاوز مجرد تمويل الحكومة، فهي آلية لتوزيع السلطة والحفاظ عليها، فلطالما دعمت الضرائب أثرياء البلاد على حساب بقية الشعب. وتكتب ويليامسون أنه بعد الثورة، كانت أبيجيل آدامز من بين النخب التي اشترت سندات الحرب الحكومية متراجعة القيمة بأبخس الأثمان، ثم شاهدت قيمتها ترتفع مع رفع ماساتشوستس الضرائب لسدادها، على حساب المزارعين البسطاء في الغالب.
وعلى الرغم من هذه التفاوتات، فإن أطروحة ويليامسون المفاجئة هي أن الضرائب، عند تطبيقها بشكل صحيح، تُفيد الديمقراطية. فقد أسهم فرض ضريبة الدخل في ستينات القرن التاسع عشر في دعم المجهود الحربي للاتحاد، مما ضمن عدم تحميل الفقراء وحدهم عبء التكاليف.
وبعد الحرب، فرضت حكومة إعادة الإعمار في كارولاينا الجنوبية ضرائب على الأراضي، مما زاد عدد الأطفال الذين يمكنهم الحصول على التعليم العام بأكثر من أربعة أضعاف، حتى في ظل تفشي التهرب الضريبي.
وتجادل ويليامسون بأن معارضة الضرائب لطالما تستّرت وراء دعوات العدالة، لكن الخطر الحقيقي يكمن في غياب الشعور بالانتماء. وتكتب أنه في نهاية المطاف، عندما يسهم الناس في تمويل حكومة فعّالة، يصبحون أكثر ميلاً للمطالبة بحقهم في إبداء رأيهم فيما تفعله، ويتوقعون منها الاستجابة.
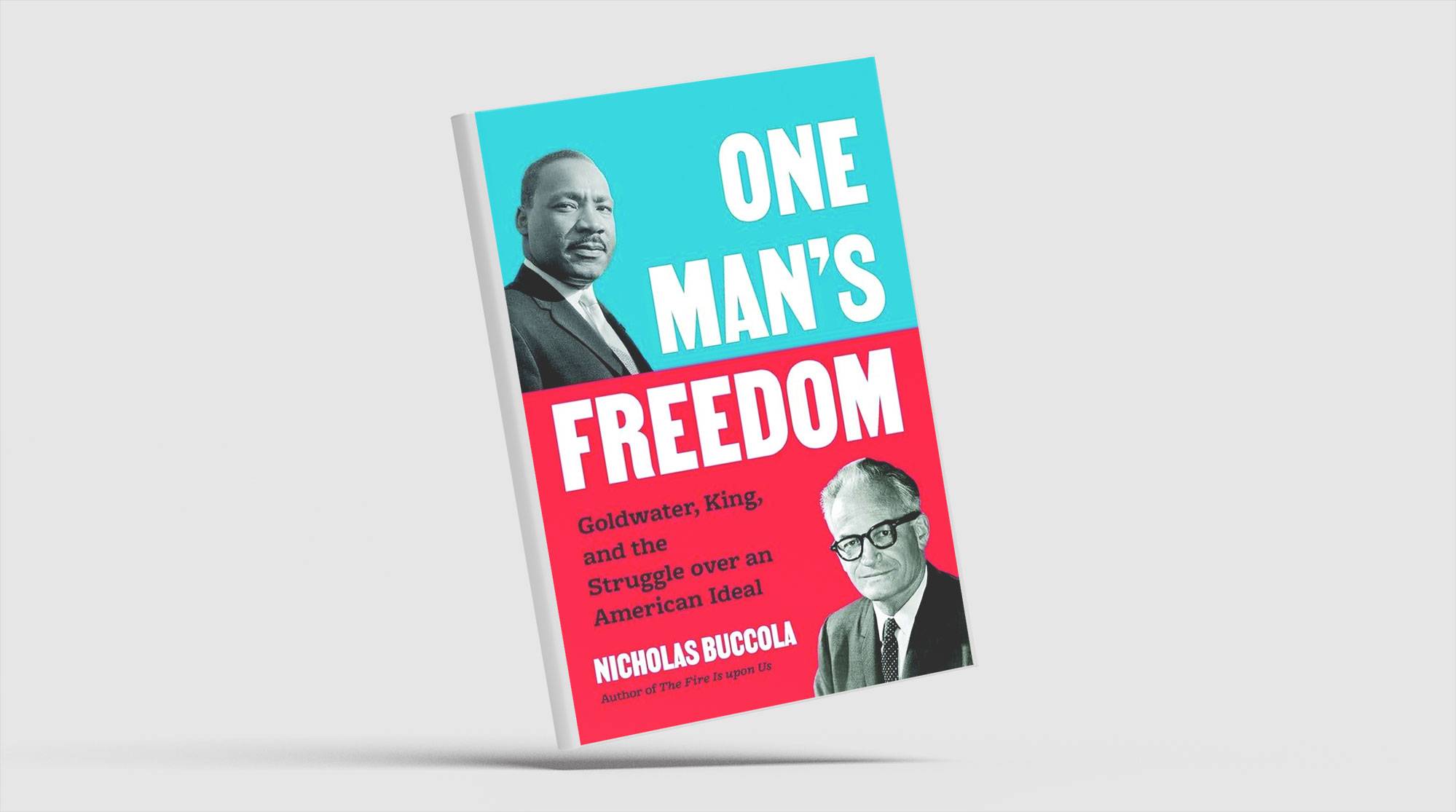
«حرية رجل واحد» لنيكولاس بوكولا
بين مقاطعة حافلات مونتغمري في خمسينات القرن الماضي وانتخابات عام 1964، طرح زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ والمرشح الرئاسي الجمهوري باري غولد ووتر، أفكاراً مؤثرة حول معنى «الحرية» في أميركا. في هذه الصورة المزدوجة المُلهمة، يُعيد بوكولا بناء كيفية تصادم حركتيهما، إذ قدّم كلا الرجلين مفهوماً مختلفاً للحرية، مُرسّخاً فهماً مُغايراً للنظام الاقتصادي الأمثل: اقتصر مفهوم كينغ عن الحرية على المساواة في الوصول إلى السلع والخدمات العامة، فيما استندت رؤية غولد ووتر للحرية إلى حقوق الملكية الشخصية.
يتتبع بوكولا، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة «كليرمونت ماكينا»، كيف أصبحت رؤاهما المتنافستان، اللتان عَبّرا عنهما في خطاباتهما ومواعظهما ومناقشات مجلس الشيوخ، المنطق الأخلاقي المزدوج لأميركا الحديثة: أحدهما يُقدّس السوق، والآخر يُطالب بإصلاحها. حذّر غولد ووتر من أن «الحكومة الكبيرة» -بضرائبها وشبكات الأمان الاجتماعي- و«العمالة الكبيرة» -بضغطها التصاعدي على الأجور- تُهدّدان «نمط الحياة الاقتصادي الأميركي». وردّ كينغ بأن الحقوق السياسية دون فرص اقتصادية هي حقوق جوفاء. ويرى بوكولا أن تحالف الحقوق المدنية الذي قاده كينغ أسهم في إفشال حملة غولد ووتر، لكن أفكار غولد ووتر انتشرت في أوساط السياسة الأميركية، مُشكّلةً ثورة ريغان وعولمة السوق الحرة في عهد كلينتون.
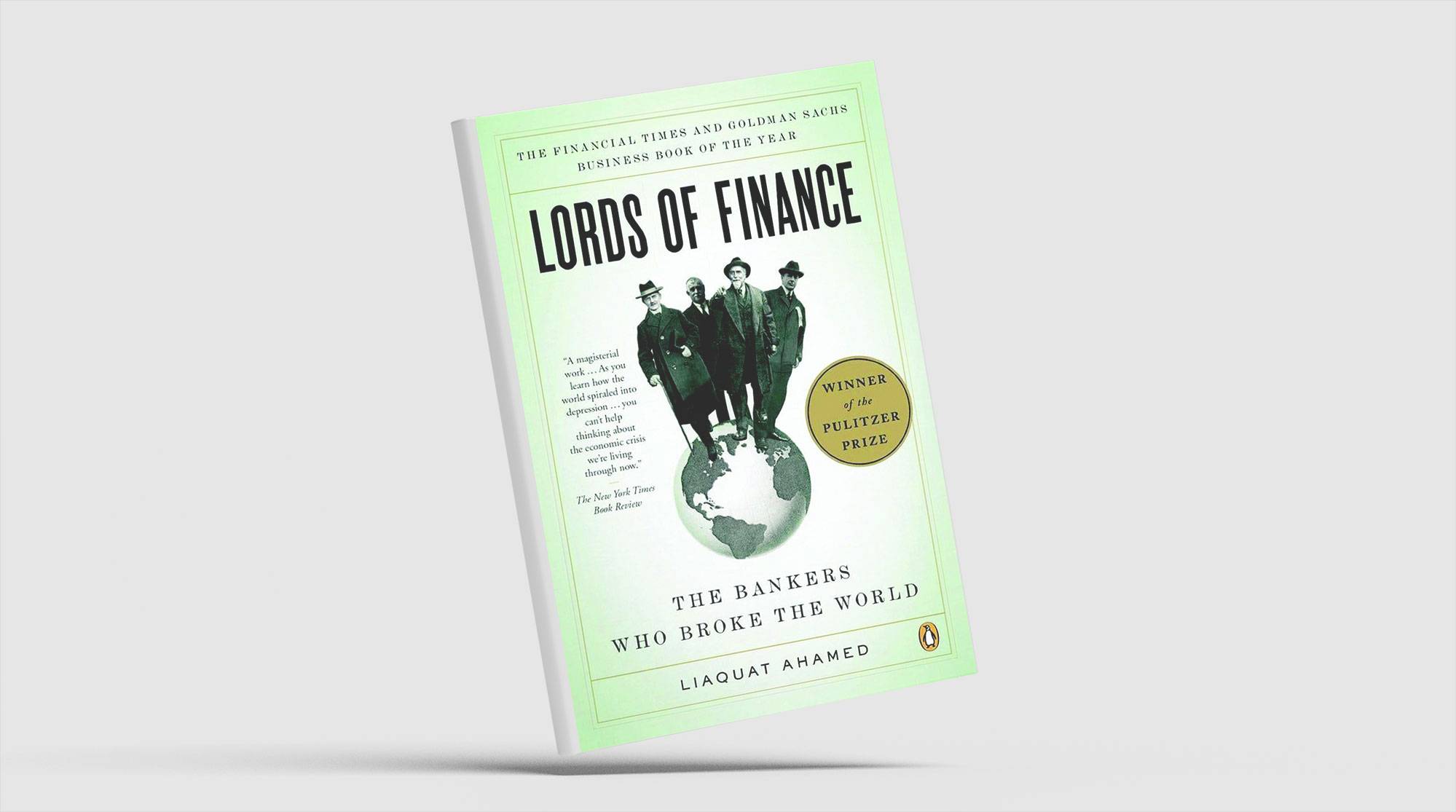
«أمراء التمويل» للياقت أحمد
في كتابه التاريخي الحائز جائزة «بوليتزر» عام 2009، يتتبع أحمد مسيرة أربعة رجال سيطروا على البنوك المركزية الكبرى في العالم في السنوات التي سبقت الكساد الكبير، وهم: مونتاجو نورمان (بنك إنجلترا)، وبنيامين سترونغ (بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك)، وإميل مورو (بنك فرنسا)، وهيالمار شاخت (بنك الرايخ).
يتناول هذا الكتاب التاريخ العالمي، ولكنه يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الأميركي، إذ لطالما امتدت آثار الاقتصاد الأميركي عبر الحدود الوطنية. وبينما كانت الاقتصادات الأوروبية تعاني من الركود بعد الحرب العالمية الأولى تحت وطأة التعويضات والديون، استخدم سترونغ خطوط الائتمان الأميركية للمساعدة في إنعاش البنوك الأوروبية.
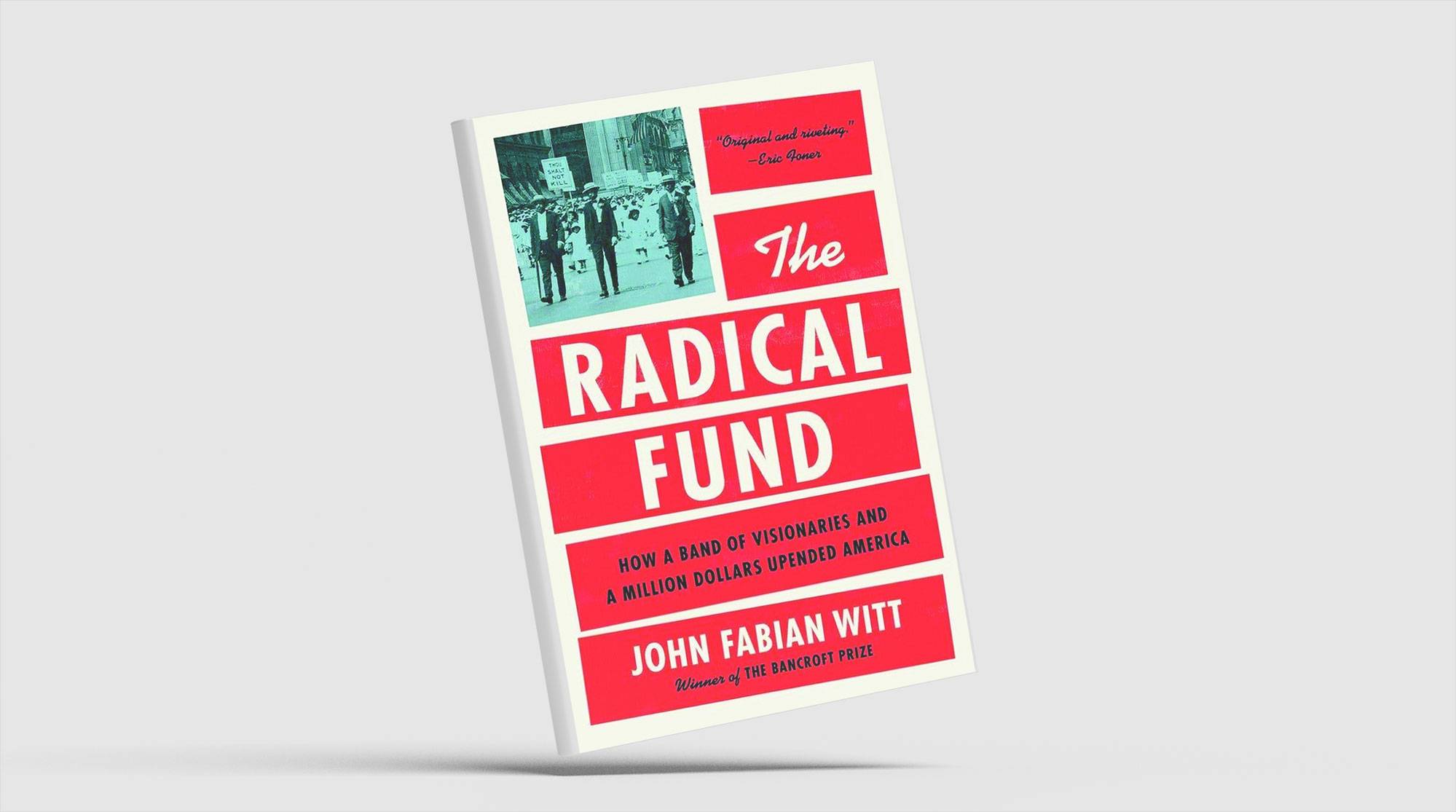
«الصندوق الراديكالي» لجون فابيان ويت
لم يعتمد الأميركيون دائماً على الحكومة لتحسين أوضاعهم المعيشية. فقد شهدت عشرينات القرن الماضي ازدهاراً في الأسواق وتفاقماً في عدم المساواة. وكان رأس المال الخاص في كثير من الأحيان شريان الحياة الوحيد لمن يكافحون الفقر والفصل العنصري المتجذر والاعتداء واسع النطاق على الحريات المدنية.
في عام 1922، رفض تشارلز غارلاند، وريث وول ستريت، المصرفي البالغ من العمر 23 عاماً من ولاية ماساتشوستس، التربح من نظام رآه ظالماً، وتبرع بكامل ميراثه البالغ مليون دولار؛ لتأسيس الصندوق الأميركي للخدمة العامة. وكما يُبين ويت في كتابه التاريخي الشيق عن الصندوق الفيدرالي، فقد أصبح هذا التنازل محركاً مالياً دعم الأفراد والمؤسسات التي ستُشكل لاحقاً برنامج الصفقة الجديدة، وحركة الحقوق المدنية.
تحت قيادة روجر بالدوين، من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعم الصندوق مشاريع عالم الاجتماع الأسود دبليو إي بي دو بويز. دو بويز، ونورمان توماس، حامل لواء الحزب الاشتراكي، وماري وايت أوفينغتون، المؤسِّسة المشاركة للجمعية الوطنية للنهوض بالملوَّنين. وأشعلت نضالاتهم شرارة تحالفات عمالية واسعة النطاق، مثل مؤتمر المنظمات الصناعية، والحملات القانونية التي بلغت ذروتها في قضية براون ضد مجلس التعليم.
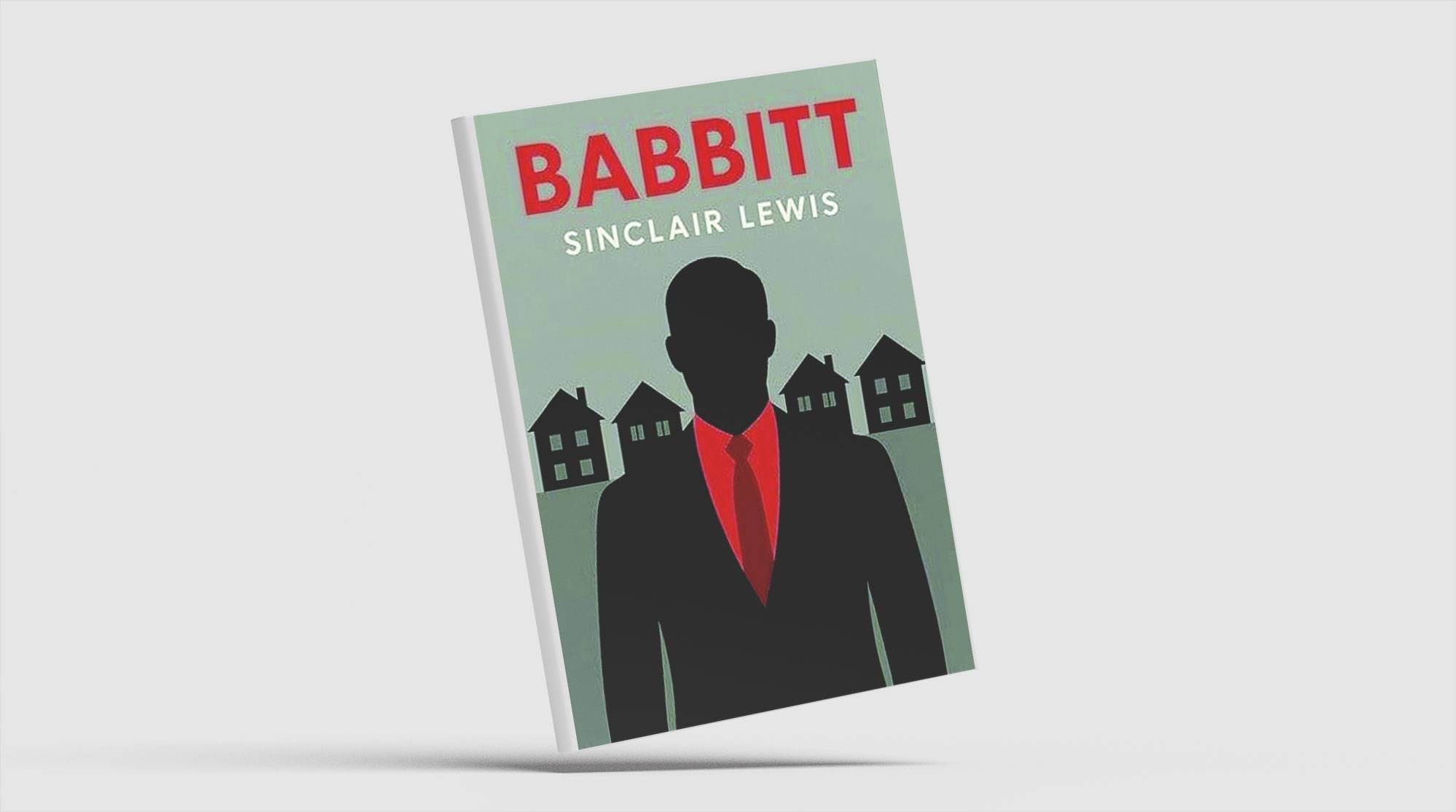
«بابيت» لسنكلير لويس
يسأل جورج ف. بابيت، رجل العقارات المولع بالأجهزة، وسائق سيارة بويك، والمنتمي إلى نادٍ ريفي، والذي يُمثّل محور رواية لويس الساخرة التي صدرت عام 1922، عن الرضا الذاتي للطبقة الوسطى: «بصراحة، هل تعتقدين أن الناس سيظنونني ليبرالياً أكثر من اللازم لو قلتُ إن المضربين كانوا محترمين؟». تدور أحداث هذه الرواية وسط احتجاجات عاملات بدالة الهاتف في مدينة زينيث الخيالية في الغرب الأوسط الأميركي.
تجيبه زوجته: «لا تقلق يا عزيزي، أعرف أنك لا تعني كلمة مما تقول». ومع ذلك، فإن مساعدة المضربين هي أول ما سيفعله ذلك الشاب الجامعي -الذي كان يحلم بالدفاع عن الفقراء. يعترف لابنه لاحقاً قائلاً: «لم أفعل في حياتي شيئاً أردته حقاً!». ثم يمر بأزمة منتصف العمر قصيرة الأمد. ينخرط في الأوساط البوهيمية، ويقيم علاقة غرامية مع أرملة، ويثير ضجة في ناديه الرياضي. لكن عندما يُقابل بتجاهل مجتمعه، ومرض زوجته، ينهار بابيت.
حققت الرواية مبيعات هائلة، ودخل عنوانها إلى اللغة الدارجة: أصبح «بابيت» اختصاراً للشخص المتوافق مع التيار السائد، العالق في عالم ضيق الأفق. لقد أدرك لويس، أول أميركي يفوز بجائزة نوبل في الأدب، ما يغيب غالباً عن الاقتصاديين: الحلم الذي انتقده ليس طموحاً، بل هو إجباري. الانسحاب يعني النفي، لذا يبقى معظم الناس في الداخل، مبتسمين في الفراغ.
* تكتب أليكسس كو عموداً عن التاريخ الأميركي في ملحق الكتب بصحيفة «التايمز». وهي زميلة بارزة في مؤسسة «نيو أميركا»، ومؤلفة كتاب «لن تنسى أبداً بدايتك: سيرة جورج واشنطن».
خدمة «نيويورك تايمز».