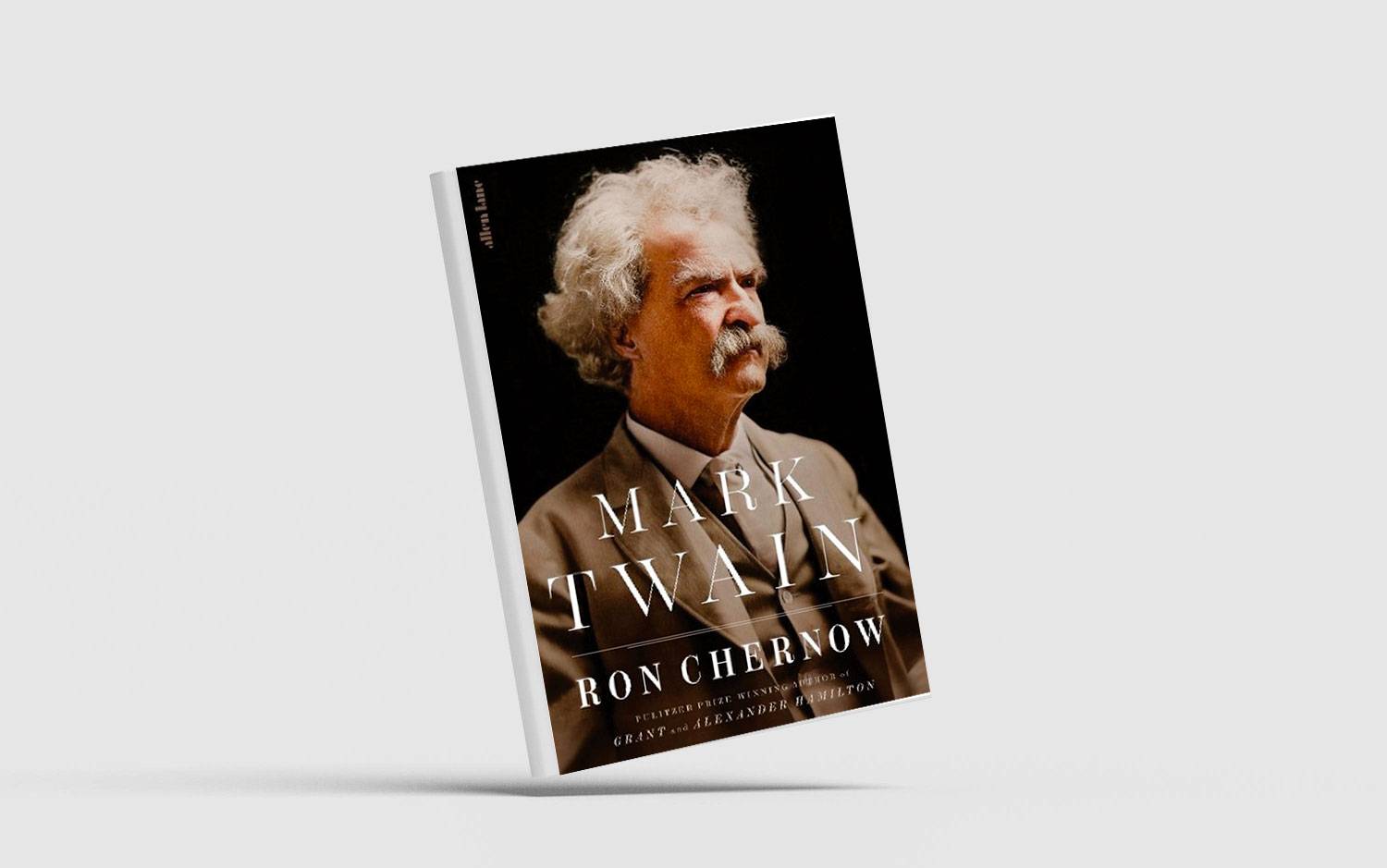يعتمد الفكر الحداثي على منهجية العزل، أي الفصل عوضًا عن الوصل. بمعنى أن حل المعضلات لا يتم إلا بتفكيك الظاهرة إلى أجزائها الواضحة، أو لنقل إن الحداثة كنمط في التفكير ساد العالم ولا يزال، يستند إلى تفتيت الكل إلى دوائر واضحة تسمح بالتحكم فيها وفض أسرارها. وهي المنهجية العلمية بامتياز. ومادام أن عملية الفصل هذه غير واقعية، لأن العالم مركب أصلا، فإن ما يتبقى لدى الدارس هو العزل كتجربة خيالية افتراضية، ثم، بعد ذلك، إعادة هذا الجزء المنزوع عن كله، إلى أصله الطبيعي، لكن بعد أن نكون قد حصلنا منه على ما نريد، أي الوضوح. وما غاية العلم في نهاية المطاف سوى السعي نحو الوضوح وإبعاد الغموض، إذ لا رؤية في الظلام.
إن المتأمل في الدرس الحداثي بدءًا من القرن السابع عشر، وهو فجر العلم الحديث، يكتشف أن عملية الفصل هذه لم تتوقف أبدا. ولعل من كان له النصيب الأكبر في العزل، وبجلاء ألقى بظله على الحياة البشرية إلى حد الساعة، هو الدين. فقد تم فصله عن العلم بقوة المتغيرات العلمية، إذ سيستغني العلماء عن الحقيقة كما تقدمها الكتب المقدسة، فترسخت فكرة أن الحقيقة بطلها الإنسان وهو صانعها، ولم يعد بحاجة إلى يد مفارقة تدعمه في ذلك، الأمر الذي يجعلنا نتذكر وبقوة، معنى كلام غاليليو الصارخ: «إن الإنجيل يعلمنا كيف نذهب إلى السماء ولكن لا يعلمنا كيف هي السماء». فهذا الأمر يحتاج طريقة أخرى، هي العلم الناشئ آنذاك. فكانت بذلك، أول عملية تفرقة، أي عزل، بين الكتاب المنظور والكتاب المسطور. فهما يختلفان من حيث منهجية التناول، ولغتهما مختلفة تماما. يقول غاليليو: «إن الطبيعة مكتوبة بلغة الرياضيات، وحروفها هي المثلثات والدوائر وباقي الأشكال الهندسية، وبدونها لن يتمكن الإنسان من فهم ولا كلمة واحدة - من كتاب الطبيعة - وسيتيه في متاهة الظلام الدامس». فيكون غاليليو بقوله هذا، أحد من مهد لللائكية في أوروبا القرن السابع عشر، وذلك عندما فرق بين منطق الدين ومنطق العلم.
إن الأمر لم يقتصر فقط على الفصل بين العلم والدين، بل تعداه، وكما نعرف، إلى عزل الدين عن السياسة، إذ سيتم تجاوز ما سمي بالحق الإلهي، حيث كان الحاكم يحكم باسم السماء، وهو ما سيبلور نظرية التعاقد الاجتماعي التي أرساها كل من توماس هوبز وجون جاك وروسو، والتي بموجبها يكون الناس هم أسياد قرارهم، واختيار الحاكم يكون من أجل قضايا الدنيا وليس قضايا الآخرة.
أما عملية عزل الأخلاق عن الدين، فقد وصلت أوجها في القرن الثامن عشر مع كانط، لتصبح قضية الخير شأنا شخصيا لا علاقة لها بالوصايا. فأنا أخلاقي، يعني: أن الأمر اختيار يمليه العقل، إذ أكد كانط أن الفعل الأخلاقي الحقيقي، تكون فيه أنت مشرع نفسك ولا تنتظر وصاية أحد. وهو ما يمكن الفرد من الاستقلال التام وبشكل بطولي. فهو قادر بواسطة عقله أن يرسم الحدود الفاصلة بين ما هو أخلاقي ولا أخلاقي، وباتفاق مطلق مع باقي البشرية من دون اللجوء إلى أي سلطة خارجية كيفما كانت. فالمرء إذا ما أراد عالم النقاء والنبل، عليه تدريب نفسه كي يطيع أمر عقله وفق القاعدة التالية: «افعل بحيث يكون فعلك قانونا عاما»، يعني عدم جعل نفسه استثناء في التشريع الأخلاقي. وهو الأمر الذي يسمح بالموضوعية والوحدة البشرية ومن ثم تحقيق الكونية المنشودة.
فماذا بقي للدين إذن، بعد عملية الاستحواذ هذه؟ فقد سحب منه البساط في قضايا كانت فيه يده هي الأولى. هذا الموضوع سيعالجه الفيلسوف المعاصر لوك فيري، الذي تجند في كل أبحاثه لمحاولة إزالة آخر ورقة تبقت للدين، وهي المعنى والخلاص تجاه قضية الموت.
سنعتمد لفهم موقفه على كتابه: «أجمل قصة في تاريخ الفلسفة». وهو الكتاب الذي ترجمه أخيرا محمود بن جماعة عن دار التنوير، الطبعة الأولى 2015. ولنبدأ بهذه التجربة الخيالية التي يقترحها كمنطلق للتفكير. يقول فيري: «لنعش حلما. لنتخيل أننا نملك عصا سحرية تسمح لنا بأن نجعل البشر، بلا استثناء، يسلكون، من الآن، تجاه بعضهم البعض، على نحو في غاية الأخلاقية. ونجعل كل واحد منهم محترما للآخرين، طيبا، دمث الأخلاق، ليس مع أقربائه وحسب، بل مع مثيله أيضا، أي مع سائر الناس على سبيل الإمكان. بالتأكيد ستتخيلون أن مصير البشرية سيتحول جذريا جراء ذلك. فلا حروب، ولا جرائم قتل، ولا أشكالاً من الإبادة الجماعية، ولا خوف من وقائع الاغتصاب والسرقة. فيستغنى عن الجيوش وعن فرق الأمن والسجون. ومن المحتمل أن يجري القضاء على أشكال اللامساواة الاجتماعية، أو على الأقل، على أكثرها فظاعة».
لقد قدمت كلام لوك فيري كما هو، لأظهر بداية، أنه لا يخرج عن النمط الحداثي في التفكير، وهو العزل المنهجي الافتراضي. فهو كما نرى، يطالبنا بأن نتصور مجتمعا مثاليا تسوده الأخلاق، ليؤكد لنا محاسن ذلك وما سيجنيه الإنسان من حقوق. لكن قصد هذا الفيلسوف عكسي، وهو إبراز كم الفارق هائل بين القيم الأخلاقية والقيم الروحية التي غالبا ما يتم الربط بينها. فإذا تحققت الأخلاقية في أعلى مستوياتها وحصل البشر على حقوقهم كاملة، فهل يعني هذا أن الإنسان سوف لا يصيبه الهرم أو المرض أو الموت؟ بل هل الأخلاقية ستحول دون معاناة المرء من محنة حداد مرعبة إثر وفاة حبيب أو صديق؟ هل إذا اتسم شخص ما بالسلوك النبيل وعلى الدوام، سيمنع ذلك تعاسته في الحب؟ هل سيمنعه ذلك من القلق جراء اليومي الرتيب القاتل؟
إن هذه الأمور: الشيخوخة، المرض، فقدان العزيز، فشل الحب، الرتابة وغيرها، لا تمت بصلة إلى الأخلاقية. فنجاحي الأخلاقي لا يعني قدرتي على تخطيها، إذن فالقيم الأخلاقية منفصلة عن القيم الروحية أو الوجودية. أو لنقل، إنه إذا كان هدف القيم الأخلاقية هو النبل والخير الإنساني، فإن القيم الروحية هدفها الحياة الطيبة بالنسبة للبشر الفاني والمحدود في الزمان. أي أن الأخلاق هي وسيلة الإنسان ليعيش علاقات أكثر مدنية وملؤها السلام، لكنها ليست أبدا شرطا كافيا لحياة موفقة. فالحياة الأخلاقية قد تكون جنبا إلى جنب مع حياة قلما ترضينا.
ولمزيد من توضيح ضرورة عدم الخلط بين دائرة القيم الأخلاقية ودائرة القيم الروحية، يضرب لوك فيري مثالا توضيحيا هو التالي: هب أن لدينا شخصا رائعا على المستوى الأخلاقي، وجاءه خبر ابنه الذي تعرض لحادثة سير مروعة. من المؤكد أن كيان هذا الأب سيهتز. وسيعيش تجربة مفعمة بقيم جوهرية وانفعالات هائلة، وتساؤلات عميقة. وإذا ما تأمل المرء الأمر جيدا، فسيجد أن ذلك لا يمت بصلة إلى الأخلاق. كما يضيف لوك فيري، أن حتى الحب، وإن كان فيه نوع من التودد والاحترام واللطف، فهو تجربة تبقى خاصة لا تتصل مباشرة بالأخلاق. فكم من الفضلاء هم تعساء في الحب، إضافة إلى أنه كوني أتصرف بشرف، لا يعني أني لن أشعر بالقلق حد الضجر، فالروتين والملل الذي يخترق وجودنا لا يجد أبدا مخرجه في الأخلاق.
إن كل هذه الأمور المذكورة أعلاه، تدخل، كما قلنا، ضمن خانة مختلفة، إنها الخانة الوجودية، الروحية، والتي هاجسها هو سؤال مختلف عن سؤال الأخلاق، إنه سؤال الحياة الطيبة بالنسبة للإنسان الفاني، إنه سؤال الخلاص.
هنا بالضبط تتدخل الأديان. فهي تقدم أحسن عزاء لمسألة الموت، ومن ثم المعنى. فأن يؤمن المرء بأن هناك حياة أخرى خالدة، تسمح بلقاء الأحباب من جديد، لهو الخلاص المغري من أخطر سؤال بشري يقض مضجعه.
إذا عدنا إلى بداية المقال، سنكتشف أن الدين منذ القرن السابع عشر، وهو يتعرض لعملية حصر وتضييق، بحيث لم يعد له سوى مجال واحد، هو تقديم جواب عن سؤال الموت. لكن العجيب، هو أن محاولة لوك فيري لن تقتصر على ترك الدين في هذه الخانة، بل سيسعى إلى إبراز أن حتى سؤال الخلاص يمكن منازعته فيه، وذاك ما ستقوم به الفلسفة باعتبارها منافسا. فكيف ذلك؟
يرى لوك فيري، أنه على الرغم من أن الدين يكسب الإنسان أرباحا بجوابه المغري عن الخلاص، لكن ذلك لا يتم من دون خسارة، حيث يتم هذا الخلاص على حساب شيئين أساسيين يحددان البشر، وهما العقل والحرية. فالعقل مع الدين يصبح خاضعا، ومطالب بالانحناء أمام حقائق الوحي، كما أن سبل الحياة الطيبة، تصبح ليس ملكا للبشر، بل إملاء من الإله، وهو ما يضرب الحرية في الصميم. فالدين بحسب لوك فيري هو الجواب الأكثر إنسانية من جهة، لأنه شخصي يعني كل فرد بعينه. لكنه من جهة أخرى، الجواب الأقل إنسانية أيضا، لأن العقل يزاح لصالح الوحي والإيمان.
هذا الأمر جعل لوك فيري يقول، إن مسألة الخلاص ليست حكرا على الدين. وبالنسبة له، يمكن تقديم جواب كحل لذلك السؤال الخالد: ما الحياة الطيبة لبشر فانين؟ بالارتكان فقط على المؤهلات الخاصة بالإنسان، فيعاد له عقله وحريته.
هذا الموقف الجذري الذي ينافس الدين في آخر معقل له، وهو الخلاص، جعل المفكر المغربي طه عبد الرحمن، يناقشه في كتابه «بؤس الدهرانية»، حيث خصص حيزا منه لنقد فكر لوك فيري الذي يريد جعل الإنسان إلها.
إرادة سحب قضية الخلاص من الدين
مسيرة عزل الدين عن قطاعات الحياة في المنظومة الغربية


إرادة سحب قضية الخلاص من الدين

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة