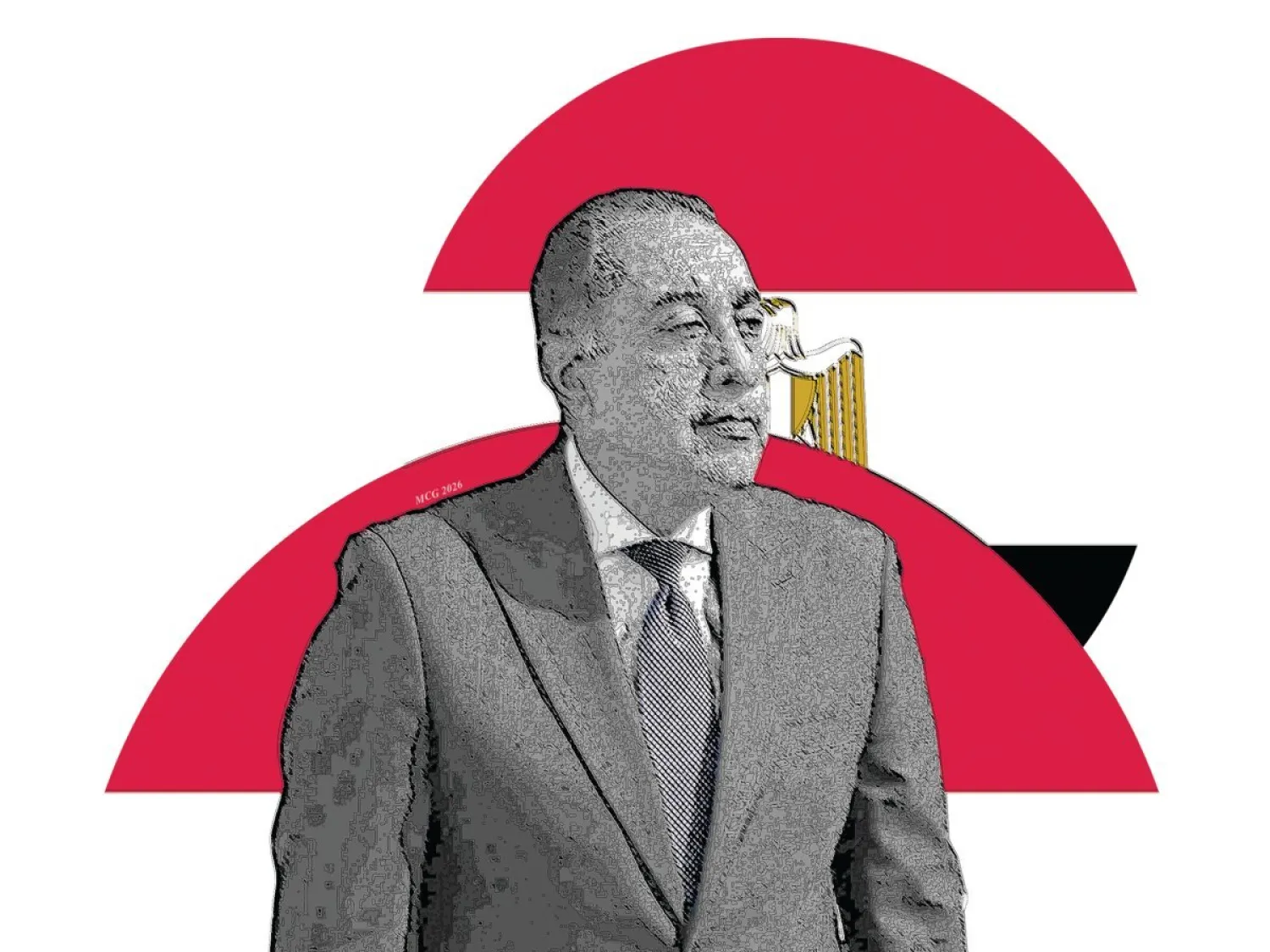جاء تكليف الدكتور هاني المُلقي لرئاسة الحكومة الأردنية، في مرحلة اقتصادية صعبة يعيشها الأردن جراء تأثيرات تداعيات أحداث المنطقة وما أفرزته الحرب في سوريا والعراق على الأردن من إغلاق للحدود وتدفق اللاجئين السوريين في بلد شحيح الموارد والمياه؛ الأمر الذي انعكس بسرعة كبيرة على حياة المواطنين. ولعل اختيار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للرئيس الملقي، جاء لما تتطلبه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد، وإحساسه بمعاناة المواطنين الذين استنزفت مدخراتهم جراء الضرائب التي فرضتها حكومة الدكتور عبد الله النسور السابقة.
حكومة المُلقي جاءت بجرعة اقتصادية واضحة، وملف الاستثمار يحتل مكانة متقدمة في اهتماماتها بحكم تركيبتها، وهي حكومة تقول للعالم إن قلبها وذراعيها مفتوحان لاستقبال الاستثمارات. أما ما يشغل بال الحكومة فملفان يعتبران من أولوياتها: الأول هو الاقتصاد والمديونية وضرورة معالجتهما، خاصة أن المواطن يعاني معاناة كبيرة. والآخر هو إجراء الانتخابات النيابية والمجالس المحلية التابع لمشروع اللامركزية.
حكومة هاني المُلقي الجديدة في الأردن «حكومة انتقالية» جاءت في ظروف حساسة، وأمامها ملفات صعبة، خاصة في المجال الاقتصادي. هكذا يصفها الكاتب السياسي فهد الخيطان، ويضيف: إن «عدد أعضاء الحكومة جاء أكبر من اللازم، وكان يجب أن تكون أكثر رشاقة؛ لأن المرحلة تتطلب العمل بديناميكية عالية، وأن الفريق موسع جدًا وسيعيق عمل الحكومة». ثم تابع: «أعتقد أنه لن يكون هناك تغييرات في السياسات والاستراتيجيات الرئيسية والتي كانت في عهد الحكومة السابقة». وبالنسبة للملفات الخارجية، قال الخيطان: إن الحكومة ستتولى الأمور الداخلية، ولن تتدخل في الأمور التي تهم الأمن والدفاع.
أما وزير الإعلام الأسبق الدكتور نبيل الشريف، فيرى أن التغيير الحكومي «جاء لإعطاء الملف الاقتصادي دفعة إلى الأمام، وليس كما يقال إنها جاءت لإجراء الانتخابات؛ إذ إنه كان بإمكان الحكومة السابقة إجراء الانتخابات، ولا يوجد نص دستوري يمنع ذلك». ثم أشار إلى أن الحكومة «جاءت لترتيب البيت الاقتصادي»، معربا عن اعتقاده أن «الحكومة السابقة أصابها الوهن والترهل في الفترة الأخيرة، خصوصا في الجهاز الحكومي، وهذا رأيناه في كتاب التكليف السامي حول ضرورة تطوير الجهاز الحكومي». وتابع الشريف «الهم الاقتصادي ومعاناة المواطنين منه هو الذي كان يشغل بال الملك، ولو استطاعت الحكومة الحالية أن تخفّف المزاج العام وتدخل التفاؤل إلى قلوب الأردنيين فهو بحد ذاته نجاح. وأعتقد أن هناك نسبة من التفاؤل على قدرات هذه الحكومة لتغيير المزاج العام وبدء التغيير في الملفات الاقتصادية».
* الحكومة الـ16
جدير بالذكر، أن حكومة هاني المُلقي هي الحكومة السادسة عشرة منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته عام 1999، وكان قد تولى رئاسة الحكومات الـ15 قبلها 11 من رؤساء الوزراء، هم: عبد الرءوف الروابدة وعلي أبو الراغب وفيصل الفايز وعدنان بدران ومعروف البخيت ونادر الذهبي وسمير الرفاعي وعون الخصاونة وفايز الطراونة وعبد الله النسور، ورئيس الوزراء الحالي هاني المُلقي. لم يأت الملك عبد الله الثاني بشخصية معارضة، أو حتى شبه معارضة، تحظى ببعض القبول لدى أحزاب اليسار والأوساط النقابية، لكي يخلق انطباعًا بأن النظام في الأردن تجاوز مرحلة «الربيع العربي» إلى مرحلة جديدة وهي استعادة هيبة الدولة. بل ذهب الخيار الملكي باتجاه اختيار دبلوماسي واقتصادي ليقود مرحلة ربما تكون انتقالية، تقف فيها الأردن على أعتاب انتخابات برلمانية، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية وجوار مضطرب يلقي بظلاله على الساحة المحلية.
* ابن عائلة سياسية
الرئيس هاني المُلقي شخصية واقعية، تنظر للمشهد من الزوايا كافة، وهو شخص عرف عنه معالجة الوضع الاقتصادي بأسلوب إداري موزون، وهو الأسلوب ذاته الذي اضطلع فيه الرجل، حين مارس السياسة الاقتصادية بمفهومها الشامل، منذ توليه مناصب وزارية في أكثر من موقع. المُلقي ابن عائلة سياسية مُخضرمة، فوالده هو رئيس الوزراء الأسبق فوزي المُلقي في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال. وعُرف عنه أنه يُعالج القضايا بأسلوب علمي هادئ يرقى إلى الوعي المبني على فلسفة (الفهم والتفاهم)، وقد يكون هذا سرّ نجاحه في المواقع السياسية والاقتصادية التي تبوأها، منذ أن دخل الحياة السياسية في أواسط ثمانينات القرن الماضي، وحتى توليه رئاسة الحكومة.
وعائلة المُلقي تقلّدت الكثير من المناصب المهمة والحساسة في الدول الأردنية قبيل وبعد استقلالها، حيث قرّب الملك عبد الله الأول (الملك المؤسس) فوزي المُلقي – والد رئيس الوزراء الجديد – وعيّنه مسؤولا عن التموين أثناء الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام 1944، ثم استعان به الملك الراحل حسين بن طلال وعيّنه أول رئيس وزراء له عند تسلمه مقاليد الحكم عام 1953. ومنذ ذلك الوقت وعائلة المُلقي مقرّبة من القصر الهاشمي. واللافت أن هاني المُلقي تسلم الحقائب ذاتها التي تسلمها والده، من رئاسة الوزراء إلى وزارة التموين إلى منصب السفير الأردني في القاهرة، حيث مكث المُلقي الابن فترة طويلة في القاهرة، وهي المدينة التي درس فيها المرحلة الأولى من تعليمه الجامعي.
لعب هاني المُلقي دورًا بارزًا في السياسة الخارجية إبان تسلمه حقيبة الخارجية عام 2004، وهي وزارة سيادية لها وزنها في التركيبة الحكومية، إضافة إلى عمله مندوبًا دائمًا لدى جامعة الدول العربية بين عام 2008 وحتى 2011، وخلال عمله مستشارًا للملك خلال الفترة (2005 – 2007)، كما عين عضوا في مجلسي الأعيان الحادي والسادس والعشرين.
ولا تقتصر خبرة الرئيس الجديد، على الجانب السياسي، بل تتعداه – كما سبقت الإشارة – إلى مؤسسات ووزارات ذات طابع اقتصادي، منها: المياه والري والطاقة والتموين والصناعة، ولعل أهم تلك المواقع تسلمه رئاسة سلطة منطقة العقبة الخاصة. وفي عهد المُلقي كان التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية، وهي الفلسفة التي ينطلق منها، ويدعو لها منذ عهد بعيد، وفقًا لتصريحاته الصحافية ولقاءاته، ومشاركاته في الندوات والمؤتمرات. وكما يقول عارفوه، فهو من القلائل الذين يجمعون بين الحنكة السياسية، والنظرة الشمولية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، من حيث دراسة المشاريع التنموية دراسة متأنية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وهو بمجمله الفهم العميق للواقع من منظوره العام.
من ناحية ثانية، فإن شخصية المُلقي القوية هي الدافع الحقيقي لإيمانه بهيبة الدولة، وبضرورة إعادة الاعتبار لها، ولقد مارس صلاحياته في حل الكثير من الإشكالات التي كانت شهدتها مدينة العقبة، إبان ترؤسه سلطتها الاقتصادية. وكذلك رفضه التسويات التي تقود إلى التمادي في المخالفات والاعتداءات على أملاك الدولة. وهو رجل دولة بامتياز، يتبنى سياسة القانون على الجميع، ويبدو أن اختياره لهذا الموقع يصب في خانة الإصلاح الشامل.
أيضًا عرف عن المُلقي أنه يفصل بين الأملاك العامة والأملاك الشخصية الخاصة، فهو يستعمل سيارته الخاصة بعد انتهاء دوامه، إضافة إلى يحمل هاتفين الأول للعمل والثاني للبيت ويستخدم أملاكه الشخصية خارج الدوام الرسمي.
* المفاوضات مع إسرائيل
سياسيا ارتبط اسم هاني المُلقي بالمفاوضات الأردنية - الإسرائيلية، التي أفضت إلى توقيع «اتفاقية وادي عربة للسلام» بين الأردن وإسرائيل عام 1994، ولقد عهد الملك الراحل الحسين بن طلال لاحقا إلى المُلقي برئاسة المجلس الأردني في مفاوضات السلام «الاتفاقيات التفصيلية» بين الأردن وإسرائيل خلال الفترة الممتدة بين عامي 1994 - 1996. ومنذ ذلك التاريخ لم يغب رئيس الوزراء الجديد عن الساحة السياسية؛ إذ تقلد الكثير من الحقائب الوزارية، منها: وزارات المياه والري، والطاقة، والتموين، والصناعة والتجارة، والخارجية عام 2004. وخلال توليه حقيبة وزارة الخارجية التقى المُلقي برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون في تل أبيب عام 2005. كما التقى بشخصيات إسرائيلية أخرى من أبرزها وزير الخارجية سيلفان شالوم عام 2005، والنائب الأول لرئيس الدولة العبرية السابق شمعون بيريز، ووزير الصناعة والتجارة إيهود أولمرت الذي أصبح رئيسًا للحكومة الإسرائيلية عام 2006. وشنّ هجومًا عسكريا على قطاع غزة نهاية عام 2008 وأوائل 2009.
* المشكلات الاقتصادية
المُلقي، كما يتوقع محللون، سيسعى إلى إيجاد حلول ذكية لمشاكل الأردن الاقتصادية، ابتداء بإغلاق معابر الدولة الأردنية البرية مع العراق وسوريا اللتين تعدّان الشريان الرئيس للصادرات الأردنية، ومرورا بأزمات تراجع معدلات النمو وتدفق الاستثمارات الأجنبية وما رافقهما من ارتفاع لمعدلات البطالة بين الأردنيين. وللعلم، كانت حكومة سلفه عبد الله النسور قد تعهدت في «مؤتمر المانحين» في لندن خلال فبراير (شباط) الماضي بتشغيل نحو 200 ألف لاجئ سوري خلال ثلاث سنوات. وما ينطبق على الاقتصاد في الأردن ينطبق على السياسة أيضًا؛ إذ شهدت البلاد تراجعا في الحريات السياسية والإعلامية، كما تراجع ترتيب البلاد سلبا على سلّم مكافحة الفساد والشفافية العالمي.
ثلاثة ملفات رئيسية تنتظر حكومة المُلقي، ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج «إصلاح مالي جديد»، وملف مجلس التنسيق السعودي – الأردني، بالإضافة إلى ملف إجراء الانتخابات البرلمانية قبيل نهاية العام الحالي. ويسود اعتقاد بأن تلك الملفات الثلاثة هي ما سيحكم على أداء الحكومة، وهل ستستمر في قيادة الحكومة للسنوات الأربع المقبلة أم لا، وهي مَن سيحدد مصيرها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
* بطاقة هوية
يبلغ عمر رئيس الوزراء الأردني الجديد 65 سنة، وهو من مواليد العاصمة عمّان عام 1951. حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الإنتاج من جامعة القاهرة في مصر عام 1974، ثم حاز شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية من معهد رنسيلير البوليتكنيكي RPI، أحد أعرق وأبرز الجامعات التكنولوجية في الولايات المتحدة الأميركية، عام 1977. ثم نال منه شهادة الدكتوراه في هندسة النظم والصناعة عام 1979.
وعلى صعيد المناصب، شغل المُلقي عددا من المناصب، منها:
- مهندس ميداني في وزارة الأشغال العامة 1974 – 1975.
- مساعد عميد الهندسة في جامعة اليرموك 1980 ـ 1981.
- مدير تنفيذي للأكاديمية الإسلامية العامة للعلوم 1987 ـ 1989.
- باحث في الجمعية العلمية الملكية 1975 ـ 1979.
- رئيس قسم الطاقة الشمسية في الجمعية العلمية الملكية 1983 ـ 1987.
- رئيس الجمعية العلمية الملكية 1989.
- الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا 1993 ـ 1997.
- تولّى رئاسة الجانب الأردني في اللجنة المشتركة لمراقبة تنفيذ معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
- النائب التنفيذي لرئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا 19-4-1999 - 1-3-2002.
- سفير للأردن لدى مصر 1-3-2002 - 24-10-2004، ومندوب دائم للأردن لدى جامعة الدول العربية.
- مستشار للملك 7-4-2005 - 1-10-2007.
- سفير للأردن لدى مصر 1-6-2008 - 11-2-2011، ومندوب دائم للأردن لدى جامعة الدول العربية.
- عضو في مجلس الأعيان الحادي والعشرين.
- عضو في مجلس الأعيان الـ 26 الحالي (استقال).
- رئيس لسلطة إقليم العقبة الخاصة عام 2014.
* الحقائب الوزارية
- وزيرا للمياه والرّي 1998.
- وزيرا للطاقة 1998 – 1999.
- وزيرا للتموين.
- وزيرا للصناعة والتجارة.
- وزيرا للخارجية في عام 2004.
هاني المُلقي.. سياسي «القانون على الجميع»
يرأس حكومة انتقالية بجرعة اقتصادية لتغيير المزاج العام الأردني


هاني المُلقي.. سياسي «القانون على الجميع»

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة