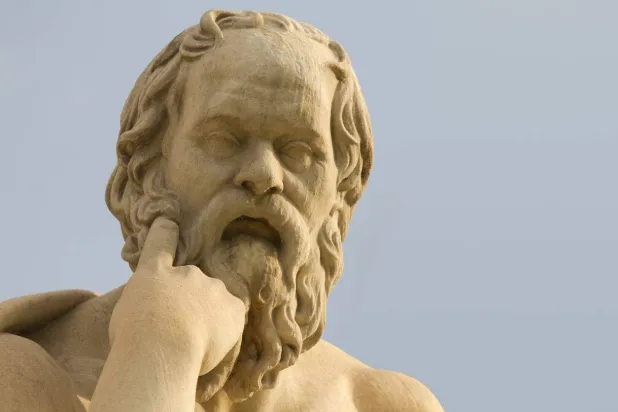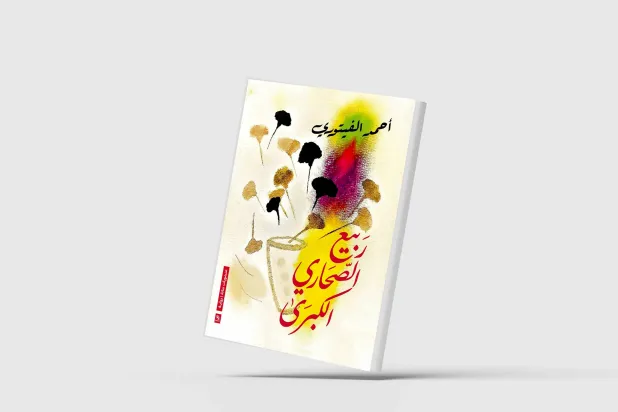يعد الباحث والمترجم والناشر المصري الدكتور أحمد السعيد أحد أبرز الوجوه المصرية المتخصصة في الثقافة الصينية التي قدمت جهداً ملموساً في السنوات الأخيرة على صعيد التقريب بين تلك الثقافة ونظيرتها العربية. في كتابه الصادر أخيراً «الصين من الداخل» محاولة لتقديم رؤية جديدة للعملاق الآسيوي صاحب الموروث الحضاري العريق تتجاوز الانبهار الشكلي. وقدم السعيد في سنوات قليلة العشرات من الأعمال المترجمة من وإلى الصينية من خلال دار «بيت الحكمة» بالتعاون مع مجموعة من المترجمين.
هنا حوار معه حول كتابه الجديد وهموم الترجمة والنشر:
> كتابك الأحدث «الصين من الداخل»، هل جاء متأثراً في عنوانه بكتاب محمد حسنين هيكل الشهير «إيران من الداخل»؟ هل ثمة ما يربط بين العملين مثل محاولة اقتحام مجتمع مثير للفضول، لكنه يتميز بالغموض والانغلاق الشديد؟
- كتابي يختلف تماماً عن كتاب محمد حسنين هيكل؛ فهو كتب عن داخل إيران وهو خارجها، معتمداً على أدواته الصحافية الرائعة كما هو دائماً، وشبكة مصادره الواسعة ليقدّم شهادة مراقب يقرأ المشهد من الخارج. أما أنا فكتبت عن الصين وأنا في قلبها: معرفياً ومهنياً ودراسياً وحياتياً. عشت في مدنها وريفها، تعلمت لغتها، احتككت بمؤسساتها الأكاديمية والثقافية، وكنت جزءاً من تفاصيلها اليومية. هذا لا يعني أن القرب وحده كافٍ، لكنه يمنح زاوية مختلفة تماماً: زاوية الشاهد لا المراقب.

> ما الدافع وراء تأليفك لهذا الكتاب؟
- الدافع كان مزيجاً من المسؤولية والقلق. بعد أكثر من ربع قرن من الاحتكاك بالصين دراسةً وعملاً، شعرت أن التجربة لا يجوز أن تبقى حبيسة صدري، بل يجب أن تتحول إلى نص معرفي مشترك مع القارئ العربي. في الوقت نفسه، أقلقني أن صورة الصين في وعينا العربي تتأرجح بين نقيضين: انبهار بمعجزتها الاقتصادية، وتشويه غربي يقدّمها باعتبارها دولة مغلقة وغامضة وخطرة.
أردت أن أكتب من منطقة ثالثة: بلا مديح أو تشويه متعمد. أردت أن أقدم الصين كما هي: بلد يحمل إنجازات كبرى وتحديات واقعية، وجذوراً ثقافية وفكرية لا يمكن تجاهلها. هذه الرغبة لم تأتِ من قرار فجائي، بل من تراكم مواقف صغيرة: نقاش فلسفي في قاعة درس حول معنى «التناغم»، حوار مع سائق عن مفهوم «الأمان»، اجتماع رسمي لاحظت فيه كيف تُدار الكلمات بقدر ما يُدار الوقت. هذه التفاصيل علمتني أن فهم الصين ليس خياراً، بل ضرورة.
> ما الفارق بين تلك التجربة وكتابك الآخر اللافت «سنواتي في الصين»؟
- «سنواتي في الصين» كان دفتر الدهشة الأولى، كتاب القلب، فيه القصص الصغيرة والانطباعات السريعة. أما «الصين من الداخل»، فهو كتاب النضج والعقل، ثمرة تراكم وتجربة طويلة، عمل يحاول أن يقرأ البنية العميقة للصين: كيف تفكر، كيف ترى نفسها، كيف تصوغ علاقتها بالعالم. كتبت مسوداته أكثر من مرة، مزّقت نسخاً كاملة خوفاً من أن يسقط في فخ الدعاية، أو أن يثقل على القارئ. كان هدفي أن أجد لغة وسطى، تجمع بين عمق الباحث وسلاسة القاص معاً.
> من وجهة نظرك، لماذا تبدو الثقافة الصينية مثيرة لفضول العالم؟ وهل يضع الإنسان الصيني، رغم تهذيبه الشديد، حواجز متعمدة من الحذر والشك بينه وبين العالم الخارجي؟
- الثقافة الصينية مثيرة للفضول؛ لأنها استثناء في التاريخ الإنساني: حضارة استمرت بلا انقطاع آلاف السنين، تتغير في الشكل لكنها تبقى في الجوهر. العالم كله يسأل: ما سرّ هذه القدرة على الصمود؟ أما الإنسان الصيني، فهو مهذب ولطيف فعلاً، لكنه يحيط نفسه بحذر. هذا ليس قسوة في الطبع، بل حصيلة خبرة تاريخية طويلة بالغزو والتدخل الخارجي؛ لذلك يمنح ثقته بالتقسيط، لا دفعة واحدة.

> ما هي أبرز نقاط «سوء الفهم» أو «الالتباس» في تعامل الثقافة العربية مع نظيرتها الصينية؟
- سوء الفهم العربي للصين يبدأ من الاقتصاد ولا ينتهي إليه. كثيرون يختزلونها في «مصنع العالم»، في السلع الرخيصة والتكنولوجيا. لكن خلف هذه القوة الاقتصادية هناك منظومة قيم وفلسفة عريقة: احترام الوقت، مركزية الانسجام، مفهوم «الوجه»؛ أي الاعتبار الاجتماعي، وفكرة أن العمل ليس مجرد رزق، بل تحقيق للذات والجماعة. سوء فهم آخر هو قراءة الصين بمنظار التجربة السوفياتية، وكأن الاشتراكية الصينية مجرد نسخة مكررة، في حين أن النموذج الصيني فريد: يمزج بين السوق والتخطيط، بين الفكر الماركسي والروح الكونفوشيوسية، بين البراغماتية السياسية والجذور الثقافية.
> في المقابل، كيف ترى نظرة الثقافة الصينية للعرب؟ وهل تكتنفها أيضاً نقاط من «سوء الفهم» أو عدم وضوح الرؤية؟
- صورة العرب في الوعي الصيني مزدوجة؛ هناك صورة رومانسية تعود إلى الأدب: «ألف ليلة وليلة»، الصحراء، الكرم، الشعر. وهناك صورة سلبية تأثرت بالإعلام الغربي: عنف وفوضى وإرهاب. بين هاتين الصورتين تضيع الحقيقة. المثقفون والباحثون الصينيون يعرفون أكثر، يعرفون أن العرب كانوا شركاء في «طريق الحرير»، وأن التجار المسلمين تركوا أثراً في مدن صينية مثل قوانغتشو وشيان. لكن هذا الوعي لا يصل دائماً إلى الشارع.
> كيف بدأت قصتك مع اللغة الصينية؟ ولماذا انتهى الأمر بهذا الولع الجارف بها؟
- قصتي مع اللغة الصينية بدأت صدفة؛ التحقت بقسمها في جامعة الأزهر لا عن حب مسبق، بل هروباً من الطب والصيدلة. لم تتقبل أسرتي الاختيار، لكنني مضيت فيه كما مضى طارق بن زياد بلا عودة. بعد التخرج عملت في السفارات، ثم في القوات المسلحة مترجماً. لكن اللحظة الحاسمة كانت عندما سافرت إلى الصين: هناك تحولت اللغة من وسيلة عمل إلى مفتاح حضارة. الحرف الصيني ليس مجرد رمز، بل صورة تحمل فلسفة. تعلمت أن الكلمة لا تكفي وحدها، بل سياقها وموسيقاها وإشارات الجسد معها. اللغة الصينية علمتني الصبر والدقة، وأعادت تشكيل طريقة تفكيري.
> ما الذي يحدد اختياراتك كمترجم من وإلى الصينية؟
- اختياراتي كمترجم تحددها القيمة وقدرة النص على أن يكون جسراً. لا أبحث عن السهل أو الرائج، بل عن العمل الذي يفتح نافذة جديدة. أحياناً أترجم نصوصاً معقدة؛ لأنها تكشف بعداً جديداً في الفكر الصيني، وأحياناً أختار نصوصاً أدبية؛ لأنها تعكس إنسانيتنا المشتركة. بالنسبة لي، الترجمة ليست تجارة، بل مسؤولية حضارية، والمترجم رسول بين ثقافتين.
> ما ملاحظاتك على حركة الترجمة بين العالم العربي والصين عموماً؟
- الترجمة بين العرب والصين ما زالت محدودة جداً، هناك جهود مشكورة لكنها موسمية. ما نحتاجه هو مشروع استراتيجي طويل الأمد، شبيه بما فعله العرب في العصر العباسي حين أسسوا «بيت الحكمة» التي لم تكن مجرد دار ترجمة، بل مؤسسة، رؤية تجمع النص وتترجمه وتشرحه وتعلمه وتدمجه في النسيج الاجتماعي. نحن اليوم بحاجة إلى «بيت حكمة جديد»، لكن بأدوات العصر: منصات رقمية، مكتبات صوتية، شراكات جامعية، وصناديق دعم مستقرة.
> كيف ترى موقع الأدب العربي المعاصر في الثقافة الصينية؟ وهل هناك تقصير في نقل إنتاجنا الإبداعي إلى الصين؟
- الأدب العربي في الصين يكاد يقتصر على نجيب محفوظ ومحمود درويش وأدونيس، أسماء الجيل الجديد مجهولة. وهذا تقصير من جانبنا قبل أن يكون من جانبهم. الأدب هو الوجه الأصدق للأمة؛ لأنه يعرض الإنسان لا الخبر. لو وصلت أعمال كتّابنا الجدد مترجمة بانتظام، لتغيّرت صورة العرب كثيراً. الأدب قادر على أن يهدم الصور النمطية؛ لأنه يكشف الإنسان في ضعفه وقوته، في ألمه وحبه، بعيداً عن السياسة والدعاية. وأنا مؤمن أن الأدب العربي يحمل قضايا إنسانية تهم القارئ الصيني كما تهم العربي: العائلة، المنفى، الحلم، العدل. لذلك أرى أن نقل الأدب العربي ليس ترفاً، بل ضرورة لصياغة علاقة متوازنة بين الشعبين. ولعلنا بحاجة إلى برامج تبادل أدبي لا تقل أهمية عن التبادل التجاري.
> نشرت ما يقرب من 1000 كتاب بالتعاون مع عشرات المترجمين، من وإلى اللغة الصينية، في عدة سنوات عبر دار «بيت الحكمة» التي تشرف عليها... ما الرؤية التي تكمن وراء هذا الجهد المدهش؟
- «بيت الحكمة» لم تكن مجرد دار نشر، بل محاولة لبناء جسر مؤسسي. نشرنا نحو ألف كتاب، لكن الأهم أننا جمعنا أكثر من 130 مترجماً يعملون وفق رؤية مشتركة. نتحرك في ثلاث دوائر: ترجمة تدخل المعرفة، تعليم يخرج مترجمين وقراء جدداً، وإعلام ثقافي يعيد تقديم المحتوى بوسائط جديدة. رؤيتي أن تخرج الترجمة من موسم بيع وعرض نسخ إلى دورة حياة كاملة: كتاب مطبوع، نسخة رقمية، تسجيل صوتي، محتوى مرئي، حضور في الجامعات. بذلك يعيش النص ويتكاثر، ولا يبقى مجرد مطبوعة على رفّ.
> أيهما يثير شغفك أكثر، النشر أم الترجمة؟ وما الفارق بين المهنتين من واقع تجربتك؟
- الترجمة عشقي الأول، فيها عزلة ومغامرة، فيها لذة البحث عن كلمة واحدة حتى تضيء النص. النشر ساحة أخرى: عمل جماعي، قرار سريع، مخاطرة بالسوق. الترجمة تعلم الصبر والدقة، النشر يعلم الشجاعة والمخاطرة. لا أستطيع أن أفصل بينهما؛ فالنص بلا نشر يتيم، والنشر بلا نصوص مسؤولة يتحول إلى ماكينة فارغة.
> أخيراً، يطلقون عليك في الصين «ماركو بولو العرب»، لكن رغم سعادتك باللقب يبدو أن لديك تحفظات عليه؟
- لقب «ماركو بولو العرب» الذي منحته لي صحيفة «الشعب» الصينية، وهي الصحيفة الرسمية للصين، يسعدني من حيث التقدير، لكنه يترك عندي تحفظاً صادقاً؛ لأن من يملك سرد القصة يملك الذاكرة. العرب عرفوا الصين قبل المؤرخ والرحّالة الإيطالي ماركو بولو بقرون: ابن بطوطة، المسعودي، التاجر سليمان. هؤلاء هم الذين رسموا الخرائط الحقيقية لـ«طريق الحرير». أفضّل أن أكون امتداداً لهم لا نسخة من سردية غربية. اللقب يعكس التقدير، لكنه لا يلخّصني. أحب أن أكون «ابن بطوطة جديداً»؛ بمعنى المثابرة على السفر بين المعاني والثقافات، والوفاء لجذري العربي وأنا أكتب عن الصين من داخلها.