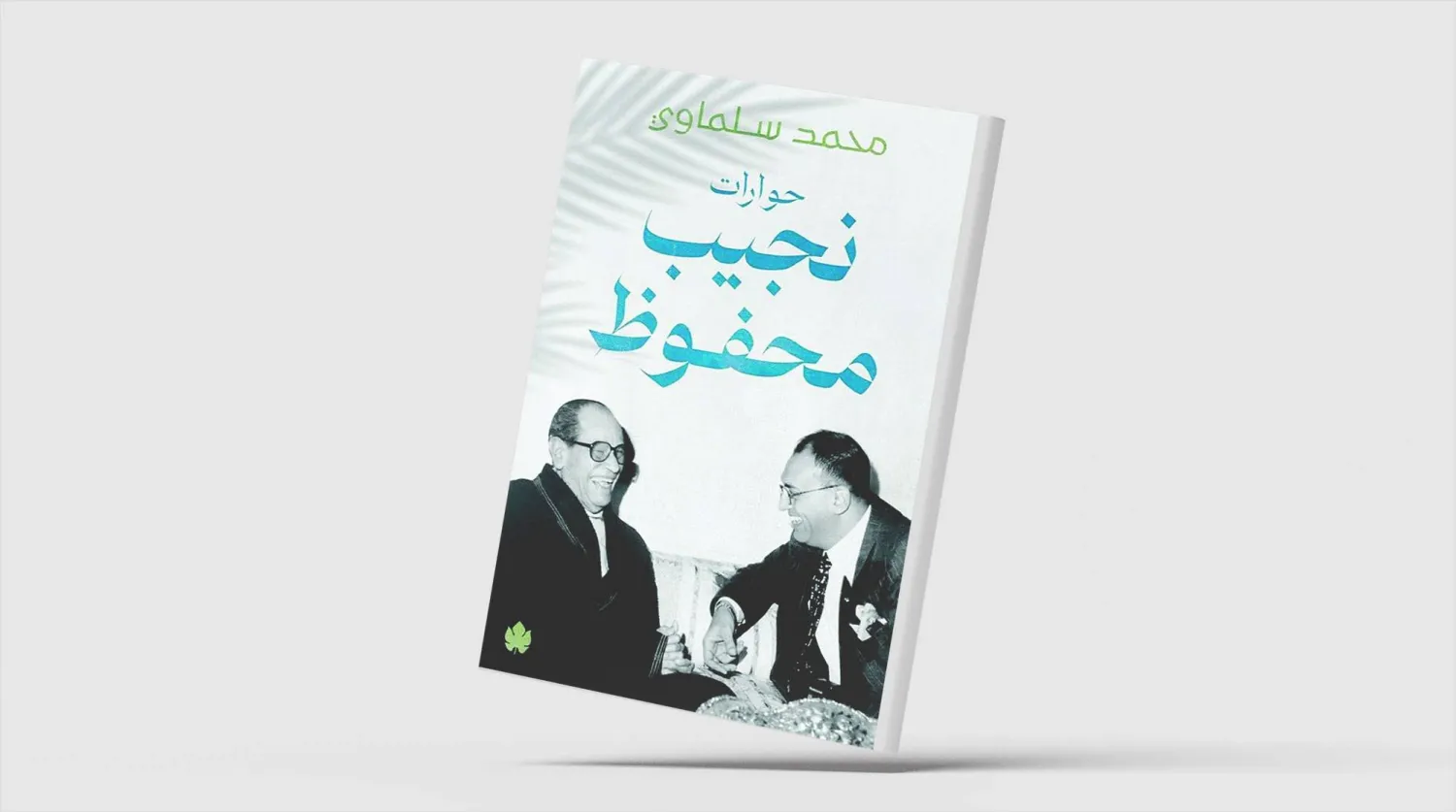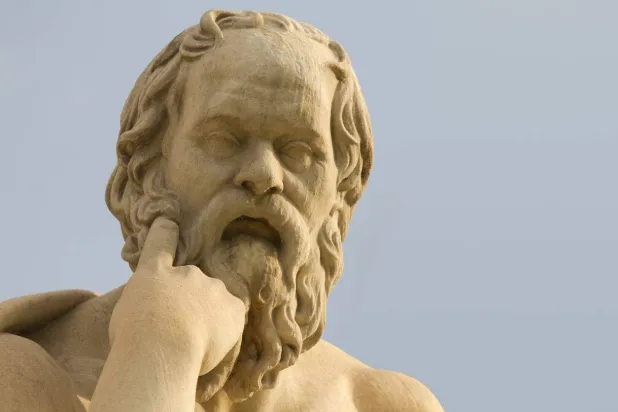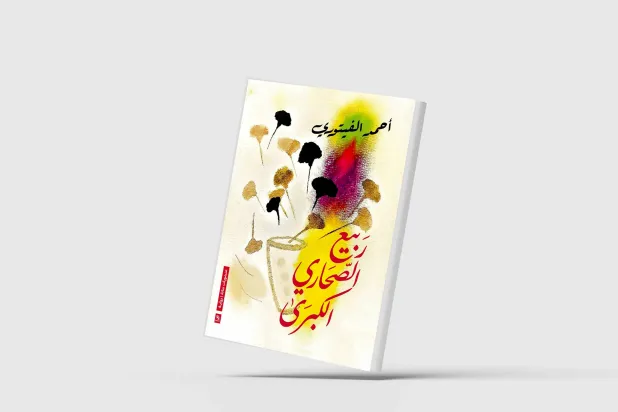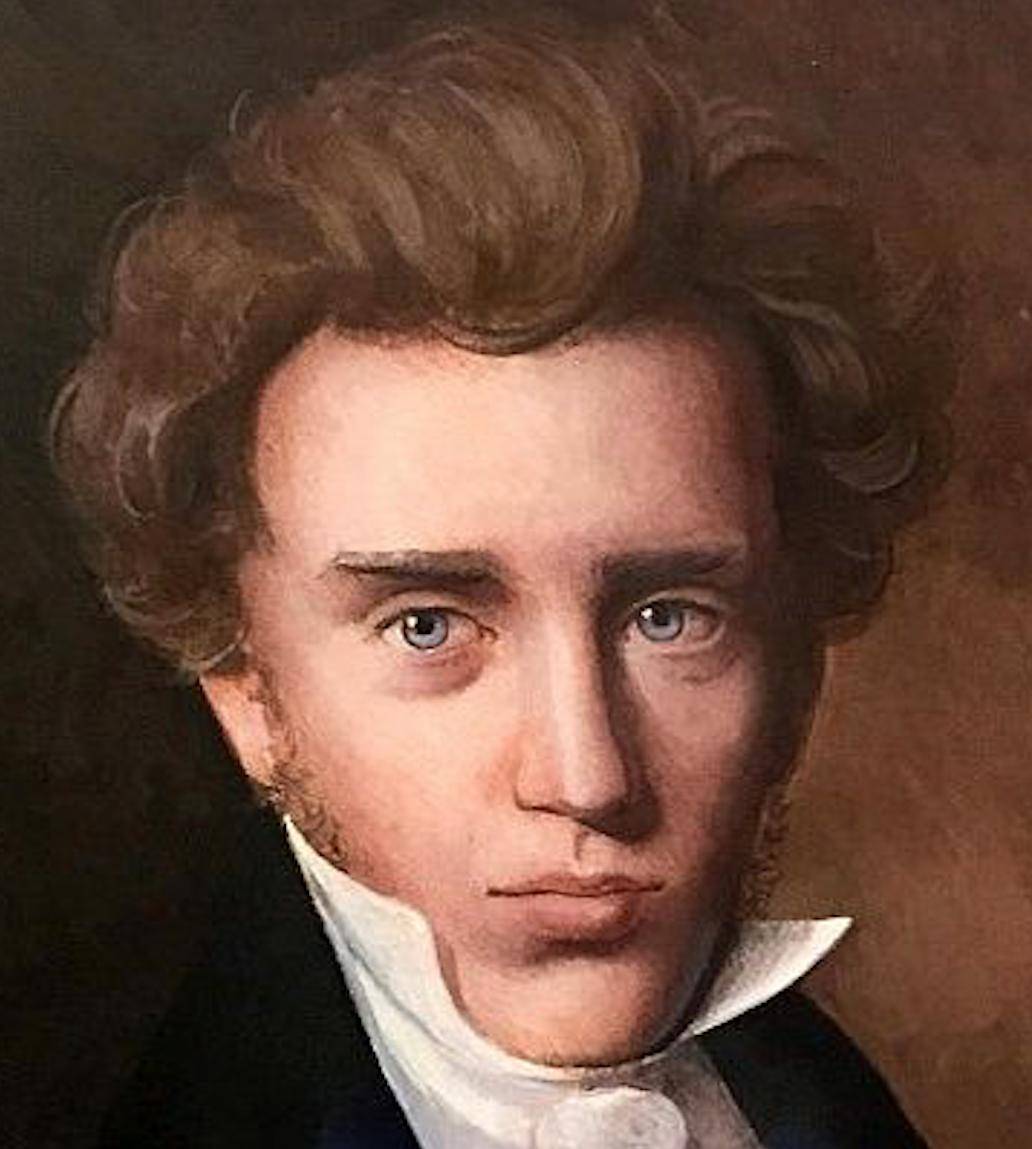يشير الكاتب محمد سلماوي في مقدمة كتابه «حوارات نجيب محفوظ»، الصادر عن دار «الكرمة» بالقاهرة إلى أن فكرة تلك الأحاديث الصحافية التي أجراها مع أديب نوبل كان هدفها توثيق آرائه على هيئة حوارات مكثفة للغاية تنشر بشكل منتظم في صحيفة «الأهرام»، كوثيقة تاريخية، في مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية المطروحة على الساحة آنذاك.
بدأ النشر لأول مرة في «الأهرام» في 22 ديسمبر (كانون الأول) 1994 وظلت تتوالى على مدى 12 عاماً حتى رحيل محفوظ في نهاية أغسطس (آب) 2006، حيث ظل سلماوي يقصد طيلة تلك السنوات منزل محفوظ بحي العجوزة في السادسة مساء كل يوم سبت ومعه جهاز تسجيل صغير يسجل المقابلة التي قد تستمر ما بين نصف الساعة أو الساعة حسب حالته الصحية.
يتحدث محفوظ خلال الحوارات في موضوعات كثيرة يطرحها عليه سلماوي أو يقترحها هو ثم يختار منها المحاور في النهاية ما يناسب النشر ويعرضه عليه قبل أن يسلمه للجريدة. ورغم أن هذه الجلسات كانت تقتصر في معظم الوقت عليهما بمفردهما، فإنها في بعض الأحيان كانت تضم بعض الصحافيين الأجانب أو السفراء أو بعض كبار زائري مصر الذي يطلبون لقاء محفوظ الذي أصبحت زيارته مكملة لزيارة معالم البلاد، فكان الضيف الأجنبي يزور الأهرامات وأبو الهول ثم يلتقي محفوظ الذي كلما أخبره سلماوي بأن هناك من يريد لقاءه قال له: «أحضره معك يوم السبت».
وهكذا تجمع لدى سلماوي ما يقرب من 500 ساعة مسجلة بصوت محفوظ يتحدث فيها عن الثقافة والسياسة والأدب كما يتحدث عن حياته الشخصية وذكرياته ويجيب عن أسئلة زوراه.
سعد زغلول
ورغم تنوع موضوعات الكتاب، فإن ذكريات نجيب محفوظ ومواقفه من زعماء مصر قبل وبعد ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 حظيت بنصيب الأسد من الكتاب، وبدأت بالزعيم سعد زغلول، القائد الملهم لثورة 1919.
يقول عميد الرواية العربية إنه شاهد تلك الثورة بعينه من شباكه الذي يطل على ميدان «بيت القاضي» وهو طفل في السابعة أو الثامنة من عمره، شاهدها وهي تصارع قوات الاحتلال الإنجليزي وسمع في هذه السن دوي الرصاص ورأى قوات الخيالة الإنجليزية وهي تقتل الناس.
ويقول محفوظ إن سعد زغلول هو بطل جيل بأكمله، ومن عرف السياسة في جيله كان مدخله إليها سعد زغلول، مدخله إلى الوطنية ومدخله إلى تاريخ مصر. ويتحسر محفوظ لأنه لم ير سعد زغلول عن قرب، قائلاً إنه كانت هناك فرصة وحيدة لرؤيته، لكنها لم تتحقق، فحين اختلف مع الملك وقامت المظاهرات أمام «سراي عابدين» تهتف: «سعد أو الثورة»، كان سيجيء لمقابلة الملك فاروق الأول فقال صاحب «الثلاثية» لنفسه: «اليوم سأراه!»، لكن ما إن وصل زغلول إلى ساحة «عابدين» حتى أحاطت به الآلاف من كل اتجاه حتى إن سيارته تحولت إلى كتلة بشرية تتقدم بصعوبة في اتجاه القصر. حاول الشاب نجيب محفوظ أن يتحرك يميناً أو يساراً عله يلمح «بطله الأسطوري»، لكنه لم يستطع حتى أن يرى سيارته.
وتدمع عينا نجيب في تلك اللحظة وتحتبس الكلمات في الحلق فيحل الصمت، لحظات متصلة لا يستطيع سلماوي خلالها مواصلة الحوار، احتراماً للحظة وتقديراً لمشاعر الرجل التي فاضت دموعه في تلقائية نبيلة. وبعد أن يستعيد الأستاذ هدوءه، يسأله: «علام حزنك يا أستاذ نجيب؟»، فيجيبه: «ليس حزناً، الحزن قد فات وقته وانقضى، إنه شريط الذكريات التي أحياها حوارك اللعين!».
مصطفى النحاس
يصف محفوظ الزعيم الوطني مصطفى النحاس بأنه «خليفة سعد زغلول، قد لا يتمتع بعبقرية سعد لكن أخلاقه وصلابته لم يُعرف لهما مثيل، فقد كان يناجز الاستعمار الإنجليزي والملك بكل شدة مدافعاً عن حقوق مصر الداخلية والخارجية وظل في هذا الجهاد من بعد وفاة سعد زغلول عام 1927 وحتى قيام ثورة يوليو 1952. كما كان النحاس، بحسب صاحب نوبل، مثالاً للنزاهة بين من حكموا مصر، فقد كان يتقاضى راتباً شهرياً زهيداً من الحزب الذي يتزعمه وهو «حزب الوفد» رغم أنه تولى رئاسة الوزارة عدة مرات في وقت كانت فيه رئاسة الحكومة تمثل سبيلاً للثراء، أما هذا الرجل فكان إما يتكسب من المحاماة وإما يصرفون له راتباً ليتفرغ لزعامة «الوفد».
وفي أواخر أيامه، كان جمال عبد الناصر يصرف له راتباً شهرياً حين علم أنه لا يملك ثمن الدواء الذي يتناوله فكان أحد الضباط يذهب إليه كل شهر بمبلغ 300 جنيه وهو مبلغ ليس كبيراً، بالنسبة لمكانته.
عبد الناصر
ويصل الحوار حول زعماء مصر إلى الرئيس جمال عبد الناصر. ويقول سلماوي إنه رأى نجيب محفوظ وقد تهلل وجهه وهو بالمستشفى حين حضر لزيارته الدكتور خالد نجل الزعيم الراحل، وقد قام لأول مرة من مرقده وأخذ يرحب بالزائر قائلاً: «أهلاً بابن الزعيم»، ثم سأل عن المصور وشعر بالأسف لأنه لم يكن هناك مصور موجود في ذلك التوقيت ليلتقط لهما صورة.
هنا ابتسم محفوظ وهو يستعيد تلك الذكرى مع «نجل الزعيم» قائلاً: جمال عبد الناصر هو زعيم ثورة وقد أثر في مصر تأثيراً كبيراً، فقد غيّر تركيبها الطبقي، أي أنه رفع الشعب عدة درجات وحطم الإقطاع دون سفك دماء وعمل إصلاحات لمصر لم تعرفها من قبل ولم يكن به عيب إلا انزلاقه أو انزلاق الديكتاتورية إليه واللعب الشيطاني الذي لعبته أجهزة المخابرات في عهده، لكنه يظل من أعظم زعماء مصر».
وحين سُئل عما إذا كان قد التقاه وجها لوجه، فأجاب: «قابلته عدة مرات في مناسبات عامة ومرة واحدة في مناسبة خاصة، أما المناسبات العامة فكانت في عيد العلم مثلاً حين قلدني وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وكان هذا أول وسام في حياتي وفي عهده أيضاً حصلت على جائزة الدولة التقديرية وفي عهده توليت كل منصب كبير توليته في حياتي».
وأما المناسبة الخاصة فكانت عند افتتاح المبنى الجديد لـ«الأهرام» عام 1968 وقد كان محفوظ جالساً مع الكاتب د. حسين فوزي والشاعر صلاح جاهين والفنان التشكيلي صلاح طاهر حين دخل عليهم عبد الناصر رفقة الكاتب محمد حسنين هيكل. ويذكر محفوظ أن ناصر داعب صلاح جاهين بقوله: «أكل لحمة الرأس جعلتك سميناً»، ثم لاطفه قائلاً: «لماذا لم نقرأ لك قصصاً في (الأهرام) منذ عدة أسابيع»؟
كان ذلك يوم الخميس، فرد هيكل قائلاً: «بالمصادفة له قصة غداً في عدد الجمعة من الجريدة وهي من النوعية التي (تودي في داهية)، فقال له عبد الناصر على الفور: «توديك أنت!».
وهنا يضحك محفوظ عميقاً، ثم يقول لسلماوي: «إن جمال عبد الناصر بالنسبة إلى جيلك هو ما كان سعد زغلول بالنسبة إلى جيلي، رمزاً للوطنية وبطلاً لجيل بأكمله».
ويستعيد نجيب محفوظ ذكرياته مع رحيل جمال عبد الناصر، فيروي أنه كان دائماً ما يأخذ إجازته السنوية في شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام. وفي 1970 عاد من الإسكندرية مساء يوم 28 من هذا الشهر هو وزوجته وابنتاه ولم يكن هناك بالطبع أي استعداد للعشاء بالمنزل الذي كان مغلقاً منذ شهر كامل، فأرسلوا منظفة البيت لتجلب لهم عشاء جاهزاً من أحد المطاعم القريبة.
جلس محفوظ مع أسرته أمام التلفزيون في انتظار الطعام، فلاحظ أن التلفزيون لا يبث سوى القرآن وعندما طال ذلك قال لزوجته إن هناك بالتأكيد كارثة وقعت. وكان الملوك والرؤساء مجتمعين آنذاك في القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الناصر في محاولة لوقف مذبحة أيلول بين الأردن والفلسطينيين. لكن في أثناء ذلك عاد الخادم من المطعم ليقول إنه سمع أن «الريس» توفاه الله فنهره نجيب محفوظ بشدة وقال له ألا يفتح فمه بمثل هذا الكلام وأن يمكث بالبيت ولا يبرحه.
لكن بدأ بداخله الشك والقلق ولم يستطع أن يتذوق الطعام، وبعد دقائق يصف محفوظ مشاعره حين أعلن التلفزيون أن نائب الرئيس سيلقي بياناً، وما إن شاهد وجه أنور السادات على الشاشة، كان هو الذي يقول: الريس مات!
سمع من التلفزيون برحيل عبد الناصر عام 1970، قائلاً: «في تلك اللحظة كنت في حالة شديدة من الارتباك، فمن ناحية لم أكن مصدقاً تماماً داخل نفسي أن عبد الناصر قد مات، فقد كنت أحد المختلفين ليس مع عبد الناصر وإنما مع نظام حكمه وكنت من المعارضين الشرفاء في الكثير من رواياتي خاصة ما كتبته بعد نكسة يونيو 67، وقد قبل عبد الناصر هذه المعارضة ولم يصادر عليها لا في كتاب ولا في فيلم. وفي الوقت نفسه أنا أول المعترفين بمآثره وما فعله للمجتمع المصري والعربي، لكن في هذه اللحظة لم يكن أمامي إلا مآثر هذا الزعيم العظيم».
أنور السادات
وحول علاقته بالرئيس أنور السادات، أوضح محفوظ أن المرة الوحيدة التي منع فيها من الكتابة كانت في عهد السادات، وذلك في بداية عام 1973 حين شارك في التوقيع على بيان ضد «حالة اللاسلم واللاحرب»، صاغه توفيق الحكيم. ونتيجة لذلك، مُنعت جميع أعماله من الإذاعة والتلفزيون هو وتوفيق الحكيم، ولم يعد مسموحاً بأن يُذكر اسم أي منهما رغم أن اسميهما لم يظهرا رسمياً في قائمة الممنوعين من الكتابة والذين نُقلوا إلى هيئة الاستعلامات، لكن عذر السادات – بحسب نجيب محفوظ - في ذلك أنه كان يعد لحرب أكتوبر العظيمة، ولم يكن يريد حدوث خلخلة في الجبهة الداخلية ولم يكن هو يعلم ذلك.