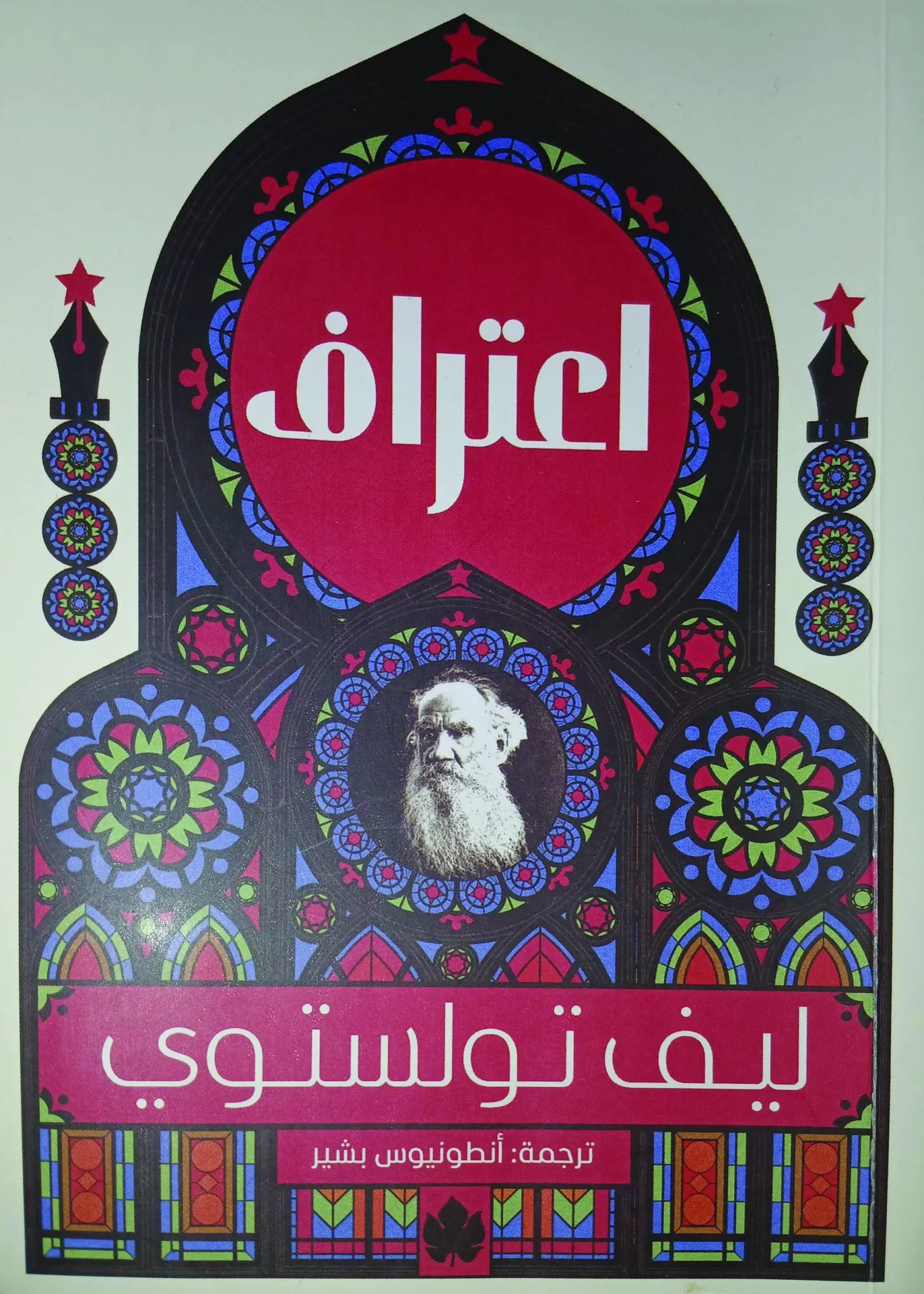اللافت في الكتاب الأخير للكاتب والباحث السوسيولوجي - الأنثروبولوجي الفرنسي إمانويل تود أنه يلخص في عنوانه «هزيمة الغرب» خلاصة 371 صفحة يقدمها للقارئ غنية بالأرقام والمعلومات والمراجع. نقطة انطلاقه حرب أوكرانيا التي تتيح له أن يعرض ويناقش الأسباب التي تجعله يجزم بأن روسيا هي التي ستخرج منتصرة من الحرب، وأن هزيمة أوكرانيا المحققة هي بالدرجة الأولى هزيمة للغرب وللولايات المتحدة.
وكما في كل إصدار جديد، يثير إمانويل تود موجة نقاشات تنحو غالبيتها نحو الانتقاد الآيديولوجي الرافض سلفاً لما يطرحه الخصم، غير مهتم بالبراهين والسياقات التي يعلل بها آراءه وخلاصاته؛ ولذا عُدّ تود «بوقاً» من أبواق روسيا في الغرب وفي فرنسا تحديداً. وعليه، فبات كل ما يأتي به خاطئاً أو زائفاً.

صحيح أنّ تود يبدو متسامحاً مع روسيا وبالغ التشدد مع الغرب، وصحيح أيضاً أنه يحمّل الأخير مسؤولية الحرب، بأن يذكّر مثلاً بتصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند اللذين أعلنا، كل واحد من جانبه، أن «اتفاقية مينسك» التي أنهت الحرب الأولى في أوكرانيا عام 2015 كان هدفها «توفير الوقت اللازم لتسليح كييف» بأسلحة غربية - أطلسية.
ويستعيد الكاتب الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي بوتين في 24 فبراير (شباط) 2022؛ ليبرر حربه على أوكرانيا، وجاء فيها: «لا يمكن أن نقبل بتمدد قواعد الحلف الأطلسي واستخدام الأراضي الأوكرانية لهذا الغرض»، مضيفاً أن ثمة «خطوطاً حمراء تم تجاوزها». لذا فالعمل العسكري الروسي هو «دفاع عن النفس». ومنذ عامين، لم يحد بوتين عن هذه السردية، وكرّرها في مقابلة مطولة أجراها معه الصحافي الأميركي توكر كارلسون، المقرّب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في موسكو يوم الخميس الماضي.

ويرى تود أن حرب أوكرانيا جاءت بعشر مفاجآت، أولها قيام الحرب في أوروبا نفسها التي نظرت إلى الحدث بصفته «غير معقول في قارة ظنت أنها تعيش سلاماً أبدياً». وثانيها أنها وضعت روسيا والولايات المتحدة وجهاً لوجه، فيما كانت واشنطن تعد الصين عدوها الرئيسي وليس روسيا «المتهالكة». أما المفاجأة الثالثة، ففي قدرة كييف على المقاومة بينما كان الغربيون يعتقدون أنها ستنهار خلال 72 ساعة، وأعدوا خططاً وسيناريوهات لإخراج الحكومة الأوكرانية وعلى رأسها فولوديمير زيلينسكي من كييف إلى الغرب. كذلك فاجأت أوكرانيا روسيا نفسها. ومع تمدد الحرب، جاءت المفاجأة الرابعة، وهي قدرة روسيا على مقاومة الضغوط الاقتصادية التي فرضت عليها منذ الأسبوع الأول للحرب، بما في ذلك عزلها عن النظام المالي الدولي. وخامس المفاجآت «انبطاح» الاتحاد الأوروبي، وغياب أي استقلالية عن الإرادة الأميركية. وما يصدم تود تحديداً تلاشي «محور باريس - برلين» الذي كان أساس البناء الأوروبي لصالح محور لندن - وارسو - كييف. ويوجّه الكاتب سهامه لبريطانيا التي تحولت إلى «كلب ينبح» بوجه روسيا ملتحقة بواشنطن. وسادس المفاجآت، انتقال عدوى الالتحاق بواشنطن وبالحلف الأطلسي إلى الدول الاسكندنافية التي «سارت على نهج مسالم» في السابق، وإذ بها تتحول إلى دول «مشاغبة»، بدليل انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي. وسابع المفاجآت عجز الصناعات الدفاعية الأميركية عن توفير الأسلحة والذخائر الكافية للقوات الأوكرانية. وبالمقابل، فإن روسيا ومعها حليفتها بيلاروسيا وهما لا يزنان سوى 3.3 في المائة من الناتج الداخلي الغربي الخام، نجحتا في إنتاج أسلحة أكثر مما أنتجته المصانع الأميركية والأوروبية مجتمعة. أما ثامن المفاجآت فعنوانها «العزلة الآيديولوجية للغرب»، بحيث لم ينجح في جر العالم وراءه ووراء أوكرانيا، مشيراً إلى الصين والهند وبلدان «مجموعة البريكس»، وغالبية أميركا اللاتينية، وغالبية دول آسيا وأفريقيا. وكتب تود: «بعد عام ونصف العام على اندلاع الحرب، ينظر مجمل العالم الإسلامي إلى روسيا بوصفها شريكاً وليست عدواً»، والمفاجأة الأخيرة الآخذة بالبروز تتمثل في توقع حتمية هزيمة الغرب. ويستبق الكاتب الفرنسي منتقديه القائلين إن «الحرب لم تنته بعد»، بالرد: «هزيمة الغرب واقعة لا محالة؛ لأنه آخذ في تدمير نفسه أكثر مما هو ضحية لهجمات روسية».

حلم الأميركيين بإطاحة بوتين لن يتحقق
يرجع الكاتب أحد أسباب قدرة روسيا على الصمود والمواجهة إلى كونها بدأت تستعد لمواجهة العقوبات منذ 2014. ولعل هذه العقوبات بالذات هي التي وفرت ثبات الاقتصاد الروسي، بدليل أن الصادرات الزراعية الروسية بلغت في عام 2020 (30 مليار دولار)، متخطية عائدات الغاز (26 مليار دولار). وتحولت روسيا إلى أول مصدر للمفاعلات النووية ذات الاستخدام السلمي، وإلى ثاني مصدر للأسلحة في العالم بفضل قفزات حققتها في التكنولوجيا الرقمية. ويتوقف الكاتب طويلاً عند قدرة الاقتصاد الروسي على «التأقلم» مع العقوبات من جهة، ومع التحول إلى «اقتصاد حرب»، وهو ما لم ينجح الغربيون في تحقيقه. ويأخذ على الغربيين رؤاهم الزائفة لروسيا التي «يحكمها ديكتاتور دموي (يذكر بستالين) ويسكنها شعب من السذج». ولنقض هذه الصورة، يسرد الكاتب فيضاً من الأرقام، ومنها أن عدد المهندسين الروس يتفوق على عدد نظرائهم من الأميركيين، والأمر نفسه يصح على نسبة المتعلمين، وذلك بالتوازي مع بروز طبقة وسطى ناشطة ودينامية، وتمكن بوتين من الحد من قدرات «الأوليغاركيين» الروس. ويجزم تود بأن «نظام بوتين» المرشح لولاية إضافية «ثابت ومستقر وحلم الأميركيين بتمرد يطيح به لن يتحقق».
ويؤكد الكاتب أن تحدي روسيا للغرب قبل عامين مرده لكونهم «أصبحوا جاهزين عسكرياً»، ولأن ديموغرافيتهم تتراجع، فقد عجلوا في إطلاق الحرب، ويعتقدون أنهم «قادرون على الانتهاء منها خلال خمسة أعوام». وبالمقابل، فإن النواقص الصناعية والعسكرية الغربية تظهر أكثر فأكثر للعيان، وعامل الزمن يلعب لصالح روسيا. ويحذر الكاتب الجانب الأميركي بالقول: «ما تريده روسيا هو الانتصار الكامل ولا شيء آخر».
وصفحة بعد أخرى، يظهر أن الكاتب يتبنى إلى حد بعيد طروحات روسيا بخصوص أوكرانيا، التي وصفها بوتين مؤخراً بأنها «دولة مصطنعة أنشأتها إرادة ستالين في عام 1922»، نافياً عنها صفة «الأمة في دولة». وحسبه هي في أفضل الأحوال «دولة فاشلة» تتجه نحو «العدمية». فأوكرانيا «ينخرها الفساد»، وهي «تؤجر بطون نسائها» للغربيين من أجل الإنجاب، وتقضي على لغة (الروسية) متجذرة تاريخياً فيها، حيث إنها «تنتحر ثقافياً». وما يراه تود غريباً أن منع اللغة الروسية استتبعه مشروع قانون يفرض على الموظفين إتقان الإنجليزية. ويجزم الكاتب بأن كييف كانت قادرة على تجنب الحرب منذ 2014 لو قبلت المطالب الروسية المعقولة الثلاثة وهي: ضم شبه جزيرة القرم لروسيا لأسباب تاريخية، ومنح سكان منطقة الدونباس (شرق أوكرانيا)، وهم من الروس، وضعاً مقبولاً، وأخيراً حياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف الأطلسي. ولكن كييف رفضت بتشجيع من الغرب ما قاد إلى الحرب.
انتحار أوروبا
ليست أوكرانيا وحدها التي تتجه إلى الانتحار بل معها أوروبا (ص 161). والحجة التي يسوقها تود أن الاتحاد الأوروبي الذي كان يسعى ليكون القوة الثالثة المستقلة بين الولايات المتحدة والصين «اختفى تماماً وراء الحلف الأطلسي الخاضع لأميركا»، وأن الدول الاسكندنافية والمشاطئة لبحر البلطيق «أصبحت تابعة مباشرة لواشنطن». وبالتوازي، يؤكد الكاتب أن الحصار المفروض على روسيا «مدمر للاقتصادات الأوروبية»، ومن ذلك ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات والتضخم ما يهدد الصناعات الأوروبية «ويقودنا إلى مفهوم الانتحار».
ولتثبيت نظريته، يؤكد تود أن الميزان التجاري الأوروبي تحول من فائض إيجابي قيمته 116 مليار يورو في 2021 إلى عجز يتجاوز 400 مليار يورو في 2022، ناهيك عن تكلفة باهظة للحرب. ويتساءل: «لماذا يريد الغربيون حرباً بلا نهاية» بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد صيف عام 2023؟
ومرة أخرى يتبنى تود السردية الروسية القائلة إن روسيا «تحارب على حدودها، بينما الجبهة تبعد 3200 كلم عن لندن و8400 كلم عن واشنطن». وخلاصة الكاتب أن «المشروع الأوروبي (الأساسي) مات، وأن أوروبا تحتاج لعدو خارجي وجدته في روسيا». وفي سياق انتقاداته يوجه سهامه إلى بريطانيا التي يصف ردود فعلها بـ«المضحكة»، وهي تحاول الإيحاء بأنها تعيش مرة أخرى «معركة إنجلترا» ضد الجيش الألماني، وقارن وزارة الدفاع البريطانية بـ«أفلام جيمس بوند» وروايات «OSS117» (ص 194)، كما عدّ أن لندن الأكثر تطرفاً بالدفع نحو مواصلة الحرب.
«العصابة الحاكمة في واشنطن»
يُكرّس الكاتب الفصل العاشر في الكتاب وهو بعنوان «العصابة الحاكمة في واشنطن»؛ ليشرح بالأرقام أسباب قوة اليهود في السياسة الخارجية الأميركية. ومخافة اتهامه بمعاداة السامية وهي تهمة رائجة، يحرص الكاتب على تأكيد أنه يتحدر من عائلة يهودية من أصول مجرية. ويذكر تود أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومساعدته فيكتوريا نولاند من أصول يهودية، في حين أن الرئيس بايدن ومستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، كاثوليكيان من أصول آيرلندية، لافتاً إلى أن اليهود لا يشكلون سوى 1.7 في المائة من الشعب الأميركي (ص 288)، فيما تمثيلهم في المواقع الرسمية، وتحديداً المرتبطة بالسياسة الخارجية لا علاقة له بنسبتهم العددية. ويسيطر اليهود على مواقع القرار في المراكز البحثية، والمثال على ذلك أن ثلث أعضاء الهيئة الإدارية لـ«مجلس العلاقات الخارجية» من اليهود، كما أن ثلاثين في المائة من أصل أكبر مائة ثروة في الولايات المتحدة هم أيضاً من اليهود. ولهؤلاء، كما هو معروف، تأثيرهم الكبير على الجامعات والمعاهد العليا على اعتبار أنهم من كبار المانحين، وهو ما ظهر جلياً مع حرب غزة.
ويُفسر الكاتب أهمية اليهود بعاملين: الأول تراجع القيم البروتستانتية لدى المجموعة الحاكمة السابقة وهي «WASP» (الأنغلو ساكسونيون - البيض البروتستانتيون). والثاني تركيزهم على التعليم، وارتياد المعاهد والجامعات الأكثر تميزاً ما يؤهلهم لاحتلال أعلى المراكز.
الكاتب يتبنى إلى حد بعيد طروحات روسيا بخصوص أوكرانيا، التي وصفها بوتين مؤخراً بأنها «دولة مصطنعة أنشأتها إرادة ستالين في عام 1922»، نافياً عنها صفة «الأمة في دولة»
ويحمل الفصل الأخير من كتاب تود عنوان «كيف وقع الأميركيون في الفخ الأوكراني؟»، وفيه يتساءل عن الأسباب التي تجعل أميركا «تدخل في حرب مع روسيا وهي عاجزة عن الانتصار فيها». ويرى تود أن حرب أوكرانيا جاءت خاتمة لدورة زمنية بدأت في 1990 مع انهيار الاتحاد السوفياتي وقناعته أن تمازج عدميتين، أميركية وأوكرانية، سيقود إلى هزيمتهما (ص 339). فبينما كانت الولايات المتحدة غارقة في حروبها (أفغانستان، والعراق...) وكانت الصين تقضي على النسيج الصناعي الأميركي، كانت روسيا تعيد ترتيب أوراقها (ص 347). ومع وصول بوتين إلى السلطة، وجد أمامه بولندا والتشيك والمجر في حلف الأطلسي. وكانت واشنطن تدفع نحو انضمام أوكرانيا أيضاً. وفي 2004، انضمت سبع دول إضافية إلى الحلف، كانت كلها أعضاء في حلف وارسو، وهي: بلغاريا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ورومانيا بحيث شعرت روسيا بالطوق الأميركي حول عنقها. وجاء رد بوتين في خطابه عام 2007، بمناسبة مؤتمر الأمن في ميونيخ واضحاً، حيث أكد أن بلاده «لن تقبل أبداً عالماً أحادي القطب تفرض فيه الولايات المتحدة القانون». ويؤكد الكاتب أنه مع دعوة كييف للانضمام للحلف الأطلسي، خلال قمة بوخارست عام 2008، «نصبت واشنطن الفخ الذي لن تستطيع الإفلات منه (ص 354)».
يستعيد تود السردية الروسية بتأكيده أن أوكرانيا كانت تخطط لهجوم نهاية عام 2021 لاستعادة الدونباس وشبه جزيرة القرم، ما دفع بوتين لمراسلة الحلف الأطلسي لطلب «ضمانات»، بيد أن هذه الضمانات لم تأت، وكانت النتيجة أن روسيا أطلقت حربها أواخر فبراير 2022 «في التوقيت الذي اختارته وبعد دراسة لميزان القوى، حيث وجدت أن هناك نافذة ما بين 2022 و2027». إلا أن انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها شمال وشرق كييف، ثم الهجوم المضاد الذي قامت به خريف العام نفسه «أوجد دينامية دافعة باتجاه الحرب» في واشنطن، وتوجهاً «للمزايدة لن تستطيع التراجع عنها تحت طائل تلقيها هزيمة، ليس فقط محلية بل شاملة: عسكرية واقتصادية وآيديولوجية (ص 366)».
هل تصح توقعات تود؟ السؤال مطروح، والجواب يخضع لعوامل ومتغيرات ليس من السهل التنبؤ بها. تود اختار تبني المقاربة الروسية إلى حد بعيد، ولعل تمسكه بحرفيتها يعد أحد مظاهر ضعف تحليلاته، حيث لم ترد في صفحات كتابه أي قراءة نقدية لما حصل وقد يحصل في الجانب الروسي.