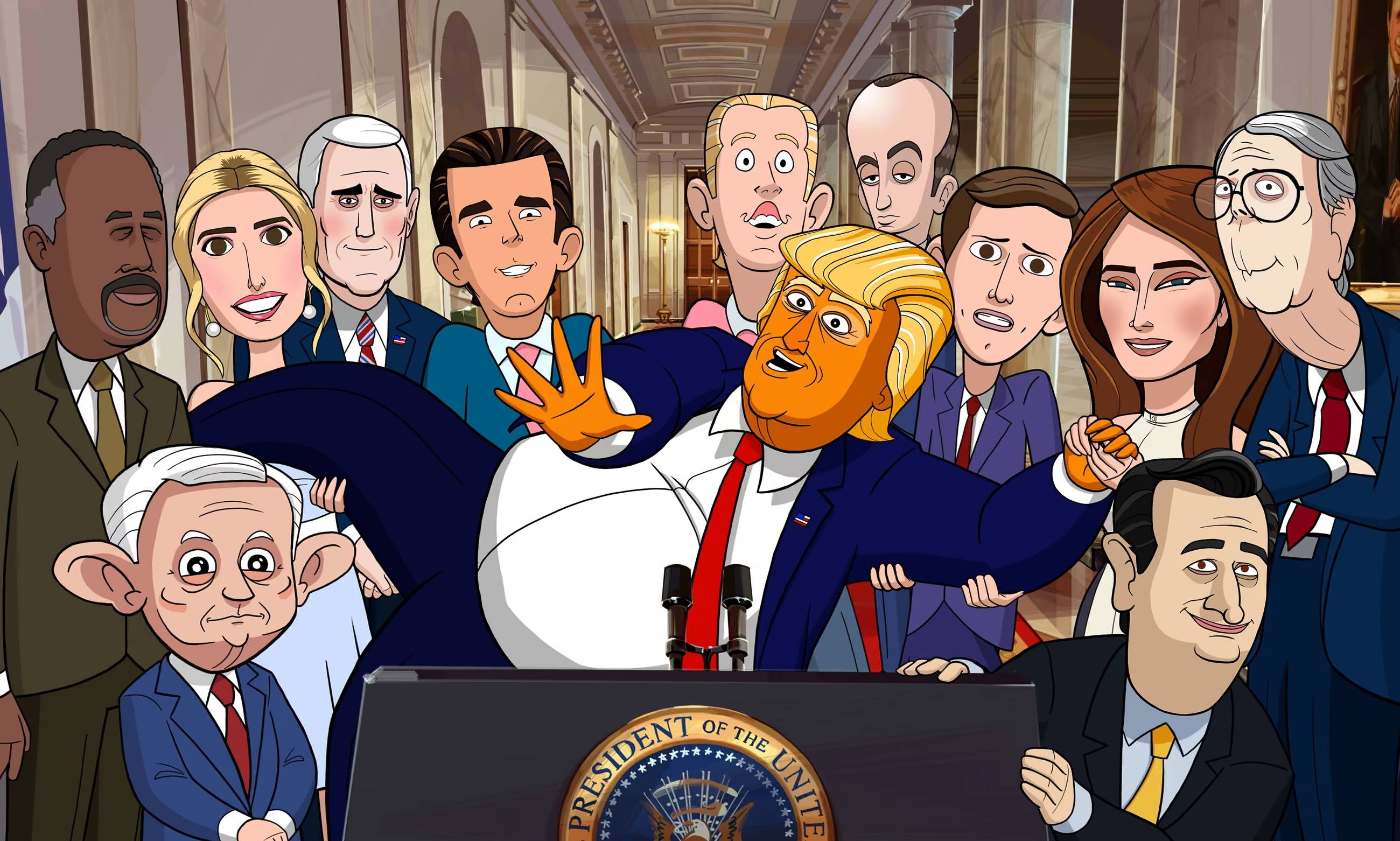أثار خبر زواج السياسي والصحافي المصري أحمد الطنطاوي من الإعلامية المصرية رشا قنديل، تفاعلاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ تصدر اسم الثنائي (الطنطاوي وقنديل) محركات البحث عبر (غوغل)، السبت، بالإضافة إلى تصدر اسميهما موقع «إكس».
وبينما علّق متابعون على الخبر بالتهنئة، وحصروه في إطار «الحياة الشخصية»، تناوله آخرون باعتبار الاثنين من الشخصيات العامة، مع الإشارة إلى «موقف السياسي الذي كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لم يحصل على التوكيلات اللازمة لخوضه الانتخابات».
ويعدّ أحمد الطنطاوي أحد الوجوه البارزة في الأوساط السياسية المصرية، منذ كان عضواً في مجلس النواب بين عامي 2015 – 2020 ضمن تكتل (25 /30) الذي ضمّ أعضاء مؤثرين في ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.
وجاءت التعليقات على منصة «إكس» لتعكس هذا التفاعل، حيث كتب «سامح عسكر» على حسابه أن زواج المذيعة رشا قنديل، من السياسي أحمد الطنطاوي شأن يخصهما، متسائلاً: «ألا توجد قضايا أهم من زواج الناس وطلاقهم؟».

وعدّ خالد البرماوي، الخبير في «السوشيال ميديا» اهتمام الناس بالمشاهير في السياسة والإعلام أمراً طبيعياً، وهو أمر قديم وليس جديداً.
وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عنصر الغرابة ينتفي في حالة الطنطاوي ورشا قنديل، فالاثنان أفكارهما متقاربة، وينتميان للاتجاه نفسه تقريباً، فهو لا ينتمي لليسار وهي لليمين مثلاً، بل يقف الاثنان على أرضية مشتركة. وفق تعبيره.
وكتب صاحب حساب على «إكس» يسمي نفسه أحمد بحيري، حواراً افتراضياً بين شخصين يتحدثان عن «زواج الطنطاوي» ويباركان له، في حين يُشار إلى الجنسية البريطانية التي تحملها الزوجة رشا قنديل، والتي قد تقضي على فرص الطنطاوي في الترشح للرئاسة مرة أخرى.
وتنصّ المادة 141 من الدستور المصري على أن «يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية».
واعتبر السياسي المصري والعضو المؤسس بالحركة المدنية، مجدي حمدان، أن هذا الزواج «يضيع مجهود أحمد الطنطاوي وجهود كل الناس الذين كانوا معه»، مشيراً إلى أن «الجنسية الأخرى التي تحملها زوجته تمنع ترشحه مرة أخرى». وقال حمدان لـ«الشرق الأوسط» إن هذه «الزيجة ترسل رسائل كثيرة للداخل والخارج».
وأضاف موجهاً كلامه لطنطاوي: «لماذا أعطيت الناس الأمل وقلت إنك مستمر إلى نهاية الأمر أو نهايتي، في حين أنك لم تكمل المشوار؟» على حد تعبيره.
ورأى صاحب حساب يحمل اسم حسين سعد عبد الله، على منصة «إكس»، أن مثل هذه الأخبار تأتي من منطلق تشتيت انتباه الناس عن الموضوع الأساسي وهو ثبات المقاومة في غزة.
وأشار البرماوي إلى أن رشا قنديل حين استقالت من «بي بي سي» وانخرطت في إحدى وسائل الإعلام المحلية «مدى مصر» أصبحت مشتبكة مع الواقع المصري أكثر، ووُصف صعود هذا الخبر لدائرة الاهتمام بأنه «أمر عادي ولن يظل طويلاً».

وقدمت رشا قنديل أكثر من برنامج حواري وسياسي في قناة «بي بي سي» العربية، أبرزها برنامج «بلا قيود»، الذي استضافت فيه أحمد الطنطاوي في إحدى حلقاته العام الماضي، وعملت في موقع «مدى مصر»، وشاركت يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن ندوة نظمتها الجامعة الأميركية بالقاهرة للحديث عن «جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة»، وتحدثت رشا قنديل في الندوة عن «دور الإعلام في المؤسسات المنحازة لإسرائيل».

ورغم أن حمدان يصف نفسه بأنه «من المتعاطفين مع الطنطاوي»، وأنه «من الذين حرروا له توكيلاً» فإنه اعتبر «الظروف الحالية المحيطة بالطنطاوي والتوقيت الراهن غير مناسب لخطوة زواجه من رشا قنديل». حسب وصفه.