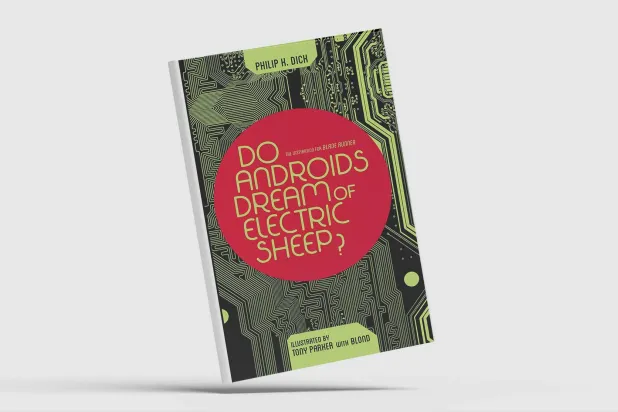منذ تخصصه الأكاديمي في مجال الثقافة الشعبية بالشرق الأوسط، يولي المؤرخ والكاتب الأميركي أندرو سايمون اهتماماً بحثياً خاصاً بهذا المجال الذي يعتبره محورياً، لفهم التحوّلات التاريخية والسياسية والاجتماعية. وكانت دراسته للغة العربية في القاهرة من أسلحته الأساسية للوقوف على تراث تلك الثقافة.
يعمل سايمون مُحاضراً بكلية «دارتموث» في الولايات المتحدة، وأنجز أخيراً كتاباً بعنوان «إعلام الجماهير: ثقافة الكاسيت في مصر الحديثة» الذي صدر عن مطبعة جامعة «ستانفورد»، ومن المُنتظر أن تصدر ترجمته إلى العربية قريباً.
هنا حوار معه حول كتابه الجديد، وعالم الثقافة الشعبية في مصر:
* بداية، ما دافعك الرئيسي لدراسة الثقافة الشعبية العربية؟
- منذ سافرت إلى مصر لأول مرة في صيف عام 2007، كنت أستمتع بالأغاني والأفلام العربية، وغيرها من المُنتجات الثقافية الشعبية، باعتبارها مواد خفيفة وترفيهية. ولكن بعد سنوات فقط بدأت في التعامل مع مثل تلك الأعمال الإبداعية بأسلوب نقدي وتحليلي. وكان أحد الأسئلة التي بدأت تقودني لعالم كتابي، هو سؤال: ماذا يمكن أن تُعلمنا الثقافة الشعبية العربية عن سياقات الماضي والحاضر؟ وحاولت في كتابي «إعلام الجماهير» استكشاف هذا السؤال، من خلال محاولة البحث في تاريخ ثقافي يحظى باهتمام مُجتمع عريض من الجمهور في العالم العربي وخارجه.
* كيف بدأ اهتمامك بـعالم «الكاسيت»؟
- بدأ مع ثورة يناير (كانون الثاني) المصرية في عام 2011. كنت أعيش وقتها في وسط القاهرة، وأُكمل زمالتي لتعلّم اللغة العربية، وأثارت فضولي تلك الأغنيات التي كانت تحفل بها مصر في هذه الفترة، فالتحقت ببرنامج دكتوراه في الولايات المتحدة للتعمّق أكثر في الثقافة الصوتية في مصر، في جامعة «كورنيل». وتعمقت في البحث عن الفنانين المصريين، والأنواع الموسيقية، والتيارات الدينية، وكان في قلب كل تلك المساعي خيط مشترك واحد، هو أشرطة «الكاسيت». وفي هذه المرحلة شرعت في كتابة تاريخ ظهور «الكاسيت» في مصر، كجانب مهم من جوانب التقصي التاريخي لمصر الحديثة.

* ما المصادر البحثية التي اعتمدت عليها في كتابك؟
- بدأت بالبحث في الصحافة المصرية؛ لا سيما المجلات الأسبوعية العريقة، مثل «روز اليوسف»، و«آخر ساعة» التي تُغطي مجموعة واسعة من الشؤون السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، من منتصف القرن العشرين إلى آخره. عند مطالعة تلك الدوريات، لفت نظري حضور شرائط «كاسيت» ليست بصورتها التقليدية والترفيهية بحفظها للأغنيات؛ بل ظهرت شرائط «الكاسيت» في تقارير استقصائية حول «تلوث» الذوق العام على سبيل المثال، وتقارير حول العمالة المصرية في الخارج، و«الكاسيت» بوصفه أحد تمظهراتها الاجتماعية، وغيرها من الموضوعات التي دفعتني للاقتراب والتفكير في كيفية استخدام «الكاسيت» كنافذة على الماضي القريب، باعتبار أنها قد تكشف عما لا نعرفه في وقت ديناميكي للغاية في تاريخ مصر الحديث.
اعتمدت على مجموعة واسعة من تحليل المواد الصوتية والمرئية والنصيّة الموجودة خارج الأرشيف الرسمي. وهي المواد التي تُمثل جزءاً من الحياة اليومية، ما بين تسجيلات «الكاسيت» والصور الشخصية والمجلات الشعبية، وهي عناصر تُشكّل جميعها معاً ما يمكن وصفه بـ«أرشيف الظل» في مصر، بما يقدمه لنا من لمحة حيّة عن لحظة ديناميكية في الماضي القريب لمصر.
* وفقاً لكتابك، كيف مثّلت الثقافة الصوتية أحد أشكال «الوسائط» الإعلامية قبل ظهور الإنترنت والمنصات الرقمية؟
- في مصر، مكّن «الكاسيت» عدداً لا يُحصى من الناس من تداول الثقافة ونشر المعلومات، قبل وقت طويل من دخول الإنترنت حياتنا اليومية، وذلك بطريقة مُغايرة عن الوسائط الجماهيرية الرسمية الأخرى، مثل الراديو. لذلك كانت تُمثل في حد ذاتها «إعلام الجماهير» كما يشير الكتاب الذي حاولت فيه استكشاف كيف كانت تكنولوجيا «الكاسيت»، من نواحٍ كثيرة، تمثل ثقافة جماهيرية قبل ظهور الإنترنت. وشرعتُ في الكشف عن كيف تُسفِر التكنولوجيا التي قد تبدو عادية، عن رؤى غير عادية في تاريخ مصر الحديث.
وإلى جانب فناني الأغاني المشهورين في فترة رواج «الكاسيت»، تطرقت أيضاً في الكتاب إلى ارتفاع موجة الأصوات الدينية الإسلامية، بما فيها أصوات «المشايخ» المحظورة في هذا الوقت.
وطرحت في الكتاب نماذج لثلاث شخصيات دينية، لتقديم لمحة صغيرة عن الثقافة الصوتية الإسلامية الحيّة في مصر التي جسدها «الكاسيت»، من بينها شرائط لشيخ يدعى عنتر سعيد مسلم، وهو شخصية كانت تتمتع بشعبية كبيرة في وقت الثمانينات؛ لكنها الآن منسية إلى حد بعيد، والذي منع الأزهر أشرطته في وقت ما، بسبب أسلوبه غير التقليدي في التلاوة.
وصوت آخر هو صوت الشيخ محمود خليل الحصري الذي كان أول شيخ يقرأ القرآن في الكونغرس الأميركي. وهناك الشيخ عبد الحميد كشك الذي عُرف بخطبه وتعليقاته على الأحداث الراهنة طوال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وكان من اللافت ظهور أجهزة «الكاسيت» بشكل دائم إلى جانبه. وكان هناك حرص على تزويد المسجد الذي يخطب فيه بمنافذ كهربائية أكثر من المساجد الأخرى، لتسجيل خطبه التي كانت تتمتع برواج كبير بين جمهور «الكاسيت» في هذه الفترة.
* أشرت في الكتاب إلى أن ثمة رابطاً بين انتشار «الكاسيت» وصعود ثقافة الاستهلاك والهجرة.
- تزامن ظهور ثقافة «الكاسيت» في مصر مع بزوغ الثقافة الاستهلاكية الجماهيرية، تحديداً مع الطفرة النفطية والانفتاح الاقتصادي. وشهد المجتمع المصري تحولاً من الاشتراكية التي ترعاها الدولة إلى رأسمالية الباب المفتوح. ففي السبعينات والثمانينات، سافر عدد غير مسبوق من المصريين إلى الخارج، بحثاً عن فرص عمل بأجور أعلى، وتحديداً إلى دول الخليج وليبيا والعراق. وبمجرد وصولهم إلى الخارج، لم يكن المهاجرون المصريون يرسلون الأموال إلى عائلاتهم في الوطن وحسب؛ بل كانوا يشترون أيضاً السلع الاستهلاكية، وكان أشهرها على الإطلاق أجهزة «الكاسيت» التي وجدت طريقها إلى مصر. هنا أتذكر المشهد الافتتاحي للفيلم الكوميدي المصري «طير إنت»؛ حيث عاد والدا البطل إلى مصر من الكويت في عام 1985، بجهاز «كاسيت» ثبَّتاه على سطح سيارتهما. إذن، فإن أصول ثقافة «الكاسيت» في مصر عابرة للحدود بالأساس.
تزامن ظهور ثقافة «الكاسيت» في مصر مع بزوغ الثقافة الاستهلاكية الجماهيرية، تحديداً مع الطفرة النفطية والانفتاح الاقتصادي.
* كيف يمكنك وصف أهمية الذاكرة الشعبية مقارنة بالتاريخ الرسمي؟
- طرحت تلك النقطة للمناقشة في الكتاب، وتحديداً: كيف يمكننا عبر فهم الثقافة الشعبية أن يتغيّر لدينا بشكل كبير ما كنا نعتقد أننا نعرفه عن التاريخ؟ أتذكر أني -خلال بحثي- لاحظت المشهد الحاشد لاستقبال الرئيس الأميركي نيكسون عند زيارته لمصر في صيف عام 1974؛ حيث نقلت وسائل الإعلام المصرية آنذاك الترحيب الحار بزيارة هذا الرئيس، لكن من خلال زاوية أخرى وجدت صورة مغايرة تماماً عند الاستماع لأغنية «نيكسون بابا» وتحليلها، والتي غناها الشيخ إمام، من تأليف الشاعر المعروف أحمد فؤاد نجم. وإمام فنان شهير فاقد للبصر، وكان معروفاً بنزعته المعارضة، وكانت أغنياته رائجة عبر شرائط «الكاسيت»، وتحمل وجهاً آخر للقصص التي يتبناها النظام الرسمي. من خلال تلك المقارنات تكمن أهمية إعادة النظر للتاريخ الشعبي.
* هل ننتظر ترجمة عربية لكتابك «إعلام الجماهير» المنشور باللغة الإنجليزية؟
- منذ بدأت العمل في كتاب «إعلام الجماهير» قبل نحو 10 سنوات، وأنا أحلم بمشاركته مع القراء العرب، وسعيد لاقتراب طرح الترجمة العربية للكتاب، ومتحمس للغاية لسماع رأي قُراء العربية فيه.
* بعد شرائط «الكاسيت»، هل تقود مشروعاً بحثياً تاريخياً جديداً في مصر هذه الأيام؟
- أتابع أكثر من مشروع بحثي خلال هذه الفترة؛ أولها كتابة سيرة الشيخ إمام، وما تحمله تلك السيرة من إضاءات عن اليسار العربي، والماضي القريب للشرق الأوسط. في الوقت نفسه، أخوض بحثاً مُطولاً حول ثقافة التسجيلات في الشرق الأوسط، كما أنني بصدد الأرشفة الرقمية لمجموعتي الخاصة من تسجيلات «الكاسيت» التي قمت بجمعها واقتنائها على مدار بحثي في الكتاب، حتى يتمكن أي شخص من الوصول إلى مصادر مختلفة للثقافة الصوتية في مصر واستكشافها، والاستمتاع بها.